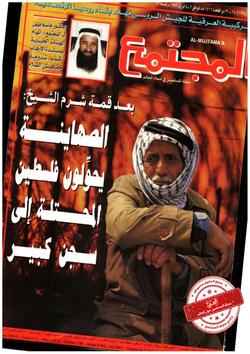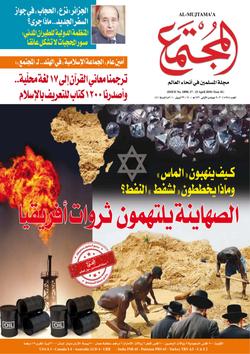العنوان «موسوعة الزاد».. أول دائرة معارف باللغة العربية
الكاتب مراسلو المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 19-نوفمبر-1996
مشاهدات 694
نشر في العدد 1226
نشر في الصفحة 55
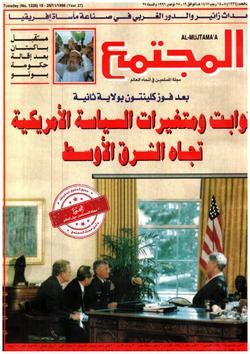
الثلاثاء 19-نوفمبر-1996
كانت المكتبة العربية تفتقر إلى مثل هذه الموسوعة، وكان على الباحث أن يستجمع كما من الكتب يستخرج منها معلومات موثقة، أو كان عليه أن يرجع إلى الموسوعات الأجنبية غير المعربة فيجد أمامه حاجزًا من اللغة، وحاجزًا من المضمون الثقافي للمعلومة المقصودة.
ولقد كانت الكتب الموسوعية أساسًا في نهضة الأمم، وكان انتشارها عنوان نهضتها وانطلاقتها لأن الموسوعة العامة تعطي لكل علم أساسياته فترتفع بالحس العام، وتنهض بالوعي الثقافي بصورة شاملة ومتوازنة، ولا يستقيم الفكر الجمعي إلا إذا وضع بين يديه كتابا مرجعيًّا يقيس عليه تصوراته ومنطلقاته ومعطياته.
ولو بحثنا في بعض أسباب انتقال أمة العرب من عصر الجاهلية، بقيمها وموازينها وأعرافها وعاداتها، إلى أمة الإسلام التي بلغت الذروة في الفكر والإيمان والعمل، لوجدنا أن شمولية مواضيع القرآن الكريم كانت سببًا رئيسيًا من أسباب البناء الحضاري الإسلامي.
ولو نظرنا في أثر الموسوعات على نهضة الأمم من حولنا لوجدنا أن الموسوعة الفرنسية لديدرو ١٧٥١ – ۱۷۷۷ التي أسهم فيها فولتير وروسو ومنتسكيو ويوفون كانت أساسًا في نهضة فرنسا وكذلك الأمر بالنسبة للموسوعة الألمانية والبريطانية، والإيطالية.
إن تشابك العلوم والمعارف، من حيث الفهم ومن حيث التطبيق، جعل اقتناء دائرة المعارف أمرًا ملزمًا، ولا يمكن لأي باحث أو عالم أن يحسن العمل ما لم يستند إلى كتاب مرجعي جامع المختلف العلوم، وهذا ينطبق على علماء الشرع وعلماء العلوم البحتة، إذ كيف لفقيه أن يتكلم في الاقتصاد إن هو لم يطلع على تطور المعاملات التجارية والأسس التي يقوم عليها النقد وحركة الاقتصاد المحلي والعالمي بخطوطه العريضة، وكيف يستقيم تعبيره إن هو لم يدرك مرامي المصطلحات وأصولها واستخداماتها.
والمطلع على أحوال علماء السلف يجدهم يتكلمون في شتَّى العلوم والمعارف في الفلك والطب والرياضيات وغيرها، وهم لا يتحدثون عن هذه العلوم من فراغ، بل كان الواحد منهم يستند إلى ترسانة، مما كتب في هذه العلوم فيشبعها دراسة واستيعابًا، ثم يقيسها على قاعدة الإيمان والعقيدة، فيعطيها بعدًا عقيديًّا وعلميا خاليا من الخرافات والنزعات.
التململ المعرفي:
وقد قامت جريدة الشرق الأوسط بإجراء مسابقة ثقافية في عام ١٩٩٥م، وكان من إفرازات هذه المسابقة أن المشاركين لم يجدوا كتابًا باللغة العربية ينهلون منه إجاباتهم على أسئلة المسابقة وكتب في حينها الأستاذ فهد الطياش بتاريخ 19/٤/١٩٩٥م تحت عنوان أكدت مسابقة الشرق الأوسط الكبرى شكوى القارئ العربي من غياب الموسوعات، فقال:
كشفت مجموعة الرسائل الهائلة التي تردنا من القراء موضوعًا هاما يتعلق بكيفية الحصول على المعلومات، ويعبر كثير من القراء عن الصعوبة الكبرى التي تواجههم في البحث عن موسوعات أو مراجع دقيقة تفيدهم في البحث السريع والدقيق عن المعلومات.. ثم يستطرد قائلًا: فالموسوعة العربية الميسرة الموجودة في الأسواق الآن طبعة قديمة تعود إلى الستينيات، فتخيل معي كم المعلومات والمستجدات التي طرأت على الساحة المعرفية، وفي ختام كلمته يحمل الكاتب دور النشر والمؤسسات الأكاديمية تحقيق رغبات القراء وطموحاتهم في إيجاد موسوعات تسهل عملية الحصول على المعلومات بشكل سريع.
إن هذا التململ يؤكد لنا أن المكتبة العربية بحاجة ماسَّة إلى موسوعة عامة تخاطب المثقف غير المتخصص وتكون له مرجعًا للمعرفة، في مختلف نواحي التأليف والتعريب.
كان بودِّي لو أن موسوعة (الزاد) كانت من نتاج عربي خالص، إذن لحق لنا أن نفخر بما تميز به هذا العمل من شمولية، وتصنيف ومنهجية وترابط بين شتى العلوم والمعارف، وبما اتسم به من صياغة موضوعية تغني الدارس عن التنقل بين شروح الكلمات والمصطلحات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فهي في قسم منها تعريب من الموسوعة السويدية الأم، وفي الآخر تأليف أما التعريب فيبدو أن القائمين عليه أحسنوا صنعًا إذ هم اعتمدوا وضع الحقائق العلمية في سياق الثقافة العربية الإسلامية، كما أحسنوا في تسخير محتواها الثقافي لخدمة المجتمع العربي، وإبانة إسهامات علماء الأمة في مسيرة الحضارة الإنسانية، وأما التأليف فقد أحسنوا في اختيار ثلة من أساتذة الجامعات العربية الإسلامية ليكتبوا عن تاريخ أمتهم، وحضارتها، وأعلامها.
عودة إلى حقائق الأشياء:
لقد اعتاد مؤرخو العلوم إغفال إسهامات العلماء المسلمين في عملية التراكم المعرفي، وفي عملية تخليص العلوم من الخرافات والاتجاهات الفلسفية اليونانية والهندية والفرعونية القديمة ولكأني بهم يطوون ثمانمائة عام من تاريخ البشرية فينتقلون بها من عصور الحضارات القديمة إلى عصر النهضة الأوروبية، والمتأمل فيما يكتب عن تاريخ التعليم مثلًا، يجد تركيزًا واضحًا على أن البنَى التعليمية نشأت في العالم الغربي، وأن أولى المدارس تأسست في الأديرة الأوروبية في نهايات القرون الوسطى، وعند الحديث عن نشأة الجامعات تقرر هذه المصادر أن أول جامعة في التاريخ هي تلك التي أسست في باريس في القرن الثاني عشر نتيجة مدارس الأديرة الأوروبية، إن هذه المغالطات التاريخية والمنطقية لا تترك لنا تفسيرًا آخر غير اتهام القائمين على إملاء التاريخ بأنهم كانوا يسعون إلى طمس كل أثر لمدارس بغداد ودمشق والقاهرة، وقرطبة، وإلى محو كل الشواهد الثابتة على انتقال تيار العلوم من الأندلس إلى الجنوب الأوروبي، فضلًا عن طمسهم وتزويرهم مكتشفات العلماء المسلمين ونظرياتهم وأعمالهم الأدبية والعلمية، ونحن لا نملك إلا أن نتساءل كيف يمكن للشعوب الأوروبية أن تأخذ من جديد زمام الإنسانية بعد قرون من الظلام العلمي الدامس فيقفزون بها من العصور الأولى إلى عصر النهضة دون أن يمروا على جسر الحضارة الإسلامية.
هناك وقائع تاريخية يمر عليها المؤرخ الأوروبي فيضرب عنها صفحا، ولكأنه لا يريد أن يعرف عنها شيئًا، ولا لما خلفته من آثار على مسيرة الحضارة العالمية، ونحن هنا لا نقرر أمورًا، وإنما نلاحظ عددا من الظواهر، نذكر منها ما يلي:
نلاحظ أن المراجع الغربية، وخاصة الموسوعية تؤكد أن الكنائس كانت في فترة من التاريخ مصدر كل الكتب، لأنها كانت تفرض على الكتاب إبداع إنتاجهم في الكنيسة لدراسته، ومن ثم تقرير نشره أو عدمه، ولهذا كان النساخ موظفين في الأديرة، ولا يحق لأي منهم العمل في أي مكان آخر، وكان النتاج العلمي والأدبي تحت رحمة السلطة الثقافية، لا تسمح بنشر إلا ما وافق التيار السائد، فدرستها وأخذت منها ما شاءت وأحرقت وأتلفت ما شات وخاصة كتب علماء الأندلس، حيث خصصت ساحة في كل مدينة لحرق الكتب والعلماء..
الملاحظة الثانية: هي أن عددًا لا بأس به من الكهان «نبغوا» في أمور علمية لم يكن لهم فيها سابق إسهام، وقد تواكب ذلك مع جمع الكتب وإبداعها في الكنائس.
والملاحظة الثالثة: هي أن هناك علماء أسهموا في اكتشافات عالمية أغفلت أسماؤهم من كتب التاريخ، وكأنهم نكرات لا يعرف لها أصول فالحديث مثلًا عن الربان المجهول الذي قاد سفن كولومبوس إلى اكتشاف أمريكا لا يعرف أحد عنه شيئًا، فلماذا كان مجهولا، ثم كيف استطاع الإسبان في عام ١٤٩٢م. أي عام سقوط غرناطة إرسال بعثة بحرية على عجل لاكتشاف أمريكا علما أنهم لم يكونوا قوم علم واكتشاف، بل إن معظمهم لم يتعلم القراءة والكتابة ولا ركوب المحيط لا شك أن مشروع اكتشاف أمريكا بمثل ذلك الحماس والإنفاق لا بد وأنه كان يقوم على أسس واضحة المعالم تتناسب وحجم المغامرة الكبرى. في وقت كانت فيه الأندلس مشتتة مبعثرة، وكانت خزينتها لا تتحمل أي نفقات إضافية، فهل كان ذلك الربان المجهول مسلمًا، أم أنه أصبح مجهولا لأنه كان مسلمًا.
هذه التساؤلات تقودنا إلى أن مؤرخي العلوم أغفلوا عن قصد أو بالإكراه، إسهامات العلماء المسلمين في مسيرة الحضارة الإسلامية، وأن هذا التزوير الثقافي، والانتحال العلمي مازال قائمًا من خلال بسط تاريخ العلوم، ومن خلال تسخير المحتوى الثقافي للحقائق العلمية لخدمة الثقافة الغربية ولاستلاب الأمة العربية من مقوماتها الثقافية ومن إمكانيات استخدام العلوم في التطبيقات العلمية المناسبة المجتمعات الأمة العربية والإسلامية.
ومما تقدم أرى أن الاستكتاب الذي قامت به الزاد، لعدد من علماء الأمة بهدف تسجيل معالم هوية الحضارة العربية الإسلامية، والحديث عن أثرها وأثر علمائها، كان أمرًا مصيبًا ومعبرًا عن حقائق التاريخ وعن أنفة الحاضر، فالأمة التي لا تكتب عن نفسها عرضة للتزوير والانتقاص والاستلاب.
التصنيف الموضوعي والتصنيف المعجمي:
من المعروف أن الموسوعات نوعان نوع يتناول المفردات والمصطلحات بمعانيها وتشعباتها، ونوع يتناول المواضيع فيدرسها بما فيها من مفردات ومصطلحات وتطبيقات، فالنوع الأول أشبه ما يكون بالمعجم الموسع يعطى الباحث المعنى الدقيق لكلمة أشكلت عليه، ولكنه لا يربطها مباشرة بالكلمات والأسماء التي لها صلة بها، بل يعتمد الإحالة بحيث لا تستكمل الفكرة المطلوبة إلا بعد الاطلاع على عدد من معاني المفردات، ولهذا غالبًا ما يطلق على مثل هذه الموسوعات اسم (المعجم الموسوعي) أما النوع الثاني فإنه يعتمد التصنيف الموضوعي أي يتناول الموضوع الواحد بكل جوانبه نشأته وتطوره، وفروعه وأشخاصه وتطبيقاته، بحيث يخرج القارئ بفكرة شاملة ومعلومات وافية عن كل ما له علاقة بالموضوع المطلوب، وبمستوى عالٍ يقف عند حدود الاختصاص.
إن التصنيف الموضوعي الذي اعتمدته «الزاد» أكثر ملاحة للمثقفين عمومًا لأنه يجزيهم عن العودة إلى الكتب الأخرى، فالذي لا يلم بالفلسفة مثلًا، أو بعلم التربية، يكفيه العودة إلى هذا الفصل من موسوعة، «الزاد» ليلم بالخطوط الكبرى لمثل هذه العلوم والمدرس الذي يرغب التوسع في منهج الدراسة يجد في الزاد ضالته ومبتغاه، ورب الأسرة يجد في هذه الموسوعة كل ما يسأله أبناؤه من علوم لم يدركها، ومع ذلك نرى أن حيازة النوعين من التصنيف الموسوعي ضروري لكل مثقف.
الكتاب الذي لا تحسن صياغته يصبح مقبرة للكلمات والمعلومات، وتصبح كمية المعطيات الواردة فيه ركامًا يفسد بعضه بعضًا، ومن هنا تأتي أهمية الصياغة والتصنيف والبسط.
إن تقاطع خطوط العمل التعليمي، وتعدد الزوايا المعرفية، وتسليط الضوء على الموضوع من حيث هو وحدة موضوعية ذات تشعبات وتداخلات في أكثر من حقل من حقول الحياة يحقق مبدا الثقافة المتكاملة، ويشيع المعرفة، ويعمق منهجية التفكير والبحث العلمي.
ولقد انتهى دور المقالات المدبَّجة والكتابات المسهبة والمزخرفة، وجاء دور العبارات الدلالية وتقنيات النشر والإيصال.
المصطلحات الأجنبية:
إن ما تضمنته النصوص من مصطلحات علمية وأدبية باللغة الإنجليزية جعلت القارئ في غنًى عن العودة إلى المعاجم، بل جعلته يخرج بحصيلة من المصطلحات الأجنبية والعربية تؤهله لقراءة الموضوع المشابه في الكتب الإنجليزية دونما عناء يذكر.
ومما لا شك فيه أن اختلاف مدارس الترجمة المصرية والسورية والمغربية والعراقية، أوجدت نوعًا من التباين الطفيف في ترجمة المصطلحات، وقد أدرك القائمون على موسوعة الزاد هذا التباين فأوردوه كلما كان ذلك ممكنًا، وهذا ما أعطاه ميزة أخرى يستفيد منها المثقف العربي ويوسع دائرة اطلاعه.
فن الدراسة:
هذا الكتاب الملحق بالجزء الثامن من الموسوعة من أجمل ما قرأت في كيفية الاستفادة من الدراسة ومن المحاضرات، وفي كيفية إعداد البحوث وعرضها.
ولعل العاملين في البحوث العلمية من طلبة الجامعات وأساتذتها معنيون قبل غيرهم بهذا الكتاب.
إن أهمية هذا الكتاب تنبع من تدريب الفرد على منهجية التفكير ومنهجية التداول بما يوفر الوقت والجهد، وبما يوصل إلى الهدف المطلوب بأسلم الطرق وأنجعها.
أسلمة المعرفة:
يبدو أن القائمين على الموسوعة اجتهدوا في أسلمة المعرفة، وفي اختيار الفاظ ومصطلحات تعمق البعد الإيماني لدى القارئ، فتجعله يتفكر في خلق الله ويقلب وجهه في السماء، فهو عندما يتحدث مثلًا في فصل تكاثر السمك يبدأ القول خلق الله الكون والطبيعة، وحفظ توازنها، وجعل فيها توازنًا مرهونًا بتعدد الأنواع وأعدادها إلخ... وفي فصل آخر يتناول الفكرة ذاتها من باب حماية الحياة البرية فيقول (اقتضت حكمته تعالى أن يكون هناك توازن بيئي، فقال في سورة الحجر: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ * وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾.
ومن الواضح أن أسلمة المعرفة لا يراد بها تطويع العلوم لتتفق مع مذاهب الفقهاء، وإنما المراد هو تحميل النص رسالة ضمنية تنفذ إلى ضمير القارئ لتذكره بفضل الله على الإنسان الذي هداه إلى اكتشاف هذه العلوم وتسخيرها لخدمته.
وأسلمة المعرفة لا تعني أبدًا إغفال الرأي الآخر، ولا الجوانب العلمية التي أسيء استعمالها، بل وضع الاستخدام البديل مقابل الاستخدام المصلحي كالسينما مثلًا، والرسم والتصوير والنحت وغيرها، بحيث لا غضاضة هناك من تعلم قواعد هذه العلوم والبحث في استخدامها لصالح الإنسان لا لصالح المنفعة الشخصية أو المذهبية الفلسفية أو المادية التسويقية.
وأخيرًا:
لا أملك إزاء هذا العمل الموسوعي إلا أن أدعو الله لأصحابه بالخير، ولمن أنفق فيه أن يضاعف له في رزقه، ولمن يقتنيه النفع.
وحري بمؤسساتنا الثقافية أن تساهم في رفع المستوى الثقافي لمجتمعاتنا، وتأخذ زمام التوجيه نحو العلم والمعرفة، وألا تنغلق في أخبار (المجتمع المخملي) التي تسرق منا أوقاتنا، وتبتعد بفكرنا نحو التفاهة والسطحية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلالعلامة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي لـ«المجتمع»: الأدب الإسلامي روح واعتقاد وتصور لإسعاد البشرية وتقويم الحضارة
نشر في العدد 1194
11
الثلاثاء 02-أبريل-1996