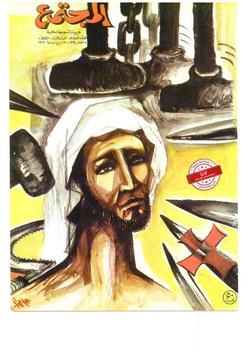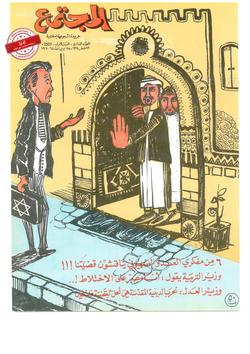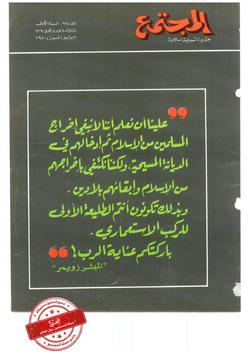العنوان ما سبب تأخر الكويت عن الأخذ بأحكام الشريعة؟
الكاتب عبد الله التائب
تاريخ النشر الثلاثاء 26-مايو-1970
مشاهدات 76
نشر في العدد 11
نشر في الصفحة 8
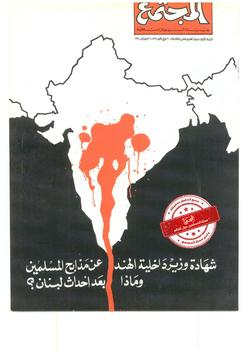
الثلاثاء 26-مايو-1970
تعليق من لندن على حديث وزير العدل الكويتي إلى «جريدة المجتمع»
ما سبب تأخر الكويت عن الأخذ بأحكام الشريعة
عبد الله التائب
في العدد السابع من مجلة «المجتمع» قرأت حديثًا لوزير العدل الكويتي، ووقفت طويلًا أمام سؤال سأله للوزير كاتب الحديث، قال: ما هي العقبات التي تقف في وجه تطبيق الشريعة؟
فأجاب الوزير:
التشريع الإسلامي أو المسؤولية الجنائية من الإسلام لا تختلف عن القانون الوضعي؛ فالتعازير في الشريعة وموجودة في القانون الوضعي... ولكن تتميز الشريعة «بما فوضت للقاضي» بشأن التعازير بحسب اجتهاده ونظرته للعقوبة، والقوانين الوضعية تقيّد القاضي؛ فلكل فعل عقوبة لا يستطيع أن يتعداها أو يجتهد في العقوبة. وإنما الخلاف في الحدود.
وأنا ممن يؤمن أن خالق الخلق ومدبر شئون الكون هو أدرى بمصالح عباده، وأن: «شريعة السماوات نزلت لتحفظ الأرض» ونأمل أن نكون مستقبلاً ممن يأخذ بأحكام الشريعة!!
هكذا كان جواب الوزير.. ووضع بعده كاتب الحديث علامتي تعجب، ومن هذه الكلمات مواضع تحتاج إلـى بیان رأينا تقديمه للناس، أداءً للأمانة التي جعلها الله منوطة بعباده ألا يكتموا العلم الذي منَّ به عليهم، وتبيينًا لمن قرأ حديث وزير العدل من غير المتخصصين الذين قد يأخذون فيه على أنه قضية مسلمة، وصدعًا بالحق الذي قال الوزير في حديثه إنه لا يكرهه إلا من أضله الله!!. ونجمل بياننا في النقاط الثلاث الآتية:-
أولا: بين المسؤولية الجنائية من النظرية الإسلامية والمسؤولية الجنائية في النظريات القانونية الوضعية تباین کالذي بين السماء والأرض، ولو أريد بحث هذا الموضوع بحث استقصاء؛ لاستغرق الصفحات الطوال بل الكتب الكبار.
وخلاصة الأمر أن أساس المسؤولية الجنائية في الإسلام هو الأساس الأخلاقي؛ إذ هي مبنية على أن اجتناب الأفعال المحرمة «الجرائم» أساسه خشية الله وتقواه، والخوف من عذاب الآخرة الذي يقول الله تعالى فيه: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 26).
أما العقوبات الدنيوية في التشريع الإسلامي فليست مقصودة لذاتها؛ وإنما هي في المرتبة الثانية، أو إن شئت فقل في المرتبة الثالثة، التقوى أولًا. وتؤدي إلى الامتثال الاختياري وما يترتب عليه من حسن الصلة بالله وصفاء العلاقة معه سبحانه وتعالى والتقرب إليه.
والعقاب الأخروي ثانيًا وما يؤدي إليه من كف النفس الأمارة بالسوء عن غيّها خوفا منه، والعقاب الدنيوي أخيرًا وما يؤدي إليه من تــرك المحرمات؛ اتقاء العقوبات، وحرصًا على حسن السمعة بين المسلمين، ورغبة في البقاء بين صالحيهم، وقد يبدو الفارق واضحًا لبعض الناس بين النتيجة التي يؤدي إليها العقاب الأخروي والنتيجة التي يؤدي إليها العقاب الدنيوي؛ ولذلك نقول إن الجمع بين نوعي العقاب في شريعة الإسلام هو الذي يجعل المسلم متحرزًا عن إتيان ما حرم الله ورسوله، ولو علم وتأكد من عدم وصول ما يفعل إلى علم الناس إيمانًا منه بأن الله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾. (الكهف: ٤٩).
فإذا نظرنا إلى القوانين الوضعية؛ وجدنا أساس المسؤولية الجنائية فيها أخذ كل مجرم بما كسبت يداه؛ زجرًا له وردعًا لغيره، بزعم أن هذا هو السبيل الوحيد لإصلاح المجتمع ووقايته شر الجريمة والمجرمين، ولا يقوم من ذلك ما يذهب إليه أصحاب المدرسة الوضعية في إيطاليا، والمدرسة الشخصية في فرنسا، والمذهب الاجتماعي في ألمانيا وبريطانيا، فكل هذه متاهات أفكار، الضلال فيها أكثر من الهدى، فضلا عن أنها لم تغير أساس المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية المطبقة في هذه البلاد. وعلى كل حال فليس في قانون الجزاء الكويتي المعمول به، ولا في مشروعه المقدم إلى مجلس الأمة تأثير رأي من هذه المدارس.
ونتيجة قيام هذه المسئولية في القوانين الوضعية على هذا الأساس المادي البحت أساس استمداد العقاب من حاجة المجتمع إليه، ولزومه لمرتكب الجريمة، نتيجة ذلك أن الناس في البلاد التي تحكمها هذه القوانين يتركون الجريمة ما علموا أنهم لا محالة واقعون تحت طائلة السلطة التي ستعاقبهم بما فعلوا، فإن وجدوا ملجأ للحماية من العقاب، أو طريقًا للتحايـل على القانون، أو مأمنًا من جاه أو سلطان؛ تتابعوا من شهواتهم واتبعوا نزواتهم، وظهر في الأرض الفساد، وهذا هو الحال في بلادنا اليوم بعد أن انفصلنا عن تشريعنا وأهملنا ديننا فكنا كالذين قال الله تعالى فيهم ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (مريم: ٥٩) أو كالآخرين الذين ورثوا الكتاب ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٦٩).
ثانيًا: التعازير من الشريعة وموجودة في القانون الوضعي:
هذه القضية لا أساس لها أصلًا؛ فنظرية الشريعة الإسلامية في التعازير لا تزال إلى اليوم -وقد بلغ القرن العشرون خواتيمه- جديدة على العالم الغربي الذي استمدت منه قوانيننا الجنائية وغير الجنائية، وهي جديدة بمعنى أنه لا نظير لها ولا مثيل، ولبيان ذلك نقول: إن التعزير عند فقهاء المسلمين: «عقوبة غير مقدرة تجب حقًّا لله تعالى أو لآدمي من كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة»، أما الحدود فهي: «عقوبة مقدرة تجب حقًّا لله تعالى». وإطلاق تعريف التعزير وإطلاق وجوبه من كل معصية، يعد إحدى المميزات الشاهدة بخلود هذه الشريعة وسموها.
فالمعاصي لا تحديد لها، وهي متجددة بتجدد الزمن، ووسائل الحياة، وطرق التعامل بين الناس متغيرة بتغير العرف من زمان إلى زمان، ومكان إلى مكان، وأمر هذا شأنه لا يتصور فيه التحديد والحصر؛ لذلك كان أولى فيه الإجمال والإطلاق.
ولنضرب مثلًا لما فيه التعزير في شريعة الإسلام لذا كيف يعالجه القانون الوضعي، الوفاء بالعقود والعهود واجب إسلامي، مخالفته توجب في شريعة الإسلام إجبار الناكث والناقض لعهده أو عقده على الوفاء أو التعويض عنه، وتعزيره بما يصلح به حاله فلا يعود إلى مثل فعله، وینزجر به غيره فلا يقلده فيه، وعلى الأول اقتصرت القوانين الوضعية؛ فهي تجبر الناكث على الوفاء أو التعويض، ولا شأن لها بعد ذلك بأخلاقه وأخلاق الناس من حوله؛ أي لا شأن للقانون الجنائي الوضعي بمثل هذه المسألة؛ فهي من خصوصيات القانون المدني أو التجاري حسب الأحوال؛ فالقانون الوضعي إذًا ينظر للأمر من زاوية واحدة لا يتعداها... زاوية تعويض المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر بعدم الوفاء، بينما الشريعة الإسلامية تنظر لعدم الوفاء بمقتضى العهد أو العقد على أنه عمل غير أخلاقي أولًا. وتعالج الضرر الذى لحق المتعاقد الآخر ثانيًا، وتضرب المثل للناس حتى لا يتتابعوا في النقض والنكث، فأين من شمول شريعة الإسلام وإحاطتها، ضيق القوانين الوضعية وانحصارها؟!
أما الحدود التي أمر الله ألا نتعداها فحكم القوانين الوضعية فيها يثير العجب، بل الدهشة أيضًا عند مقارنته بحكم الله فيها، وأعجب منه قبولنا إياه في بلاد الإسلام وبين المسلمين.
بقي بعد ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الجنائية: القصاص والكفارة لا تعرفهما القوانين الوضعية ولا مكان لهما فيها، فكيف يقال بعد ذلك بالتوافق بين الشريعة الإسلامية والقوانين؟!
ثالثًا: يقول وزير العدل الكويتي إنه يؤمن بأن الخالق أدرى بمصالح العباد، ويأمل أن تكون الكويت مستقبلًا ممن يأخذ بأحكام الشريعة.
ولسنا ندري لماذا نترك للمستقبل أن يحقق لنا صفة الآخذين بأحكام الشريعة؟ وما الذي يقعدنا عن ذلك في دولة كالكويت أهلها مسلمون، ووزراؤها مسلمون، وأعضاء هيئتها التشريعية مسلمون، والأسرة الحاكمة أسرة مسلمة.. كل هذه الحقائق تدعونا للتساؤل عن سبب لترك الأخذ بأحكام الشريعة «للمستقبل» بدلاً من الأخذ بها الآن؟!!
إن القوانين جزء من ضمير الجماعة التي تطبق فيها، وهي تشكل حياة الناس بقواعدها التي تطبق على نواحي هذه الحياة، والأجيال التي تُربّى في ظل القوانين الوضعية المستمدة أصلًا من القوانين الغربية لا يتصور أن يكون يسيرًا عليها أن تستبدل بما رُبيت عليه، ونشأت في ظله، قوانين الإسلام والفرصة اليوم سانحة، والصعاب قليلة، والمؤيدون كثرة غالبة، والمعارضون أصوات جوفاء لا تجد لها من سواد الشعب نصيرًا، فلم نبقى على ما نحن عليه ولا نعود إلى حظيرة الإسلام؟!
ولعل خير ختام لهذه العجالة أن نبين مدى خطورة الكلمات التي توهم التوافق بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية المطبقة في بلادنا اليوم، إن هذا الإيهام سلاح ذو حدين؛ فهو يخذل من حول المطالبين بالعودة إلى شريعة الإسلام بدعوى أنه ما دام الخلاف قليلاً أو غير ذي أهمية؛ فلنبق كما نحن بدلاً من التغيير، وما يترتب عليه من اضطراب الأوضاع وتغير القواعد التي ألفها الناس.
وهو من جهة ثانية يصرف الدارسين عن شريعة الله إلى قوانين الناس يجعلونها أساس دراستهم، وتأتي الشريعة بعدها من مكان جانبي أو خلفي لا يلبث أن يجعل قيمتها قيمة أثرية أو تاريخية، لا واقعية ولا عملية ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (آل عمران: ٥٣) ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٤٠) صدق الله العظيم.
بقلم: عبد الله التائب
جامعة لندن
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل