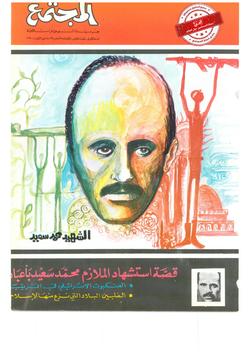العنوان تربوي: 2197
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 01-نوفمبر-2024
مشاهدات 20
نشر في العدد 2197
نشر في الصفحة 60
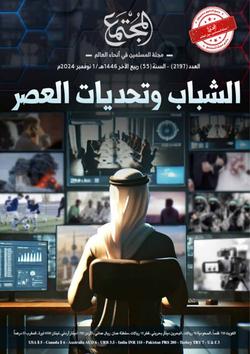
الجمعة 01-نوفمبر-2024
العظماء السبعة
د.أحمد عيسى
دكتوراة في العقيدة وأصول الدين
من يكون هؤلاء
العظماء السبعة الذين يعيشون بيننا؟ ولماذا حازوا التقدير والشرف والمكانة العظمى،
في الدنيا والآخرة، فلا تضرهم الفتن الكبرى ولا يحزنهم الفزع الأكبر؟
قال النبي صلى
الله عليه وسلم: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل،
فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون
إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا» «صحيح الجامع».
ويبلغ الناس
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، في زحام شديد وعرق غامر وانتظار طويل،
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن الله عبادًا سيظلهم في ظله في هذا
اليوم، فقال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، وشاب نشأ
في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه
وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» «رواه
البخاري».
هؤلاء سبعة
أصناف من أمتنا في كل زمان ومكان ارتفعوا بأخلاقهم المكرمة فتنعموا بظل العرش، وقد
نال هؤلاء العظماء
السبعة تلك
الخصوصية والمنزلة، وذلك التقدير والقرب بالإخلاص لله ومخالفة الهوى وهم يكونون معًا،
بصفاتهم العظيمة والمثل العليا والقدوات الحسنة، أركان المجتمع الصالح في انسجام
وتناغم وتكامل.
أولًا: العدل
والإصلاح:
فأول هؤلاء
السبعة الإمام العادل الذي يحكم في رعيته بالعدل بشريعة الله، ويحافظ على حقوقهم،
ويرعى مصالحهم، وقد تمكن من العدل بمخالفة هواه، يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (النساء: ١٣٥)، ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ
أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ
أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: ٥٨)، يشمل الحكم بينهم في الدماء
والأموال والأعراض القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر،
والولي والعدو.
ثانيًا:
النشأة والتربية الصالحة:
والثاني: شاب
نشأ مجتهدًا في عبادة ربه ملتزمًا بطاعته في أمره ونهيه، وخص الشاب بالإشارة؛ لأن
العبادة في الشباب للفتيان والفتيات أشد وأصعب لكثرة دواعي المعصية وغلبة الشهوات
فإذا لازم الشاب العبادة حينئذ دل ذلك على شدة تقواه وعظيم خشيته، قد خالف هواه
وآثر عبادة الله على داعي شبابه، ولا شك أن تربية والديه ومعلميه كان أثرها عظيمًا
على هذه التنشئة.
ثالثًا:
العبادة قلبًا وقالبًا:
والثالث:
الرجل المعلق قلبه في المساجد فهو شديد الحب لها يتردد عليها ويكثر مكثه فيه،
يلازم الجماعة والفرائض وينتظر الصلاة بعد الصلاة، كأن قلبه قنديل من قناديل
المسجد! يقول الله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ
فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (النور: 36)،
يدخل في ذلك الصلاة فرضها ونقلها، وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والدعاء
والذكر، وتعلم العلم وتعليمه، والاعتكاف، وإنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي
له إلى أماكن اللذات واللهو واللغو.
رابعًا:
الأخوة الصادقة والحب في الله:
والرابع:
رجلان أحب كل منهما الآخر في سبيل مرضاة الله، لا لغرض دنيوي، مخالفين الهوى في
علاقة المصالح، وحبهما صادق مستمر في حين اجتماعهما وافتراقهما، يقول الله سبحانه:
﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا
أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: ٦٣)، وكانت الموالاة الإيمانية لها شأن عظيم، حتى إن
النبي عليه الصلاة والسلام أخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة، غير الأخوة
الإيمانية العامة.
خامسًا: العفة
والمراقبة:
والخامس رجل
طلبته للفاحشة امرأة حسناء ذات حسب ونسب ومال وجاه فخالف هواه وفقال: إني أخاف
الله يقول ذلك بلسانه زجرًا لها عن الفاحشة، ويقول ذلك بقلبه ويصدقه فعله بأن
يمنعه خوف الله عن اقتراف ما يغضبه، وهكذا كان يوسف عليه السلام: ﴿وَرَاوَدَتْهُ
الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ
هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (يوسف: ۲۳)، وكذلك يكون دأب المؤمنين
والمؤمنات: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ (الأحزاب: ٣٥)؛ حفظًا
عن الزنى ومقدماته ودوافعه من كشف العورات والنظر إلى النساء والرجال في الحقيقة
والصور والأفلام والإنترنت، والخلوة والصداقة المحرمة.
سادسًا:
الإخلاص والتراحم:
والسادس: رجل
تصدق، فبالغ في إخفاء صدقته على الناس، وسترها عن كل أحد حتى عن نفسه، فلا تعلم
شماله ما تنفق
لنتخيل
مجتمعًا يسود فيه:
- الحكم بالعدل
والإنصاف
- القلوب تتعلق
بالمساجد
- الابتعاد عن
الفواحش
- الذكر والخشية
من الله
- الشباب في الطاعة
- الأخوة
الصادقة والحب في الله
-
التراحم وبذل المال
يمينه،
للمبالغة في الإخفاء والإسرار، وهذا أفضل وأبعد من الرياء، وإن كان يشرع الجهر
بالصدقة والزكاة إن سلمت عن الرياء، وقصد بها حث الغير على الإنفاق وليقتدي به
غيره ولإظهار شعائر الإسلام، قال سبحانه: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا
هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (البقرة:
۲۷۱).
سابعًا: الذكر
والخشية:
والسابع: رجل
ذكر الله بلسانه خاليًا، وتذكر بقلبه عظمة الله تعالى ولقاءه، ووقوفه بين يديه،
ومحاسبته، حال كونه خاليًا منفردًا عن الناس؛ لأنه حينها يكون أبعد عن الرياء أو
خاليًا بقلبه من الالتفات لغير الله حتى ولو كان بين الناس، فسالت دموعه خوفًا من
الله وخشية، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الأنفال: ٢).
لنتخيل مجتمعًا
يسود فيه صفات هؤلاء العظماء السبعة، يسود فيه الحكم بالعدل والإنصاف وينشأ الشباب
والفتيات فيه نشأة الطاعة والتربية الصالحة، وتتعلق القلوب بالمساجد للعبادة قلبًا
وقالبًا، وتنتشر فيه الأخوة الصادقة والحب في الله، ويترفع فيه الرجال والنساء عن
الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقاومون المغريات بالعفة والمراقبة لله.
لنتخيل مجتمعًا
شعاره التراحم وبذل المال للفقراء وكل ما يصلح المجتمع إخلاصًا بعيدًا عن الرياء
والسمعة، مجتمعًا ترتفع فيه الأدعية النقية والتسابيح التقية في قيام الليل وتبتل
الأسحار، ممزوجة بدموع الخشية من الله.
إنه المجتمع
المسلم المنشود، الذي وإن صعب تحقيقه على مستوى الدول فلا يصعب تحقيقه على مستوى
الأفراد والمجتمعات الصغيرة.. ولنجرب!
إن المدينة
الفاضلة «UTOPIA» من
أشهر الأمور الفلسفية التي أثارها أفلاطون، قبل الميلاد، وهي مدينة خيالية يحكمها
الفلاسفة يحلم بأن يسكنها أناس طيبون يعيشون فيها في سلام ووئام وتكافل اجتماعي،
وهي لم تتحقق أبدًا، كما لم تتحقق مع كل الفلسفات الأرضية القديمة والحديثة.
وإذا كان
هنالك مدينة فاضلة واقعية على مر العصور فهي تلك التي أسسها الرسول صلى الله عليه
وسلم في المدينة المنورة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فصبغت حياتهم أخلاق
الإسلام من العدل والإخلاص والتسامح والتآلف والتراحم والعفة وحسن الخلق والتعامل،
وشاعت مشاعر الحب وأروع الأمثلة من العطاء والإيثار، وكانوا جسدًا واحدًا في
السراء والضراء، والآلام والآمال، كأنه قد استنسخ فيهم هؤلاء العظماء السبعة مرات
ومرات وهذا ما نطمع أن يحدث في مجتمعاتنا الآن.
حسن تصوير الأحداث
يحتاج التأثير الدعوي إلى بصيرة تسهم في إدراك الواقع وفهم الواجب تجاهه، من
أجل الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية وإن الدعوة الإسلامية تتطلع إلى تكوين هذه
البصيرة في الدعاة، حتى يدركوا ما تنطوي عليه نفوس الناس، وما يجب لهم من مهارات
وأدوات تستطيع أن تقودهم إلى الصراط المستقيم.
وتأتي هذه السلسلة من المقالات الدعوية تحت عنوان «الأسس النفسية للتأثير
الدعوي، من أجل الوقوف على الركائز النفسية التي يستند إليها الداعية ليحقق النجاح
في مهمته السامية، ويأتي الأساس الرابع عشر بعنوان «حسن تصوير الأحداث».
د. رمضان أبو علي
أستاذ جامعي– دكتوراة في الدعوة
الإسلامية
يقصد بـ«حسن تصوير الأحداث» قيام الداعية بتصوير الأحداث التي يتناولها بطريقة تكشف عن
مضمونها وتعين على استحضارها، من أجل الانتباه لها، وحسن التعامل معها.
التأصيل الشرعي:
إن الناظر في القرآن الكريم يجد أنه يصور الأحداث التي تحمل المعاني والدلالات
الدعوية بطريقة تجعل القارئ يشعر أنه يعيش في وسط هذه الأحداث، وذلك من خلال الحديث عن قصص الأنبياء والصالحين، وما أعده
الله للمؤمنين من أجر عظيم، وتصوير أحوال العصاة والمكذبين وما أعده للكافرين من عقاب أليم.
كل هذا صاغه القرآن الكريم بصورة تأخذ بالعقول والقلوب، حتى لكأن القارئ لها يشعر أنه المخاطب بها، بل إنه سبحانه
وتعالى يجعل في ختامها رسالة موجهة إلى كل من يطالعها، مثل قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ﴾ (القمر: ٣٥)، وقوله: ﴿كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ۱۹۱)، كما حرص القرآن الكريم على غرس القيم من خلال التصوير المؤثر في النفس، ومن
ذلك ما جاء في النهي عن الغيبة، بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحجرات: 12)، فقد صور القرآن المغتاب
بصورة تجعل المؤمن ينفر من هذه الصفة.
أما السنة النبوية، فقد تنوعت فيها الأحاديث التي يحكي فيها الرسول صلى الله
عليه وسلم أحداث الأمم السابقة وما ناله الطائعون والعصاة من الجزاء العادل، كل هذا في صورة واضحة تسهم في غرس المعاني الدينية
والسلوكيات التطبيقية في واقع الحياة الدعوية.
التوظيف النفسي:
يهدف تصوير الأحداث إلى استثارة عواطف الجماهير، فالصورة تعيش في أعماق النفس
في فعالية دائبة، حيث تميل بنا إلى العمل الذي تمثله، وذلك لأنها تحمل عنصرًا شعوريًا وشحنة عاطفية، فتصور حادث محزن يحمل على البكاء، وتصور حادث مفرح يبعث على السرور، وتصور شيء قذر يولد
الاشمئزاز(١)،[1] وهنا
يتبين أن حسن تصوير الأحداث يؤدي إلى تغيير الرأي أو الاتجاه أو السلوك على وفق
مقتضى الصورة.
ولهذا كانت وسائل الإعلام فاعلة ومؤثرة في توجيه الجماهير، حيث إنها تستخدم
خطاب الصورة المجسمة أو المتخيلة، من خلال تسخير إعلاناتها
وبرامجها وأفلامها وأخبارها بشكل منهجي من أجل الترويج الفكرة محددة، سواء كانت
هذه الفكرة قيمة أخلاقية، أم منهجًا تعليميًا، أم تراثًا فكريًا أم نظامًا سياسيًا، أم تسويقًا تجاريًا(٢)، إلى غير ذلك من الأفكار، بحيث يجد الأفراد أنفسهم
أمام فيض من الصور المتنوعة
تصوير الأحداث يهدف إلى استثارة عواطف الجماهير حيث إن الصورة تعيش في أعماق
النفس
ويمكن الداعية من التأثير في المدعوين فيحملهم على قبول رسالته والاقتناع بها والاستجابة
لها
التوظيف الدعوي:
يحرص الداعية على توصيل رسالته إلى الناس من خلال استمالة قلوبهم وإقناع
عقولهم، وضبط فكرهم، وتوجيه سلوكهم إلى الصراط المستقيم، وهذا يستلزم أن يتفنن في
تصوير مادته الدعوية بطريقة تحقق هذا المقصد النبيل، ومما يساعده في حسن تصوير هذه
المادة أن يستخدم الأساليب الآتية:
أولًا: ضرب الأمثال وهو يعني
تشبيه الشيء بغيره من أجل الاعتبار به، وهو أسلوب حسي يهدف إلى تقريب المعاني
ووضعها في صورة محسوسة طلبًا للتوضيح والتأثير، ومن
ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها
مثل المسلم فحدثوني ما هي؟»، فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا:
حدثنا ما هي يا رسول الله! قال: «هي النخلة».(٣)[2]
فقد ضرب النبي صلى الله عليه المسلم المثل حين شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها
وطيب ثمرها والمنفعة الحاصلة من خشبها وورقها وأغصانها ثم جمال نباتها وحسن هيئة
ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم
أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات
وغير ذلك (٤)[3]، وفي هذا التشبيه حسن
تصوير يؤدي إلى التأثير.
ثانيًا: فن حكاية القصص؛ حيث
يحكي الداعية من القصص ما يشبه المشكلة التي يريد علاجها، ويتفنن في تصويرها
وتقريبها من خلال أساليب التشويق وترتيب الأحداث ورسم الصورة الكاملة لها، كأن
المستمع يشاهد أحداثها تقع أمامه، ثم بعد ذلك يؤكد الدروس المستفادة منها في خدمة
موضوعه الذي يتحدث فيه.
ومن الأمثلة التي تدل على ذلك ما صور به القرآن الكريم قصة لوط عليه السلام، حين جاءته
الملائكة وأراد قومه أن يرتكبوا معهم الفاحشة فوقع في حرج شديد وعرض عليهم السبيل
الرشيد فأبوا وأصروا، حتى عاقبهم الله بالعذاب الشديد، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا
سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ (٨٢)
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (هود: ٨٢-٨٣)، والناظر في التصوير القرآني للمشهد يجد أنه يرسم
الصورة الكاملة للأحداث، والنتيجة المترتبة عليها، ثم يسوق الحق سبحانه وتعالى في
خواتيم الآيات ما ينذر الناس إلى يوم
القيامة أن من فعل مثل ما فعلوا فسيصيبه ما أصابهم، وهذه رسالة دعوية واضحة جاءت
بعد تصوير مشهد العذاب، وهي الواردة في قوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾
(هود: 83).
نجاح وسائل الإعلام بالتأثير في الجماهير يرجع لاستخدامها خطاب الصورة المجسمة
أو المتخيلة
ثالثًا: حسن استخدام الحواس في
تصوير الأحداث حيث يستخدم الداعية حواسه في تصوير المعاني التي يريد أن يتحدث
فيها، فإذا كان المعنى المقصود مبشرًا فإنه يبسط وجهه، ويبدي ابتسامته، ويشير بمجامع يده باسطًا جميع أصابعه، راسمًا بذلك صورة مشرقة تضيف إلى كلامه جمالًا وسرورًا، وإذا كان المعنى المقصود منذرًا؛ فإنه يُظهر الحزن على وجهه، ويقبض يده مشيرًا بسبابته راسمًا بذلك صورة غاضبة تضيف إلى كلامه تهديدًا ووعيدًا.
ويدل على ذلك ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله الدعوية التي
نقل عنه فيها مثل هذه التعبيرات من أقوال الرواة: «وكان متكئًا فجلس..»، وكذلك قولهم: «رفع بها صوته»، وقولهم: «وأشار بالسبابة والوسطى»، وقولهم: «وشبك بين أصابعه».. إلى غير ذلك من التوظيف الدعوي لكلام الداعية وصوته وجسده
وإشاراته في حسن تصوير الأحداث وتقريبها للناس بقصد التأثير فيهم.
الدليل على التأثير الناجح:
يسهم حسن تصوير الأحداث في تمكين الداعية من التأثير في المدعوين، حيث ينفذ
بذلك إلى قلوبهم وعقولهم، فيحملهم على قبول رسالته والاقتناع بها والاستجابة لها،
ومن الأمثلة التي تدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم مر بالسوق، داخلًا من بعض العالية «مكان بأعلى أراضي المدينة».
والناس يمشون بجانبه، فمر بجدي أَسَك «مقطوع الأذن» ميت، فقال: «أيكم يحب أن
هذا له بدرهم؟»، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ والله لو كان حيا كان
عيبًا فيه أنه أسك، فكيف وهو
ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا أهون على
الله من هذا عليكم».(٥)[4]
فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حقارة الدنيا عند الله، فصوّرها
لهم في شكل مهين، حتى لا يغتروا بها، وحين أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحث أصحابه على قراءة
القرآن وتعليمه، صور لهم فضل ذلك من خلال
ما تشاهده أعينهم، فقال: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَومٍ إلى بطحان،
أو إلى العَقِيقِ «أقرب المواضع التي تقام
فيها أسواق الإبل إلى المدينة». فَيَأْتِي منه
بناقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ «عظيمة السنام وهي من خير
مال العرب» في غيرِ إِثْم، وَلَا
قَطْعِ رَحِم؟»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، نُحِبُّ ذلك، قَالَ: «أَفَلا
يَغْدُو أَحَدُكُمْ إلى المَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِن
كِتَابٍ الله عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَه مِن نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثَ خَيْرٌ لَهِ
مِن ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِن أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ
الإبل»(٦)[5]، إنه يرسم في أذهانهم
صورة عظيمة لقراءة القرآن وتعلمه من خلال التصوير الجيد للثواب الحاصل منه.
والخلاصة أن الداعية يحتاج في توضيح مقصوده إلى تبيين المعاني وتقريبها لي الناس من خلال حسن تصوير الأحداث وإيضاح جوانبها والكشف عن نتائجها، والتوصية بحسن التصرف تجاهها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل