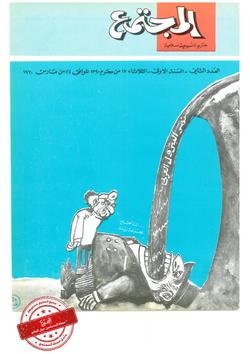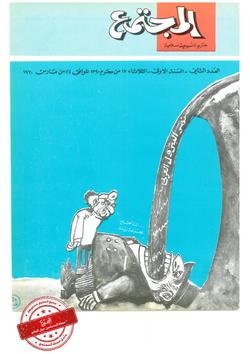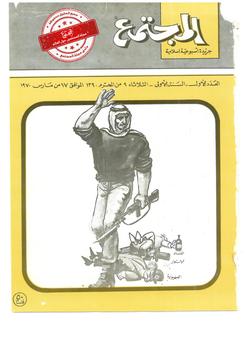العنوان المجتمع..بين فاعليّة المُصْلح وسكون الصَّالِح
الكاتب د. محمد أحمد عزب
تاريخ النشر الأربعاء 01-مارس-2017
مشاهدات 725
نشر في العدد 2105
نشر في الصفحة 77
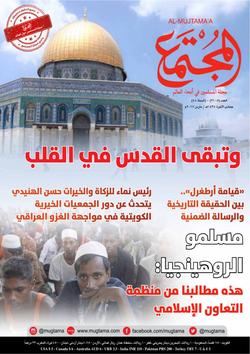
الأربعاء 01-مارس-2017
المجتمع..بين فاعليّة المُصْلح وسكون الصَّالِح
مهمة المصلح تكون حيث يوجد الشر ظناً أو تحققاً فإذا اختفى الشر لم يعد للمصلح ضرورة في الوجود
إنسان الاستخلاف هو الإنسان الفاعل في الحياة يفعل الخير ويأمر به ولا يكتفي في نفسه بالصلاح
أستاذ مشارك بقسم العقيدة بكلية العلوم الإسلامية جامعة المدينة
أوجد الله تعالى الإنسان في الأرض واستخلفه فيها؛ ليقوم بمهمة تعمير الأرض، والانطلاق من التعمير للمصير الذي ملاقيه في نهاية دورة حياته على الأرض.
والاستخلاف في الأرض، يتحقق حين يقوم الإنسان بمهامه المنوطة به؛ من تعمير الأرض والأخذ بأسباب البقاء، والفرار من الوقوع تحت سنة الإهلاك والاستبدال.
في محاولة لفهم طبيعة إنسان الاستخلاف المنوط به تعمير الأرض، ثم استحقاق الفوز في الآخرة؛ نستلهم الصورة ونستشف معالمها من القرآن، إذ يرسم القرآن هذه الصورة لذاك الإنسان.
إن أول مقومات بقاء الكون هو بقاء آثار الرسل وعدم اندراسها، وإنما تندرس آثار الرسل وتنمحي بتعطيل الوسيلة الضامنة لبقائها، وهذا يسوقنا للتأكيد على حقيقة مفادها أن الشريعة تبني الأفراد المصلحين، الذين هم الأقدر على الحفاظ على آثار الرسل والقيام بها والدعوة إليها كلما انحرف مسار الفِطَر، أو بعد عنها أفراد المجتمع.
الإصلاح والعصمة من الهلاك
ونلاحظ في التناول القرآني أن الهلاك والاستبدال لا يلحقان بالأمم التي يشيع فيها الإصلاح بين أفرادها، يقول المولى عز وجل: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ {117}) (هود)، نلاحظ أن الآية عبّرت بلفظ «مصلحون» ولم تعبر بلفظ «صالحون»، يقول الطبري (310هـ): (وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ {117}) فيما بينهم لا يتظالمون، ولكنهم يتعاطون الحق بينهم، وإن كانوا مشركين، وإنما يهلكهم إذا تظالموا(1)، وفي قول الطبري: «يتعاطون» دلالة على عنصر الفاعلية الملحوظ في صيغة الفعل، وإن تعاطي الحق الذي هو مظهر من مظاهر الإصلاح - حتى مع وجود الشرك - ضامن لعدم الهلاك؛ إذ يقول: «يتعاطون الحق بينهم، وإن كانوا مشركين»، وهو ما أكده القرطبي (671هـ) بقوله: «لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد»(2)، فليس الكفر وحده - على ما قرر القرطبي - سبباً للإهلاك، بل قيام الكافر برعاية أسباب البقاء قد يؤخر عقوبته أو يؤجلها بالكلية.
وهو جواب لمن يسأل عن بقاء أمم شتى حولنا لم يلحقها هلاك بكفرها، فقد تلاحظ أنهم تمسكوا ببعض أسباب البقاء، ففي الصحيح أن المستورد القرشي قال عند عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس»، فقال له عمرو: أبصر ما تقول؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً؛ إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك(3).
ويوضح القرطبي أن الإهلاك إنما يكون في المتخاذلين عن الفاعلية والإصلاح، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده»(4).
إذاً؛ تقرر معنا حقيقة أولية هي أن الإصلاح ووجود الفرد المصلح ضرورة للإفلات من الهلاك.
بين الصالح والمصلح
من خلال الآتي ثانياً يتقرر أن الهلاك يلحق الأمم إذا خلت من المصلحين، حتى لو تكاثر فيها الصالحون، ومما يؤكد هذا هو استفهام أم المؤمنين رضي الله عنها قائلة: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ»(5)، بل وجود الصالحين لم يمنع التفرق والتشتت قال تعالى: (وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَماً مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ) (الأعراف:168)، قال البغوي (510هـ): «.. فرقهم الله فتشتت أمرهم ولم تجتمع لهم كلمة»(6)، فلم يكن صلاح بعضهم حائلاً دون تشتتهم وتقطعهم في الأرض.
إن الفرق بين الصالح والمصلح يبدو جلياً في حوار الباغي الإسرائيلي مع الكليم موسى عليه السلام قبل المبعث؛ إذ يقول الله تعالى على لسانه: (إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ {19}) (القصص)، فلقد لحظ ذاك الإسرائيلي بحسه خصيصة الكليم موسى عليه السلام أنها الإصلاح والنجاة بالقوم مما حاق بهم من الاستضعاف، واستنقاذهم من ظلم فرعون، وهذه مهمة المصلح الذي ينازل الشر ليقضي عليه أو يحدّ من فاعليته.
ونلاحظ أيضاً أن إطلاقات القرآن فيما يتعلق بالأنبياء تكون بوصفهم صالحين لا مصلحين، قال تعالى: (وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ {39}) (آل عمران)، وقال: (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ {46}) (آل عمران)، (فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ {50}) (القلم)، وقال تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ) (التحريم:10)، فكيف تأتَّى هذا مع ما يلحظ من كون المصلح أعلى درجة، بل بدرجات من الصالح؟
والحقيقة أن درجة النبوة والرسالة، وما يصحبها من مهمة البلاغ المبين والإصلاح لا تقارن بأي وجه برتبة المصلحين، ولعلنا نجد في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام هذا الملحظ، إذ يدع ربه: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ {100}) (الصافات)، فلو سأله مصلحاً لما كان نبياً، لكنه سأله صالحاً بوصف ما سبق في الأنبياء، فرتبة المصلح هي لغير النبي، لكن حقيقتها وراثة النبوة في فاعليتها وبلاغها المبين، فمهمة الأنبياء أن يكونوا مستنقذين لأقوامهم عن طريق البلاغ المبين الذي هو قمة الفاعلية، قال تعالى: (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ {35}) (النحل)، فليس الاقتصار على صلاح النفس من مهمات الرسل صلوات الله عليهم.
كما أننا نلاحظ أن مهمة المصلح تكون حيث يوجد الشر ظناً أو تحققاً، فإذا اختفى الشر لم يعد للمصلح ضرورة في الوجود، ولذا يكون أهل الخير في الآخرة صالحين وليسوا مصلحين، قال تعالى في وصف بعض من يستحق الجنة من النبيين: (وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {130}) (البقرة:130)، (وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {122}) (النحل)، فلما كانت الجنة موطن جزاء ومثوبة، خالية من الشر، بعيداً عن الفساد، فقد وصف الله أهلها بأنهم صالحون لا مصلحين، حيث لا حاجة لإصلاح بين أناس لا يفعلون الفساد، ولا يقومون بالشر.
ملاحظة أخرى أن الله تعالى يثني بالوصف بالصلاح على بعض عباده بعد قيامهم بالمهمة الأساس وهي الإصلاح من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: (يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ {114}) (آل عمران)، فلقد نالوا من الله تعالى مرتبة الوصف بالصلاح، حين جمعوا بين الإيمان بدرجاته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو عمل المصلح.
فإذا قال بعضهم: إن الله تعالى جعل وراثة الأرض للصالحين وليس المصلحين كما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ {105}) (الأنبياء)، فإن المراد بالأرض هنا هي الجنة على ما ذكره المفسرون، وهو مروي عن عكرمة، وقتادة، وأبي العالية، والشعبي(7).
نخلص من هذا كله أن إنسان الاستخلاف هو الإنسان الفاعل في الحياة، يفعل الخير ويأمر به، لا يُلقي باللائمة على الأقدار من حوله، ولا يكون نصيبه من العمل هو النقد أو التحسر، ولا يكتفي في نفسه بالصلاح، تاركاً من حوله يسقط في هوة الانحراف؛ بحجة الانشغال بالنفس، والفرار من الفتن، الذي هو في حقيقته إيثار للسلامة وركون للراحة بمبرر من الشرع، فهي وسائل العاجزين، ومستراح البطالين، ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة(8)، وبين أنها تبذل لله ورسوله وللمؤمنين وعامتهم، وإنما تحيا المجتمعات دوماً بحراسة الفضيلة وشيوع القيم، وتفشي الأخلاق، وتستحق الكرامة والمثوبة إذا ضمت لذلك الإيمان.>
الهوامش
(1) تفسير الطبري، لمحمد بن جرير الطبري، ط. دار هجر، الأولى: (12/ 632).
(2) تفسير القرطبي، لشمس الدين القرطبي، ط. دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1964م، (9/ 114).
(3) صحيح مسلم (2898).
(4) الترمذي (ح: 3057)، وصححه الألباني.
(5) متفق عليه، البخاري (ح 3168)، ومسلم (ح 2880).
(6) تفسير البغوي، الحسين بن مسعود البغوي، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة (3/ 295).
(7) الدر المنثور، للسيوطي، مركز هجر للبحوث، الناشر: دار هجر - مصر (10/ 387).
(8) متفق عليه، البخاري: (ح 57)، ومسلم: (ح 56).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل