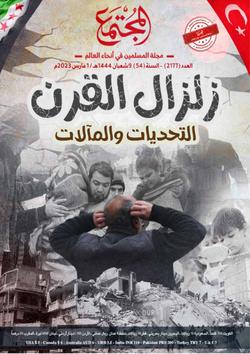العنوان راشد الغنوشي: بالثورة انتهت معركة الهوية والديمقراطية وانتقلنا لمعركة التنمية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأربعاء 01-يونيو-2016
مشاهدات 66
نشر في العدد 2096
نشر في الصفحة 10

الأربعاء 01-يونيو-2016
في أول مقابلة له مع الإعلام بعد فوزه برئاسة النهضة بتونس..
راشد الغنوشي: بالثورة انتهت معركة الهوية والديمقراطية وانتقلنا لمعركة التنمية
التقت «المجتمع» برئيس حزب النهضة التونسي الشيخ راشد الغنوشي في منزله بعد ليلة حافلة بالنشاط الحزبي والخلافات السياسية والفكرية، في طور إقرار اللوائح الجديدة، وانتخابات رئيس الحركة، ومجلس الشورى، وبعد إقرار التحول الإستراتيجي بتجديد هوية الحزب إلى «حزب سياسي وطني ذي مرجعية إسلامية، وفصل الدعوي عن السياسي».. وقد تحدث رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي لـ «المجتمع»، مؤكداً قدرة الحركة على التكيف مع الوضع الجديد، وتأهيلها لتصبح حركة سياسية، وقيماً فعّالة يكون فيها الوطن أعلى من الحزب.
وقد أجرى المقابلة رئيس تحرير مجلة «المجتمع» الأستاذ محمد سالم الراشد، على هامش دعوته لحضور المؤتمر العاشر لحزب النهضة بتونس.
• مرت حركة النهضة بمراحل وتحولات.. فهل يمكنكم تلخيص مسارها الفكري والسياسي في عمرها الزمني؟
- أحيي مجلة «المجتمع» التي سبقت غيرها بهذا الحديث، وذكّرني هذا بأول حديث أجرته معي المجلة في أول إعلان عن هذه الحركة عام 1981م، وكان وقتها د. إسماعيل الشطي هو الذي أجرى الحوار المشهور، وظل جزءاً من تاريخ الحركة، وكل دارسي الحركة يذكّروني بهذا الحدث؛ مما يعتبر في ذلك الوقت جرأة غير معهودة؛ حيث دافعت عن الديمقراطية وأصالتها في الإسلام، واعتبرت سلطة الشعب هي السلطة الحقيقية في الإسلام.
حتى إذا سألني في تلك الندوة صحفي: ماذا تراكم فاعلون إذا انتخب الشعب الحزب الشيوعي؟ أجبت بدون تردد: سنحترم إرادة الشعب! ليس أمامنا إلا أن نقنعه بالتراجع في انتخابات تالية.
لم يكن هذا حديثاً مستساغاً في الأدبيات الإسلامية يومئذ، ولم يكن مستساغاً ذلك التحول في الحركة الإسلامية التونسية نفسها والتي نشأت قبل ذلك بـ10 سنوات، متأثرة بكتابات سيد قطب يرحمه الله في الجاهلية والمجتمع الجاهلي والدولة الجاهلية وتكفير الديمقراطية بطبيعة الحال والاشتراكية وغيرها.
في عام 1981م بدأت نقلة في الحركة الإسلامية من الجماعة الإسلامية إلى الاتجاه الإسلامي، وكانت نقلة من الدفاع عن الهوية إلى معركة الديمقراطية، بدأنا حركتنا عام 1970م، ولكن منذ عام 1970 إلى 1981م ركزنا على أن تونس دولة إسلامية عربية كرد فعل ضد التطرف العلماني (اللائكي) الذي قادته دولة الاستقلال، التي حاولت تهميش الهوية العربية الإسلامية وقامت بإغلاق المعاهد الدينية والكتاتيب وصادرت الأوقاف.
وفي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وتحديداً في عام 1981م حدثت أزمة للنظام التونسي؛ مما اضطره إلى شيء من الانفتاح، فأعلن رئيس الدولة عدم ممانعته في قيام أحزاب معارضة، حيث إنه منذ الاستقلال عام 1956 إلى 1981م كان هناك نظام الحزب الواحد الشمولي والذي يقوده الرئيس «بورقيبة»، وكان رد الفعل على هذا الحزب الشمولي نشوء أحزاب شمولية أخرى، حيث كانت النهضة حزباً شمولياً، والشيوعيون والقوميون أحزاباً شمولية، فكان عصر الشمولية.
وأعلن الرئيس «بورقيبة» أن الدولة مستعدة للاعتراف بأحزاب معارضة، فلم يكن من الحركة إلا أن هيَّأت نفسها فتقدمت، ولم يمر شهران حتى أعلنت عن نفسها حزباً سياسياً يتبنى الديمقراطية والانتقال من اسم الجماعة الإسلامية إلى حركة الاتجاه الإسلامي، فتقدمنا بطلب اعتمادنا وفق قانون الأحزاب كحزب سياسي، وتبنينا الخيار الديمقراطي بدون تحفظ، وذهبنا مع الديمقراطية إلى النهاية لأول مرة، ومع شرعية الانتخاب وشرعية الدولة، ولم يكن الرد الرسمي إيجابياً، فالدولة لم ترحب بهذا التطور، وقد أجرينا استفتاءً داخلياً للانتقال من السرية إلى العلنية، ومرر بنسبة 70%، حيث كنا حركة سرية، وهناك تخوف من العلنية.
ولم يمر على طلبنا أكثر من شهرين حتى بدأت أول عملية اعتقال واسعة، وطرقنا باب القانون، فخرج لنا القانون يحمل عصاه؛ حيث اعتقل أكثر من 5000 شخص بتهمة تكوين حزب غير مرخص، وثلب الرئيس، وبالرغم من أننا طلبنا الترخيص! وقد حكم عليَّ بالسجن عشر سنوات قضيت منها 3 سنوات.
هذه السنوات الثلاث كانت مهمة؛ لأنها سمحت لنا أن نعمق فكرنا، وأن تتوسع مطالعتنا خارج فكر سيد قطب، والمودودي، تعمقنا في فكر مالك بن نبي رحمه الله وفي الفكر اليساري الصادر من أمريكا اللاتينية، بسبب تشابه أوضاعهم مع بلادنا، فتعمقنا في الفكر الديمقراطي والاجتماعي، وأتيحت لنا فرصة للاستفادة من الحركة الإصلاحية في تونس التي نشأت في القرن التاسع عشر بقيادة عدد من المشايخ على رأسهم المصلح الكبير خير الدين باشا، ومشايخ جامع الزيتونة وعلى رأسهم الشيخ سالم بوحاجب، ومن أهم أفكارهم ضرورة التطور، حيث ملأهم شعور عميق بصدمة حضارة وتفوق الغرب، وتأخر المسلمين، فكان الجواب ليس اتهاماً للإسلام وإنما اتهام للمسلمين، والدفاع عن قابلية الإسلام للحضارة والتطور، فكان إحياء الفكر الخلدوني وإحياء فكرة الإصلاح والعدالة ومشروعية الاقتباس حتى من غير المسلمين، فيما يوافق قيم الإسلام ومقاصده، فأعيد نشر كتابات وأدبيات المقاصد؛ مثل مقاصد الشاطبي، وأن للإسلام مقاصد في الإصلاح ومقاومة الفساد، وأن مدار السياسة الشرعية درء المفاسد.
قبل هذه المرحلة كنا نعيش على الأدبيات المشرقية، ولكن في سنوات السجن تجذرت الحركة؛ فأدركنا أن لدينا آباء وأصولاً، وأننا امتداد للتاريخ ولسنا مسقطين على هذه البيئة، من هنا كانت شرعية الاقتباس من الحضارات الأخرى بما فيها الحضارة الغربية في مسائل الحكم والإدارة وتنظيم الحياة.
هذا الانتقال عام 1981م من معركة الهوية إلى معركة الديمقراطية، ومنذ ذلك التاريخ الصراع محتدم مع النظام الشمولي الدكتاتوري التونسي نظام «الحزب الواحد» حتى وإن أصبح بغطاء ديمقراطي، ولكنه شكلي؛ لأنه ظل الحزب الحاكم الذي يسيطر على الدولة والمجتمع سيطرة كاملة، مكتفياً منذ عام 1981م بعناوين ديمقراطية (ديمقراطية الواجهة)؛ حيث اعتراف بأحزاب صغيرة لا تمثل منافساً حقيقياً، والاستمرار في اضطهاد المنافسين الحقيقيين وعلى رأسهم الحركة الإسلامية، فمنذ عام 1981 – 2011م والمعركة محتدمة، هي معركة الديمقراطية، هذه المعركة انتهت بسقوط الدكتاتورية وقيام الثورة، وما كان يمكن الاعتراف بالنهضة في تونس إلا بقيام الثورة، وكنا أكثر المستفيدين من الثورات باعتبارنا أكثر المضطهدين من النظام السابق حيث تعرض عشرات الآلاف للسجون، وما يزيد على 100 شهيد.
• ذكرت في المراحل شرعية الاقتباس من الحضارات، فما الاختلاف بين هذا وادعاء العلمانيين بأنهم يقتبسون من الغرب مواد الحضارة؟
- منذ ذلك الوقت كان هناك مشروعان لتحديث مجتمعاتنا؛ الأول: مشروع تحديث؛ أي دخول العصر والعالم الحديث من بوابة الإسلام والفكر الإسلامي من أجل استيعاب كل القيم الحديثة، والبحث عن حلول لمشكلاتنا، مستفيدين من تجارب الآخرين مع الالتزام بثوابت الإسلام ومقاصده، تحديث في إطار قيم الإسلام، وهذا مشروع تحديثي.
وهذا هو الذي قادته الحركة الإصلاحية في تونس والأستانة والقاهرة في القرن التاسع عشر، وكان هو مشروع الجامعة الإسلامية بقيادة الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، هذا المشروع هو تحديث في خدمة الإسلام وفي إطاره.
الثاني: وهو مشروع للتحديث في إطار الفكر الغربي بما ينتهي به الأمر إلى تهميش الإسلام، وهو تحديث باكتساب القيم الحديثة، ولو أدى ذلك إلى التضحية بالإسلام، فمنذ القرن التاسع عشر نشأ في بلادنا هذان المشروعان، فلم يبق الصراع بين القديم والحديث، كان في البداية رفضاً لكل ما جاء من الغرب، ولكن بعد ذلك مع الحركة الإصلاحية تبلور مشروع استيعاب الحداثة لاحتوائها، وليس للصدام معها.
• كيف تأكدتم من أن معركة الهوية والديمقراطية قد انتهت؟
- بالثورة انتهت معركتان؛ معركة الهوية، ومعركة الديمقراطية، فالثورة اعترفت بالهوية العربية الإسلامية للدولة التونسية، كما نص عليه البند الأول للدستور، والقيم الإسلامية تخللته، فلم يقتصر الأمر على بند واحد، كما هو في المادة الأولى من الدستور لدولة تونس أن لغتها العربية ودينها الإسلام، كما ينص الدستور على أن الدولة يجب أن ترعى الإسلام وأن تحمي مقدساته.
وفي البند (39) أوجب الدستور على الدولة أن تجذر الناشئة بالفكر الإسلامي، فانتهت معركة الهوية، كما حسمت معركة الديمقراطية بالاعتراف بسلطة الشعب وبالحريات العامة والخاصة ومنها حرية الاعتقاد والضمير وحرية الشعائر الدينية واحترامها.
من هنا جاءت النقلة في المؤتمر العاشر؛ فبعد معركة الهوية ومعركة الحرية, وجب الانتقال إلى معركة جديدة هي معركة التنمية.
لم تعد المعركة ذات طابع أيديولوجي، فقد فرغنا من هذا الموضوع، ولا هي معركة الديمقراطية، فالتونسيون يعيشون الحرية في ظل دستور ديمقراطي تقدمي.
وإنما هناك معركة التنمية بما يقتضيه من إصلاحات في التعليم والإدارة والاقتصاد وفي كل مجالات الحياة، بما يوفر للتونسيين العمل، وهو هدف أساسي للثورة بسبب تفاقم البطالة، هناك ما يزيد على 600 ألف عاطل عن العمل (15%)، نصفهم تقريباً يحملون شهادات عليا، قامت الثورة ونسبة البطالة 14%، واليوم نسبتها 15%، يلحق بذلك وجود فوارق جهوية شاسعة كانت سبباً رئيساً لقيام الثورة في المناطق الهامشية الداخلية، وحتى الآن هذه المناطق بعد 5 سنوات من الثورة لا تشعر أنه استجيب لندائها واحتياجاتها، الشباب الذين أحرقوا أنفسهم كانوا من المناطق الداخلية.
لذلك فالحركة اليوم تعدل ساعتها بحسب مشاغل الناس وهمومهم وحسب احتياجات المجتمع، وتعتبر الميدان الأساسي لها اليوم هي معركة الاقتصاد، وهي المعركة الحقيقية وليست الهوية والديمقراطية والدفاع عن الإسلام, فهذه مناطها المجتمع المدني أو الأهلي, أما نحن كحزب مشارك في السلطة فمهمتنا هي حل مشكلات الناس في التشغيل والتعليم والصحة وتوفير الأمن.
• ما التحولات الجديدة والتي سميتموها بالتحول الإستراتيجي؟ وهل هذا التحول هو تحول الحركة إلى شيء من العلمانية كما يدعي البعض؟
- من كل ما سبق؛ فإن هذا اقتضى نوعاً من التخصص والفصل بين أبعاد المشروع الإسلامي المختلفة، بين الوظيفة السياسية وهي وظيفة الحزب، وبقية أبعاد المشروع (الدينية، الثقافية، والعمل الخيري.. وما إلى ذلك).
في المؤتمر الحالي العاشر أنجزت هذه المهمة، وأقر مبدأ تخصص الحزب في المجال السياسي وتركيزه على موضوع الإصلاح والتنمية؛ أي الإصلاح انطلاقاً من الدولة, وتم الفصل مع بقية أبعاد المشروع ليكون مكانها مؤسسات المجتمع المدني؛ كالجمعيات الثقافية والرياضية والنقابات والأعمال الفكرية والتعليمية، وهذا تطور طبيعي وانتقال من العموم إلى الخصوص، وهكذا تتطور كل العلوم والظواهر.
وإذا كان المشروع الإسلامي الشمولي نشأ كرد فعل على مشاريع علمانية شمولية، فقد أسقطت الثورة تلك المشاريع الشمولية، واقتضى تطور الظاهرة الإسلامية أن تدخل مرحلة التخصص والفصل بين الوظائف، وهي سمة من سمات المجتمعات الحديثة.
في مرحلة الدكتاتورية كانت السياسة تتخفى في المساجد, وتحت النقابات والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لأنها كانت محظورة.
بينما اليوم لم يبق هناك مبرر لأن يختفي نشاط تحت نشاط آخر، فكلٌّ يمارس وظيفته بشكل علني وفي إطار الدستور الذي فرض هذا التخصص، إذ حظر الجمع بين وظيفة قيادية في جمعية من الجمعيات ووظيفة قيادية في حزب سياسي.
ولذلك في الانتخابات الماضية فرضنا على عدد من مرشحينا الذين كانوا أئمة وأرادوا أن يترشحوا للمجلس النيابي أن يختاروا بين الإمامة أو النيابة، حتى لا نقع في شبهة توظيف المنابر الدينية لأهداف سياسية، المساجد أماكن عبادة ووحدة وتآخٍ, بينما التنافس الحزبي هو مجال صراع واختلاف،
نرى هذا التطور طبيعياً، ووقت الإنسان محدود، فلا يمكن أن يغطي كل شيء، وأيضاً تجربتنا كشفت أن هذا الخلط ونحن نتحدث عن خلط وظيفي وليس انفصالاً عقلياً بين السياسة والدين، نحن لا نتحدث عن فصل فلسفي؛ أي فصل في عقل المسلم بين السياسة والدين والحياة، نحن نتجه إلى التخصص، وليس إلى فصل في العقل والقيم، نؤثر التخصص والتفرغ والاستقلال العملي لأبعاد المشروع، بلغة أخرى شمولية المشروع الإسلامي لا تعني شمولية التنظيم، فإذا كانت الفكرة الإسلامية شاملة فأداؤها ليس من الضرورة أن يتم من خلال وعاء تنظيمي واحد يضم السياسة والاقتصاد والتربية والعمل الخيري.. إلخ، هذا لا يتناسب مع ظاهرة التطور؛ لأن التطور من سماته التخصص.
جمْع أبعاد المشروع الإسلامي أضر به عملياً؛ لأن تجربتنا بينت أنه كلما اصطدمت السياسة بالدولة، والسياسة عادة مجال للتجاذبات والتدافعات، ماذا يحصل لأجزاء المشروع المترابطة؟ تغلق المساجد ويمنع النشاط المسجدي، باتهامها أنها توظّف لصالح السياسة، ويبدأ بمصادرة كل المشاريع الفكرية والجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية والاجتماعية والتعليمية، كلها تضررت من وراء ارتباطها بالحزب السياسي، ولأن الحزب في كثير من الأحيان يدخل في مصادمات وهذه طبيعة السياسة، ثم إن الحزب أصبح متهماً بأنه يوظف الدين لأغراض سياسية.
كل التيارات الكبرى في العالم من التيار اليساري أو اليميني أو الليبرالي هي في الحقيقة متعددة الأبعاد, من أحزاب تعبر عن هذه التيارات والأفكار, إلى جمعيات ومفكرين ومثقفين وأدباء وإعلاميين, لا يجتمعون تحت مظلة تنظيمية واحدة، ولكنهم يندرجون ضمن أحزاب وجمعيات مستقلة عن بعضها.
ما مبرر الإصرار على أن الظاهرة الإسلامية ينبغي أن يستوعبها تنظيم واحد، فيكون تنظيماً عملاقاً يخلط بين العمل الدعوي والسياسي والمجتمعي، هذا يمكن أن يلوث الحياة السياسية كما يلوث العمل المجتمعي والدعوي.
هذه المرحلة الشمولية أنهتها الثورة والدستور باعتبار التخصص مرحلة متقدمة يقتضيها التطور، التخصص هو سمة المجتمعات الديمقراطية الحديثة وسمة الحضارة.
• علاقة المجتمع بالدولة في بلادنا العربية نشأت بعد حروب التحرير الوطني، فأصبحت الدولة من حيث قدرتها ونفوذها أكبر من المجتمع، والمجتمع أصبح ضعيفاً، ما رأيكم في ذلك؟
- هذه هي الدكتاتورية؛ مجتمع ضعيف ودولة قوية، والحقيقة أن الدولة تبدو قوية ولكنها في النهاية ضعيفة؛ لأن الدولة تقوى بقوة مجتمعها، ولذلك رأينا كيف سقط الاتحاد السوفييتي (نموذج للدولة القوية في مجتمع ضعيف) كورق الخريف، ورأينا الدكتاتورية في العالم العربي، دكتاتورية «صدام حسين» لم تصمد أكثر من 3 أسابيع، بينما الديمقراطيات قاومت، مثل ديمقراطية «تشرشل» قاومت حتى انتصرت، قاومت الفاشية (نموذج للدولة القوية) رغم الأسلحة المتقدمة والتنظيم القوي ومع ذلك انهارت تماماً.
الديمقراطيات ليست ضعيفة بل لها أنياب، فمثلاً انهارت مناطق الأنبار أمام «داعش»، بما في ذلك مدينة مثل الموصل فيها 3 ملايين نسمة، وبنك مركزي، وكميات مهولة من أسلحة، بينما مدينة صغيرة مثل بن قردان في الجنوب التونسي وهي تقع على حدود ليبيا حيث توجد جماعات شبابية تونسية وغير تونسية متمركزة في مناطق من ليبيا حاولوا أن ينتزعوا من السيادة التونسية نقطة صغيرة جداً، ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً؛ لأن هناك مجتمعاً قوياً ملتحماً مع دولته، رغم أن هذا المجتمع كان محتجاً على الدولة لأنها منطقة مهمشة, الناس كانوا غاضبين، وظن أولئك المجرمون أن هذه خبزة سهل تناولها، وأن الأمور ناضجة ليرفعوا علمهم على تلك المدينة ويعلنوها إمارة، ولكن الناس التحموا بالدولة وتصدوا للمهاجمين وصاروا يدلون قوات الأمن على الإرهابيين المختفين في البيوت، لذلك فشل «الدواعش» في أن ينتزعوا أي قطعة من تونس، صحيح أنهم ضربونا ضربات موجعة؛ يضرب ويهرب، وهذا ممكن أن يحدث في أي دولة.
• «داعش» في تونس.. من وراءها؟
- هذا ليس نتاجاً للثورة، وإنما هو إرث للدكتاتورية، باعتبارها إرث «بن علي», وقد حصلت عدة عمليات ومواجهات بين الدولة والشباب المتأثر بتيارات العنف في العهد السابق، وكان من بين هؤلاء حوالي 3000 في السجون، الثورة أطلقت سراحهم؛ لأنها فتحت أبواب السجون، فانطلقوا بسرعة للمساجد، وانتشروا وسيطروا على المئات منها، وأنشؤوا شبكات من العمل الخيري، مستغلين حالة الفوضى وضعف الدولة بعد الثورة؛ لأن الدولة قبل الثورة كانت تبدو قوية مسيطرة تحكم بالرعب، وبعد الثورة انهار كل شيء، واحتاج الأمر إلى مدة حتى يعود للانتظام ليس على أساس الرعب والخوف وإنما على أساس القانون، واحتاج الأمر وقتاً في المرحلة الانتقالية تلك.
توسع الفكر المتطرف العنيف، وانتبهت الدولة بخبرتها المحدودة، وكانت منشغلة ببناء الدستور وإعادة النظام على أساس الحرية وليس على أساس القمع، ولكن الدولة تنبهت لخطرهم بعد سنتين تقريباً، بعدما انتقلوا من مرحلة التبشير والدعاية إلى مرحلة الممارسة، وبدؤوا بالاغتيال السياسي, منذ ذلك الوقت بدأت الدولة تنتبه لهم، وكانت الحكومة بقيادة النهضة في ذلك الوقت، وأقدمت على تصنيفهم تنظيماً إرهابياً، وأعلنت عليهم الحرب، ومُنعوا من عقد مؤتمرهم الثاني.
إذاً نستطيع أن نقول: الإرهاب في تونس ليس من منتوجات الثورة، وإنما هو امتداد للفكر التكفيري في المنطقة، وثمرة من ثمار العهد الدكتاتوري، لا سيما وأن تونس دولة الاستقلال همَّشت المؤسسة الدينية التونسية المعتدلة, وفي هذا السياق جاء إغلاق جامع الزيتونة، وهو أقدم جامعة في العالم، الآن أصبح مسجداً ولم يعد جامعة، يوم الاستقلال كان جامع الزيتونة يدرس 27 ألف طالب، وله معاهد ممتدة على طول البلاد وعرضها، وكان له معهدان في الجزائر، وكان يشع على الإسلام المالكي في أفريقيا، حيث إن تونس كانت تتوافر لها مرجعية دينية.
نشأ فراغ في تونس، هذا الفراغ أنتج الحركة الإسلامية، وهي نفسها نشأت متأثرة بنوع من التشدد كرد فعل على التشدد العلماني، ولكنها لم تلبث أن تفاعلت مع البيئة التونسية ومع العصر، فاعتدلت وبدأت تندمج في المجتمع عام 1981م بطلبها بأن تعتمد حزباً سياسياً، ولكنها جوبهت بالقمع.
إذاً هناك حالة فراغ جعلت المجتمع التونسي في الحقيقة أرضاً منخفضة تهب عليها الرياح من الخارج، يتلقى التأثيرات الخارجية تأثير «الدواعش» و «القاعدة» في غياب المرجعية الدينية التونسية، وفي غياب الحركة الإسلامية المعتدلة التي هي نفسها أقصيت بحجم هائل من العنف شمل عشرات الآلاف من المعتقلين.
• بالرجوع إلى موضوع المرجعية، هل في مشروعكم تطوير لمرجعية دينية في البلاد؟
- لو قارنا مثلاً بين المغرب وتونس ستكتشف الفرق، المغرب في موضوع الإرهاب لم يتعرض إلا لعملية أو عمليتين، السبب أن النظام المغربي أعطى للمؤسسة الدينية دوراً مهماً في مواجهة أفكار التشدد والتطرف والإرهاب، بينما في تونس للأسف لم يتم إدراج المعطى الديني في مقاربة التصدي للإرهاب، إلى الآن ليس هناك إلا الرد الأمني ضد الإرهاب، بينما خلفية الإرهاب خلفية دينية، ولذلك هؤلاء الخوارج يحتاجون علماء يواجهونهم مواجهة فكرية مؤصلة، فهم يعتبرون أنفسهم أهل الدليل.
ولذلك لابد من إعادة المرجعية والمدرسة التونسية العلمية الشرعية، هناك تراث ديني في تونس مثل مدرسة أبي زيد القيرواني، ابن عرفة، المازني، ابن عاشور، نحتاج إلى إحياء وتجديد هذه المدرسة حتى تستأنف السند العلمي في تونس لإنشاء طبقة علمائية قوية.
كان هناك مشروع إصلاحي من داخل جامع الزيتونة يقوده العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور، الاستقلال ألغى هذا المشروع، وكان يمكن لتونس أن تدخل الحداثة من إطار جامع الزيتونة؛ أي تدخل الحداثة من باب الإصلاح الداخلي الذي كان يتم من جامع الزيتونة، ولكن جاء الإصلاح ثورة على الماضي كله، البلاد الآن تحتاج إلى استعادة تراثها الديني، بعيداً عن التوظيف السياسي لهذا الطرف أو ذلك، المطلوب من الدولة أن تقوم بهذه المهمة باعتبار أن الدستور يعتبرها الراعي للدين.
مثلاً هناك 7% فقط من أئمة تونس (بالرغم من وجود 7000 مسجد) تقريباً، هؤلاء في الإطار الديني لا يقل عن 30 ألفاً ليس هناك متخصص في العلوم الدينية إلا 7%، الجامعة الزيتونية إمكاناتها محدودة، الأمر يحتاج إلى نظام تعليمي وجامعة كبرى لتخريج العلماء الأكفاء والأئمة؛ وذلك لنشر الفهم الصحيح للإسلام ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة.
• الآن هذا التطور الجديد في الحركة، كيف ستحاولون تسويقه داخل الحركة نفسها للفهم الذي قد ينعكس باتجاه المشروع السياسي، وفصل الدعوي عنها؟ كيف تستطيعوا أن تسوقوه للقواعد الداخلية والعامة بأن هذا ليس فهماً علمانياً؟
- من المؤكد أن النهضة ليست حزباً علمانياً، هي حزب سياسي ديمقراطي وطني يستند إلى المرجعية الإسلامية دون احتكارها أو النطق باسمها، هذا واضح في كل أدبياتنا وفي كل لوائحنا، لك أن تطلع على أهم لوائح هذا المؤتمر، وقد أدرنا حوارات داخلية طويلة ومعمقة ومع أوسع عدد من أعضائنا وحتى أصدقائنا طيلة سنتين، كما تم عرض هذه اللوائح ومناقشتها في أكثر من 400 مؤتمر محلي وجهوي بين عشرات الآلاف من منخرطينا, ومن خلال هذا النقاش نشأ توافق أو إجماع حول الوجهة العامة، ولذلك في المؤتمر العام الذي جمع 1200 مؤتمِر, تم إقرار اللوائح السبع بنسبة عالية تفوق الـ80% بما يشبه الإجماع.
• رأينا حركة الثورات منذ عام 2011م حتى اليوم، هذه الثورات متفاوتة في قدرتها على التكيف مع الأوضاع، وفي الوقت نفسه تواجه الثورات المضادة، النتائج اليوم لها تأثير كبير جداً على العالمين العربي والإسلامي من جانبين؛ تدهور المجتمعات، وتآكل هامش الدولة، ما توقعاتك على ضوء هذه التغيرات؟
- على كل حال، تونس أطلقت شرارة ثورات «الربيع العربي»، وحافظت عليها في الوقت نفسه، لديَّ القناعة الشديدة بأن تلك الشرارة أدخلت المنطقة العربية في طور جديد، ليس في تونس فقط ولكن المنطقة كلها، وما يبدو اليوم وكأن تلك الشرارة قضي عليها نهائياً في بعض البلدان وأننا عدنا إلى ما كنا عليه بل أسوأ، هذا بادئ الرأي (ظاهر الأمر)، أما الحقيقة فتلك الشرارة لا تزال تعمل عملها، وتعطي آثارها بأشكال مختلفة، ولكن لا عودة إلى الماضي، قد يبدو الأمر في مصر أسوأ من الماضي، حتى إن العودة لعهد مبارك يبدو حلماً بعيد المنال، ولكن الوضع الآن مختلف عما كان عليه قبل الثورات.
قبل الثورة، حركة مثل «كفاية»، وهي مجموعة صغيرة من المثقفين، كان خروجها في تظاهرة أمراً غريباً، ويمثل حدثاً كبيراً، بينما اليوم رغم القمع لا يخلو يوم من تظاهرات في الأرياف والقرى والمدن والجامعات؛ بما يعني أن هناك شيئاً جديداً قد حصل، الناس تحرروا، كسروا جدار الخوف، سقطت هيبة الدكتاتورية، وهذا ما يفسر حجم العنف الذي تمارسه؛ لأنها مرعوبة، الناس استعادوا ثقتهم في أنفسهم.
• المنطقة دخلت في مخاض التغيير، متى سيفضي إلى نتائجه؟
- مسار الثورات ليس خطاً صاعداً أبداً، خط الثورات هو خط مضطرب، الثورة الفرنسية أمضت قرناً حتى تحقق انتقالها من نظام ديني مقدس إلى نظام ديمقراطي، مرت الولايات المتحدة بحرب أهلية طاحنة ذهبت بالملايين، الثورة الإنجليزية قضت عقوداً، ثورة إسبانيا والبرتغال وأوروبا الشرقية كلها أمضت عشرات السنوات من التقلب، الفرق ما بين تونس وغيرها من الثورات العربية هو فرق موضوعي، إذ إن الأوضاع مختلفة، بحيث لا تستطيع أن تمارس السياسة في مصر متجاهلاً دور الجيش، الدولة دولته وهو أنشأها، الانقسامات الطائفية في سورية والعراق هذه لها دور كبير، فرق بين تونس وسورية، المجتمع التونسي منسجم عقائدياً وسكانياً ولغة وديناً، ولذلك عندما قامت الثورة في تونس وجد «بن علي» نفسه وحيداً لا يثق في أحد، بينما «الأسد» لديه رصيد مرتبط معه، ولكن كون الأوضاع مختلفة لا يعني ثورة تنجح وغيرها تفشل، التغيير حصل في النفوس قبل أن يحصل في الواقع ما دامت الثورة نجحت في بلد لماذا لا تنجح في بلد آخر؟
تكاليف التغيير وزمن التغيير سيختلفان، ومدى حكمة إدارة النخبة للحدث بحسب تعقد الأوضاع.
لم يكن من الحكمة التورط في العنف في سورية، نجح النظام في جر المعارضة للعنف، تكاليف السلم أقل من تكاليف العنف، بعكس ما يثار أن المسارعة إلى العنف سيقلل التكاليف، فن إدارة المعركة إما أن يقل الثمن أو يخففه، ينبغي أن يكون التحرك وطنياً وليس دينياً ولا فئوياً، لأن هذا مفيد للنظام أن يخرج المعركة في ثوب أنها معركة بين نظام يحمي الأقليات والتعدد وبديل يريد أن يقضي على الأقليات، وفي مصر أي معادلة سياسية تتجاهل الجيش، أو تتجاهل الإخوان أو الليبراليين لا يمكن أن تنجح، وستكون لصالح الدكتاتورية.
السياسة هو فن إدراك ميزان القوى، كيف تحسن قراءة موازين القوى وتنزل سياستك وفق هذا الإطار، أي قراءة خاطئة في ميزان القوى تؤدي إلى كارثة؛ «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها», وليس علماء الدين هم من يحدد هذا الوسع؛ لأنه ليس موضوع حلال وحرام، هذه قراءة تحتاج إلى عالم بالواقع, إلى سياسي يقرأ ميزان القوى السياسية، وعلماء في الإستراتيجية، وفي القانون والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية، هؤلاء هم الذين يقرؤون موازين القوى.
وميزان القوى لا يتحدد بالكم فقط، وهذا الخطأ كثيراً ما نقع فيه، فنحن نخطئ خطأ شديداً إذ لا نقرأ ميزان القوى بأبعاده المختلفة، ولذلك معظم الأخطاء السياسية آتية من سوء تقدير الموقف، تقدير الموقف مهم جداً؛ مثلاً في الطب تشخيص الداء هو الخطوة الرئيسة للدواء.
ولذلك العلوم التي ينبغي أن ننميها كأحزاب سياسية هي العلوم التي تعين على حسن تقدير الموقف؛ أي على قراءة موازين القوى، وذلك هو الحكمة حيث وضع الشيء في موضعه.
ونحن وقعنا في هذا، أخذنا من الحكم في عام 2011م ما يتجاوز ميزان القوى، ميزان القوى لم يكن يسمح للنهضة أن تأخذ الحكم والوزارات الكبرى ورئاسة الحكومة، هذه طفرة حماسية، سرعان ما عادت موازين القوى تعمل عملها، ولولا انسحابنا لسقط السقف على رؤوسنا، لم يكن في الإمكان المحافظة على الحكم إلا بسقوط التجربة؛ لأن ميزان القوى لا يسمح لنا إلا المشاركة وليس القيادة، ولذلك أُنقذت الثورة والديمقراطية والبلد والنهضة عند انسحابنا، ورفعنا شعار «تونس أعز علينا من النهضة»، أو كما يقول الرئيس الباجي: «الوطن قبل الأحزاب»، خروجنا من الحكومة حفظ تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وحفظ تونس من الارتكاس إلى الدكتاتورية أو السقوط في الفوضى، وقد تبنينا عدداً من المبادئ نعتقد بأنها ساهمت في صنع النجاح التونسي, وهي مبدأ الحوار بين جميع الأطراف لحل الخلافات, الابتعاد عن الإقصاء والاستقطاب الأيديولوجي, وتبني مبدأ الوفاق كسبيل وحيد لحفظ وحدتنا الوطنية وحفظ تجربتنا الديمقراطية الوليدة.
• البعض يحمل حركة الإخوان في مصر ما حدث، من خلال استقرائك للوضع، ماذا تنصح في هذا الصدد؟
- لا نتمنى إلا الخير لكل مصر وشعبها، فقوة مصر هي من قوة العالم العربي، وضعفها هو ضعف للعالم العربي؛ إذ إن مصر هي قلب العروبة, لذا يتألم كل محبي مصر لما يحدث، ما أرى سبيلاً إلا البحث عن تسويات ومصالحات كبرى، إذا لم تكن متاحة اليوم ستتوافر ظروفها في الأيام القادمة، كل من يتجاهل المكونات الحقيقية للشعب المصري ويتصور أنه يمكن القفز فوقها سيخطئ الحساب، فلا يمكن القفز فوق مكون الجيش، ولذلك لا ينبغي استفزازه بشعار «يسقط حكم العسكر»، هذا شعار خاطئ؛ لأنه يضع الحل مقابل إقصاء الجيش، ولا يمكن إقصاء الجيش في مصر، الجيش ينبغي أن يكون جزءاً من الحل، أيضاً من يظن الأرض ستبتلع الإخوان هذا تصور خيالي، الإخوان مثل أهرامات مصر، جزء لا يتجزأ، لا يمكن تصور مصر دون إخوان.
في مصر أقباط أيضاً، هذه حقيقة من حقائق الحالة المصرية، كما يوجد في مصر نخبة ليبرالية قوية ونافذة.
فأي معادلة تختزل هذه الحقائق في شيء واحد (إخوان أو جيش أو أقباط) فهذا ليس معناه إلا إطالة النزيف المصري.
ولذلك لا بد من البحث عن تسوية تأخذ بعين الاعتبار الحقائق المصرية الصلبة، وتوطن الكل، وتشارك الجميع، وتجعل الجميع جزءاً من الحل وليس من المشكلة.
• التدخل الإيراني، هل هذا التدخل سيستمر في تقديرك؟
- للأسف هناك شعور في المنطقة أن السياسة الإيرانية الإقليمية تنحو منحى توسعياً، وصلت حتى زعم بعض المسؤولين الإيرانيين السيطرة على عدد من العواصم العربية.
هذا الشعور إن تجذر، وهذه السياسة إن تواصلت خطيرة ومضرة، ليس فقط لبلدان المنطقة، ولكن لإيران أيضاً؛ لأنها تغذي نيران الفتنة الطائفية، لا يمكن لإيران أن تسيطر على المنطقة؛ لأنها متعددة، وهي منطقة في أغلبها سُنية، لا يمكن القفز فوق هذه الحقائق.
نحتاج إلى خلق حالة توازن في المنطقة؛ لأن ذلك ربما يقنع كل الأطراف باستحالة استفراد طرف واحد بالسيطرة عليها، ولذلك فالمشروع الذي يبدو أن الملك سلمان يقوده في محاولة للجمع بين السعودية وتركيا ومصر، هذا مشروع لو كُتب له النجاح قادر على أن يُحدث التوازن, وهذا سيكون في مصلحة الجميع؛ لأن التوسع كثيراً ما يقضي على الإمبراطوريات، وهو أيضاً لصالح السُّنة والشيعة؛ لأنه يبعد الحرب الطائفية التي هي مدمرة للجميع ولا رابح فيها، الحرب سببها في كثير من الأحيان طموح غير مشروع للهيمنة، ولذلك استعادة التوازن في المنطقة مهم جداً.
• أعطنا ملامح لمشروع مواجهة التمدد الإيراني؟
- مواجهة إيران ليس مشروعاً، إنما المشروع الحقيقي هو التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتطوير علمي يوفر لهذه الشعوب مقومات الحياة ومقومات الدفاع عن نفسها، والمنطقة حالياً غير قادرة على توفير احتياجات شعوبها، ولا هي قادرة على الدفاع عن نفسها، والسبب هو التجزئة والعجز عن البحث عن مقومات حياتها والدفاع عن هذه المقومات وتحقيق طموحات الشعوب في التعاون والوحدة والتنسيق والتخطيط المشترك، وهذا يقتضي التخفيف من الحواجز بين الشعوب والدول، الحواجز في انتقال الأشخاص والأفكار والسلع التجارية، رسم إستراتجية مشتركة، ليس بالضرورة أن تكون المعادلة ما بين وحدة اندماجية وقطع الحدود وما يشبه الحرب الباردة، أوروبا 27 دولة محافظة على راياتها وعلى وزاراتها وسيادتها، ولكنهم خففوا من وقع السيادة بحيث تمر من دولة لأخرى لا تشعر بأنك انتقلت.
• هل يمكن التواصل مع العلمانيين؟
- لا ينبغي أن نحكم على العلمانيين حكماً واحداً وكأنهم شيء واحد، هناك علمانيون ديمقراطيون، وهناك علمانيون استئصاليون، كما أن هناك إسلاميين ديمقراطيين، وإسلاميين متطرفين، ولذلك من الممكن أن نتعايش مع علماني ديمقراطي، ومستحيل أن نتعايش مع إسلامي تكفيري؛ لأنه يستحل دماءنا.
أطلق الأكاديميون الغربيون على الظاهرة الإسلامية مصطلح «الإسلام السياسي»، ليميزوه عن «الإسلام اللاسياسي», ونحن نعتبر أن هذا المصطلح ليس دقيقاً ولا يصف الظاهرة الإسلامية الوسطية بدقة، ونفضل وصف أنفسنا بأننا مسلمون ديمقراطيون, بينما مصطلح الإسلام السياسي يضع كل الظاهرة الإسلامية في سلة واحدة مع «القاعدة» وتنظيم «داعش»، نحن نريد أن نتباين عنهم وأن نُعرِّف أنفسنا بأنفسنا.>