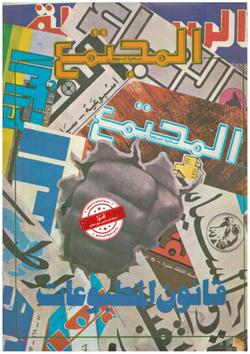العنوان من ضوابط الإنكار
الكاتب د.عبدالحميد البلالي
تاريخ النشر الثلاثاء 13-أغسطس-1985
مشاهدات 47
نشر في العدد 729
نشر في الصفحة 38
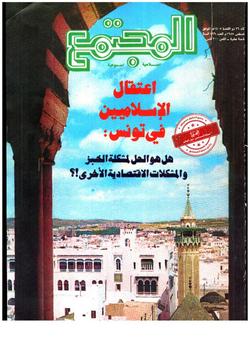
الثلاثاء 13-أغسطس-1985
- سليمان والهدهد..
لذلك نرى هذه الصفة واضحة في سليمان عليه السلام، وذلك في قصته مع الهدهد إذ يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾(1)
يقول سيد رحمه الله «ومن ثَم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ﴾ (النمل:٢١) ولكن سليمان ليس ملكًا جبارًا في الأرض، إنما هو نبي، وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نهائيًا قبل أن يسمع منه، ويتبين عذره... ومن ثَم تبرز سمة النبي العادل: ﴿أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ (النمل:٢١). أي حجة قوية توضح عذره، وتنفي المؤاخذة عنه»(2).
إن الأناة والتثبت صفة جميلة يحبها الله وتكون أجمل إذا جاءت من القادر على العقاب واتخاذ القرار، لهذا قال الشاعر ابن هانئ المغربي:
وكل أناة في المواطن سؤدد***ولا كأناة من قدير محكم
ومن يتبين أن للصفح موضعًا***من السيف يصفح عن كثير ويحلم
وما الرأي إلا بعد طول تثبت***ولا الحزم إلا بعد طول تلوم(أ)(3)
الاستخبار قبل الإنكار..
ومن فقه قصة الخضر مع موسى وسليمان مع الهدهد وغيرها من التوجيهات القرآنية والنبوية استنبط العلماء أحكامًا في الإنكار، والتي منها ما نحن بصدده من التثبت والتروي والاستخبار قبل الإنكار، فها هو القاضي أبو يعلى يذكر في الأحكام السلطانية ما يتعلق بالمحتسب ، «وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار، وإن كان الوقوف في طريق خالٍ، فخلوا بمكان ريبة، فينكرها ولا يعجل في التأديب عليهما حذرًا من أن تكون ذات محرم، وليقل «إن كانت محرم فصُنها عن موقف الريب، وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله عز وجل» وليكن زجره بحسب الأمارات، وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنَّى وفحص وراعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار»(4)
- حرمة العلماء..
روى البخاري في صحيحه الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: «من عادى لي وليًّا آذنته بالحرب...»(5).
فإذا كان الأمر بالتثبت لعامة المسلمين واجبًا ففي العلماء أوجب ذلك لما يؤَثِّرُهُ التسرع باتهامهم من حرمان العوام من علمهم، أو ظن السوء فيهم وربما كانوا منه براء؛ لذلك على القائمين بأمر الإنكار أن يتثبتوا إذا سمعوا أو قرؤوا ما
يمس أحد العلماء وإلا يخوض فيما يخوض به الآخرون، ثم يندم إما في الدنيا إذا تبينت له الحقائق وإما بالآخرة حيث سيقف خصمًا لذلك العالم وهو يطلب من الله جل جلاله أن ينصفه مما اتهمه فيه من تهم باطلة دون أن يتثبت وحتى لا نقع في هذه المحظورات وضع الإمام السبكي في طبقات الشافعية قاعدة ذهبية في تجريح العلماء، إذ قال «الصواب عندنا أن من تثبت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنَّا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه، لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون وقد عقد الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب العلم بابًا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال -استمعوا علم العلماء، ولا تصدقوا بعضهم على بعض فو الذي نفسي بيده لهم أشد تغايرًا من التيوس في زروبها - وعن مالك بن دينار يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض.
ولعل ابن عبد البر يرى هذا، ولا بأس به، غير أنا لا نأخذ به على إطلاقه ولن نرى أن الضابط ما نقوله من أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه أما لتعصب مذهبي أو غيره، ثم قال ابن عبد البر -فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض، فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فأن فعل ذلك فقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخسر خسرانًا مبينًا، فنقول مثلًا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون، صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الداعي إلى نقله -ومن أمثلة ما قدمنا، قول بعضهم في البخاري -تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ، فيا لله والمسلمين أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة، ومقدم أهل السنة والجماعة»(6).
القاعدة الخامسة.. لا إنكار على مجتهد ولا مختلف فيه.
وهو لون من ألوان الجهل، تجعله يتعصب لرأيه في مسألة خلافية، فينكر على كل مخالف للرأي الذي تبناه معرضًا بذلك من قول جمهور العلماء بأن الإنكار لا يكون إلا فيما اتفق على كونه مُنْكَرًا.
فهذا ابن قدامة يقول: «ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلومًا كونه مُنْكَرًا بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد، فلا حسبة فيه»(7).
وروى أبو نعيم بسنده عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قوله: «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه»(8).
وروى الخطيب البغدادي عنه قوله «ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذ به»(9).
ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد رضي الله عنه تحت عنوان «لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع - ما نصه: وقد قال أحمد في رواية المروزي لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم...»(10).
ويستثني القاضي أبو يعلى من ذلك، إذا كان الخلاف ضعيفًا في مسألة من المسائل، وقد يؤدي عدم الإنكار إلى محظور متفق عليه، إذ يقول «ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربًا النقد.. فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته»(11) وهذا الذي يكون فيه الحق واضحًا والأدلة بينة من الكتاب والسنة والإجماع اما إذا خلت المسألة من ذلك كله، فلا إنكار على مجتهد.
وقال النووي في المروضة «ثم أن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره وإنما
ينكرون ما خالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا»(12)
القاعدة السادسة: اختيار الوقت المناسب
فلا يختار وقت غضب صاحب المنكر بل يختار وقت هدوءه وانبساطه ولا يختار
وقت انشغاله بل يختار وقت فراغه، ولا يختار وقتًا يكون فيه الحديث بعيدًا عن موضوع المنكر، بل يقتنص الوقت الذي يثار فيه موضوع الإنكار أو موضوعًا قريبًا منه يجعله مدخلًا لإنكاره، وهذا ما فعله يوسف عليه السلام عندما جاء له صاحبا السجن بعد أن وثقوا به وبعلمه فأرادا منه أن يفسر حلمهما فانتهز الفرصة للإنكار بأسلوب ذكي، لأن صاحب المنكر هنا هو صاحب الحاجة، وهو الذي يريد أن يستمع برضاه واختياره؛ فلذلك يكون استعداده للقبول أكثر مما لو أجبر على الاستماع دون رغبة منه، ومن فقه يوسف عليه السلام بالإنكار أنه عرض عليهما ما يريد من الحق وأنكر ما يريد من الباطل قبل أن يعطيهما ما يريدان، لأنه يعلم أن دافع الرغبة في معرفة تأويل الأحلام وخوفهما مما ينتظرهما من الغيب المجهول يجعلهما يستمعان لكل شيء من أجل معرفة ماذا سيحدث لهما، فاختيار الوقت المناسب والظرف المناسب من أكبر الأسباب لقبول النصيحة وإزالة المنكر، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول «إن للقلوب شهوة وإقبالًا، وفترة وأدبارًا فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وأدبارها»(13).
فهنيئًا لذلك الداعية الفنان الذي يعرف متى تدبر القلوب ومتى تقبل فيحسن الإنكار ويجيد مخاطبة القلوب.
القاعدة السابعة.. الإِسْرار بالنصيحة.
إن من طبيعة النفس البشرية أنها تحب ألا تبدو ناقصة أمام الآخرين وتتولد من هذه الطبيعة طبيعة أخرى وهي أنها تبغض من يحاول أن يبدي بعض عيوبها
أمام الآخرين بغضًا يجعلها تأبي قبول الإصلاح فيها، حتى وإن كان النقد في محله والعيب موجود وذلك على سبيل العناد لمن بين هذه العيوب، ويستثنى من هذه الطبيعة البعض القليل والذي يسعى هو بنفسه للآخرين من أجل أن يبينوا له العيوب، ولكن حتى هؤلاء مع طلبهم للنصح إلا أنهم يرفضون تبيين العيوب أمام الآخرين ويعتبرون ذلك نوعًا من التوبيخ لا يرضون استماعه ولنستمع هنا إلى الإمام الشافعي وهو يقول لأحد هؤلاء الذين فقدوا هذه القاعدة من قواعد الإنكار:
«تعمدني بنصحك في انفرادي***وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع***من التوبيخ لا أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت قولي فلا***تجزع إذا لم تعط طاعة»(14)
بل إن بعض النفوس تأبَي حتى الإسرار في النصيحة إذا كانت مباشرة فلا تود أن تبدو ناقصة أمام الآخرين، وهذا الصنف من النفوس الحساسة لا بد أن ننكر عليهم بطريقة غير مباشرة؛ ليكون ذلك أدعى للقبول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم كثيرًا هذا الأسلوب غير المباشر فكان إذا رأى خطأ في أحدهم اجتمع بالجميع وقال موجها كلامًا عامًا دون أن يعين شخصًا بذاته: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» أو كما قال، وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية رواية عن الخلال يقول فيها «قيل لإبراهيم بن أدهم الرجل يرى من الرجل الشيء ويبلغه عنه أيقول له؟ قال هذا تبكيت، ولكن تعريض»(15).
القاعدة الثامنة - خلط بعض ما تشتهيه الأنفس مع أمور الآخرة.
النفس تشتهي المال، وتحب النساء والمناصب ولا يمكن إغفال هذه الفطرة عند الإنسان حينما ندعوه أو نمارس عملية الإنكار معه، ولهذا لم يغفل التشريع وحاشاه أن يغفل عن هذا الأصل من أصول الدعوة، وهذه القاعدة من قواعد الإنكار فكان أحد الأصناف المستحقة للزكاة «المؤلفة قلوبهم» ومن التسمية يتبين لنا الهدف من إعطاء المال لهذا الصنف، وهو تأليف قلوب من لم يسلم حتى يدخل في الإسلام، وبعدها نهدم المنكر الذي كان فيه ونبني إنسانًا جديدًا عابدًا لله، ولو تصفحنا كتب السيرة لرأينا من ذلك الكثير، فهذا صفوان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنمًا ما بين الشعبين حتى أنه يتعجب من ذلك ويذهب جاريًا إلى قومه وهو يقول: «أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء مَن لا يخشى الفقر» وهذا أبو سفيان رضي الله عنه وهو سيد قومه، لا ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته من قومه عندما جاء فأتي لمكة فيقول: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمِن»، فهذا الشرف الذي أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه له، إلا ليشعره أن الإسلام ما جاء ليجني زخارف الدنيا، وما كان هدفه أن يذل الزعامات ولا ليحتقر العزيز في قومه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء في بقاع الأرض يطمئنهم على ملكهم بأنهم إن أسلموا سيبقيهم على ما هم عليه من المُلك.
هذه القاعدة التي تشربت في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ثم تلاشت أو كادت أن تتلاشى في عهد ما بعد الخلافة الراشدة لولا أن أحياها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فهذا هو ابنه عبد الملك يتعجب من تروي أبيه في ترسية أسس العدل والقضاء على المناكر التي أحدثت في عهد من كان من قبله من الخلفاء فيقول له: «يا أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل، فو الله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك؟
قال: «يا بني، إني إنما أروِّض الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أحي الأمر من العدل فأؤخر تلك حتى أخرج منه طمعًا من طمع الدنيا، فينفروا لهذه ويسكنوا لهذه»(16).
فعلى الداعية أن يتنبه كما تنبه الخليفة الراشد الخامس لطبيعة النفور والسكون عند من نريد أن نمارس معهم عملية الأمر والإنكار، فإذا كانت المؤسسات التبشيرية للباطل قد تنبهت مبكِّرًا لهذا المبدأ فأخذت تستخدم آلاف الوسائل الترغيبية من طمع الدنيا لمن تريد تنصيرهم من مال ومنصب وعلاج مجاني وتدريس وتسهيلات، فإن الدعاة وخاصة في هذا العصر لهم بأشد الحاجة للتنبه لهذه القاعدة وممارستها على أوسع نطاق، فإذا نفروا مما ننكر عليهم فسيسكنون لما نعطيهم من طمع الدنيا.
القاعدة التاسعة: ترك الاستفزاز واستخدام الحجة.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(17).
يقول سيد رحمه الله: «إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها أن كل من عمل عملًا فإنه يستحسنه ويدافع عنه فإنْ كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنها، وإن كان يعمل السيئات استحسنها ودافع عنها وإن كان على الهُدى رآه حسنًا، وإن كان على الضلال رآه حسنًا كذلك فهذه طبيعة في الإنسان... وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرزاق.. ولكن إذا سبَّ المسلمون آلهتهم هؤلاء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية الله، دفاعًا عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدهم... فليدعهم المؤمنون لما هم فيه: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام:١٠٨). وهو أدب يليق بالمؤمن المطمئن لدينه الواثق من الحق الذي هو عليه، الهادئ القلب الذي لا يدخل فيما لا طائل وراءه من الأمور فإنَّ سبَّ آلهتهم لا يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادًا، فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه؟ وإنما قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون من سب المشركين لربهم الجليل العظيم؟!»(18).
فليس من واجب الدعاة سبّ رموز الضلال وخصوم الدعوة أو الاستهزاء بهم، ولئن كان هذا هو أسلوبهم فليس من اللائق أن يتشبه بهم الدعاة في هذه الأساليب الرخيصة وينزلوا إلى مستواهم والالتزام بهذا الخلق يؤدي إلى كسب الأنصار ويجعل المكابر المعاند يصفى إذا دعوناه للحق.
يتبع في العدد القادم
(1) النمل 20، 21
(2) الظلال ٥/ ٢٦٣٨
(3) موسوعة أخلاق القرآن ٣/ ٢٧ – (أ) التلوم: الانتظار أو التأني في الأمر
(4) الآداب الشرعية ١/ ٢٢٢
(5) رواه البخاري - وللحديث بقية
(6) طبقات الشافعية ١/ ١٨٧ إلى ١٩٠
(7) مختصر منهاج القاعدين
(8) الحلية ٦/ ٣٦٨
(9) الفقيه والمتفقه ٢/ ٦٩
(10) الآداب الشرعية ١/ ١٨٦.
(11) الآداب الشرعية ١/ ١٨٦.
(12) تنبيه الغافلين - للنحاس ١٠١.
(13) الآداب الشريعة ١/ ١٠٩
(14) آداب الشافعي ٥٦.
(15) الآداب الشرعية ١/ ٢١٥.
(16) الزهد لأحمد ٣٠٠
(17) الأنعام
(18) الظلال ٢/ ١١٦٩
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل