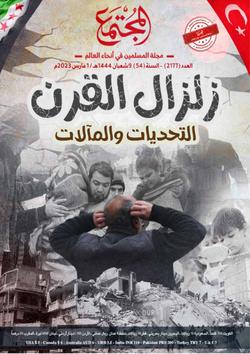العنوان القبلية والدولة.. والشعوبية الجديدة
الكاتب محمد صلاح الدين
تاريخ النشر الثلاثاء 22-ديسمبر-1998
مشاهدات 8
نشر في العدد 1331
نشر في الصفحة 46
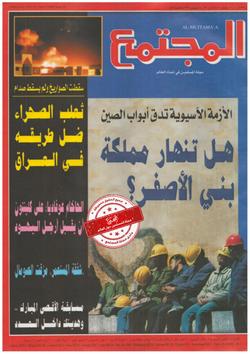
الثلاثاء 22-ديسمبر-1998
هل يتطلب بناء الدولة الحديثة القضاء على القبلية وأنماط ولائها، وتركيبات السلطة داخلها، واستبدال ذلك كله بعلاقات المواطنة؟!، وهل يستلزم تثبيت شرعية الدولة إلغاء المشيخة القبلية، ومنع الانتماء العشائري، وتذويب الأصول القائمة على النسب القبلي، والاستعاضة عنها بالبطاقات المدنية؟.
وهل يمكن في الدولة الحديثة أن تحل المواطنة محل الانتساب القبلي، وأن تكون بالعمق نفسه والفاعلية، وأن تؤدي الدور نفسه الإنساني في المجتمع؟.
أليس في الإمكان ترشيد الانتماء القبلي، والانتساب العشائري، وجعله رافدًا من روافد تدعيم شرعية الدولة وتعميق المواطنة؟!.
ناقش هذه الأسئلة في جريدة الشرق الأوسط الأستاذ السيد ولد أباه بالنسبة لموريتانيا المعاصرة، وانتهى إلى القول: إن القبيلة وإن كانت لا تزال تمثل إطار الانتماء الاجتماعي الأول وحاضنة التراث والقيم المميزة للشخصية الموريتانية، إلا أنها فقدت مجالها الحيوي وبنيتها التراتبية، وتلاشت قبضتها على الفرد الذي أصبح منتميًا بالضرورة، والاختيار للعديد من دوائر الانتماء التي تتقاسم مع المؤسسة العشائرية النفوذ وعلاقات الولاء.
قد نتفق مع الأستاذ ولد أباه بشأن ضعف السلطة القبلية في الدولة الحديثة، وتراخي الانتماء العشائري، لكني أريد أن أضع موضع التساؤل افتراض التناقض بين الولاء للقبيلة والولاء للدولة، وزعم البعض أن عمق الانتماء للعشيرة قد يضعف الانتماء الوطني أو يوهن من شرعية السلطة الحكومية، وكل ذلك نتائج واجهها بعض الدول العربية لغياب منهجية الإسلام كمناط أعلى للولاء والانتماء بين المسلمين، ومجيء السلطة المركزية في بعض الأحيان بأسلوب غاشم وعن غير الطريق الشرعي الذي يرتضيه الناس.
لقد تنزل الإسلام على مجتمع ليس موغلًا في القبلية وعصبية الانتماء الجاهلي فحسب، بل لم يعرف في حياته أي سلطة مركزية، فأقر ما في القبلية من خير، وهذب ما فيها من شر، وجعل الولاء للدين وأمة المسلمين فوق كل ولاء، كما جعل موازين التقوى والعمل الصالح ترجح كل ما عداها من موازين.
إن القبلية في جوهرها اعتزاز المرء بأرومته، وحرصه على أهله ومسارعته إلى خيرهم، ودفع الشر عنهم، وهي كذلك صلة للرحم والتحام بالقربي، ثم هي أيضًا حافز على التزام المرء بمكارم الأخلاق، فلا يجلب المعرة لقومه، وكل ذلك جميل طالما ابتعد عن ظلم الآخرين والعدوان عليهم أو الحط من شأنهم.
والمجتمع الذي يقوم على التحام القربى وصلة الرحم والاعتزاز بالأهل، وتعارف الأنساب، مجتمع قوي متماسك متكافل يصعب تعرضه للتفكك أو الوهن، كما يتعذر اختراقه بما يشين الرجولة والنجدة ومكارم الأخلاق.
وليس من شك في أن احتفاظ الإسلام خلال القرون الأولى من تاريخه بجوهر التركيبة الاجتماعية للمجتمع العربي، وتنميته لكل عوامل التماسك والقوة فيها ورعايته لجوانب الخير والتكافل في تقاليدها، قد شكل رافدًا عظيمًا من روافد القوة والتفوق للعالم الإسلامي، وعاملًا من عوامل الاستقرار والتميز لمجتمعات المسلمين.
ألم تر إلى رسول الهدى - صلوات الله وسلامه عليه - لا يستنكف أن ينادي وهو في ساحة الحرب: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب»، وإنه ليخفض جناحه لضعفاء المسلمين حتى أن الأمة لتوقفه ﷺ في سكك المدينة وتمسك بيده فلا يترك يدها حتى ينتهي حديثها، وقد تنزل عليه قول ربه: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الكهف: ٢٨).
وفي الوقت الذي كان المصطفى ﷺ يحترم أقدار الناس وينزلهم منازلهم، وكان يسمي القبيلة لتكون على ميمنة جيشه في القتال، ويسمي قبيلة أخرى على ميسرته، ويقول في فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، فإن موازين الحق عنده وعند المجتمع المسلم لم تكن إلا التقوى والعمل الصالح، بهما يتقدم المرء أو يتأخر كائنًا من كان، وهو القائل ﷺ: «إن وليي المتقون من كانوا وحيث كانوا».
مر أبو سفيان- رضي الله عنه- بعد إسلامه ببلال وبعض ضعفاء المسلمين، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله، فغضب لذلك أبو بكر، وقال: أتقولون ذلك لسيد قريش؛ ثم اتجه إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال له المصطفى: يا أبا بكر إن تكن أغضبتهم فقد أغضبت ربك، فكر أبو بكر راجعًا حتى وقف على بلال وصحبه، فقال: يا إخوتي، لعلي أكون قد أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر.
ولما قدم جبلة بن الأيهم - وهو من ملوك العرب - على عمر بن الخطاب مسلمًا أكرم عمر وفادته، حتى إذا كان يطوف بالكعبة داس أعرابي على إزاره فلطم جبلة الأعرابي على وجهه، واشتكاه الأعرابي إلى عمر طالبًا القود، فسأل جبلة مستنكرًا: أو تقتادون للسوقة من الملوك؟، قال عمر: نعم، إن الإسلام سوى بينكما.
وتشاء حكمة المولى - عز وجل - أن يكون الكثير من أئمة الحديث والفقه والدين، وكذلك أئمة اللغة العربية والنحو وعروض الشعر من غير العرب، فلا يلتفت إلى ذلك أحد، وبل ينعقد عليهم احترام الأمة وإجلالها على مر العصور.
إن الإسلام لا يمنع الناس من الاعتزاز بأنسابهم، ولا يستنكر عليهم الانحياز لأهليهم أو الانتساب لعشائرهم وقبائلهم والغيرة على سمعة أقوامهم، طالما كان كل ذلك في البر والخير ودون عدوان أو مظلمة أو تحقير، فذلك كما أسلفت أساس لقوة المجتمع وتكافله وعماد تماسكه وصلابته، ولا يعني بأي حال عدم المساواة بين الناس أو التمييز بينهم على أساس الأصل والأعراق.
وإن من حسن السياسة أن نأخذ من الوطنية والقبلية والقومية كل ما فيها من إيجابيات وخير، وأن ندع ما سوى ذلك، وألا نستمع إلى ما خلفته موجات الغزو الاستعماري والفكري، وأفرزته عقليات الاستبداد وسياسات الطغيان في العالم العربي من شعوبية جديدة همها تحقير ما توارثه معظم المجتمعات العربية من حرص على انتساب المرء لأهله، واعتزازه باسم عشيرته دون غلو، وحماسة لصلة رحمه وحميته لقومه دون استعلاء، فقد شقيت مجتمعات افتقدت ذلك، وتفككت شعوب لم تجمعها وشائج القربى، ولا ربطت بين أبنائها أواصر الأرحام، وإن خير ما يمثل هذا التوازن والاعتدال قول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ١٣).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل