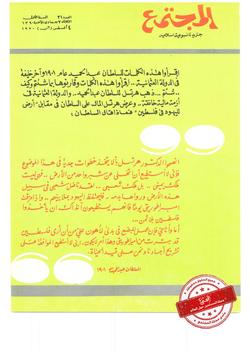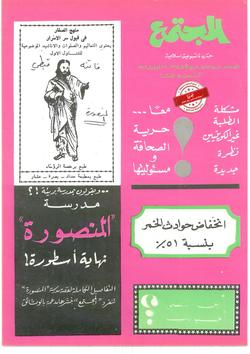العنوان إحياء فقه الدعوة.. تناصح وتغافر
الكاتب محمد أحمد الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 29-يناير-1974
مشاهدات 39
نشر في العدد 185
نشر في الصفحة 32
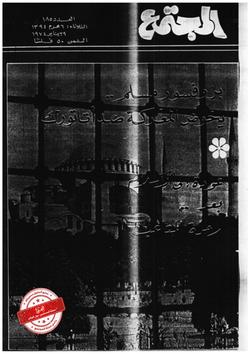
الثلاثاء 29-يناير-1974
والله، إن أمر قرآننا لَكَما أقسم الله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾. (الطارق: ١٣-١٤).. دور فصل جاد، أراده الله تعالى للقرآن، وسيرة مفاصلة جادة، ليس معها هزل، فرضت تبعًا لذلك على من يختار الانتساب إلى سرايا رجال القرآن.
وجد مقابل ليس بمستغرب، ما زال يتداعى إليه الباطل، حفاظًا على نفسه، ودفاعًا عن مصالحه، یرد به علی جدنا.
وإذ بأمر دعوة الإسلام كله جد أنى نظرته، لا يستطيع فيها صاحب الفترة المتراخي أن يتمنى أمنية من أماني الهزل، ولا تنبغي له، وإلا: فقد الثبات، وتدحرج أمام الجد الهادر السائر.
نرى الدهر قد جد في أمرنا
فيا ويل تدبيرنا إن هزل
وهذا ما يلقي على عاتق كل جيل من الدعاة، يشرفه الله تعالى بكفاية حاجة مرحلة متميزة من مراحل المعركة المستمرة عبر القرون، واجبًا من التربية الصعبة، وسمتًا من التشدد في الاختيار، يكفل بها نقاء المجموعة وتماسك البناء.
إذا اختل شيئا بناءُ الأساس
تضاعف في الصرح ذاك الخلل
وإنما ثمن هذا الأساس المتين: أن يرفع الدعاة القواعد من التنظيم بشمول محيط وميزان، وأن يرمموا ما استهلكته الشبهات حين كانت تمر في ثنايا الأيام.
فلا بد من رأب كل الصدوع
ولا بد من قصد ذات الإله
وجمع الصفوف، ودرء العلل
وحشد القوى، ليصح العمل (١)
ومعنى ذلك: أن نلجأ دومًا إلى تربية تسلك بنا في مسارين دائمين، وخطين متكاملين: مسار التجرد الإيماني، ونيل الرضا الرباني، بإطراح شهوة النفس، وتعليم تمييز الإلقاء الشيطاني، من خلال تأسيس تكتل ينوي عملًا حركيًّا فكريًّا سياسيًّا، يتجاوز أشكال التعاون الاجتماعي الخيري.
ومسمار الاستدراك، بعلاج ما هنالك من عيب طراً بعد صحة، أو نقص فضح المنظر بعد كمال، من خلاف، أو تخليط، أو سير بلا تجديد تخطيط.
وأنوار الفطنة التي أضاء منها أول ما أضاء: نور الاستعاذة بالله من الفتن، هي أنوار أوقدت لتنير مراحل من كل من هذين المسارين، فهي تؤنس المؤسس الرائد، كما تهدي العاثر المنيب.
فالعائذ بالله المستغفر يتوغل في دربه على ضوء:
• النور الثاني، وهو: تنقية النية مما علق بها من شوائب:
نور آثاره خالد -رضي الله عنه- يوم احتدمت اليرموك فقال: «إن هذا يوم من أيام الله، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادكم، وأريدوا الله بعملكم، فان هذا يوم له ما بعده». (۲)
ونقول بالذي قال: إن أيامنا هذه التي نصاول فيها جاهلية القرن العشرين لاستئناف الحياة الإسلامية؛ إنما هي من أيام الله التي لها ما بعدها، فانه لا ينبغي للداعية أن تجره فتنة إلى فخر وتطاول على أصحابه، ولا إلى بغي وعدوان على ذي إمرة قد بويع.
إخلاصا يتجاوز معناه الوعظي العابر الذي تلوكه ألسن القصاص، إلى تأمل استقرائي صامت، يحمي ما جنته النيات المشوبة الممزجة من موبقات وكبائر أضرت بسير الحركة الإسلامية الحاضرة، وهزته وأرادت له الحيدة عن خطه المستقيم، لولا أن الله عصم القادة، ومن عليهم بثبات وسكينة.
من أجل ذلك أوصى فقه الدعوة أن من لم يتعظ فيسارع إلى تنقية نيته: سارعنا نحن إلى تنقية الجماعة منه.
بهذا جزم الإمام البنا فقال: «إن الإخلاص أساس النجاح، وإن الله بيده الأمر كله، وإن أسلافكم الكرام لم ينتصروا إلا بقوة ايمانهم وطهارة أرواحهم، وذكاء نفوسهم وإخلاص قلوبهم، وعملهم عن عقيدة واقتناع جعلوا كل شيء وقفًا عليها، حتى اختلطت نفوسهم بعقيدتهم، وعقيدتهم بنفوسهم، فكانوا هم الفكرة، وكانت الفكرة إياهم. فإن كنتم كذلك ففكروا، والله يلهمكم الرشد والسداد، واعملوا، والله يؤيدكم بالمقدرة والنجاح. وان كان فيكم مريض القلب، معلول الغاية، مستور المطامع، مجروح الماضي، فأخرجوه من بينكم، فإنه حاجز للرحمة، حائل دون التوفيق». (۳)
انظر قوله: إنه حاجز للرحمة، ودقق في تاريخنا القريب: كم من قصة وواقعة لها لسان يتهم الشرط المتساهل في التجميع بحجز أشكال الرحمة المتعددة، من نصر وتمكين، وسكينة وطمأنينة، ووحدة ووفاق! إن الكثير من عشرات السير مردها إلى هؤلاء أهل الشوائب الذين احتضنتهم الجماعة على سذاجة منها، وفي غفلة من نفسها.
وقديمًا قال ابن الجوزي صادقًا: «إنما يتعثر من لم يخلص»(٤).
وهو وإن كان يعني بذلك الفرد، إلا أن للمجموعة أيضًا قلبًا واحدًا مشتركًا يضره مرض البضعة الصغيرة منه كما يفر مرض بعض قلب الفرد ذاك الفرد، فإذا مرض داعية برياء: تضررت جماعة الدعاة كلها بمرضه، وتعثرت، ومرض قلبها، حتى يتخلص منه بتوبة، أو تتخلص منه بإبعاد.
وقبل ابن الجوزي بقليل كان الكيلاني ينادي: «يا غلام: فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوة.. السير سير القلب». (٥)
ومعناه الجماعي كذلك أيضًا، فإن مما يخشى على الدعوات أن تطيل لسانها، فتكثر من تأليف الكتب، وتتخذ لها من الصحف ميدانًا، وتتعب درجات المنابر بخطبائها، وتترك تأليف الأرواح وتربية القلوب، فتقف لا تخطو نحو التمكن خطوة، كوقفة غلام الكيلاني.
وربما كان الضرر أبلغ من ذلك، فإن التعثر يبقى السير معه مستمرًا، والوقوف يحفظ الجماعة سالمة قائمة على الأقل، لكن تلبس الجماعة كلها بالرياء قد يدفعها في طريق الاضمحلال الذي شاهده التابعي الربيع بن خثيم في أعمال الآحاد فقال: «كل مالا يراد به وجه الله: يضمحل». (٦)
فرياء الجماعات ليس بغريب، بل شوهد في التاريخ الفكري والسياسي مرارًا، متلبسًا شكلًا من التكلف للاصطلاحات، ومن التبني للاجتهادات الشاذة التي ربما زل بها لسان الفقهاء الأقدمين والمحدثين، أو مندفعًا في طريق التكاثر بالأعضاء على حساب النوعيات.
والظلام يزحف تدريجيًّا مع أشكال التراجع الثلاث هذه، فان العاثر حين عثرته يكون رأسه أقرب إلى الأرض، ملتهيًّا بتخليص نفسه من هويه، فينقطع عن رؤية المنار حينًا. والواقف يخدره السكون فتأتيه سنة أو نوم، فيغتمض جفنه، وشأن المضمحل أوضح، وبذلك يتحقق كون الرياء من ظلمات الفتنة، وكون الإخلاص من أنوار الفطنة.
وبسبب ظلمته هذه وصف زاهد الصحابة شداد بن أوس -رضي الله عنه- الشهوة التي تقترن به بأنها خفية. فإنه، حين حضرته الوفاة وطلبوا منه وصية يودع خلالها خلاصة فقهه في العمل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم: الرياء، والشهوة الخفية». (٧)
أي أنها تتسلل مستغلة ظلام الرياء. ومع هذا فإن الاستدراك في هذا الباب بسيط جدًّا، فقد سئل التابعي طلحة بن مصرف عنه، فأرشد المرائي إلى أن يقول: «اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي». (۸)
هذا فقط من لسان ندم.
فاستغفر مما كان من رياء لا تعلمه من نفسك، الله يعلمه، وابدأ صفحة جديدة بيضاء، ثم سلام عليك إذ تقتبس لأهلك قبسًا من:
• النور الثالث، وهو: قبول النصيحة وطلبها من الخبراء
وكان الحسن البصري ملحاحًا في الحث على هذا الخلق، لهاجًا في تزيينه، حتى جعله ثلث العيش، فقال: «لم يبق من العيش إلا ثلاث: أخ لك تصيب من عشرته خيرًا، فإن زغت عن الطريق: قومك. وكفاف من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة. وصلاة في جمع، تكفي سهوها، وتستوجب أجرها». (۹)
فزينة الحياة عنده، في جيل التابعين ذاك، كانت ترتفع عن الأرض وتتناقص، حتى لم يبق منها مما يرى إلا هذه الثلاث التي يتقدمها الأخ الناصح المقوم لاعوجاجك. فكم ثمن بقية الزينة هذه في يومنا هذا؟ ثم جعل الحسن التقدم بالنصيحة خصلة ضرورية للمؤمن الذي: «هو مرآة أخيه، إن أرى منه مالا يعجبه: سدده وقومه ووجهه وحاطه في السر والعلانية». (۱۰)
فالعين تنظر منها ما دنا ونأى
ولا ترى نفسها إلا بمرآة
وعند عمر بن عبد العزيز هو: من إحسان الصلات الإخوانية وواجباتها، وذاك قوله: «من وصل أخاه بنصيحة له في دينه، ونظر له في صلاح دنياه، فقد أحسن صلته، وأدى واجب حقه». (11)
وأما الحارث المحاسبي فقد جعله دليل الحب، فقال في رسالته للمسترشد:
«واعلم أن من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك». (۱۲)
فمثل التقدم بالنصيحة: قبولها.
فالصادق يفرح بها، ولكن «وصف الله تعالى الكاذبين ببغضهم للناصحين، إذ قال: ﴿وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِين﴾ (الأعراف: 79) (۱۳)
وللناصح الحق في أن يسقط من عينه من يرد نصيحته، وأن يستن بسنة الشافعي التي بينها في قوله: «ما نصحت أحدًا فقبل مني اإا هبته واعتقدت مودته، ولا رد أحد على النصح إلا سقط من عيني ورفضته». (١٤)
• اتخذ صاحبًا يحصي عليك..
ولكن، إن عاش الشافعي حتى رأى من يرد نصيحته، فإن التابعين، في الجيل الذي قبله، كانوا يبادئون بالسؤال مبادأة، يرجون الإصلاح.
فعمر بن عبد العزيز كان يقول لمولاه مزاحم: «إن الولاة جعلوا العيون على العوام، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن سمعت مني كلمة تربأ بي عنها، أو فعالًا لا تحبه، فعظني عنده، وانهني عنه». (15)
وكان سيد تابعي الشام بلال بن سعد يقول لصاحبه عبد الرحمن بن يزيد: «بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، فهل تستريب من أمري شيئًا؟» (١٦)
وأصرح منهما: ميمون بن مهران قدوة أهل الجزيرة، فإنه عرض نفسه على جمع من أصحابه وقال لهم: «قولوا لي ما أكره في وجهي، لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره». (۱۷)
هذا فعل الصالحين.
هو... أو السماح للعيوب بالتراكم.
ولداعية اليوم في فعلهم موعظة ونور وبلاغ، ولا بد له أن يخرج من الفتن التي من حوله بأسئلة عمرية ميمونة، تبعث سمت الاتباع ذاك وتعيده حيًّا، فإنه لولا كبر واعتداد رأيناهما لعقل مقدمات الفتن المندرسة جيل من المغرورين كثير عددهم، بطحتهم لوجوههم تباعًا، وأخذتهم أخذة رابية، وكان من الممكن أن ينجوا منها لو أعطوا من أنفسهم أذنًا صافية، لكنهم كانوا قومًا يصدون.
وذهبت فتنتهم، وثبت الأجر للثابتين، وبقي طريق العمل الواسع اللاحب، وبقيت أنوار الاستعاذة والإخلاص والتناصح، تقود السالك إلى:
• نور رابع وهاج، هو: تغليب نفسية التغافر
أوقده الزاهد ابن السماك واعظ هارون الرشيد لما: «قال له صديق: الميعاد بيني وبينك غدًا نتعاتب» كأنها كانت هفوة من ابن السماك أو زلة تعكر لها قلب صديقه.
«فقال له ابن السماك -رحمه الله تعالى: بل بيني وبينك غدا نتغافر». (18)
وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب، ملؤه فقه وواقعية، يشير إلى وجود قلب وراء هذا اللسان يلذعه واقع المسلمين، وتؤلمه أسباب تفرقهم.
وكذلك يكون استدراك الوازن لتسرع الحساس.
فلماذا التعاتب المكفهر بين الإخوة؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصومًا.
أليس التغافر أولى وأظهر وأبرد للقلب؟
أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لي ولأخي هذا، ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟
أو ليس عبوس التعاتب تعكيرًا تصطاد الفتن فيه كيف تشاء؟
بلى والله.
ولقد كان شاعر أسبق من دعاة يدعون الفقه، فراح يمرح ويتغنى. . .
من اليوم تعارفنا
فلا كان ولا صار
وإن كان ولا بد
ونطوي ما جرى منا
ولا قلتم ولا قلنا
من العتب فبالحسنى (۱۹)
ثم يأبى ألا أن يزيد مرحه، فيبدل نغمته:
تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى
تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا
لقد طال شرح القال والقيل بيننا
من اليوم تاريخ المحبة بينا
ولا سمع الواشي بذاك ولا درى
وحتى كان العهد لم يتغيرا
وما طال ذاك الشرح إلا ليقصرا
عفا الله عن ذاك العتاب الذي جرى (۲۰)
ثم يبدل نغمته ثالثة، ويتملق أصحابه ليديم محبة أخوية لذيذة قد ذاق طعمها الفريد، فيقول:
تعالوا نخل العتب عنا ونصطلح
ولا تخدشوا بالعتب وجه محبة
وعودوا بنا للوصل والعود أحمد
له بهجة أنوارها تتوقد (۲۱)
فلا تخدش أيها الداعية، بالله عليك، وجه محبة منيرة لا زلت فذًّا فيها والناس من حولك تستهلكهم العداوات، وغلا وضعت نفسك على شفير الاستهلاك. إن التغافر خير.
(۱) هذه الأبيات الأربعة للأميري في ألوان طيف /٩٩
(۲) تاريخ الطبري ٣٩٥/٣
(۳) مجلة «الدعوة» عدد ٥٠
(٤) صيد الخاطر - ٣٥٥
(٥) الفتح الرباني - ٢٩
(٦) طبقات ابن سعد ١٨٦/٦
(۷) زهد ابن المبارك - ۳۹۳، حلية الأولياء ٢٦٨/١
(۸) حلية الأولياء ١٦/٥
(۹) تاريخ بغداد ٩٩/٦
(۱۰) زهد ابن المبارك - ۲۳۲
(۱۱) تاريخ الطبري ٥٧٢/٦
(۱۲) رسالة المسترشدين - ۷۱
(۱۳) إحیاء علوم الدین ۱۸۳/۲
(١٤) طبقات الشعراني ٤٥/١
(۱٥) عيون الأخبار لابن قتيبة ۱۸/۲
(١٦) زهد ابن المبارك - ٤٨٥
(۱۷) طبقات الشعراني ٣٥/١
(۱۸) اللمع للطوسي - ۲۰۸
(۱۹) (۲۰) (۲۱) للبهاء زهير في ديوانه - ٣٤٠ - ١٢٩ - ١٠
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل