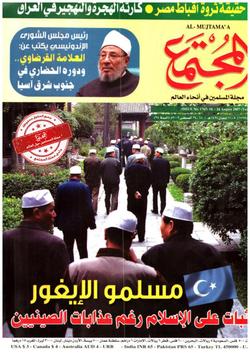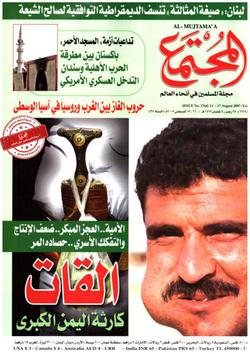العنوان اقتصاد الأمة كما تنظمه سورة البقرة (٤ من ٦) الوسطية في المفهوم الإسلامي
الكاتب يوسف كمال محمد
تاريخ النشر الثلاثاء 01-فبراير-1994
مشاهدات 25
نشر في العدد 1086
نشر في الصفحة 46
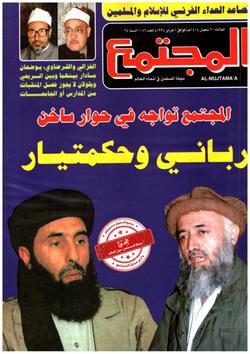
الثلاثاء 01-فبراير-1994
إن الانتماء إلى الأمة ليس بالوراثة وإنما بعقيدة هي الإسلام، تملأ قلب إنسان وأمة وتتحقق في هداية وإصلاح وهو الشرط لاستحقاق الخلافة عن الله في الأرض، والإمامة بالحق على الناس.
وعندما أتم إبراهيم عليه السلام الكلمات التي ابتلاه الله بهن جعله الله للناس إمامًا، وكانت سنته تعالى ألّا ينال عهده الظالمين.
﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: 124)
ودعا إبراهيم ربه أن يمن الله عليه وابنه بالإسلام، وأن يجعل من ذريته أمة مسلمة لله. وأن ينعم على البشرية برسالة خاتمة تزكي الناس وتعلمهم الكتاب والحكمة.
﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (البقرة: 128-129).
وكان الإسلام بذلك هو صبغة الله التي تحدد نقطة الافتراق بين الحضارة والجاهلية وبين الهدى والشقاق في مسيرة الإنسان على الأرض.
﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ (البقرة: 137-138).
إن أهم ما يشغل الحكومات في العصر هو تحقيق مستوى جيد من الدخل للفرد لتمكين الإنسان من العيش الكريم، وتوفير وسائل الأمن القومي لحماية الناس من الأخطار، ولهذا تشغل وسائل تحقيقهما جزءًا هامًا من وظيفة الدولة العصرية وتغطي أكبر جزء من مؤسساتها.
ولقد كانت دعوة إبراهيم لذريته أن يجعل الله بلدهم آمنًا وأن يرزقهم من الطيبات.
فاستجاب الله تعالى له، مع تذكيره بأن الدنيا يعطيها لمن يحب ومن لا يحب لأنها دار ابتلاء لا دار جزاء، ومن ثم لو تمتع بها الكافر قليلًا في الدنيا فإن مصيره إلى العذاب.
﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرة: 126).
يقول الرازي: «الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين كان ذلك أعظم أركان الدين، فإذا كان البلد آمنًا حصل فيه الخصب وتفرغ أهله لطاعة الله، وإذا كان البلد على ضد ذلك كانوا ضد ذلك» ج ۲ ص ۹۱.
ولأن الدنيا دار ابتلاء، فقد يبتلى المؤمن بنقص الرزق والخوف، فإن شكر كان خيرًا له. وقد يبتلى المؤمن بالخوف والجوع، فإن صبر كان خيرًا له، وبهذا يصير أمره كله خير ولكنفي النهاية العاقبة للمؤمن في الأمن والنعيم والعاقبة للكافر هي الخوف والعذاب.
﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (البقرة: 155-156-157)
ومن هنا بدأت السورة تحدد نظام كفالة الأمة المسلمة الأمن والرزق من خلال عقيدتها وشعيرتها وشريعتها.
وهي حين تحقق ذلك إنما تخرج الأمة الوسط التي تكون شاهدة على الناس بما أنعم الله به عليها.
﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ﴾ (البقرة: 143)
يقول ابن العربي: «ليس للوسط الذي هو بمعنى ملتقى الطرفين ها هنا دخول، لأن هذه الأمة آخر الأمم، وإنما أراد به الخيار العدل فأنبأنا ربنا تعالى بما أنعم به علينا من تفضيله لنا باسم العدالة، وتوليته خطة الشهادة على جميع الخليقة، فجعلنا أولًا مكانًا وإن كنا آخرًا زمانًا» أحكام القرآن ج 1 ص٤٠-٤١.
ويقول الرازي: «المعنى هو العدل والوسط حقيقة هو في البعد عن الطرفين، ولا شك أن طرفي الإفراط والتفريط رديئان، فالمتوسط في الخلق يكون بعيدًا عن الطرفين، فكان معتدلًا فاضلًا والوسط من كل شيء خياره» التفسير الكبير ج ۲ ص ۱۰۷.
ويقول ابن قيم الجوزية: «وضابط هذا كله هو العدل، وهو الآخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل جاوزه أو نقص عنه، ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطًا بين الطرفين المذمومين كانت عدلًا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصًا وأمرت نقصًا». الفوائد ص ١٤٩.
وتحدد السورة الوسط في الرزق بعيدًا عن تفريط الرهبانية وإفراط المادية، فلا تحرم طيبات ما رزق الله، فهي نعمة منه على الذين آمنوا فلا تمزقه برهبانية تعذب الجسد. كذلك لا تحل له الخبيث الذي يضر جسمه ويدمى روحه، فلا تمرغه في الوحل كما تفعل المادية.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة: 172)
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَن اضطُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ﴾ (البقرة: 173).
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ (البقرة: 219).
وفي نفس الوقت تؤمّن السورة حاجة الفقير، فتشرّع في أموال الأغنياء بما يكفي الفقراء، فتحقق الوسط في توزيع الدخل وكفاية الحاجات. ولذا كانت شريعة الإنفاق تسري في كل جنبات السورة.
﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: 177)
يقول القرطبي: «يذهب أكثر المفسرين إلى أن الإيتاء في الآية غير الزكاة، واستدلوا على ذلك أن عطف الزكاة على الإيتاء يوجب التغير» الجامع لأحكام القرآن ج ١ ص ٢٤١.
ويقول الرازي: «ومن حق المعطوف عليه أن يتغاير ليثبت أن المراد غير الزكاة، ووقف التقوى عليه، ولو كان ذلك مندوبًا لما وقفت التقوى عليه، فثبت أن هذا الإيتاء، وإن كان غير الزكاة، إلا أنه من الواجبات».
ويرى ابن تيمية أن الإيتاء هنا على سبيل الوجوب فيقول: «بذل المنافع والأموال، سواء كان بطريق التعوض أو بطريق التبرع ينقسم إلى واجب ومستحب وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة أقسام، مذكورة في الحديث المأثور: «أربع من فعلهم فقد برئ من البخل، من أتى الزكاة، وقرى الضيف، ووصل الرحم، وأعطى في النائبة» مجموع الفتاوى جـ ۲۹ ص ١٨٥، ١٦٦
وفى تشريع الوصية في الثلث لغير الورثة تحقيق للتكافل على مستوى الأسرة وتوفير الرزق وعدالة التوزيع.
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 180).
والإسلام يحقق الوسط بين العبادات والمعاملات فليس هو تصوفًا زاهدًا ينعزل عن الحياة، وليس هو اهتمامًا قاصرًا على الدنيا يجبُّ الإنسان عن معرفة الله والسعي لأخراه، وإنما وسط بشعيرة تغذى الشريعة وشريعة تصون الشعيرة.
فحينما شرع الله القصاص في القتلى، ردعًا للظالمين وتحقيقًا للأمن في ربوع الأمة، حصنها بشعيرة الصيام التي ترقق القلوب وتستعلي على شهوات النفوس.
﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 179).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183).
ثم حرّمت السورة أكل المال بالباطل لتحقق الأمن على المال كما حققته على الأنفس.
ويتحقق الوسط في سلوك الأمة نحو غريزة رئيسية في النفس البشرية وهي الملكية.. فهي تؤكد الملكية الخاصة وتحميها وتجعل حرمتها كحرمة النفس، ولكن في نفس الوقت تمنعها من الطغيان حيث صاحب المال في مركز القوة ولا يحق له أن يستغل هذه القوة في أكل المال بالباطل، كأن يرشو ليأخذ أكثر من حقه عند الحكام، أو أن يقرض بربا فيعنت المحتاج، كما يظهر حين يفسد السلطان عملة الناس فيزيدها ليحصل على مزيد من الإيراد بينما يضار الناس بانخفاض قيمتها.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188).
يقول ابن العربي: «بالباطل، يعنى بما لا يحل شرعًا ولا يقيد مقصودًا، لأن الشرع نهى عنه، ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما. والباطل ما لا فائدة فيه، ففي المعقول هو عبارة عن المعدوم وفي المشروع عبارة عما لا يفيد مقصودًا» أحكام القرآن جـ ۱ ص ۹۷.
ولتحقيق الأمن من العدوان الخارجي على الأمة فرض الجهاد في وسط فاضل فليس هو قتال للاستعلاء والاستغلال وإنما لتحقيق العدل والأمان. وهو قتال لمن يعتدى فإن انتهى فلا عدوان.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة:190-191-192-193).
وحصنت هذه الشريعة بشعيرة الحج ففي الحج رعاية الأمن في المكان والزمان فيبلد الله الحرام وأشهر الله الحرام.
﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ (البقرة: 194)
ومع شعيرة الحج تتواكب شعيرة الإنفاق على المحتاجين، فشرع الهدي على من قصر في واجب أو تمتع بالعمرة إلى الحج.
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ﴾ (البقرة: 196)
وكما يتزود الإنسان لرحلته بالزاد فعليه أن يتزود في أعماله بالتقوى، وشعيرة الحج تربي المسلم على ذلك، وهي مع أنها شعيرة فإن الله يحض فيها على التجارة والتبادل فيظل هذه القيم.
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ (البقرة: 197-198).
يقول ابن العربي: «قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وإن القصد في ذلك لا يكون شركًا، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض» (أحكام القرآن جـ ١ ص ١٣٦).
والجهاد يحتاج إلى نفقة فإذا لم تتوفر عاث العدوان في الأرض الفساد وأهلك الحرث والنسل، بذلك كان الجهاد بالنفس والمال.
يقول الجويني: «لو شغرت الأيام عن قيام إمام بأمور المسلمين والإسلام، ومست الحاجة إلى إقامة الجهاد إلى مال وعتاد وأهب واستعداد، كان وجوب بذله عن تحقق الحاجات على منهاج فرض الكفايات فليست الأموال بأعز من المهج التي يجب تعرضها للأضرار المؤدية إلى الردى... ولو لم يتدارك الإمام ما استرم من سور الممالك، لأشفى الخلائق على ورطات المهالك، ولخيفت خصلة لو تمت لا كانت ولا ألمت لكان أهون فائت فيه أموال الأغنياء، وقد يتعداها إلى إراقة الدماء وهتك الستور وعظائم الأمور» الغياثي ص ٢٦٩ – ٢٧٠.
﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: 195).
يقول الجصاص: «قال أبو أيوب: إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه الإسلام، قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها... الإلقاء في التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد»، أحكام القرآن جـ ١ ص ٢٦٢.
وبالطبع يتبع الجهاد كل الضرورات اللازمة لتحقيق الأمن القومي كإقامة الصناعات الحربية والاستراتيجية والإعلامية والاستخبارية.
ويبين الرازي بعدًا آخر للآية في تحقيق الوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف فيقول: «نهاه أن ينفق كل ماله، فإن إنفاق كل المال يفضي إلى التهلكة عند الحاجة الشديدة» التفسير الكبير جـ ٥ ص ١٤٨.
إن وسطية الإسلام بين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة تؤدى إلى مجتمع القيم والفضيلة.
﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (البقرة:200، 201).