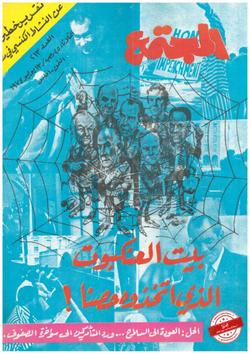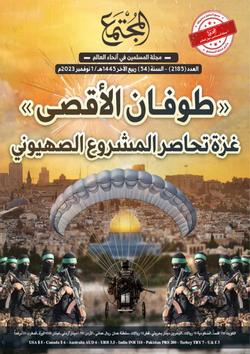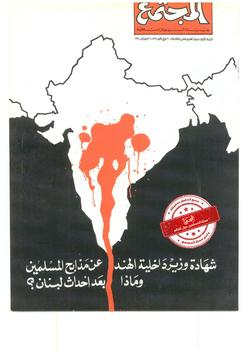العنوان الإنسان.. بين الجبر والاختيار "الحلقة الأخيرة"
الكاتب محمد سلامة جبر
تاريخ النشر الثلاثاء 08-أغسطس-1972
مشاهدات 19
نشر في العدد 112
نشر في الصفحة 12
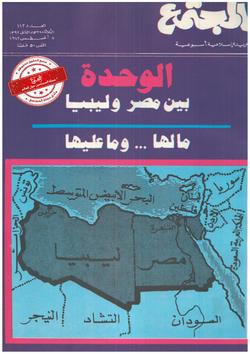
الثلاثاء 08-أغسطس-1972
الوجه الرابع: استدلاله بقوله تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا... ﴾. (النحل : ٣٥).
ثم قال رحمه الله: «فدل هذا على إنكار الله عليهم قولهم، وعلى أن الضلالة إنما حقت عليهم بعد النذارة بفعلهم».
قلت: صدقت، ولكن، ما وجه إنكار الله عليهم قولهم هذا؟
أـ هل أنكره –سبحانه- عليهم من حيث إنهم نسبوا ما هم فيه من ضلال وشرك إلى مشيئته؟
ب- أم لأنهم قالوا ذلــــــك استهزاءً؟
ج- أم أنكر عليهم فهمهم لمشيئته بمعنى رضاه بفعلهم فيكون معنى الآية على هذا الوجه «لو كان الله غير راض عن شركنا لحال بيننا وبينه، ولكن لما خلانا وما نحن فيه من الشرك والتحريم دل ذلك على رضاه عنا».
هذه ثلاثة احتمالات:
أما الأول: فلم يذهب إليه أحد من أهل السنة أصلًا.
وأما الثاني والثالث فعليهما مدار جميع المفسرين.
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله: «وقد أنكر الله سبحانه على من احتج لمحبته بمشيئته في ثلاثة مواضع من كتابه، في سورة الأنعام والنحل والزخرف؛ فقال تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾. (الأنعام: ١٤٨ - ١٤٩ ).
فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاه به بكونه أقرهم عليه وأن لولا محبته له ورضاه به لما شاءه منهم، وعارضوا بذلك أمره ونهيه ودعوة الرسل» إلى أن قال -رحمه الله: «ثم ختم الآية بقوله: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وأن لا يكون شيء إلا بمشيئته وهذا من تمام حجته البالغة، فإنه إذا امتنع الشيء لعدم مشيئته لزم وجوده عند مشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كان هذا من أعظم أدلة التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد من دونه، فما احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك هو من أظهر الأدلة على بطلانه وفساده فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدًا له وافتقارًا والتجاء إليه وبراءة من الحول والقوة إلا به ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء ألا يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك ولفتح لهم باب الهداية، ولكن ذكروه معارضين به أمره، ومبطلين به دعوة الرسل، فما ازدادوا به ضــــــــــــلالًا، والمقصود أنه –سبحانه- فرق بين محبته ومشيئته وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك» انتهى كلام ابن القيم شفاء العليل ص۱۷۹.
وقال النسفي رحمه الله في تفسير الآية ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ...﴾. لم ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن اعتقاد، بل قالوا ذلك استهزاءً» انتهى «عن تفسير النسفي »
وقال البيضاوي -رحمه الله: «أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء كقوله: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ لما فعلنا نحن ولا أباؤنا، أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع المرضي عند الله، لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إياها منهم حتى ينهض ذمهم به دليلًا للمعتزلة ويؤيد ذلك قوله: ﴿ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي مثل التكذيب لك في أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه، كذب الذين من قبلهم الرسل ﴿حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ﴾ من أمر معلوم يصح الاحتجاج على ما زعمتم ﴿فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ فتظهروه لنا ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ تكذبون على الله -سبحانه وتعالى ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ بالتوفيق لها والحمل عليها، ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين» انتهى بنصه.
وقال شيخ المفسرين/ ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسيره الجامع ج۸ ص ۷۸ ما نصه «قال الله مكذبًا لهم في قيلهم: إن الله رضى منا ما نحن من عليه من الشرك وتحريم ما نحرم، ورادًّا عليهم باطل ما احتجوا به من حجتهم في ذلك ﴿ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ثم قال: «وبنحو الذي قلنا من ذلك قال أهل التأويل» ثم أراد أن يثبت صحة ما ذهب إليه من التأويل فقال: «فإن قال قائل: وما برهانك على أن الله –تعالى- إنما كذب من قيل هؤلاء المشركين قولهم: رضى الله منا عبادة الأوثان وأراد منا تحريم ما حرمنا من الحرث والأنعام دون أن يكون تكذيبه إياهم كان على قولهم «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» وعلى وصفهم إياه بأنه قد شاء شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما كانوا يحرمون، قيل له: الدلالة على ذلك قوله تعالى ﴿كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم سلكوا في تكذيبهم نبيهم محمدًا -صلى الله عليه وسلم- مسلك أسلافهم من الأمم الخالية المكذبة الله ورسوله، والتكذيب منهم إنما كان لمكذب «بتشديد الذال وفتحها »، ولو كان خبرًا من الله عن كذبهم في قيلهم «لو شاء الله ما أشركنا» لقال « كَذَٰلِكَ كَذبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ » بتخفيف الذال، وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على الله لا إلى التكذيب، مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب وفي ذلك كفاية لمن وفق لفهمه» انتهى بنصه.
قلت: حاصل كلام الإمام الطبري، أن الله رماهم بالتكذيب لا بالكذب، وفرق بين الاثنين، إذ التكذيب منهم يحتاج إلى شيء يكذبون به -وهو الرسالةـ واحتجوا على ذلك بمشيئة الله، وفهموا منها رضاه، فإنه وإن كان كل ما هو كائن فبمشيئة الله، لكانوا كاذبين لا مكذبين، ولقال -سبحانه: كذلك «كذب» لا «كذب» أي بتخفيف الذال لا بتشديدها.
وقال العلامة السلفي المحقق «صديق حسن خان » رحمه الله في تفسير الآية «وقد تمسك القدرية والمعتزلة بهذه الآية ولا دليل لهم في ذلك على مذهب الجبر والاعتزال، لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته ولا يلزم من ثبوت المشيئة دفع دعوة الأنبياء -عليهم السلام» انتهى كلامه -فتح البيان في مقاصــــــــــــد القرآن ج ۳ ص ٢٦٠ وقبل أن أنهى مناقشتي للأستاذ/ سيد -رحمه الله- أحب أن أذكر نصين وردا في الظلال ولا يتم الجمع بينهما وعلة ذلك أنه -رحمه الله- عاش هذه القضية بالذات الجبر والاختيار -عاشها في ظلال القرآن وحده ولم يستأنس بآراء السلف الصالح في فهم آيات المشيئة لأسباب تزيده رفعة حيث إنه وقف نفســـــــــه وقلمه على رسم منار الدعوة وإعداد الدعاة، ولم ير سببًا يدعوه إلى توجيه جهده لقضية حسب أنه أصاب الحق فيها من فهمه لآيات المشيئة ونتيجة لذلك وقع في هذا التعارض الذي سنذكره: يقرر -رحمه الله- في أكثر من موضع من الظلال:
«إن الإنسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه فإذا اتجه إلى الهدى وجاهد فيه هداه الله ووقع هداه بقدر من الله، وإذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضله الله، ووقـــــــع ضلاله وتحقق بقدر الله» ويقول «قد جرينا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة فلم تلتوِ علينا حتى الآن».
وفي تفسيره لقوله تعالى ﴿ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ في سورة النساء يجعل التوفيق بين آيات المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية سرًّا يستعصى على الإفهام، والأولى ألا نبحث فيه بل نكل أمره إلى الله فتأمل قوله -رحمه الله: «أما القضية التي تمثل هذه النصوص جانبًا منها أو التي تذكر بها، وهي قضية الجبر والاختيار وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فيما يحدث منه أو يحدث له؟ وكيف تكون له إرادة الله هي المنشئة لكل ما يحدث، ومنه إرادة الإنسان نفسه واتجاهه وعمله إلى آخر هذه القضية فالنصوص القرآنية تقول: «إن كل ما يحدث بإرادة الله وقدره» وتقول في الوقت ذاته «إن الإنسان يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله» والقرآن كله كلام الله، ولن يعارض بعضه بعضًا، فلابد إذن أن تكون هناك نسبة معينة بين هذا القول وذاك، ولابد إذن أن يكون هناك مجال لإرادة الإنسان وعمله يكفي لحسابه عليه وجزائه دون أن يتعارض هذا مع مجال الإرادة الربانية، والقدر الإلهي.. كيف؟ هذا ما لا سبيل لبيانه لأن العقل البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله» انتهى بنصه الظلال سورة النساء الآيتان ٧٨-٧٩.
فانظر إلى قوله في النص الأول «قد جرينا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة فلم تلتو علينا آية حتى الآن» ثم التوت عليه تلك القاعدة في الجمع بين الآيتين 78-79 من سورة النساء حتى قال: «العقل البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله»
وهذا الذي ذكره -رحمه الله- حق لا مراء فيه فالعقل البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله، ولذلك تلقينا فهم آيات المشيئة عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه الذين تلقوها عنه -رضوان الله عليهم- وعن التابعين من أهل السنة والجماعة الذين اتفقوا على ما قررناه في هذا البحث.
وكما قلت سابقًا: إن حسن ظني بأستاذي الكبير يقتضيني القول بأنه ما كان يسعه إلا اتباع أهل السنة والجماعة لو اطلع على مذهبهم كاملًا في القدر، ولم يقتصر على فهمه وحده لآيات المشيئة، غير أني التمس له العذر في ذلك، فلعله ظن الاستقصاء في هذا الباب ترفًا عقليًّا أولى له ألا يضيع فيه جهده، وقد كان فيما صرف فيه همته أعظم النفع للأمة، فجزاه الله خيرًا، وأعظم له أجرًا.
وبهذا القدر أنهي جوابي لأستاذي غير أني أجد من المفيد نقل بعض أقوال السلف الصالح في هذه القضية لتوضيح مبهمها، وتعزيز أدلتها، والاطمئنان على إجماع الأئمة على صحتها.
والله المستعان.
نقل العلامة المحقق/ صديق حسن خان -رحمه الله- في كتابه «الدين الخالص » ج ۳ ص۱۷۰
عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله -رحمه الله: «مذهب أهل السنة والجماعة أن الله –سبحانه- خالق كل شيء، وربه، ومليكه، لا رب غيره، ولا خالق سواه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، والعبد مأمور بطاعة الله، وطاعة رسوله، منهى عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته، وإن عصى كان مستحقًا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره، ومشيئته وقدرته.
وذكر ابن القيم في شفاء العليل حديثًا لعمر -رضي الله عنه- رواه أبو داود عن عبد الله بن الحارث قال: « خطب عمر -رضي الله عنه- بالجابية فحمد الله وأثنى عليه، وعنده جاثليق يترجم له لما يقول، فقال: «من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادى له» فنفض الجاثليق جبينه كالمنكر لما يقول، قال عمر.. ما يقول؟ قالوا يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدًا، قال عمر، كذبت أي عدو الله، بل الله خلقك، وقد أضلك، ثم يدخلك النار، أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك، إن الله -عز وجل- خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون، فقال هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه» قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر» وقال ابن القيم -رحمه الله- في مقام سرد الأدلة على مذهب أهل الحق قال: « ومن ذلك قوله تعالى «واصبر وما صبرك إلا بالله» وقول هود عليه السلام «وما توفيقي إلا بالله» ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للصبر، وقد أخبر أنه به لا بالعبد، وهذا ينبغي أن يكون فعلًا للعبد حقيقة، ولهذا أمر به، وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه سبحانه، وإنما يؤمر العبد بفعله هو، ومع هذا فليس فعله واقعًا به وإنما هو بالخالق لكل شيء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالتصبير منه –سبحانه- وهو فعله، والصبر هو القائم بالعبد وهو فعل العبد ولهذا أثنى على من يسأله أن يصبره فقـال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ، فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ ...﴾ (البقرة: 250) انتهى شفاء العليل ص ۹۷ ولئن ذهبت أستقصي أقوال الأئمة في هذا الشأن لطال الكلام، وفيما ذكرته كفاية لمن وفق لفهمه والله المسئول أن يغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وأن يهدينا سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل