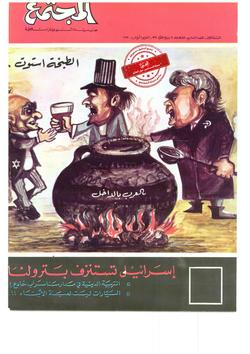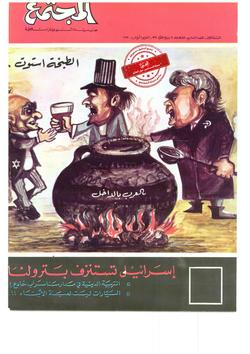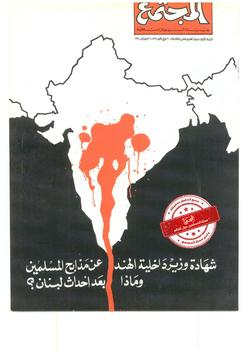العنوان أدب (396)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 25-أبريل-1978
مشاهدات 9
نشر في العدد 396
نشر في الصفحة 30
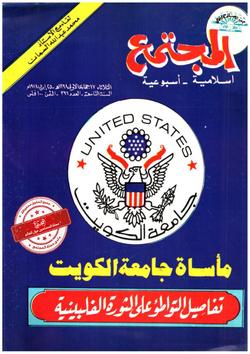
الثلاثاء 25-أبريل-1978
الالتزام في الأدب
الأدب، والنحت، والتصوير، والرسم والموسيقى كلها معا تشكل مجموعة يمكن أن نطلق عليها اسم
-الفنون الجميلة-
فالرسام يضرب بريشته ويعبر باللون، والنحات يحفر بأزميله ويعبر عن فكرته بالشكل والموسيقى يعبر عن إحساساته بلحنه.. وهكذا لكل فن أداته التي يعبر بها.. أما الأدب فيعبر عن مكنوناته بالكلمة.. هذه الكلمة التي تصور الفكرة وتجعلها سابحة في بحر من الخيال.
وللأديب نافذة داخلية تنفتح على الحياة فيحس بالأشياء وبالموجودات إحساسًا لا يملكه أي إنسان آخر.. والأديب إنسان متميز عن الأناس العاديين.. الأديب خفقة في روح هذا الوجود ويحس بكل نامة، وتضطرب خلجاته لكل رفة في هذا المحيط اللانهائي من نبضات الحياة.
فالأديب بكلمته يشارك في عزف سيمفونية عذبة لهذه الحياة تجعلها أكثر بهاء وأشد روعة..
نظرية الفن للفن:
وقد ظهرت في منتصف القرن الماضي- الفن للفن- وقد تقدمت نظرية هذه النظرية تقدمًا كبيرًا وقطعت شوطًا بعيدًا.. ولكن اتباعها بعد ذلك وجدوا أنفسهم في فراغ وجدوا أنهم يجرون في طريق لا يؤدي إلى نتيجة، ولا يوصل إلى غاية، وجدوا أنفسهم في طريق والجماهير كلها في طريق أخر.. بل وجدوا أنفسهم وليس معهم أحد مطلقًا وإن هذه النظرية قلا لاقت حتفها مع بداية هذا القرن . وبالتحديد منذ الحرب العالمية الأولى ، ولفظت أنفاسها الأخيرة مع الحرب العالمية الثانية.
نظرية الالتزام :
وقد انطوت تلك النظرية من عالم الفنون لتحل محلها نظرية جديدة هي- نظرية الالتزام ويهمني هنا أن أتحدث عن جوانب هذه النظرية في واحد من هذه الفنون إلا وهو فن الأدب..
إن طبول الحرب العالمية الأولى والثانية قد أيقظتنا على عالم ممزق الأوصال على عالم تبعثرت أشلاؤه مزقا هنا وهناك.. صحونا على وطن فيه مستعمر، وعلي أمة فيها تخلف وعلى أناس قد أجهدهم المرض والجهل..
فوجد الأديب نفسه معزولًا عن خوض هذه المعركة وأحس بأنه لا يمكنه أن يجلس في برجه العاجي بعيدًا عن هذه الأنات المتعالية من حواليه وجد الأديب نفسه وسط هذا الزحام المتلاطم فلم يملك إلا أن يستخدم كلمته لطرد الاستعمار، وليحث أمته على ترك التخلف ولينبه قومه إلى ضرورة مواصلة ركب الحضارة والعلم.. وهنا نجد الأديب قد التزم بقضية ما.. وأصبح الأدب أدب التزام..
نتساءل الآن.. هل يمكن للأديب أن يكون ملتزمًا أو غير ملتزم؟ للجواب عن هذا السؤال علينا أن نلقى نظرة إلى الأدباء لنجد كلا منهم قد التزم بقضية ما.. فمنهم من التزم بقضية المرأة ومنهم من التزم بقضية الوطن. وما مكسيم جوركي الملتزم بالأدب الشيوعي وجان بول سارتر الملتزم بالأدب الوجودي إلا أمثلة واضحة لهذا الالتزام وقد صدر كل واحد منهم من خلفية معينة، وعن اعتقاد أعتقده فأخذ يصور هذه الحياة من خلال هذه الرؤية التي ارتآها للحياة والوجود وللإنسان.
نظرية الالتزام في الأدب الإسلامي
ولنا الآن أن نتساءل أيضًا.. أليس من حق الأديب المسلم أن يصدر عن اعتقاده، ويصور الحياة من زاويته التي يعتقد أنها حق كلها.. وشرف كلها .. و.. وضرورة كلها أليس من واجب الأديب المسلم أن ينطلق في هذا الاتجاه بعد أن أصبح وطنه الإسلامي قطعًا قطعًا .. وأصبح دينه بعيد عن حياة الناس.. وبعد أن مد الاستعمار بكل أشكاله القديمة والحديثة يده إلى هذا الوطن وإلى هذا الدين وأخذ يعمل فيه يد التشويه والتقسيم..؟؟ أليس من حقه أن ينطلق من خلفية إسلامية ويصدر عن منطلق ديني ليحارب هذه الأشكال التي تبتز وطنه وتستهلكه.. ليجعل قلمه وفكره ومشاعره في خدمة يقظة الأمة الإسلامية وبعثها من رقدتها وأن يحدو لها في طريق بناء الحضارة والتقدم وليرسم لها ذلك المستقبل المشرق الذي ينتظرها يوم أن تتربع على عرشها كيوم ولدت؟
الفنان المسلم اليوم.. يجد نفسه أمام طريقين لا بد من أن يسلك أحدهما مختارًا: أما أن يسلك طريق مذهب - الفن للفن- ويعيش وحيدًا يناجي نفسه ويتكلم مع أفكاره. سجينًا في عالمه الخاص.. وإما أن يسخر قلمه وفكره ومشاعره وكل خلجة من خلجات قلبه لخدمة دينه ووطنه الإسلامي.. وعند ذلك يجد من حوله الجماهير والناس تسمع لكلماته، وتترسم خطاه، وتنهج سبيله، وتجد الأمل.. المنشود.. وقد مثل هذا الاتجاه في الأدب الإسلامي أدباء كثيرون .. من أمثال أحمد باكثير والشاعر محمد إقبال وعزيزة الإبراشي وهاشم الرفاعي وغيرهم وكأمثلة على ذلك نقف وقفة عند الشاعر محمد إقبال وعند الشاعر الشهيد هاشم الرفاعي..
الشاعر محمد إقبال أستطاع بنظرته الإسلامية ورؤيته العالمية أن يخلص الباكستان من الاستعمار البريطاني عندما كان يحدو لأمته الإسلامية بهذا النشيد الرائع..
الصين لنا والهند لنا ***والعرب لنا والكل لنا
أضحى الإسلام لنا دينًا ***وجميع الكون لنا وطنًا
أما الشاعر الشهيد هاشم الرفاعي فيقول:***ويهدني ألمي فأنشد راحتي
في بضع آيات من القرآن ***أهوى الحياة كريمة لا قيد لا
إرهاب لا استخفاف بالإنسان ***قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق
إلا أخيرًا لذة الإيمان ***فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي
يغلي دم الأحرار في شرياني***ويقول في موطن آخر:
تفيض قلوبنا بالهدى بأسًا ***فما تغضي عن الظلم الجفونا
أمد يدي فانتزع الرواسي ***وأبني المجد مؤتلفًا مكينًا
ففي هذه الخفقات نحس الالتزام بأعلى معانيه، ونحس بالإنسان صاحب القضية، نحس بالشاعر الذي يقدم كل ما يملك، قلمه، وروحه، ودمه في خدمة قضية دينه وأمته ووطنه.. وحري بشعراء اليوم. وكتاب العصر وقصاصي الساعة وكل من يشتغل بالأدب أن يصدروا عن هذا المنحى، وينطلقوا في هذا الاتجاه ويترسموا هذه الخطا فأمتنا وشعوبنا المسلمة تتلهف لهذا النوع من الالتزام وتصفق له أيما تصفيق.. أما الذي يريد أن يقف في محرابه يصف المرأة خدًا وقدًا ويتحدث عن طولها وقصرها أما الذي يريد أن يجلس في برجه العاجي بعيدًا عن الأمة فالأمة ليست في حاجة إليه ولا إلى شعره ولا إلى أقاصيصه ولا إلى أدبه. والأدب ككل يرفض هذه الأشكال في يومنا هذا.. بل الفنون الجميلة ككل ترفض هذا المنحى.. ونظرية -الفن للفن- قد ماتت- وشبعت موتًا لتحل محلها- نظرية الالتزام التي ينطلق منها كل مفكري اليوم وحري بالإنسان المسلم أن ينطلق في أدبه نحو أدب إسلامي ملتزم ولهذا الاتجاه ستقف أمتنا وقفة تقدير وستنظر إليه نظرة إجلال وإكبار.
عبد الرزاق على ديار بكرلي
من أدب القرآن
قال تعالى:﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (النور: 39)
ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسط، والخداع الوهمي للسراب. فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع، فأرض الصحراء وسماءها قد طبعا عليه انعكاسهما، فليس ما نلاحظه مما يتصل بالظاهرة القرآنية التي تشغلنا سوى ما نجده في الآية من بلاغة، حين تستخدم خداع السراب المغم، لتؤكد بها تلقيه من خلال تبدد الوهم الهائل لدى إنسان مخدوع، ينكشف في نهاية حياته غصب الله الشديد، في موضوع السراب الكاذب سراب الحياة.
والمثال الثاني قوله تعالى:﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ (النور: 40)
فهذا المثال يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي، بل لا علاقة لها بالمستوى العقلي، أو المعارف البحرية في العصر الجاهلي، إنما هي في مجموعها منتزعة من بعض البلدان الشمالية التي يلفها الضباب في الدنيا الجديدة أو في أيسلندا. فلو افترضنا أن النبي رأى في شبابه منظر البحر فلن يعدو الأمر شواطئ البحر الأحمر أو الأبيض. ومع تسليمنا بهذا الفرض فلسنا ندري كيف كان يمكن أن يرى الصورة المظلمة التي صورتها الآية المذكورة؟
وفي الآية، فضلًا عن الوصف الخارجي الذي يعرض المجاز المذكور سطر خاص، بل سطران، أولهما:
الإشارة الشفافة إلى تراكب الأمواج والثاني: هو الإشارة إلى الظلمات المتكاثفة في أعماق البحار، وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة علمية بالظواهر الخاصة بقاع البحر، وهي معرفة لم تتح للبشرية، إلا بعد معرفة جغرافية المحيطات، ودراسة البصريات الطبيعية.
وغني عن البيان أن تقول: إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج، وظاهرة امتصاص الضوء واختفائه على عمق معين في الماء، وعلى ذلك فما كان لنا أن ننسب هذا المجاز إلى عبقرية صنعتها الصحراء، ولا إلى ذات إنسانية صاغتها بيئة قارية.
الظاهرة القرآنية- مالك بن نبي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل