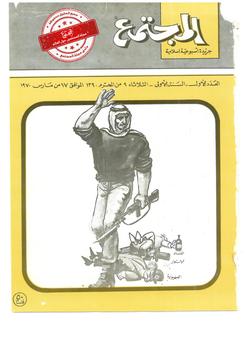العنوان التنكُر للصَحوة تشويه للحياة
الكاتب المهدى أبن عبود
تاريخ النشر الثلاثاء 08-ديسمبر-1987
مشاهدات 29
نشر في العدد 846
نشر في الصفحة 26
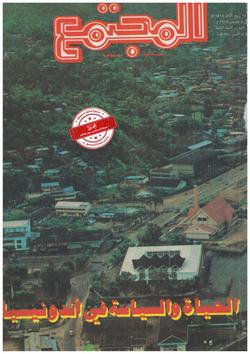
الثلاثاء 08-ديسمبر-1987
الدين الرباني، «والإسلام» الرباني هو إسلام
القرآن الكريم والسنة المطهرة.. المعصوم من الخطأ، المغروس في فطرة البشر، وفي فطرة
المخلوقات كلها من سموات وأرض وما بينهما، من تصريحهما ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت:11).
هذا «الإسلام» في عمق الوجود إظهار لتسبيح
الكائنات حتى تراه العيون المستبصرة والقلوب المتفتحة والعقول النيرة والأجيال السعيدة.
أما المسلمون فهم محض بشر، إذا اتبعوه بصدق
وإخلاص تعلقت همومهم بالحق، ففازوا بمقتضى المقولة الحكيمة «فاز من تعلقت همته بالله».
وإذا تنكروا للحق سبحانه وتعالى استولى
عليهم الباطل فتفل شوكتهم وتزهق أقدامهم؛ لأن الباطل نفسه كان زهوقًا.. وهذا الباطل
لا يوجد إلا في أوهام الناس.. إذ الموجود الواحد الحق هو الحق سبحانه وتعالى وما تجلى
به في مخلوقاته بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو الحي يتجلى بالحق، وهو رب العالمين يتجلى
بالربوبية والتدبير، وهو الحي القيوم الساهر على كل الكائنات بمقتضى حكمته وهو الحكيم،
وعلمه وهو العليم وكرمه وهو الكريم.
أما الباطل..
فما سمي «اشتقاقًا» باسمه المعروف إلا لأنه.. عاطل.. أي إن كل من اتبعه فهو في الوهم
والظن لا في العلم.. يسبح في سراب.. ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ
مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ (النور:۳۹) ولكن. ولكن.. ولكن.. وجد الله
عنده، لأن ربك لبالمرصاد.. فيكون جزاء الخير في مجرد اتباع طرق الخير لأنه لا يعمل
بالخير إلا الخيِّر (بتشديد الياء) الحر العظيم، ويكون عقاب الشر في محض اتباع طرق
الشر، لأنه لا يقدم على الشر إلا جاهل بالحق والعلم والخير، المريض بشخصية شريرة عقابها
«مضمون» «فيها» منذ نقطة انطلاقها.. وهذا الباطل يتسرب إلى الأفراد والشعوب بكسل العقل
وتبعية العبيد لأسيادهم على عكس استقلال العقل عند الأحرار.. ثم بطغيان الأهواء مثل
شهوة الحكم.. لا العدل.. وحب الشهوة التي لا تكون في مكانها إلا إذا نسيها الإنسان،
أما طالبها فهو مغرور بنفسه ثم طهارة النفس وتفتح القلب حتى يجتمع عمل العقل بعمل القلب،
فيكون للناس قلوب يعقلون بها، والباطل مآله الاحباط.. فكل من اتبع الباطل حبطت أعماله.
فالعقل والنفس والقلب في مجموعها نبراس
الظاهر من جسم الإنسان إلى تصرفه فيما سخر الله له. فالمسخرات منفعلة بعمل الإنسان
في طريق الخير إذا توفرت شروطه لتكون خير أمة.. ولا يمكن لأية أمة أن تكون خير أمة
إلا بتوافر «الشروط»، خلافًا لزعم الصهيونية بأنهم خير أمة «بدون شروط».. بل إن صفة
الإنسانية اقتصرت عليهم ولم يحظ بها إلا شعبهم إطلاقًا وبدون أدنى استثناء!
ثم إن المسلمين- خلافًا للإسلام- يهيأ لهم
رؤية بعض الحق لا كل الحق، وبعض وجوه العلم لا كل العلم فيتيهون في مذاهب وفلسفات وطرق
وفرق وما إلى ذلك من كل ما يبني على الظن لا على العلم، ويأتي هنا ما يسمى بالفكر الإسلامي،
وهو فكر «المسلمين» لا فكر «الإسلام» «المضمون» في الكتاب والسنة.. وعند حراس الكتاب
والسنة الذين يطلق عليهم اسم «السلف الصالح».
السلفية هنا يمكن أن تتلخص في كلمة واحدة
وهي الثبات على المبدأ.
ومن هنا نرى أن التابعين المطهرين في زمرة
السلف الصالح، لخوفهم من الشطط والزيغ والبدع والخرافات والوثنيات الجديدة، وبجانبهم
من قلد الأفكار الأجنبية والفلسفات والمذاهب الماضية والحاضرة.. هم كالصبيان لا يستطيعون
أن يستقلوا بعقلهم، يجدون أنفسهم في أشد الحاجة إلى من «يفكر لهم».
الإسلام ليس بفكر.. هو علم، هو حق.. بحسب
ألفاظ القرآن الكريم.
فلا بد إذن أن ينجح من يسلك طريق الحق،
وأن يواجه الفوضى الفكرية والنفسية والاجتماعية من يسجن نفسه في قفص الظن أو الأهواء
والشهوات والأغراض المبينة.. إلى غير ذلك من النقائض التي تنم عن ضعف الشخصية وقلة
العمق في التفكير.
خلاصة القول: فإن الخلل في الناس وليس في
العقيدة.
على أن سؤالًا مهمًا قد يطرح نفسه هنا كيف
يكون للاجتهاد دوره الثابت وبعث الروح الإسلامية الوثابة وتفسير تشريعات الإسلام لما
يصلح لهذا العصر؟
وفي هذا الصدد يمكن لنا القول:
إن عبارة مثل «لقد حصحص الحق» وفي كل زمان
ومكان تفيد بثلاثة أشياء.
أولها: الحق
كعلم.. وهو الذي يطلبه كل ذي بصيرة؛ ليستريح من الفوضى الفكرية الظاهرة في الشك والذبذبة
والقلق النفسي والحيرة والتقليد الأعمى للغير.
ثانيها: سلوك
سبل السلام وطريق الخير من تضامن وتضحية وصدق وإخلاص ووعد وإرشاد وتقوى وورع، كل ذلك
شيء واحد بسيط لا يجادل فيه أحد.. مثل النقطة السالفة التي تعد واضحة وبسيطة، خصوصا
وأن الله لا يفعل إلا خيرًا. والحياة من حكمته، وجمال صنعه بما في ذلك صنع القلب البشري
الذي يرجع إليه الإنسان.. يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم «استفت قلبك».
ثالثها: هي أن الأمر شورى بين الناس، إذن
الأمر مفتوح فيما يتعلق بباب الاجتهاد، وفي ميادين المصلحة العامة والخاصة.
إن الله عظم
العقل بحيث جعله أساس التكليف، فالأحمق والرضيع غير مكلف، وبدون العقل لا يبقى مجال
حتى للإسلام نفسه.
إذن لابد من استعمال هذا العقل، فيما يتعلق
بالعلم والمصلحة.. ولابد من استفتاء القلب فيما يتعلق بالذوق وأعمال البر، ولابد من
مساعدة الجوارح بما لا تستطيعه هذه الجوارح ويصنعه العقل وهو ما يسمى اليوم «بالتكنولوجيا»،
وإطالة الكلام في هذا الباب كما في الباب السابق- الذي اختص به السؤال الأول يعتبر
في عداد الإسهاب الذي لا نهاية له.
ومع ذلك نقول- من وجهة نظرنا- بأن للاجتهاد
قناة متصلة بحاجة ما ملحة إذا ظهرت وكان من الصعب حل مشكلة متعلقة بها كان للفطرة دور
ما، وكذلك العقل والقلب.. وغيرهما أيضًا.
ثم إن للاجتهاد شروطا معروفة ومحددة، وهي
العلم الراسخ- يعني علم المؤمنين الخاشعين الخائفين من الخطأ وعصيان الله.
ثم عمق النظرة إلى أسرار الآيات والأحاديث
بالإضافة إلى أسرار الكائنات قصد اليقين من مطابقة الحقائق للمخلوقات.
ما عدا ذلك تعسف وجهل مركب.
على أننا نشاهد في عالم اليوم بعض المظاهر
منها:
1- زلزلة الثقة بالنفس بما يسمى
الثقافة الغربية- في الدول الأوروبية المصنعة- ولذلك انتشرت المسكرات والمخدرات وألوان
الفسق والفجور والعنف من اختطافات وعدوانيات وأساليب العدوان على النفس «كالانتحار»
وعلى الغير «كالتدمير» الشيء الذي يدل على ما يسموه بالرفض.
2- طلب البديل.
3- التوجه إلى المعنويات سواء كانت معنویات أو
شبه معنويات مثل الفرق الشبه الدينية الضالة كما حدث مع «جونز تاون» الذي أمر اتباعه
بالانتحار.. فانتحروا!
4- الشعور المتزايد بالحاجة إلى مذهب على شكل
دين ترتاح له النفس من متاعبها.
5- العودة إلى المعابد والكنائس في الغرب وحتى
في المعسكر الشيوعي، بل وخصوصًا في هذا المعسكر.. مثل بولونيا والاتحاد السوفيتي.
6- الشعور عند المسلمين بالظلم الاستعماري والاستبداد،
بالإضافة إلى ما يلاحظه المسلم من أزمة شنيعة يشتكي منها الغرب نفسه- في عقر داره-
وعدم ثقته بالمذاهب شبه العلمانية التي يسمونها «بالعلموية» والتي آلت إلى الفشل الذريع
كما رأينا.
7- يقين المسلم بشمولية الإسلام وضرورة أن
يكون مذهبًا شاملًا يصلح للبشر كلهم بعدما يتيقن أنه الوحيد الكفيل بإصلاح شأنهم.
8- من هذا الشعور العام.. وبما للإسلام من قوة-
في الكتاب والسنة والبيان- أخذ الشبان والشيوخ يقترب بعضهم من بعض لطلب النجاة في الحياة
النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
إذن الصحوة.. هي تلبية لنداء «الفطرة»..
بلا زائد ولا ناقص.. وكل تنكر «لها» يعتبر تشويها للحياة ومحاولة للتغطية على امتياز
ما أو مصلحة انتهازية ما.
نعود فنقول: إن مجموع الحقائق التي عددناها
تؤكد فعلًا على حصول هذه الصحوة الإسلامية..
وحصولها بالكيفية التي حددناها بالذات-
من وجهة نظرنا- أي إنها صحوة الفطرة.. بمعزل عن أي توجهات أو ترتيبات من هنا.. أو من
هناك.. من هذا.. أو من ذاك.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل