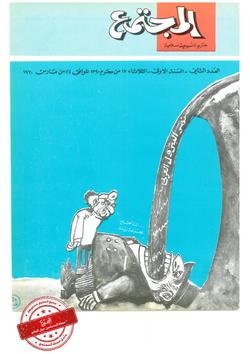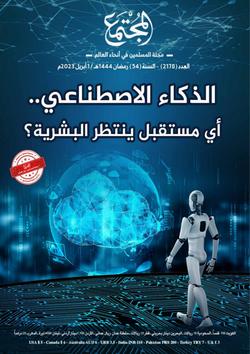العنوان الدعوة إلى الانقلاب على النصوص والثوابت الإسلامية.. والرد عليها
الكاتب خيري عمر
تاريخ النشر الأحد 01-مارس-2015
مشاهدات 45
نشر في العدد 2081
نشر في الصفحة 12

الأحد 01-مارس-2015
في ظل حملة الهجوم على الإسلام، صدرت دعوات مشبوهة للثورة (الانقلاب) على النصوص المقدسة والثوابت الإسلامية، ويهدف أصحاب هذه الدعوات إلى ضرب العقيدة الإسلامية وثوابت الدين.
وفي هذا الملف، نستعرض بعض هذه الدعوات ورد العلماء والفقهاء والمفكرين عليها، وكيف يفعل المسلم حيالها، وحكم من ينادي بها.
خلفيات الدعوة لتغيير النصوص الإسلامية
د. خيري عمر
بعد موجة الثورات العربية، تشهد البلاد العربية حالة من التباعد مع القيم والأخلاق تحت دعاوى التحديث، وهي ظواهر تترافق عادة مع التغيرات التي تشهدها المجتمعات، وكان من اللافت تكرار المطالبة بالثورة على النصوص الدينية، باعتبارها عقبة في طريق التقدم والاستقرار، كما أنها تشكل أرضية خصبة للإرهاب، وهي مقولات ومطالب تقتصر فقط على الإسلام دون غيره من المعتقدات، وهي ما يثير النقاش حول دلالات تبني بعض المسلمين والسياسيين لهذه التوجهات.
الخلفية الفكرية
ومن الناحية الفكرية، يعد فلتان انتقاد الإسلام كنصوص ومرجعية، امتدادًا لسياسات التغريب التي بدأت في القرن التاسع عشر، وهي سياسة تستهدف ترسيخ النمط الفوضوي في المجتمع، وظهرت سياسات مزدوجة، عملت من ناحية على تطوير الفكر الغربي، ومن ناحية أخرى اتجهت لتفكيك النظريات الإسلامية والثقافة العربية، وبغض النظر عن الجدال الفكري حول نتائج هذه السياسات، فإنها أدت إلى تشوه التنمية في العالم الإسلامي، وساهمت في تركز السلطة والاستبداد، وتكسير البنى الاجتماعية التقليدية، وتراجع التطور الصناعي.
لقد ركزت جهود المثقفين وتحالفهم مع الدولة على توطيد أسس الدولة العلمانية، على نحو يتعذر معه مزاحمة مشروع آخر، حتى وصلت الأمور إلى أنه من الضروري تشويه الدين باعتباره عقبة أمام التقدم، واستبداله بعلمانية عقدية، وقد نظَّر المبشرون بالعلمانية - وهم من المسيحيين - إلى التخلف العربي، تطورت في وقت لاحق، ليس فقط فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية (فصل الدين عن الدولة)، ولكن استبعاد الدين من المجتمع، وهو ما يظهر في السياسات الاجتماعية المتعلقة بـ"تكميش" (انكماش) الدور الاجتماعي للمسجد وتوحيد الخطابة، وهي نوع من السياسة التدخلية للسيطرة على المؤسسات الدينية والتحكم في توجهاتها.
ويعد الهدف الرئيس لهذه التوجهات؛ هو هز الأرضية التي تقوم عليها الثقافة والقيم الدينية والوطنية؛ فكانت فكرة الدولة القومية مقابلة لمفهوم الأمة بشكل أثار الدعوة إلى إعادة صياغة تاريخ الإسلام وتأويله تبعًا للمنهجية الغربية، وهي تشكل امتدادًا لكتابات "محمد أركون"، و"جورج طرابيشي" وغيرهما، حيث كان محور مؤلفاتهم إعادة تشكيل النظم الاجتماعية عبر تغيير المقومات الدينية والثقافية، وهذه المسائل ظلت تشكل خلفية مواقف الدولة من الدين (الإسلام) وبصورة تخرجها عن الحياد تجاه الأيديولوجيات والأفكار.
وفي ظل قصور الدولة في بعض البلدان العربية عن تفسير موقفها تجاه الإسلام، يؤكد كثير من المشاهدات الآراء التي تذهب إلى أن الحكومات تسعى لتهميش الإسلام ذاته وتغيير بعض مقوماته الفكرية والعقيدية؛ تحت دعاوى مكافحة الإرهاب، وظهور توجهات ودعوات تسمح بالتوسع في الحريات لدرجة تتجاوز الفلتان الأخلاقي، والمشكلة أن هذه الحالات صارت تحظى بحماية قانونية، وتعمل تحت مظلة سياسية، وهي أمور تثير الجدل حول تحيُّزات الدولة، ليس فقط ضد الدين، بشكل عام، ولكن لصالح قيم تراها تعبيرًا عن الحرية مهما كانت مخالفة للتقاليد والعادات.
وقد برزت وجهتا نظر في تفسير المطالبة بمراجعة النصوص الإسلامية أو التخلص منها، وكانت الوجهة الأولى تتعلق بأن المقصد العام يتجه نحو التراث الفقهي وليس المصادر الأصلية (القرآن الكريم، والسُّنة النبوية)، وهي توجهات تطالب بمراجعة الاجتهادات الفقهية التي عالجت ظواهر وأوضاعًا سابقة، وأصبحت لا تلائم الظروف الراهنة.
وذهبت الوجهة الثانية إلى أن المطالبة بالتخلص من التراث لا تميز بين النصوص الدينية واجتهادات العلماء عبر الزمن، ويستندون في ذلك إلى حالتين؛ أن الخطاب السياسي للسلطة لم يميز أو يفسر ما يقصده بالأفكار التي ساعدت في تفاقم النظرة السلبية للإسلام، وأن كثيرًا من المثقفين العلمانيين والفوضويين اتجه للتعامل مع القرآن والحديث النبوي كتعامله مع القصائد الشعرية، ولذلك خلص لنتائج وآراء تطالب بحذف بعض الآيات والأحاديث باعتبارها لم تعد تناسب العصر.
سياسات ونماذج
وقد كان من المؤمَّل، أن تقود ثورات "الربيع العربي" حراكًا ثقافيًا يملأ الفراغ الذي عانت منه البلاد لفترات طويلة، لكن العثرات التي واجهتها، وخصوصًا منذ انقلاب يوليو 2013م بمصر، أدت لحدوث تغيُّر في سياسات وطرق بناء وتكوين الثقافة الاجتماعية والدينية، وهناك الكثير من الحالات الأخرى التي توضح انحدار المسارات السياسية في العديد من البلدان نحو انحياز الدولة لموضة الحداثة دون معايير واضحة.
وبعد تردد، اتجهت مصر لرفع الرقابة عن الأعمال السينمائية، وعرض الأفلام دون مراجعة تراعي قيم المجتمع أو تحافظ على الحد الأدنى من وضع ضوابط للنشر الفني، وهذا ما يعبر عن وجود انحراف في النظر لدور السينما تجاه المجتمع؛ وهو يتشكل من ثلاثة اتجاهات.
إن إطلاق الخيال لطائفة من الأعمال "الفنية"، يأتي في سياق الكثير من الدعوات التي تميل بقوة للخروج على القيم والأخلاق، وهي محاولات تجاوز الدعوة لـ"علمنة" المجتمع وإبعاده عن التدين إلى مرحلة فرض موجة من الانحلال والصدام مع الدين، وهنا تفقد الدولة دورها كحارسة للقيم وحامية للتقاليد، وانتقلت لمربع حماية ثقافات لا تلائم البيئة الوطنية، وقد لقي هذا التوجه انتقادات من وجهة أنه يعزز الانفلات الاجتماعي.
تقييم اتجاهات "العلمنة"
ويمكن القول: إن ظهور مثل هذه السياسات يكشف عن مرامي وغايات تفكيك النصوص الدينية واستبعادها، سواء باعتبارها نصًا أصيلًا ومقدسًا أو باعتبارها اجتهادًا علميًا، فالفكرة المركزية هنا تتمثل في الخروج على دائرة الضوابط الأخلاقية والنظم الاجتماعية؛ وبالتالي، تبدو مسألة تقييم هذه التوجهات غير ذات أهمية، وذلك يرجع إلى أن طرحها في هذا التوقيت يرجع لخلفيات ومواقف سياسية، وكرد فعل على الدور السياسي للحركات الإسلامية، خلال السنوات الماضية، ولم تأتِ في سياق جدل ثقافي وفكري يطرح مقولات جديدة ومختلفة في النظر والتعامل مع التغيرات الاجتماعية والسياسية.
فالمطالب التي تنتقد الخبرات والتراث الإسلامي تعاني من سطحية شديدة مقارنة بكتابات السابقين منهم؛ كـ"نصر أبو زيد"، و"فرج فودة"، حيث ارتكزت مقولاتهم على اجترار السوابق دون تقديم طرح مختلف يشكل إضافة لأفكارهم، وهذا ما يشير لتراجع المساهمات العلمية والمشروعات السياسية في التطوير الاجتماعي وطرح بدائل للتنمية.
وبغض النظر عن غموض مواقف بعض الدول من المطالبة بتصحيح النصوص الدينية، تشير الخبرات السابقة إلى وجود مشكلات منهجية في تناول العلمانيين للسياقات الإسلامية، حيث يُخضعون النصوص الإسلامية للمرجعية الفلسفية الغربية؛ ولهذا يصلون إلى نتائج مخالفة لطبيعة وخصائص النصوص ومقاصد الإسلام، فالتوجهات الاستبعادية في الفلسفات الغربية تفسر نظرتهم الدائمة إلى محتوى القرآن على أنه عقبة أمام التطور والتقدم، ويكون التصحيح بالتخلص منها.. فيما تسعى بعض الدول توظيف الجدل الفكري في إطار مكافحة الإرهاب؛ ولذلك ترى أهمية تجنيب النصوص التي تحض على القتال والجهاد؛ باعتبارها تشجيعًا على العنف، وهذه المواقف لا تأخذ في الاعتبار السياقات العلمية والمنهجية في تفسير النصوص وتكتفي بظواهرها.
إن استمرار هذه الظواهر يرتبط بالكثير من العوامل، لكنه من الممكن التركيز على عاملين مهمين؛ أن تلك الأفكار تستند في جزء منها إلى انخفاض اضطلاع المؤسسات الإسلامية بمهامها في الاجتهاد والتفسير والفتوى، ويؤدي هذا القصور إلى بروز كيانات علمانية وإسلامية تتصدى لهذه المهام دون دراية علمية.
كما أنه رغم اتساع تأثير الحركات الإسلامية، لم يتبلور مشروع متكامل يستطيع أن ينهض بعمليات التقدم والتحديث ومعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع، وخلال السنوات الماضية، لم تظهر أفكار تعبر عن توجهات تجديدية يمكن الارتكاز عليها في تطوير السياسات الاجتماعية.
مفكرون وشيوخ وباحثون جامعيون:
"الثورة" على النصوص.. ظاهرها التجديد وباطنها التشكيك المستمر في ثوابت الدين
عبدالله غازيوي: إن أهم مرتكزات وأسس الاجتهاد هو علم أصول الفقه لأنه الميزان الحقيقي لفهم النصوص الشرعية ومحاولة إعمالها
بن دودو: بين متحجِّر يرى الدين كله قولًا واحدًا.. وبين متميِّع يرى في كل قضية مجالًا للنظر وذريعة للترك.. يجد المتحاملون على الإسلام من أعدائه سبيلًا للطعن
عزيز البطيوي: الساحة الإسلامية تعرف فوضى منهجية وفكرية ودعاوى تدعو إلى الثورة على النصوص لا يمكن بتاتًا اعتبارها محاولات تجديدية بل هي محاولات لإبطال النص وتعطيله بحكم تاريخيته
الرباط: عبدالغني بلوط
تناسلت الخطابات في العصر الحالي حول التعامل مع النص الديني الشرعي من المطالبة بتجديده، إلى ضرورة إعادة قراءته، إلى الانقلاب عليه؛ هذا الانقلاب يستهدف - على ما يبدو - التعامل المباشر مع النصوص، عارية من كل فهم وتأويل شرعي؛ لتتولى هي الفهم الذي تريد، والتأويل الذي تحب.
وفي استطلاع لـ"المجتمع" لآراء عدد من المفكرين والفقهاء والأساتذة الجامعيين والباحثين بالمغرب العربي، أكدوا أن الظاهرة قديمة، ظاهرها التجديد، وباطنها نقيض ذلك، وقد تجددت مع دخول الاستعمار لبلاد المسلمين، وهي حرب قذرة على الإسلام، تستند إلى حملات التشكيك المستمرة في قطعيات الدين وثوابته.
يستهل د. محمد خروبات، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، التعليق على "الدعوة إلى الثورة على النصوص الشرعية"؛ بأن هذه مقولة عدوانية، فالثورة تعني المناهضة والصراع لأجل التغيير والتبديل، فماذا عسانا أن نقول لمن يناهض النصوص الشرعية لأجل تبديلها وتغييرها وتحويلها وتأويلها وفق التأويل الذي تأباه؟ أي حوار نفتحه معه إذا كان هذا هو طموحه ورغبته؟
ويضيف د. خروبات، المحاضر في علوم الدين؛ أن الإسلام هو دين الله، ولله رب يحميه، والنصوص الشرعية المراد الانقلاب عليها ملقحة بسياج العلوم الشرعية، هي كذلك للمؤيدين وللمعارضين، فالمؤيدون لا مدخل لهم إلى هذه النصوص إلا عبر بوابة العلوم الإسلامية، والمناوئون سيجدون أمام النصوص سياجًا قويًا صامدًا.
العدو من داخلنا
ويكشف د. عبدالله غازيوي، أستاذ بكلية الشريعة بمدينة فاس، عن جذور هذه الظاهرة، فيقول: إن الأمة الإسلامية ابتليت بويلات الاستعمار، إلا أن الأقسى أن يسهم في ضرب الثوابت الدينية والثقافية والوطنية أناس محسوبون على الثقافة والفكر، فصاروا لا يفرقون بين الثابت والمتغير، وذلك من أجل محاولة تنفيذ أغراض من يريدون القضاء على أوجه التمييز بين المجتمعات الإسلامية وغيرها، فأباحوا لأنفسهم الاجتهاد والتوجيه لكل ما يناسب أهواءهم، ويحقق مقاصدهم.
ويؤكد غازيوي، الأستاذ الباحث، أن من خصائص شريعتنا الغراء، الدعوة إلى الاجتهاد وإعمال الفكر، وإيجاد الحلول لكل الحوادث والمستجدات، بدليل قول الحق سبحانه: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) (النساء:59)، وقوله عز من قائل: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) (الشورى:10)، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – لمعاذ بن جبل: "فإن لم تجد في كتاب الله ولا سُنة رسول الله"، قال معاذ: "أجتهد رأيي ولا آلو".
ولكن هذا مشروط بتوافر شروط الاجتهاد، وإلا كان المتعدي على استنطاق النصوص آثمًا بدليل قوله – صلى الله عليه وسلم-: "القضاة ثلاثة؛ رجل في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، وهذا هو موطن الشاهد.
ويتابع غازيوي: إن أهم مرتكزات وأسس الاجتهاد هو علم أصول الفقه؛ لأنه الميزان الحقيقي لفهم النصوص الشرعية ومحاولة إعمالها، كما أنه هو السبيل إلى ضبط كيفية تنزيل النصوص على الوقائع الجزئية الحادثة والمستحدثة، وأظن أن الذين يتطاولون على النصوص بشرحها وتوجيهها، لا دراية لهم بوسائل الفهم ولا بكيفية التنزيل، والباحث في العلوم الشرعية الذي يحترم نفسه، هو الذي يؤمن باحترام المنهج العلمي أولًا، ثم يعلم ثانيًا أن النصوص على نوعين: نوع من قبيل القطعي الذي ينبغي التسليم به؛ لأنه لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا عند جمهور الأصوليين، ونوع من قبيل الظني وهو حمّال أوجه، وقابل لأن تختلف فيه وجهات نظر المجتهدين.. فالأول ينبغي أن يكون محل اتفاق بين الدارسين والباحثين، حسب ما يقتضيه المنهج العلمي، والثاني جعل الله فيه توسعة على الناس، وفيه يبرز تفاوت القدرات العقلية بالنسبة للمجتهدين، ومع ذلك فلابد من احترام الشروط والضوابط التي سَنَّها العلماء للخوض في غمار النصوص الظنية.
ويبرز غازيوي أن هناك فوضى عارمة في محاولة قراءة النصوص قراءة جديدة مقطوعة عن فهوم من مضى من سلف هذه الأمة، من ذلك حديثهم عن المساواة، فصاروا يعقبون عن أحكام الله القطعية، فالتعقيب على النصوص التي تفيد الجزم ليس عن أحد، وإنما هو تعقيب عن أحكم الحاكمين، وعن الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، كما هو تعقيب عن إجماع هذه الأمة التي يعتبر إجماعها معصومًا.
الخلط والاستهانة
أما الشيخ محمد سالم بن عبدالحي بن دودو، رئيس قسم الدراسات العليا بمركز تكوين العلماء، ونائب الأمين العام لمنتدى العلماء والأئمة بموريتانيا، فيعتقد أن الخلط بين الثابت والمتغير في الإسلام مازال بؤرة لاختلافات أهله عن قصد أو من غير قصد، فبين متحجِّر يرى الدين كله قولًا واحدًا لا رأي فيه ولا تعدد ولا تنوع، فلا ظني لديه ولا متغير عنده، وبين متميِّع يرى في كل قضية مجالًا للنظر ومدخلًا للطعن وذريعة للترك، فلا قطعي لديه، ولا ثابت عنده.. ويشير إلى أن بين تميُّع هؤلاء وتحجُّر أولئك يجد المتحاملون على الإسلام من أعدائه، والمتحلِّلون منه من أبنائه؛ الثغرة المأمولة للانقضاض عليه والإرجاف فيه، ويؤكد أنه لم تسلم من هذه الهمجية والهجومية فرعية من فرعياته ولا كلية من كلياته، حتى كلية "حفظ الدين" التي غدت مؤشر تناقض لافت بين مكفِّرين يخرجون من الملة لمجرد الأخذ بالرخصة أو ترك العزيمة، وبين مفكِّرين يخلطون بين الفكر الحر والكفر البواح.
ويقول الشيخ: لعل أبرز علامة فارقة بين القطعي الثابت وبين الظني المتغير؛ هو انعقاد إجماع الأمة على مقتضى دليل معين، أو تقرر اختلافها فيه، فحيث انعقد الإجماع حصل القطع وتقرر الثبات، وأما حيث تقرر الخلاف فيكون المعول على "الأرجحية" في الدليل و"الأحوطية" في الدين، ويبقى العذر قائمًا إذ الكل مصيب، أو المصيب واحد غير معين لنا، والحرج مرفوع عن غيره، ورأيك صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرك خطأ يحتمل الصواب.
فوضى المنهجي والمعرفي
أما د. عزيز البطيوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير، المتخصص في الفكر الإسلامي ومناهج الدراسات العلمية في السيرة النبوي، فيقول: إنه بغض النظر عن خلفيات هذه الخطابات ومدى تمكّنها المنهجي والمعرفي في فهم النص الشرعي؛ فإن الساحة الإسلامية تعرف فوضى منهجية وفكرية، ودعاوى تدعو إلى الثورة على النصوص لا يمكن بتاتًا اعتبارها محاولات تجديدية، بل هي محاولات لإبطال النص وتعطيله بحكم تاريخيته؛ فجعلت الواقع حكمًا على النص بعد أن حكمت على النص بنسبيته وتاريخيته، وألغت إطلاقيته، وأصبحت هذه المقولة مقولة النسبية مقولة مطلقة تحكم النص والواقع معًا في عبثية معرفية وفوضى منهجية، حيث لا ثوابت ولا مطْلقات؛ خدمة لأهواء سياسية بئيسة، ومطامع شخصية رخيصة، فلا تجديد مع استعارة آليات خارج المجال التداولي للنصوص، ولا يمكن أبدًا تمثل التجربة الغربية في الثورة على النصوص، فالفرق واضح بين نصوص لم تعد أصلية؛ أي لم تعد كلام الله بخلاف القرآن.
ويرى المتحدث بأن المدخل الأساس لكشف عوار هذه الدعاوى هو ضبط خصوصية النص ومعرفة الحدود بين الثوابت والمتغيرات؛ فالنص القرآني والحديثي من حيث هو النص الأصل المؤسس يمثل الثابت المطلق، ولا يمكن أن تحكمه الوقائع الإنسانية والمناهج التأويلية البشرية إلا بقدر ما تكون قواعدها وآلياتها ووسائلها مستمدة من القرآن نفسه، ويقابله نص بشري موازٍ مفسر له يمثل المتغير النسبي.
تجفيف منابع الفكر
أما الداعية الإسلامي والمفكر، أ. حماد القباج، فيرفع الستار عن أبعاد "الدعوة إلى ثورة دينية" بالقول: إنها تأتي في سياق استكمال مشروع محاصرة ومصادرة حركات وتوجهات ما يسمى بـ"تيار الإسلام السياسي"؛ وذلك بمحاولة تجفيف المنابع العلمية والفكرية التي تغذيه، فإن جانبًا من قوة هذا التيار تكمن في كون كثير من أطيافه؛ متمسكة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومتمسكة بالمرجعية العلمية والفكرية للمسلمين.. وقد أثبت ذلك التيار قدرته على تقديم مشروع سياسي معاصر يجمع إلى حد كبير بين المحافظة على الثوابت الشرعية وتدبير الشأن السياسي في إطارها، كما نجحت مكوناته في إنتاج خطاب إعلامي قادر على إقناع شرائح واسعة من الناس، وبطرحه القوي نجح تيار "الإسلام السياسي" في الصمود أمام حملات التشويه الممنهجة التي شنت ضده من طرف الإعلام العلماني.
ويضيف القباج أنه لا يخفى أن بقاءه أمر ضروري ومصيري بالنسبة للدول الإمبريالية لمصالحها المتعددة في ذلك، وأهمها بقاء وهيمنة دولة "إسرائيل"، وهكذا وبعد الانقلاب العسكري في مصر ومحاولة السيطرة على المشهد السياسي وتركيع الفاعلين فيه لإرادة العسكر؛ كان من اللازم الشروع في تفكيك عناصر القوة في المشروع السياسي (الإسلامي)؛ وعلى رأسها التمسك بالثوابت الشرعية والمرجعية العلمية، والقدرة على عرضها بصورة منسجمة مع الواقع المعاصر ومتطلباته.
ويشير إلى أن الانقلابيين يتجشمون اقتحام حصن اندقت عند عتبته أعناق من سبقهم، ويحاولون استعمال قوة السلطة السياسية وما يتبعها من هيمنة على أجهزة الأمن والقضاء والإعلام.
أما د. مولاي عمر بن حماد، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، فيشدد على أنه يصعب الحديث عن ثورة على النصوص؛ لأن للثورة معناها الإيجابي، وفي الأثر عن ابن ومسعود رضي الله عنه: "من أراد خير الأولين والآخرين فليثوِّر القرآن"، لكن الذي نعانيه هو الحرب على الإسلام وحملات التشكيك المستمرة في قطعيات الدين وثوابته.. يمكن القول من حيث المبدأ وبإجمال: إن الحرب على الإسلام لم تنتهِ منذ بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يمنع الفرص المتاحة التي يسَّرت انتشار الدعوة الإسلامية، ولم يمنع أيضًا فرص التعريف بالإسلام والاحتضان الذي لقيه هذا الدين من أول يوم سواء ممن آمن به أو من سانده وإن لم يؤمن به.
ويظهر أن الأمر ليس حكرًا على دين الإسلام، بل هي سمة مميزة لمسيرة الأنبياء جميعًا عليهم السلام، ويشهد لذلك قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) (الأنعام:113)، وقال تعالى: (مَا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) (فصلت:43).
ويؤكد بن حماد أنه معلوم أن الذي تعرض له الأنبياء والرسل لم يكن لأشخاصهم، ولكن لما جاؤوا به، وواجب العلماء التصدي لمثل هذه الدعوات بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها، وتلك هي رسالة العلماء التي قال الله تعالى عنها: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) (الأحزاب:39)، وهو مقتضى الميثاق الوارد في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) (آل عمران:187).
ويمكن القول: إن أغلب من يسلك منهج الجرأة على القرآن والسُّنة وما دلَّا عليه من الثوابت الإسلامية، هو دائر بين أن يكون قد تتلمذ على بعض المستشرقين القدامى منهم أو المعاصرين، أو اختار لنفسه مذهبًا فكريًا بعيدًا عن القرآن والسُّنة، ووقع أسيرًا لتلك القناعات التي تبلورت عنده بعيدًا عن الوحي، فلما اصطدم بها ظهر بمظهر الثائر عليها.
ويبقى المطلوب من جهة وضع الأمور في إطارها العام، أو الإمساك بالصورة الكاملة للاستهداف عوض الانجرار مع بعض الجزئيات كأنها هي المقصودة وحدها، ومن ذلك أيضًا النبش في خلفيات الهجوم ودواعيه ومراميه، لكي توضع الخطة المناسبة للتصدي له، ومن ذلك أيضًا إنشاء مراكز بحث متخصصة في الموضوع عوض انشغال الأفراد بالرد.
دعاه كويتيون: الدعوة لثورة دينية طعن في صميم تعاليم الإسلام
الحساوي: حلقة من سلسلة الصراعات بين الحق والباطل
الفضلي: يحاولون الهجوم على الثوابت الشرعية لهدم العقيدة الصحيحة
كتب: سامح أبو الحسن
الانقلاب يعني تحوُّل الشيء عن وجهه، والثورة هي تغيير أساسي في الأوضاع، فالانقلاب أو الثورة على النصوص والثوابت الدينية تعني المناهضة والوقوف في وجه تلك النصوص والثوابت لمحاولة تغييرها أو تبديلها، فماذا عسانا أن نقول لمن يحاول أن يقوم بتغيير النصوص والثوابت الدينية؟ لأجل تبديلها أو تغييرها وفق هواه، فكثير من الإعلاميين العلمانيين الآن لا همَّ لهم إلا محاولة فتح نافذة أو فتحة صغيرة في تلك الثوابت الدينية للبدء بتوسيعها بعد ذلك، وهو ما يقوم به بالفعل بعض الإعلاميين الذين يحاولون الطعن في كتب الصحاح عن طريق الطعن في بعض الأحاديث؛ محاولين بذلك نزع الهوية الإسلامية من مجتمعاتنا، فتلك الثورة هي صراع بين الحق والباطل، فالدعوة إلى الثورة الدينية ترجمها المنافقون باعتبارها ثورة على الدين، وانقلابًا على تعاليمه ورموزه ومؤسساته، وليس تجديد الفكر وتوظيف الاجتهاد.
وقد أكد دعاة أن الدعوات إلى القيام بثورة على الثوابت الدينية هي حلقة من سلسلة الصراعات بين الحق والباطل، والتي امتدت على مدى عصور من الزمان، مؤكدين أن هناك من يسعى إلى تعزيز الظلم، في محاولة للقفز على النصوص التي تحارب الظلم كأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الجهاد.
فقد قال الكاتب الصحفي وائل الحساوي في تصريح خاص لـ"المجتمع": إن الدعوات إلى القيام بثورة على الثوابت الدينية هي حلقة من سلسلة الصراعات بين الحق والباطل، والتي امتدت على مدى عصور من الزمان، فمثل هذه الدعوات ليست وليدة اللحظة، وإنما تأتي في الأوقات التي يضعف فيها أهل الإيمان، ويتسلط فيها بعض الطغاة لمحاولة الضرب والطعن في صميم تعاليم الديني الإسلامي.
واستنكر الحساوي الدعوات التي تخرج بين الفينة والأخرى على شاشات التلفاز، وتطالب بالطعن في كتب الصحاح – صحيح البخاري، وصحيح مسلم – مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات الاصطياد في الماء العكر، مشيرًا إلى أن مواجهة مثل هذه الدعوات والشبهات الواهية يجب أن يكون عبر شرح حقيقة الإسلام وتسامحه مع الآخر، مبينًا أن الصمت أمام مثل هذه الدعوات سيجعل من يقومون بها يبالغون في دعواتهم.
وأكد الحساوي أن الدعوات إلى تنحية البخاري ومسلم هي مناقضة للإسلام، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"، فالسُّنة مفسرة للقرآن، وإلا فكيف لنا أن نعرف عدد الركعات في الصلوات أو كيفية أداء الصلاة؟ مؤكدًا أن الهدف من مثل هذه الدعوات هو ضرب الإسلام في العمق تحت مسميات تجميله يختارها أصحاب تلك الدعوات.
ومن ناحيته، قال عضو رابطة علماء الشريعة وعضو نقابة الخطباء عبدالعزيز الفضلي: إن الطعن في الثوابت الإسلامية ليس وليد اللحظة، فمنذ أن خلق الله الخليقة والصراع موجود بين الحق والباطل، والله سبحانه وتعالى دائمًا ما ينتصر للحق قال تعالى: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الإسراء:81)، مشيرًا إلى أن بعض من يحاولون الهجوم على الثوابت الشرعية يسعون إلى هدم العقيدة الصحيحة لأهل السُّنة التي تخالف هواهم وتهدم عقيدتهم الباطلة القائمة على البدع؛ ولذلك هناك من يسعى للطعن في الأحاديث الصحيحة في محاولة لتبرئة أهل الباطل.
وأضاف الفضلي أن هناك من يسعى إلى تعزيز الظلم في محاولة للقفز على النصوص التي تحارب الظلم كأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الجهاد، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول الطعن في بعض الأحاديث الصحيحة الموجودة في صحيح البخاري ومسلم، ويقول: إنها تنافي العقل؛ في محاولة لإثبات أن الكتب الصحاح فيها أحاديث ضعيفة، ومن ثم يبدأ التشكيك في باقي الأحاديث، فالكتب الصحاح هي أصح كتب بعد القرآن الكريم، ومحاولة القفز عليها أو الطعن فيها لأهداف شخصية أو أي أهداف أخرى يجب الوقوف أمامها.
وأكد الفضلى بأن الرد ينبغي أن يكون من قبل المؤسسات الرسمية؛ لأنها الأولى بالدفاع عن شرع الله سبحانه وتعالى كوزارة الأوقاف؛ لأن الطعن ليس موجهًا إلى شخص بعينه، بل هو موجه لشرع الله سبحانه وتعالى، كما يجب على دار الإفتاء الوقوف في وجه تلك المحاولات، بالإضافة إلى روابط الشريعة والنقابات، كما يجب على الإعلام الإسلامي أن يقوم بدوره المنوط به من خلال التوعية الإسلامية الصحيحة بدلًا من الإعلام الذي يبث السم في أذهان أبنائنا.
وأوضح الفضلى أن هناك من يسعى إلى الطعن في المناهج الإسلامية في التربية؛ وذلك لتغيير تلك المناهج وفق هواه، مؤكدًا بأن هناك ثوابت في الشريعة الإسلامية لا يمكن الطعن فيها، ولا يمكن القبول بتغييرها، أما المسائل التي تُركت للاجتهاد ففيها متسع؛ مثل التعزير والرسائل الدعوية وغيرها.
الدعوة إلى الثورة الدينية.. والرد عليها
د. إبراهيم أبو محمد
مفتي عام أستراليا
يفترض في المسؤول الكبير أن تكون كلماته محسوبة، وحسابات الكلمة تختلف باختلاف مواقعها ومن قيلت فيهم ومن قيلت لهم؛ لأن الكلمة لها صخب وضجيج، وبعض الكلمات ملغمة، وتحدث مثل دوي المتفجرات ما لم تكن مضبوطة اللفظ ومحددة في المعنى، ومن ثم يجب أن تخضع ليس فقط للمراجعة اللغوية، وإنما لحساب المآلات حتى لا يلتبس معناها على الناس، وتستعمل في التأويل الفاسد؛ فتميل مع الهوى وتحيف مع الشنآن.
ولذلك تحرص الهيئات المحترمة أن يكون لدى المسؤول عنها خبراء استشاريون يخدمونه ويقدمون له العون والنصيحة، ويشرفون على ما يصدر منه للناس؛ حتى تظل مهابة الموقع في شخص المسؤول أمام الناس مصانة ومحترمة.
ونود أن نقدم للجنرال "السيسي" ما سكت عنه الآخرون ممن كانوا معه حينما خاض فيما لا علم له به، أو ورّطه فيه من كتب له الخطاب المشؤوم (الذي ألقاه في الاحتفال بالمولد النبوي).
أخطر ما جاء في ذلك الخطاب هو وصف الأمة كلها عن بكرة أبيها وبكل ملاينها التي تبلغ 1.6 مليار إنسان أنهم يعتنقون فكرًا مقدسًا يحرضهم على قتل الآخرين لكي يعشوا وحدهم!
ثقافتي الإسلامية المتواضعة التي كونتها دراستي الأزهرية منذ نعومة أظفاري وحتى نهاية الدكتوراه تمنحني يقينًا بأن المقدس لدينا وعلى مدار 14 قرنًا من الزمان هو القرآن الكريم والسُّنة النبوية الصحيحة وحدهما، وما عداهما فكر بشري يُحترم ولكن لا قداسة له، فيؤخذ من صاحبه ويرد عليه مهما كان موقعه العلمي، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وليس هناك منازع واحد في هذا الأمر، فأين الفكر المقدس الذي يحرض مجموع الأمة ذات 1.6 مليار على قتل بقية المليارات السبعة ليعيشوا وحدهم كما تحدث عنه الخطاب؟!
الكارهون لدين الله، والذين يريدون التخلص من الإسلام ولو بالتقسيط المريح؛ هم فقط الذين ينظرون إلى الوحي المعصوم قرآنًا وسُنة على أنه ظاهرة تاريخية تجاوزها الزمان والمكان، ومن ثم فالناس في عصرهم الحاضر أو المستقبل غير ملزمين بالنظر إليه أو بالنظر فيه، فهل كاتب هذا الكلام أو قائله واحد منهم؟!
صفة "المقدس" التي جاءت في الخطاب ليست دقيقة، وإنما أراد بها كاتب الخطاب "الإرهاب"، وعلى ذلك فالوصف خطير ومستفز؛ لأنه يشمل بهذا الوصف كل المسلمين في كل بقاع الأرض وليس هذا الادعاء صحيحًا.
على أقصى درجات حسن الظن، نفترض أنه أراد التطرف والإرهاب الذي تمارسه بعض الجماعات وليس مجموع الأمة، ومن ثم فليس من الدقة وصف المليار وستمائة مليون مسلم بهذا الوصف المشين، والذي لم يجرؤ عليه أعتى الكارهين للإسلام والمسلمين في العالم.
ثم أليس من الأجدى والأنفع أن نناقش ظاهرة العنف مناقشة علمية بعيدة عن الميل المندفع نحو الإخضاع والسيطرة؟ وأن نتعرف على أسبابها ودوافعها وبواعثها والبيئة التي تستوطنها وتنمو فيها؟ وما الأسباب التي جعلت من الوطن العربي والإسلامي مستوطنة للتطرف الديني وبيئة حاضنة له؟ وهل من تلك الأسباب استمرار الدكتاتوريات وسياسة القمع واغتصاب السلطة بالقوة عن طريق الانقلاب وإلغاء إرادة الناس في الاختيار الحر؟
ذلك هو الواجب حتى نتمكن من فهم جذور الظاهرة بدلًا من الهروب بكلمات ملتبسة، وتحميل الآخرين وزر الاضطرابات والقلق والكراهية السائدة، وتسويق الذات للغرب بوصفها معتدلة يمكن الاعتماد عليها في قمع كل ما هو إسلامي، أحسب أن من كتب له الخطاب أراد أحد أمرين كلاهما خطير.
الأول: أنه أراد أن يقدم الجنرال "السيسي" للغرب على أنه "أتاتورك العرب" الجديد، الذي على يديه يمكن أن تسقط كل فكرة إسلامية مهما كان مصدرها في الاعتدال والوسطية؛ ومن ثم فعلى أثر الرسالة يخف الضغط وتتوقف التلميحات بوقف الضخ المالي الذي بدأ مع انخفاض أسعار النفط، ثم تكون المساعدات والدعم بغير حدود أو قيود، مباشرة من السادة الكبار، أو عن طريق الوكلاء المعتمدين في الصرف الآلي والإنفاق الذي يريده السادة الكبار في عواصم العرب الأجاويد.
الثاني: أن كاتب الخطاب ربما يكون متواطئًا مع أصحاب التسريبات الغريبة؛ ومن ثم فقد أراد أن يضع الرجل في مواجهة مع العالم الإسلامي كله، وأن يكشف للدنيا كلها أن وصف الإرهاب لا يتوقف عند الجماعة التي تعارض الرجل وتنازعه مكانه وموقعه، وإنما ثقافته عدائية للأمة كلها لا فرق فيها بين مسالم ومعتدٍ، ولا فرق فيها بين وسطي ومتطرف، وحتى المؤسسات الدينية التي أمَّمها ووقفت معه في الانقلاب لم تعد في مأمن من الوصف بالتعصب والجمود والتخلف، ولعل حالة السعار الإعلامي والثقافي التي تعرض لها الأزهر شيخًا ورجالًا من كتَّاب الصحف والفضائيات وغضب منها شيخ الأزهر كانت هي المقدمة لبدء عملية الاستفزاز وصناعة الأزمة.
الخطاب المثير للجدل لم يحظَ باعتراض ممن حضروه من شيوخ الانقلاب، ولم يتوقع أحد من العقلاء أن يكون لديهم اعتراض رغم عموم الوصف حتى عليهم.
الرجل من دهائه أدخلهم شركاء له في توجيه الاتهام لكل الأمة حين أقسم أنه سيحاججهم أمام الله تعالى يوم القيامة ما لم يشتركوا معه في رؤيته.
المشكلة أن الاتهام طال كل مسلم حتى في مجتمع المهجر، وكونه يصدر من مسؤول له مثل هذه الصفة يزيد الأمر تعقيدًا؛ لأنه يجعل مسلمي المهجر وأغلبهم نماذج ناجحة محل ريبة، ويحول أنظار الآخرين إليهم من نماذج مشرفة ومعطاءة إلى النظر إليهم وكأنهم ذئاب بشرية تنقض على فرائسها متى سنحت الفرصة.
الوصف الذي ورد في الخطاب بعمومه لم يجرؤ أحد لا من خصوم الإسلام ولا حتى من أعدائه على إطلاقه بهذا الشمول وعلى كل الأمة؛ الأمر الذي يجعل الآخرين يستقبلونك قائلين: وجودك غير مرحب به، أيها المسلم عُدْ من حيث جئت فقد أصبحت إرهابيًا!
بركات الثورة الدينية التي طالب بها الجنرال بدأت بشائرها، فقد توجه مذيع مسيحي باللوم لكل المسلمين على سكوتهم طوال 1400 عام، ثم طالب بتنقيح القرآن الكريم كخطوة ثانية، وختم باقتباس من كلام الجنرال موجهًا حديثه لشيخ الأزهر: "طول ما أنت فيه مش حتقدر تشوفه.. لازم تخرج منه علشان تشوفه"، فإذا كان المرء لا يستطيع رؤية تلك المقدسات الضالة وهو داخلها ولابد من الخروج من هذه النصوص حتى يراها المرء؛ فكيف رآها صاحبنا الذي يطالب بثورة دينية؟ هل خرج منها "السيسي" حتى يراها؟
ثم كيف سيرى شيخ الأزهر هذه النصوص المقدسة وهو بداخلها؟ هل لابد من الخروج منها حتى يراها؟ هكذا قال المذيع متوجهًا لشيخ الأزهر ومتطاولًا كما جاء في فيديو تداوله نشطاء على موقع "يوتيوب" ونشرته جريدة "المصريون" يوم الأربعاء 7 يناير 2015م، فما رأي الإمام الأكبر ودار الإفتاء يا ترى؟
مع شديد الأسف، المؤسسة الدينية تنازلت عن موقعها التي يجب أن تكون فيه، ورضيت بموقعها التي اختارته حين تحولت إلى بوق للسلطان الجائر والحاكم المستبد، وبدلًا من الوقوف بجانب الشعوب المقهورة والانتصار لمبادئ الحرية والعدل وكرامة الإنسان، أعاد لنا شيوخ العسكر الصورة الكئيبة لـ"راسبوتين"، رجل الدين المبرِّر والمحلل والمشارك للطاغية في كل مظلمة والشريك له في كل إثم وجريمة.
خسارة المجتمع كبيرة ومضنية ومكلفة حين يكون الديني تابعًا والسياسي متبوعًا، وفي عصرنا الحديث رجل السياسة (الحاكم)، ينظر إلى مولانا الديني، نظرة استخفاف، ولا يرى السياسي في الديني إلا تكملة للديكور الذي تحتاجه الدولة من حيث الشكل فقط.
صورة الفسيفساء الدينية قلما يتذكرها الحاكم أو يلتفت إليها أو حتى تخطر له على بال إلا عندما يفقد النظام عزيزًا يريد أن يواريه التراب، أو أن يُطل على شعبه بطلعته البهية في مناسبة من المناسبات الدينية.
حالة أخرى كذلك يكون للفسيفساء الدينية دور كبير فيها وتحتاجها الدولة لتقول كلمتها، وهي عندما يكفهر الجو السياسي وتتلبد سماء الوطن بغيوم الغضب الشعبي، حينئذ يكون لتلك الفسيفساء أو الرمز الديني كلمته في تهدئة الخواطر وتسكين الغضب العام، هنا أيضًا تستخرج النصوص - بعملية انتقاء خبيث ومدلس - لتوظف الدين في تدعيم الدكتاتور الطاغية، وتخفيف الضغط عليه بحديث عن حرمة الخروج على الحاكم، وإن جلد الظهور وأكل الأموال وأفسد البلاد وأهان العباد.. وهكذا الطاغية السياسي يستعمل الرمز الديني في خدمة طغيانه وتكريس نظامه وتدعيم دولة الظلم، فعلى الرموز الدينية أن تنأى بنفسها عن السقوط أو السكوت، وألا يجعلوا من أنفسهم مطية لحاكم ظالم، وأن يدركوا أن ما يحملونه من علم هو أعلى وأغلى من كل ما تمتلئ به خزائن الحاكم الطاغية من مال مسروق ومغصوب ومهرب في خزائن البنوك الأجنبية.
وعلى العلماء أن يتذكروا أن أمر الصلاح والإصلاح لا يستقيم بعوجهم ولا يقام بتفريطهم، وكما قال الإمام علي رضي الله عنه: "لاَ يُقِيمُ أمْرَ اَللَّهِ سُبْحَانَهُ إلاَّ مَنْ لاَ يُصَانِعُ وَلاَ يُضَارِعُ وَلاَ يَتَّبِعُ اَلْمَطَامِعَ".