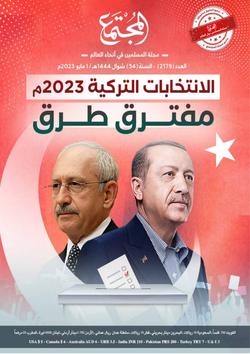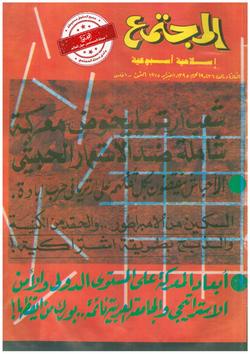العنوان الشورى أم الاستبداد؟
الكاتب د. عبد الله أبو عزة
تاريخ النشر الثلاثاء 29-ديسمبر-1970
مشاهدات 101
نشر في العدد 41
نشر في الصفحة 12
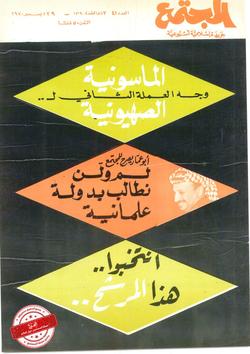
الثلاثاء 29-ديسمبر-1970
﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: 159) صدق الله العظيم
- عانى المسلمون منذ أواخر القرن الهجري من عسف الحكام الذين أقاموا المذابح للمسلمين وبددوا أموال الأمة وملأوا الأرض فسادًا، فلو كانت الشورى الملزمة هي القاعدة لما انفتح الطريق أمام هذا العبث الرامي، ولكن الحكام استبدوا، والفقهاء سكتوا، فانهارت الدولة وانهار المجتمع.
في مقالنا السابق تناولنا الادعاء القائل بأن الشورى غير ملزمة للأمير بنتيجتها ودحضنا أدلته الموهومة وأثبتنا أنه لا يوجد دليل واحد على عدم إلزامية الشورى، في هذا المقال سنشرح للإخوة القراء بإيجاز الأساس الذي بنينا عليه قناعتنا بإلزامية نتيجة الشورى في الإسلام.
لم توضح الآيتان اللتان تعرضتا للشورى قضية التزام الأمير بنتيجة الشورى، ولم تصل إلى علمنا أخبار عن حدوث اختلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ونزوله على رأي الأغلبية المخالف لرأيه سوى ما حدث يوم أحد، كما أنه لم يصلنا شيء من هذا القبيل من عهد أي من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم.
ولقد قلنا في المقالة السابقة إنه ليست لدينا نصوص قطعية واضحة تجعلنا نُجزم بإلزامية نتيجة الشورى بيد أننا نستطيع أن نزعم أن لدينا أدلة تجعلنا نرجح أن الشورى ملزمة، وتجعلنا نؤكد أن إلزاميتها أقرب إلى روح الإسلام وأخلق بتمثيل مبادئه العامة.
حادثة أحد ودلالتها:
في السنة الثالثة للهجرة وصل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش من أهل مكة قد قدموا لغزو مدينته لينتقموا من المسلمين على ما أنزلوه بهم في وقعة بدر في السنة السابقة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبرها بأنها نازلة تصيب أصحابه، لذلك كان عازفًا عن الخروج (1).
ولكنه -مع ذلك -شاور أصحابه، وختم مشورته بتوضيح رأيه الخاص قبل أن يسمع آراءهم فقال: «فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها (۲)».
وكانت الأغلبية الساحقة من الصحابة -رضوان الله عليهم- تتوق إلى لقاء العدو، فقالوا: «يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا، فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، فلبس لأمته، ثم خرج عليهم، وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله: استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد، فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل (۳)».
هكذا أورد ابن هشام خبر حادثة أحد، وقد تحدث عنها الطبري (٤) في تاريخه بما يتفق مع رواية ابن هشام، وكذلك فعل ابن الأثير (٥)، وابن كثير (٦).
ومن الواضح هنا في هذه الحادثة:
١- أن مشكلة عامة عرضت للمسلمين.
٢- أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض المشكلة على الصحابة رضوان الله عليهم.
٣- أنه عرض عليهم الموقف الذي يرى أن يتخذه المسلمون وذلك قبل أن يسمع رأيهم.
٤- أن أغلبيتهم عرضت رأيًا مخالفًا لرأيه وتمسكت به وتشددت.
٥- أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند رأيهم فدخل ولبس عدة الحرب.
٦- أنهم ندموا لاستكراههم النبي لا لأنهم اكتشفوا أن رأيه أصوب من رأيهم.
٧- أعلنوا ندمهم للرسول وقالوا له: ليس لنا أن نستكرهك.
٨- لم ينف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اتبع رأيًا يكرهه، ولكنه أجابهم: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» أي أنه لا ينبغي للنبي أن يكون مترددًا، يعقد العزم على الأمر ويشرع فيه ثم يتراجع وهو في بداية الطريق.
وبعد أن جرت معركة أحد، وكان ما كان من هزيمة المسلمين واستشهاد عدد كبير من الصحابة، بعد هذه الحادثة التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية جاء القرآن الكريم لا ليقول له: لا تعد إلى الشورى بل على العكس من ذلك جاء يحضه على الشورى: ﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: 159)
وقد تناولنا مسألة «العزم» في مقالنا السابق وبينا أن لا علاقة لها بإلزامية الشورى من عدمها.
التزام الرسول بالشورى
ومع وضوح دلالة حادثة أحد فإنها لم تسلم كذلك من محاولات أنصار الحكم الفردي لتصويرها على النحو الذي يدعم مذهبهم؛ فالدكتور عبد الكريم زيدان -مثلًا- يرد على من يرون إلزامية الشورى وعلى استنادهم إلى «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأكثرية في مسألة الخروج إلى معركة أحد مع أنه كان يميل إلى عدم الخروج (۷)».
قال الدكتور: «والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيهم لأنه رأى ذلك، لا لأن الأخذ برأي الأكثرية ملزم، وكلامنا في إلزام رأي الأكثرية لرئيس الدولة أو عدم إلزامه (۸)».
أرأيت يا أخي القارئ، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى معركة أحد مع أنه كان يرى عدم الخروج، بل يرى البقاء في المدينة.
والرسول خرج إلى أحد ونزل على رأي الأكثرية لا لأنه ملزم، بل لأنه رأى ذلك.
أليس هذا تناقضًا يريد الكاتب، من حيث لا يقصد -أن يفرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم حين يسلم بأنه لم ير الخروج وأنه رأى الخروج في حادثة واحدة؟؟
وقد يفسر بعضهم قول الدكتور زيدان بأن الرسول رأى النزول على رأيهم، مع قناعته بأن رأيهم خطأ، وبأن البقاء في المدينة أصوب، وبأن النزول على رأيهم غير ملزم له.
هل هذا معقول؟ نترك ذلك لتقدير الأخ القارئ!
ويمضي أخونا الدكتور عبد الكريم مؤكدًا أن حادثة أحد لا تعني إلزامية الشورى -حسب رأيه، فيتناول اعتراضًا آخر لمن يذهبون إلى «أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي الأكثرية (٩)».
يقول الدكتور: «الاعتراض الثاني -ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم رئيس الدولة برأي من يشاورهم أو برأي أكثريتهم؟ والجواب: فائدة المشاورة تظهر في ظهور الرأي الصواب، والمظنون في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب، فإذا لم يأخذ برأيهم فمعنى ذلك أنه لم يقتنع بما قيل لا لكونه يريد العناد والخلاف (۱۰)».
في رد الدكتور ثلاث نقاط:
١- فائدة الشورى تظهر في ظهور الرأي الصواب.
٢- المظنون في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب.
٣- أن رفضه رأيهم يعني عدم الاقتناع ولا يعني مجرد الرغبة في العناد والمخالفة.
ونحن نريد أن نسأل الدكتور زيدان ومن هم على رأيه:
كيف يظهر الصواب وما هو المعيار لتحديد الصواب والخطأ عندما يختلف أهل الشورى ورئيس الدولة حول قضية لا نص فيها ولا دليل واضح من كتاب أو سنة؟ وإذا لم يكن رأي أغلبية أهل الشورى، المفروض أنهم كبار أهل الرأي في المجتمع الإسلامي، إذا لم یكن رأيهم هو الدليل الترجيحي على الصواب فما هو الدليل؟؟ وكيف نقنع أنفسنا بأن رئيس الدولة غير الملتزم أخذ بالرأي الأصوب والدكتور عبد الكريم زيدان يزعم أن لرئيس الدولة الحق في أنه «إن شاء أخذ برأي الأكثرية، وإن شاء أخذ برأي الأقلية وإن شاء أخذ برأيه هو وإن كان خلاف رأي الأكثرية والأقلية (۱۱) »
نعم، ما هو معيار الصواب والخطأ؟؟
أما «المظنون في رئيس الدولة» فإن أمور الدول والأمم والشعوب لا يمكن أن تُبنى على الظنون يا أخانا العزيز، بل لا بد لها من ضوابط واضحة تحميها، سيما إذا كان تاريخنا طوال مئات السنين، وحتى يومنا هذا ينضح بظلم الحكام ورؤساء الدول الذين أذاقوا الشعوب الإسلامية أشد الويلات في غياب إلزامية الشورى، رغم «الظنون» «المظنونة» في حرصهم على اتباع الصواب (۱۲).
ثم إذا كنا نحسن الظن برئيس الدولة، ونقول إن المظنون فيه أن يتبع الصواب فما الذي يجعلنا نسيء الظن بأغلبية أهل الشورى، وهم خلاصة أهل الرأي والفكر في المجتمع الإسلامي؟ أليس المظنون في كل من يرفع إلى منزلة أهل الشورى في الدولة الإسلامية أن يختار الصواب حين يتبين له؟ إن هذا سؤال عن بديهية لا تحتمل أن تكون موضع سؤال، ولكنها طريقة الدكتور زيدان هي التي ألجأتنا إلى هذا.
نعم، إن المظنون برئيس الدولة أن يختار الأصوب حين يتضح صوابه، وفي هذه الحالة فإن المظنون في كل فرد من مجلس الشورى الإسلامي أن يختار الأصوب، أي حين يكون الصواب بينًا.
معيار الصواب
ولكن ما هو معيار الصواب حينما يعوزنا الدليل وينعدم الوضوح؟؟
وإذا كان رئيس الدولة عدلًا ثقة عالمًا أفليست هذه الصفات ضرورية وملازمة لأهل الشورى؟
ثم من ذا الذي زعم أن رئيس الدولة يمكن أن يرى الصواب ثم يحيد عنه لمجرد الرغبة في العناد؟ إن أحدًا لم يثر مثل هذا الاعتراض، لا من القدامى ولا من المحدثين، هي قضية أثارها الدكتور زيدان فقط من غير أي داع وخطؤها بديهي، لكن إثارتها على هذا النحو توحي بأن أصحاب فكرة إلزامية الشورى يحتجون بها، وهذا مستحيل.
ونحن مضطرون إلى مجاراة الدكتور زيدان بالتساؤل عن هذه البديهية بالنسبة لأهل الحل والعقد، هل يجوز أن نفترض أن أغلبية أهل الحل والعقد سيرون الصواب ثم يحيدون عنه لمجرد الرغبة في المخالفة والعناد؟ وإذا كان الجواب بالنفي -بطبيعة الحال -فمعنى ذلك أن رئيس الدولة وأعضاء مجلس الشورى جميعًا سيختارون الصواب حين يتبين لهم، ولن يحيد عنه أحد منهم لمجرد المخالفة والعناد، فما هو المعيار المرجح حين ينعدم الدليل وتغمض القضية وتتباين الاجتهادات؟؟
ويعترض الدكتور محمود بابللي على فكرة إلزامية الشورى بأن الأمير «لو كان ملزمًا لوجب على الرسول أن يأخذ بالأكثرية قبل غيره، ولكان تحقق وضع نظام لها ولما تخلى عن دراسته الفقهاء (۱۳)».
ونحن نذكر أخانا الدكتور بابللي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على رأي الأكثرية في أحد، أما في الحديبية فكان في القضية أمر من الله -كما بينا في مقالنا السابق ما كان للنبي أن يحيد عنه، وهاتان القضيتان اللتان حدث فيهما خلاف.
أما عدم وضع نظام للشورى وتحديده «لمقدار النصاب ولكيفية إجراء التصويت ولحساب النتيجة (١٤)» هذا «العدم» هو أحد عوامل خلود المبادئ الإسلامية، لقد جاء الإسلام بالمبادئ العامة وترك التفاصيل لكل جيل يصوغها في أنظمة حسب احتياجاته، ولو أن القرآن الكريم أو السنة جاءا بنظام مفصل يصلح لبيئة المدينة أو الحجاز في صدر الإسلام لما صلح هذا النظام لعصرنا الحاضر، بل لما صلح لدولة هارون الرشيد أو دولة معاوية.
لكن ليس معنى عدم الإتيان بنظام مفصل إقرارًا للفوضى أو تركًا لمصالح الأمة الإسلامية تحت رحمة فرد، وتقديرات فرد، والتقلبات والمؤثرات التي قد تؤثر في تفكيره ومزاجه.
ولقد قصر الفقهاء عندما تجنبوا دراسة موضوع الشورى ومحاولة وضع نظام لها يناسب عصرهم، كما قصروا في أشياء كثيرة، لقد كانت الغالبية العظمى منهم تتجنب كل ما يمكن أن يثير عليها غضب الحكام، لذلك كانت جل بحوثهم في الطهارة والوضوء والصلاة وغيرها من الشعائر التعبدية، بينما لم يكد التنظيم السياسي للمجتمع يظفر بشيء من الاهتمام.
والفقهاء -في رأينا -يشاركون الخلفاء والحكام في المسئولية عما أصاب المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية من مفاسد وانحلال وتدهور وصراع وتمزق طوال ما يزيد على ألف سنة انتهت بانهيار الدولة الإسلامية حتى جاء الغرب فوجدها جثة هامدة لا حراك فيها، فأخذ ينهشها بأنيابه ويمزقها بمخالبه.
ويسوق الدكتور عبد الكريم زيدان اعتراضًا آخر على فكرة إلزامية الشورى فيقول:
«إن الخليفة -رئيس الدولة -مسئول مسئولية كاملة عن أعماله، فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره إن لم يقتنع بصوابه، لأن كون الإنسان مسئولًا عن عمله يعني أنه يعمله باختياره ورأيه لا أن يعمل وينفذ رأي غيره على وجه الإلزام وهو كاره له غير مقتنع به ثم يسأل هو عن هذا الرأي ونتائجه (١٥)».
إن الأستاذ زيدان هنا يرسم صورة خاطئة، يبتدعها ابتداعًا، لكي يناقشها ويظهر خطأها، وهو يوحي بأنها لصيقة بفكرة إلزامية الشورى وبذلك يصل إلى سوق دليل على تسفيه فكرة الإلزامية.
إن الدكتور هنا يجهد نفسه ويستجمع قدرته لكي يناقش البديهيات ويثبت صحتها، والبديهيات واضحة بذاتها، ليست بحاجة إلى نقاش أو حجج تسندها، وليست بحاجة إلى سند.
من ذا الذي قال إن الخليفة الذي التزم برأي أكثرية أهل الشورى المخالف لرأيه سيكون مسئولًا عن نتائجه؟؟
إن أحدًا لم يقل ذلك.
إن الله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين بـ ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾ (الشورى: 38)، أنهم يبحثون أمورهم بصوره جماعية، وهذا يعني ضمنها أنهم يقررون مواقفهم أيضًا بصورة جماعية (١٦)، ويتحملون نتائجها بصورة جماعية كذلك، إن الله لن يسأل الخليفة يوم القيامة عن نتيجة لم يختر هو (أي الخليفة) مقدماتها، فالله يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ (الزمر: 7).
كذلك فإن الأمة وأعضاء مجلس الشورى لن يلوموا الخليفة عندما يتبين أن الضرر جاء من رأي أغلبيتهم الذي كان الخليفة يعارضه.
فعندما تضع دولة إسلامية لنفسها نظامًا شوريًا فلن تنص على أن يكون الخليفة مسئولًا وحده، بل سيشاركه کل المتعاونين معه في المسئولية.
وستكون مسئوليته بقدر ما له من حرية اختيار.
أما أعدل العادلين فلن يعاقب الخليفة على خطأ لم يرتكبه، وبذلك يثبت بطلان الاحتجاج بأن الخليفة مسئول وحده.
تلك كانت قضية الشورى في غزوة أحد.
أساس فكرة الإلزام
ومهما يكن من أمر فنحن لا نستند في رأينا إلى هذا الدليل الواحد والحادثة الواحدة على إلزامية الشورى، إن هناك أدلة متعددة تسند فكرة الإلزامية سنحاول أن نأتي على ذكرها بشيء من الاختصار حيث لا يتسع مجال مقال في مجلة كهذه للإطالة:
أولها: إن رئيس الدولة الإسلامية يجري اختياره عادة من بين زعماء الأمة وقادة الرأي فيها، وهو ـ عندما يتم اختياره- لا يكون فريدًا، أو عملاقًا بين أقزام، بل يكون واحدًا من بين نخبة يتقارب أفرادها تقاربًا شديدًا في مستواهم حتى يكاد يصعب التمييز بينهم، فإذا ما رفع من بينهم ونصب في مركز الخلافة أو الإمارة فإن مقدرته العقلية لن تزيد، وسيظل من حوله يقاربونه، وستظل حصيلة آرائهم أكبر من حصيلة رأيه هو منفردًا، على الأرجح.
ثانيًا: مبدأ المساواة بين الناس، ذلك المبدأ الذي أكده الإسلام، يجعل الخليفة واحدًا من قادة المسلمين، لا يختلف في ميزان الحق عنهم، ما دامت صفات العلم والإخلاص والتقوى متساوية، وما دام الناس ـ في مثل هذه الحالات -لا يستطيعون الجزم بأن هذا أفضل عند الله من ذاك.
ثالثًا: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من «أن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد (۱۷)» وأن «يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار»
«وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية».
ونحن لا نزعم أن هذه الأحاديث قد قيلت بشأن الشورى، ولكننا نريد أن نبرز المبدأ العام الذي تقرره، وهو أن الجماعة أقرب إلى الحق والصواب من الفرد، وذلك عندما يكون الحديث عن الجماعة المسلمة -كأهل الحل والعقد أو مجلس الشورى- لا عن «أكثر من في الأرض» من الكفار والوثنيين والفاسقين الذين عنتهم الآية التي استشهد بها السادة زيدان وبابللي وطبارة.
رابعًا: مبدأ الإجماع، فقد اعتبر علماء الأصول الإجماع أصلًا من أصول التشريع (۱۸) وعدّوه الأصل الرابع أو الثالث بعد القرآن والسنة، وأضافوا إليه القياس. ويذكر الإمام ابن تيمية أن عمر وأبا بكر وابن عباس رضي الله عنهم قدموا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع (۱۹)، ولقد قالت طائفة الفقهاء الذين سبقوا عصر ابن تيمية بأن «يبدأ المجتهد بأن ينظر أولًا في الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصًا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقال بعضهم الإجماع نسخه (۲۰)» وقد فهم بعض الفقهاء من كلام الإمام الشافعي «وتعبيراته أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة (۲۱)» لكن هناك من يخالف هؤلاء الفقهاء كالأستاذ محمد أبو زهرة الذي يشك في أن الشافعي قدّم الإجماع على الكتاب والسنة، أو ينفي ذلك، ومع هذا فإن الشيخ أبا زهرة يؤكد «أن الشافعي أخذ بالإجماع على أنه حجة (۲۲)» وقد «قال بعض الأصوليين: إن إنكار حكم الإجماع القطعي کفر (۲۳)» ومن الخلفاء من رأى أنه إذا انعقد الإجماع على مسألة وانقرض من جيل المجمعين فإنه لا يجوز - في رأي هؤلاء - أن ينقض إجماع جيل تال إجماع الجيل السابق بل يرون «الحجر على الخلف أن ينظروا في المسألة إذا تبين لهم الدليل الذي يوجب غير ما قضى به الإجماع الأول، وقد اختار ابن الهمام أن يجيب على ذلك بأنه يجب إلغاء الدليل، وهو الخبر الذي يخالف حكمه ما أجمعوا عليه، تقديمًا للقاطع وهو الإجماع، على ما ليس بقاطع، وهو الخبر الصحيح، وتسليم أن المجتهد محجور عليه النظر في الحكم بعد الإجماع (٢٤)».
وإذا دققنا النظر في حقيقة الإجماع الذي أعطاه الفقهاء هذه القوة، فاتفقوا على اعتباره أصلًا تشريعيًا يتلو القرآن والسنة في الأهمية، وعدّه بعضهم ناسخًا للنصوص وجعلوه ملازمًا للأجيال التي تتلو الجيل الذي حدث فيه الإجماع، إذا نظرنا إلى حقيقة هذا الإجماع وجدناه يمثل أعلى درجات الشورى كمالًا، ووجدناه قريبًا جدًّا من قرار الأغلبية، ونحن لا نلقي الكلام على عواهنه ولا ندّعي بغير دليل، فرغم أن الأصوليين المتأخرين قد عرفوا الإجماع بأنه «اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة محددة (٢٥)» إلا أن هناك ما يجعل هذا التعريف محل نقاش وأخذ ورد، فالإمام ابن تيمية يحدثنا:
«قال أحمد وغيره من العلماء: من ادّعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى المريسي والأصم. ولكن يقول: لا أعلم نزاعًا، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعًا، ويقولون: هذا هو الإجماع الذي ندّعيه (٢٦)» وقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة «أن الشافعي رضي الله عنه كان إذا ناظر أحدًا وادّعى الإجماع فيه أنكر وجود الإجماع حتى ادّعى عليه أنه ينكره (۲۷)» والحقيقة أن الشافعي أخذ بالإجماع على أنه حجة وهو -أي الشافعي - «يقرر وجود الإجماع في أصول الفرائض» كالإجماع على عدد الصلوات وعدد الركعات، والصوم والحج والزكاة وغيرها (۲۸).
صحيح «أن ندرة المخالف تؤثر في تحقق الإجماع، لأن مفهوم الاتفاق لم يتحقق، إلا أن كثيرًا من الأصوليين يحتجون برأي الأكثرين إذا ندر مخالفهم (۲۹)».
ونحن لا نريد من الحديث عن الإجماع أن ندّعي بأن الأغلبية تساوي الإجماع، بل نريد أن نقول إن الإجماع الكامل متعذر التحقق أو مستحيل في غير أصول الفرائض، وذلك حسب رأي أكبر فقهاء هذه الأمة، والإجماع كما تصوروه هو عدم العلم بوجود مخالفين، وقد احتج الكثيرون من الأصوليون برأي الأغلبية.
ونحن لا نريد لرأي الأغلبية أن يصبح مصدرًا تشريعيًّا بحيث يحكم قرارها الأجيال اللاحقة ولكن إذا كانت للإجماع هذه الدرجة من الفاعلية والقوة، وإذا كان رأي الأكثرين حجة عند كثيرين من الأصوليين؛ أفليس من المعقول والمنطق القريب إلى روح الإسلام وإلى اجتهادات الفقهاء أن نقرر: أن رأي الأغلبية أرجح من رأي الفرد، ومن رأي الأقلية، وأن احتمال كون الصواب في جانب الأكثرية أكبر من كونه في جانب الأقلية، وأن الزعم بأن الصواب مرجح من خلال رأي الخليفة الفرد زعم باطل؟؟
وهل يعقل أن ينتقل الإسلام من هذا التقديس لرأي الجماعة إلى ما يناقضه من تقديس رأي الفرد لمجرد أن بعض أفراد الجماعة من أهل الشورى خالفوا رأي الأغلبية الساحقة، أو الأغلبية؟؟
خامسًا: عندما اعترض الصحابة رضوان الله عليهم على موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية رد عليهم صلوات الله عليه بأنه يتبع أمرًا جاء من عند الله، ولم يقل لهم: قد سمعت مشورتكم ومن حقي أن أنفذ ما أراه، وعندما حصل الخلاف في الرأي فيما يتعلق بالخروج إلى أحد، لم يقل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد استشرتكم وسمعت حججكم ولم اقتنع بها ومن حقي أن أتبع الخطة التي أراها، بل نجده يترك ما يراه کارهًا ويتبع رأيهم، ولو كان مقصود الشارع أن يستشير الأمير للاستنارة فقط ثم ينفذ خلاف رأي الأغلبية لما تصرف الرسول على النحو الذي تصرف به، ولا فهم المسلمين -بسلوكه العملي- أن ولي الأمر يستشير وبعد ذلك ينفذ ما يراه هو صوابًا.
وعندما اختلف أبو بكر والصحابة حول إنفاذ جيش أسامة لم يحتج الصديق بأن من حقه أن ينفذ السياسة التي يراها بعد سماع المشورة لكنه ناقشهم وأفهمهم أن في القضية أمرًا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقدم على نقضه؛ لأنه لا اجتهاد -في رأيه- مع وجود دليل من الكتاب أو السنة.
وقد دعاهم للتشاور فتشاوروا واقتنعوا بحجته، وكذلك فعل حين حارب مانعي الزكاة، احتج بأن الزكاة حق المال الذي وردت الإشارة إليه في الحديث، هذا فضلًا عن أن القرآن الكريم يقرن الزكاة بالصلاة، ويأمر المسلمين بتأديتهما في كلمتين متتاليتين في كثير من الآيات؛ فكيف يفرق بين الصلاة والزكاة ويعطل أمر الله؟ لقد ذكرهم أن الحديث يشترط «إلا بحقها».
وعندما اختلف عمر مع بعض كبار فاتحي العراق حول قسمة الأراضي بين الغانمين -حسب إحدى الروايات- وضيقوا عليه أشد التضييق لم يحتج عليهم بأنه رئيس الدولة، وأنه سمع رأيهم، وأن له أن ينفذ السياسة التي يريدها، ولو كان يعتقد أن ذلك حقه لما تأخر عن استعماله ومواجهتهم به، لقد حاول إقناعهم فلم يقتنعوا، واستشار كبار المهاجرين فاختلفوا، فجمع رهطًا من كبار الصحابة من الأنصار وعرض عليهم القضية فأيدوا رأيه بالإجماع (30)، فنزل الجميع عند رأيه بعدئذ حتى إن الشيخ محمد أبو زهرة عندما أراد أن يعدد القضايا التي حدث فيها الإجماع تاريخيًّا ذكر منها: «إجماع الصحابة على أن الأراضي المستولى عليها تبقى في أيدي زراعها على أن تكون في حكم ملك الدولة، وإجماعهم على قتال المرتدين ونحو ذلك (31)» رغم زعم الزاعمين بأن عمر وأبا بكر قد انفردا برأيهما في هاتين المناسبتين.
سادسًا: دلالة الواقع التاريخي، فقد عانى المسلمون منذ أواخر القرن الهجري من عسف الحكام الذين أقاموا المذابح للمسلمين وبددوا أموال الأمة، وملأوا الأرض فسادًا في أكثر الفترات، ومن شاء فليقرأ في المصادر التاريخية الإسلامية أخبار التطاحن بين الخلفاء والأمراء والسلاطين والملوك من بغداد إلى مصر إلى شمال إفريقيا إلى الأندلس إلى الشام وفارس وخراسان، ولا يتسع المجال هنا للحديث عن هذه المفاسد؛ فلو كانت الشورى الملزمة هي القاعدة لما انفتح الطريق أمام هذا العبث الدامي ولكن الحكام استبدوا، والفقهاء سكتوا، فانهارت الدولة وانهار المجتمع.
لقد عالجنا موضوع الشورى باختصار وتعرضنا لأهم الآراء والاحتجاجات فيه، وأثبتنا عدم وجود أي دليل بأن الشورى غير ملزمة، وقدمنا الأدلة التي اعتبرناها مؤيدة لمبدأ الإلزام، ولقد تركنا مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم التي استشهد بها الآخرون وضربنا عنها صفحًا لعدم ارتباطها بالموضوع الذي نعالجه، ومن هذه المواقف: استشارة النبي لصحابته في أمر لقاء النفير يوم بدر، ومشورة الحباب بن المنذر يومها بالسيطرة على نبع الماء، ومشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق يوم الأحزاب، واستشارته صلى الله عليه وسلم للسعدين في موضوع الاتفاقية التي أزمع على إبرامها مع زعيمي غطفان يوم الخندق واستشارته لعلي وأسامة في أمر حديث الإفك، وموعدنا مع الإخوة القراء في عدد قادم لنبين سبب اعتبار هذه المواقف بعيدة عن الصلة بموضوع الشورى.
عبد الله أبو عزة
مصادر المقال:
(1) ابن هشام، السيرة، مجلد 2، ص 63.
(2) المصدر والصفحة ذاتهما.
(3) المصدر والصفحة ذاتهما.
(4) تاريخ الطبري، مجلد 2، ص 502 -503.
(5) ابن الأثير، الكامل (القاهرة: د.ت)، مجلد 2، ص 61 -62
(6) ابن كثير، البداية والنهاية، مجلد 4، ص 11 -12.
(7) زيدان، أصول الدعوة، ص 175.
(8) المصدر والصفحة ذاتهما.
(9) عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص 162 وقد نقله الدكتور بابللي، ص 63
(10) زيدان، أصول الدعوة، ص 175.
(11) المصدر نفسه، ص 172 -173
(12) الغريب أن الدكتور بابللي يستعمل كلمة «المظنون»حين يقول: المظنون في ولاة الأمور حسن القصد.
بابللي، الشورى، ص 78
(13) بابللي، الشورى، ص 88.
(14) المصدر والصفحة ذاتهما.
(15) زيدان، أصول …، ص 174
(16) أيّد ذلك بعض المفسرين مثل: الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج27، ص 177، ومحمد محمود حجازي في التفسير الواضح في تفسير الآية 159 من آل عمران.
(17) أوردة الشيخ محمد أبو زهرة، أصول الفقه (القاهرة: دار الفكر العربي، 1377 هـ / 1957 ص 190.
(19) انظر کتابي أصول الفقه للخضري وأبي زهرة وكتاب علم أصول الفقه الخلاف، في موضوع الإجماع.
(19) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (الرياض: 1382هـ)، مجلد 19، ج 1، ص 201.
(20) المصدر والصفحة ذاتهما.
(21) محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت)، ج 2، ص 261 -262
(22) المصدر نفسه، ص 262.
(23) الشيخ محمد الخضري، أصول الفقه، ص 316.
(24) المصدر نفسه، ص 309.
(25) الخضري، ص 299، عبد الوهاب خلاف، ص 45، أبو زهرة، أصول...، ص 189
(26) ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، مجلد 19، ج 1، ص 271.
(27) أبو زهرة، تاريخ المذاهب، ج 2، ص 262.
(28) أبو زهرة، المصدر والصفحة ذاتهما، وانظر أصول الفقه، ص191 -192.
(29) الخضري، ص 299.
(30) تناولنا كل هذه المواقف وقدمنا أدلة رأينا في المقال الذي نشر في عدد المجتمع بتاريخ 10 شوال 1390هـ.
(31) أبو زهرة، تاريخ المذاهب، ج 2، ص 338.