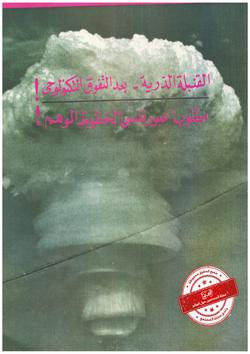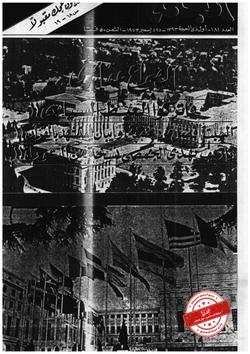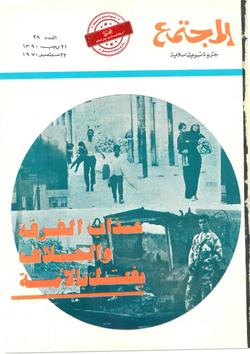العنوان القصة .. منشؤها وتطورها
الكاتب أحمد الطحان
تاريخ النشر الثلاثاء 01-أغسطس-1972
مشاهدات 168
نشر في العدد 111
نشر في الصفحة 24
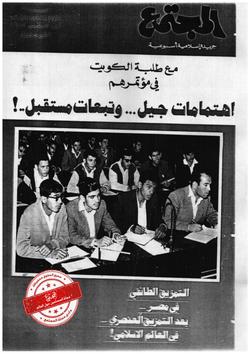
الثلاثاء 01-أغسطس-1972
القصة من قديم قدم الإنسان ذاته، فقد وجدت معه كلازمة من لوازم تعبيره عن مشاعره وأفكاره، وتعتبر التوراة القديمة هي المنبع الأساسي للقصة، وإليه تُنسب القصة الأولى في بنائها وتركيبها، ولقد كان اليونان من أسبق الناس إلى هذا الفن؛ فنسجوا الكثير منها معبرين عن مادة يشتهرون بها وهي كثرة الإلهة واختصاص كل منها بمجال!
ولقد حفظ لنا التاريخ إلياذة هوميروس التي تحكي قصة الحرب اليونانية في طروادة، وأديسته وهي قصة تيه البطل أوديسوس عند عودته من تلك الحرب.
أما عن القصة في بلاد العرب؛ فسنجعل الرأي بها إلى قسمين: الأول قبل الإسلام، ثم تطورها بعد الإسلام، وعدم الاستفادة من هذا الدين الجديد والثروة الفنية المتمثلة في القرآن الكريم.
والثاني: سنوضح فيه القصة القرآنية المرشدة، خصائصها ومميزاتها، ضمن إطار الالتزام بمفهومه الواسع ـكما سنرى- والقصة العربية قبل الإسلام لم تكن لتتعدى الحديث عن المفاخر والمغازي والعصبية القبلية والثأر والوفاء والحماس ضمن إطار واسع من التهويل والمبالغة يمثل فيها الشعر والفناء الدور الرئيسي، وفي بطون الكتب حتى الآن تلك القصص -كقصة يوم داحس ويوم الغبراء ويوم الفجار ويوم الكلاب-الشيء الكثير، ثم إنهم قد صرفوا للغزل جزءًا من القصة، وغالبًا أنهم كانوا يمزجون الغزل والبطولة والفخر في حيز واحد.
قيل لأحدهم: ما كنتم تتحدثون إذا خلوتم في مجالسكم؟
قال: كنا نناشد الشعر، ونتحدث بأخبار قومنا ومفاخرهم، ثم أشرق الإسلام بنوره على الجزيرة العربية، وأخذ يثبت في النفوس عقيدة جديدة، ومفاهيم جديدة وتصورات جديدة، شريطة التحرر التام من قيود العقيدة القديمة، والمفاهيم القديمة، والتصورات القديمة، فلم تكن تلك الفترة بمؤاتية للعرب للاستفادة من ذخر قرآنهم الغني، والانتماء بأسلوبهم القصصي نحو الأحسن؛ فبقيت القصة العربية على ما كانت عليه من العنف والقصور، وفيما يلي عرض موجز للأسباب الرئيسية التي منعت العرب من تلك الاستفادة:
أولًا: الإنتاج الفني لابد وأن يمر بثلاث مراحل هي:
ا - الانفعال النفسي بالتجربة الجديدة.
ب ـ استبطان هذا الانفعال بداخل النفس، حتى يمتزج بأعماقها ويعطيها من لونه ويأخذ من لونها.
ج - ارتداد التجربة إلى الخارج في الصورة إفراز أو تعبير.
عند ملاحظة المراحل الثلاث السابقة ندرك أن فترة البناء للعقيدة الجديدة لم تكن مناسبة لهذا اللون من التعبير؛ لأن العقيدة الجديدة تغسل النفوس تمامًا مما علق بها في الجاهلية، وتملؤها أولًا بأول بتصورات جديدة ومفاهيم جديدة ومشاعر جديدة وسلوك وعمل جديدين. وضمن هذه الحركة لن يتحقق الانفعال، ثم الاستيطان، ثم الارتداد، ومعنى ذلك أنه لن يوجد إنتاج فني في المستوى الرفيع المطلوب.
ثانيًا: قد كان الرصيد القديم بنظر المسلم يحس نحوه بنفرة وتقزز، وهذا ما لا يدع مجالًا لإيجاد شحنة مذخورة تريد الانطلاق، كما أن النفوس في دور التلون في دور التكون في المفاهيم الجديدة، فلا يمكن أن تفيض بالتعبير قبل أن تمتلئ بالشحنة.
ثالثًا: كان الانبهار بالقرآن الكريم -حتى من غير المسلمين- من الأسباب التي أدت إلى التوقف عن التعبير الفني، فقد كانت شحنته الفنية العجيبة تملأ نفوسهم ملئًا، وتستوعب منهم كل طاقة الفن، وتغنيهم عن جمال الأداء بجمال التلقي والأفعال.
وقد يكون الارتياح النفسي والإحساس بالرضى والاطمئنان من العوامل التي أوقفت الانطلاقة الفنية عن تحويمها في عالم التساؤل والتشتت والضياع -وهذا ما يدخل في المجال الشخصي أكثر منه في مجال التعميم- مما يؤدي إلى الركون، وبالتالي إلى التعبير عن هذا القلق بتعبير فني.
تلك هي الأسباب الأساسية التي منعت العرب من الاستفادة الكاملة بالذخر الفني القرآني والتوجيهات الإسلامية في نتاج فني رصين، وسنتابع العرض في تطور القصة بعد الإسلام؛ حتى نتمكن من لمس هذه الحقيقة في عوالم المشاهدة.
قيل إن أول من زاول القصة البسيطة هو تميم الداري، وقد روي عن ابن شهاب قال: أول من قص في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تميم الداري، وقد طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقص في خلافته فأبى عمر، وفي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل له ذلك، وعن إلقاء بعض الأضواء على هذه الرواية نستخلص أن هناك شكًا في ذات المادة المروية أو المقصوصة، فلو كان الأمر متعلقًا بالقصيدة توجيهًا وإرشادًا لما وقف عمر رضي الله عنه في وجه راويها، وهو الحريص على الدعوة إلى الله على بينة.
. .
أما أول من زاول القصة فيما وراء عالم الشهادة، فهو لوط بن يحيى المكني بأبي محنف من أبناء القرن الأول الهجري، وتوفي سنة ١٧٥ هجرية، ويقال إنه كان نابغة في الرواية والإحاطة، وله أربعة وثلاثين كتابًا في الروايات والأحاديث منها كتاب فتوح الشام وكتاب الردة كتاب النهروان، وكتاب الضحاك الخارجي، ويذكر الطبري وابن الأثير أن أغلب إذن فلا بد من مأخذ في إحدى الاتجاهين على تلك الرواية.
وهذا ما يفسح لنا المجال للاستدلال على نوعية القصة، فهي ولا شك ضرب من الحكايا لن يعدو المغازي، وأخبار الأنبياء والوعظ والإرشاد.. «وفي حقيقة الفن الإسلامي لا يعد ذلك أدبًا هادفًا» هذه الكتب قد أورده بأسلوب القصة وفيها نوع من الدراما، وأغلبها ينطبع بالطابع التراجيدي «المأساوي»، وقد ذكرنا في بداية الحديث أن العرب قد استعاضوا عن جمال الأداء بجمال التلقي والانفعال بالنسبة للقرآن الكريم، وهذا مما يحتم وجود مؤثرات جديدة غير القرآن الكريم في القصة العربية نذكر منها:
أولًا: أثر كليلة ودمنة في القصة:
كليلة ودمنة كتاب قصصي وضعه بيدبا الفيلسوف الهندي لدبشليم ملك الهند على ألسنة الحيوان، وقد ترجمه عبد الله بن المقفع عن اللغة الفهلوية.
يعتبر ابن المقفع من أوسع من كتبوا في النثر والقصة ثقافة وأكثرهم امتلاكًا ناصية التعبير الفني، ففي أسلوبه جذالة العربية الأصيلة وبراعة الأديب المقتدر، وقد توفي عام ١٤٣ هجرية.
ولا أدل على تأثير هذا الكتاب في الأدب العربي والقصة العربية على وجه الخصوص من تأليف أبو العلاء المعري لكتاب «القائف» على مثال كليلة ودمنة، كذلك تأليف ابن الهبارية لكتاب «الصادح والباغم» وغيرهما، حتى أن الكتاب قد نظم شعرًا على أكثر من شاعر وفي أكثر من عصر.
فقد نظمه إبان بن عبد الحميد إجابة لطلب البرامكة في أربعة عشر ألف بيت ومطلع منظومته:
هذا كتاب أدب ومحنة..
وهو الذي يدعى كليلة ودمنة.
وقد أثيب على ذلك بعشرة آلاف دينار من يحيى البرمكي وبخمسة آلاف من الفضل ولم يعطه جعفر بن يحيى شيئًا، وقال له:
يكفيك أن أحفظه فأكون راويته، وقد امتد هذا الاهتمام بكليلة ودمنة إلى العصر الحديث فقد نظمها الكثير من الشعراء، وحققها كثير من الأدباء، حتى أن الجواهري قد بدأ في ذلك بقصيدة مطلعها:
قال ملك الهند دبشليم..
لبيدبا يا أيها الحكيم
ومن الطرائف الأدبية أن إمام الأدباء المحدثين المرحوم مصطفى صادق الرافعي قد استخدم أسلوب كليلة ودمنة سلاحًا استعمله في حربه مع العقاد وطه حسين، وقد نشر مجموعة الردود و التهكمات على «كليلة» طه حسین و«دمنة» العقاد في كتاب أسماه المعركة، وكم كانت المناقشات حادة بين الشيخ العقيل والشاب الغرير «العقاد» حول كتاب «وحي الأربعين» عام ١٩٣٣..
ثانيًا: أثر قصة ألف ليلة وليلة:
اختلف المحققون في أصل هذه القصة، فمنهم من قال بأنها فارسية، ومنهم من قال بأنها هندوسية، ومنهم من قال إنها لكاتب واحد، ومنهم من قال إنها لمجموعة من الكتاب، ويرجح «علي حكمت أصفر» إنها هندية الأصل، ويرجع تاريخها إلى نحو ۲۰۰۰ سنة، وقد جمع لذلك الوثائق وحقق هذا الرأي بالدلائل اللازمة.
ومن المستشرقين من قال إنها مترجمة عن «هزار افسان».
والذي يهمنا في الأمر أن هذه القصة كانت من المؤثرات الأساسية في الأدب العربي والأدب الغربي على السواء.
فقد ألف «بوكشيو» الإيطالي كتابًا أسماه الليالي العشر، كما أن فولتير قال إنه لم يقدم على تأليف قصصه إلا بعد مطالعة ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة.
وقد أثرت في الأدب العربي في الجانب الآخر، فلا تخلو القصص العربية على مدارها الطويل من هذه الصبغة المسلية التي لا تعدو الحديث عن الأسفار والمغامرات والخيال، وليس لها من الأهداف سوى التسلية وقتل الوقت وعرض اللغة والقدرة، ومن أمثال قصصه: قصة الحمار والثور في صاحب الزرع، وقصة التاجر مع العفريت.
ثالثًا: الأصمعي:
أديب من رجال القرن الثاني الهجري، كانت له طريقة خاصة في صياغة الفكرة بأسلوب قصصي طريف، فيها من الفكاهة والأدب والملح الكثير، وله الفضل في إيجاد هذا النوع من القصص الخاطفة الطريفة في الأدب العربي، ومن مؤلفاته في هذا المضمار كتاب الأتراب، وكتاب المسير، وكتاب القداح، وكتاب الأخبية، وكتاب الوحوش.
يقول «المبرد» إن «الأصمعي كان بحرًا من اللغة لا يعرف مثله فيها، وفي كثرة الرواية»، ولن نتمكن من معرفة منهج الأصمعي في القصة العربية إلا عندما نقرأ ما كتبه عن السحاب والمطر.
قال الأصمعي: مررت بغلمة من الأعراب، فقلت أيكم يصف لي الغيث وأعطيه درهمًا؟ فقالوا كلنا يصف، وهم ثلاثة.
فقلت: صفوا فأيكم ارتضيت صفته أعطيته الدرهم.
فقال أحدهم: «عن لنا عارض قصرًا تسوقه الصبا، وتحدوه الجنوب، يحبو حبو المعتنك، حتى إذا ازلأمت صدوره، وانثلجت خصوره، ورجع هديره واصعق زئيره، واستقل نشاطه، وتلائم خصاصه، وارتعج ارتعاصه وأوفدت رقابه، فامتدت أطنابه تدارك ودقة، وتألق برقه، وحفزت تواليه، وانفسحت عزاليه، فغادر الثرى عمدًا، والعزاز تئدًا، والحث عقدًا والصخاصخ متواصلة، والشعاب متداعية».
«ترأت المخايل من الأقطار تحن حنين العشار، وتترامى بشهب النار قواعدها متلاحقة، وبواسقها مضحكة، وأرجاؤها متقاذفة، فوصلت الشرق بالغرب، والوبل بالودق، سحًا دراكًا، متتابعًا لكاكًا، فصخصخت الجفاجف وأنهرت الصفاصف، وحوضت الأصالف، ثم أقلعت محسبة محمودة الآثار موقوفة الحبار».
وقال الثالث:
«بيننا الحاضر بين اليأس والإبلاس، غمرهم الإشفاق، رهبة الإملاق حتى حقبت الأنواء ورفرف البلاء، واستولى القنوط على القلوب، وكثر الاستغفار من الذنوب، ارتاح ربك لعباده، فأنشأ سحابًا مجهرًا كنهورًا، معنونكًا مملوكًا، ثم استقل واحزال، فصار كالسماء دون السماء، والأرض المدحورة في لوح الأهواء، فأحسب السهول، وأتأق الهجول، وأحيا الرجاء، وأمات العزاء وذلك من قضاء رب العالمين».
قال ـأي الأصمعي- فملأ والله اليفع صدري، فأعطيت كل واحد منهم درهمًا وكتبت كلامهم.
هذا أنموذج لأدب الأصمعي، وتبدو فيه طريقته الفنية والتي تأثر بها الأدب العربي من بعده بكثير أو قليل.
والذي يسترعي الانتباه أن الأصمعي كان يحرص على اللفظ الغريب إظهارًا للقدرة، وإمتاعًا للسامعين، وهو يقف بين يدي الخلفاء والوزراء، أما عن الفكرة في القصة فليست ذات أهمية كبيرة بجانب الطريقة في الصياغة؛ لأن الاعتقاد الذي ساد -والذي تأثر به النقاد الحاليون- أن الأدب وسيلة للإمتاع بحد ذاته، فاللفظ الجميل ذو الجرس والموسيقى، والصورة المتكاملة الأركان من صوت وحركة ولون بالإضافة إلى عاطفة الأديب، تلك هي الغاية من الأدب في نظرهم، وهذا ولا شك جور على الفكرة، وابتعاد عن منهجية القصة في القرآن الكريم بصورة خاصة، والأدب الهادف بصورة عامة.
وتحقيقًا للبحث العلمي، فإنني لا أنكر وجود بعض المحاولات الناجحة في القصة العربية القديمة، ولكن الطابع العام هو الطابع المذكور وفيه يبتعد الأدب العربي عن نهج القصة المستمدة من القرآن الكريم ذات الطابع الفني المتكامل ضمن إطار التوجيه والوعظ.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل