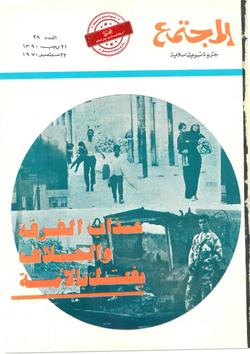العنوان المجتمع الثقافي.. عدد 1659
الكاتب مبارك عبد الله
تاريخ النشر السبت 09-يوليو-2005
مشاهدات 18
نشر في العدد 1659
نشر في الصفحة 48

السبت 09-يوليو-2005
اللغة العربية وحرفها (4)
اللغة العربية والآلة الصوتية
أ.د. حامد بن محمود أل إبراهيم
إن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تستخدم الآلة الصوتية في الإنسان استخدامًا كاملًا، وقد ثبت ذلك بعد استحداث علم الصوتيات Phonetics، فلم يعد الأمر تفاخرًا وتطاولًا بدون دليل علمي، ولغة هذا شأنها قمينة بأن تتولى الصدارة، ولا تُوأَد تحت سطوة القوة والعلو في الأرض بغير الحق.
يقول الأستاذ العقّاد في كتابه «أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» في دراسته عن أنّ الحرف العربي هو أصلح الحروف لكتابة اللغات بما فيها اللغة اللَّاتينية: «ولكن الأمر في صلاح الحروف للكتابة لا يعود إلى كثرة الأفراد اللذين يكتبونها، بل إلى أنواع اللغات التي تؤدي ألفاظها وأصواتها، وعلى هذا الاعتبار تكون الحروف العربية أصلح من الحروف اللّاتينية أضعافًا مضاعفة لكتابة الألفاظ والأصوات؛ لأنّها تؤدي من أنواع الكتابة ما لم يُعهد من قبل في لغةٍ من لغات الحضارة، فالحروف اللاتينية تستخدم للكتابة في عائلةٍ واحدة من العائلات اللغوية الكبرى وهي العائلة «الهندية الجرمانية».
وهذه العائلة الهندية الجرمانية، هي العائلة التي يقوم فيها تصريف الكلمات على «النَّحت» أو على إضافة المقاطع إلى أوَّل الكلمة أو إلى آخرها، وتُسمّى من أجل ذلك باللغات الغرَوية من الغِرَاء اللاصق في أدوات البناء والتجارة.
أما الحروف العربية فهي تقوم بأداء الكتابة بهذه اللغات وبكثير غيرها، فهي تستخدم لكتابة الفارسية والأُردية وهما من لغات النحت، أو من عائلة اللغات الغروية.
واستُخدِمَت لكتابة التركية وهي من العائلة الطّورانية، ويرجعون في تصريف ألفاظها إلى النحت تارة، وإلى الإشتقاق تارة آخرى، فهي وسط بين الفارسية واللغة العربية.
وتستخدم الحروف العربية بطبيعة الحال لكتابة لغة الضّاد المميزة بمخارجها الواضحة الدقيقة بين جميع اللغات، وهي أعظم لغات الإشتقاق التي اشتهرت باسم العائلة السّامية.
ويقول الأستاذ العقاد: «وتكتب بالحروف العربية لهجات ملاوية تتفرع على لغات المقاطع القصيرة والخبرات الصوتية المنغومة، ويختلفون في نسبتها إلى إحدى العائلات الثلاث حتى اليوم؛ لأنّها مستقلة بكثير من الخصائص وقواعد التصريف، ولعلها عائلة مستقلة من العائلات اللغوية الكبرى تشعّبتْ فروعها لتفرِّق الناطقين بها بين الجزر المنعزلة.
وقد استطاعت هذه الأمم جميعًا أن تؤدي كتابتها بالحروف العربية دون أن تدخل عليها تعديلا في تركيبها ولا أشكالها المنفردة، ولم تتصرف فيها بغير زيادة العلامات والنّقط على بعض الحروف، وهي زيادة موافقة لبنية النقط والشكل عند الحاجة إليها، وليست زيادة شرطة على الكاف بأغرب من زيادة النقط على الحروف، مفردة أو مثناه وفوق الحرف أو تحته، للتمييز بين الأشكال المتشابهة أو المتقاربة.
وعلى كثرة اللغات، والعائلات اللغوية، التي تؤديها حروف العربية، لم يزل ضبطها للألفاظ أدقّ وأسهل من ضبط الحروف اللاتينية التي تستخدم لكتابة عائلة لغوية واحدة، وهي العائلة الهندية الجرمانية.
فالإسباني يقرأ الانجليزية على حسب قواعد لغته فيعرفها كثيرًا ويبلغ من تحريفها مبلغًا لا نعهده في نطق الفارسي الذي يقرأ الأردية أو التركية أو العربية، ولا تعهده في نطق العربي الذي يقرأ الفارسية بحروفها، ولو لم يكن على علم بمعانيها، ولكنه إذا عرف معناها لم يقع في خطأ من أخطاء اللفظ، ولم يكن هناك خلاف بينه وبين أبناء الفارسية في كتابتها وقراءتها.
هذه حقيقة لا جدالَ فيها، ينبغي أن نحضرها أمامنا لنعرف مدى التهويل المفرط في شكوى الشاكين من صعوبات الكتابة العربية المزعومة: فإنّ حروفنا إذا قيست بغيرها لم نجد لها نظيرً بين حروف الأبجديات على تعدده وكثرة التحسينات التي أدخلت عليها.
حتى حركات الإمالة التي يبالغون فيها وهـي عندنا أهوَن خطبًا من نظائرها عند الأوروبيين فإن حرف الألف A وحرف الياء I يمالان على غير قاعدة مطردة بين الإنجليزية والفرنسية والهولندية، وقد استطاع حُفَّاظ القرآن الكريم أن يضبطوا مواضع الإمالة والإشمام في القراءات المختلفة ضبطًا لا يعسر تعميمه بعلاماته عنه الحاجة إليه في سائر الموضوعات.
وعلينا أن نسقط من حسابنا تهويل المهوِّلين باختلاف نطق الحروف على حسب اللهجات الفصحى أو العامية: فإنَّ الملايين من أبناء العربية يكتبون الجيم بشكلها الأبجدي المعروفة وينطقها ابن القاهرة وابن الصعيد وابن دمشق كل منهم على حسب منطقه الذي نشأ عليه».
وهناك باب تنفرد فيه اللغة العربية، وتزداد ثراء عن أي لغة قد تكون فيها لمحة من هم الباب العجيب من أسرار اللغة العربية وذوقها وطرائق تركيباتها، ألا وهو أن الحروف لها علاقة بدلالات الكلمات:
يقول الأستاذ العقاد: «فحرف الفاء هو نقيض حرف العين بدلالته على الإبانة والوضوح «فتح، فضح، فرح، فلق، فجر، فسر».
وحرف الضاد خص بالشؤم يسم جبين كا لفظة بمكرهة، لا يكاد يسلم منّا اسم أو فعل «ضجر، ضر، ضير، ضجيج، ضوضاء، ضياع، ضلال، ضنك، ضنى، ضوى، ضراوة، ضئزى».
وبعكسه حرف الحاء، التي تكاد تحتكر أشرف المعاني وأقواها: «حب، حق، حرية، حياة حسن، حركة، حكمة، حلم، حزم».
والميم، تدل على التوكيد والتشديد والقطع «الحتم، والحسم، والجزم، والحطم، والختم والكتم، والعزم، والقضم، والقطم، والكظم».
وحرف السين على النقيض من الميم، يد على المعاني اللطيفة «كالهمس، والوسوس، والنيس، والتنفس، والحس، والمساس، والاقتباس»، ولكنه يتغير إذا تغير موضعه من الكلمة، مثل «السد، والشد، والصد».
والنتيجة بعد هذه الملاحظات السريعة، قد تكون كبيرة الجدوى مع التوسع فيها، وتعد الناظرين إليها من جميع جوانبها، وخلاصتها:
1- أنّ هناك ارتباطًا بين بعض الحروف ودلالة الكلمات.
٢- أنّ الحروف لا تتساوى في هذه الدلالة، ولكنها تختلف باختلاف قوتها وبروزها في الحكاية الصوتية.
3- أنّ العبرة بموقع الحروف من الكلمة لا بمجرد دخوله في تركيبها.
4- أنّ الاستثناء في الدلالة قد يأتي من اختلاف الاعتبار والتقدير، ولا يلزم أن يكون شذوذًا في طبيعة الدلالة الحرفية.
ولا نعرف بين اللغات الكبرى لغةٌ أصلح من لغتنا العربية لهذا الباب من أبواب الدراسات اللغوية؛ لأنّ مخارج حروفها مستوفاة متميزة: خلافًا لأكثر اللغات التي تعوزها الحروف الحلقية أو تلتبس فيها مخارج حروف الهجاء.
وبعد هذا ننتقل الآن إلى اللغة العربية، ونعرض هنا إلى جانبين مهمين منها هما:
قواعدها وكلماتها
فالقواعد هي قانون اللغة، إنّ صحَّ واستقام استقامتْ، والكلمات هي وعاء العلوم ومادتها، إن كثرت وسَهُل إخصابها وزيادتها كانتْ صالحةً سابغةً، وإن قلَّت وانحصرت، ضاقتْ بالتَّطور والعلوم الجديدة، وللغة العربية في كلا الأمرين- كما سنرى باعٌ- وأيُّ باعٍ- لا تدانيها فيه أي لغة معروفة.
قواعد اللغة العربية
يزعم الزاعمون أنّ قواعد العربية عَسيرة، وهذا ليس صحيحًا، فقواعدها ليست أعسر من قواعد الفرنسية، أو الألمانية، أو الإنجليزية، ولإيضاح ذلك نقول إنّ لقواعد اللغة جانبين هما:
جانب الاستعمال العلمي
وتعني بذلك استخدام اللغة لشرح العلوم، وتدوين التجارب، وكتابة البحوث، ولا يلزم لذلك إلاّ قواعد محدودة وسهلة، لا تتطلَّب إلا القليل من الجهد، وسوف نُلِخّص ذلك بعد قليل.
جانب الاستعمال البحثي والأدبي
ونقصد بذلك الأبحاث اللغوية وإمكاناتها، التي تكشف عن دقيق معانيها، ولطيف تراكيبها، وذلك علم كأيّ علم لا يخوض فيه إلّا القادرون، ومن قال إنّ علم الطب والتشريح سهل يسير: أو أنّ علم الإلكترونيات، والحاسب الإلكتروني مُبَسَّط هزيل! إنّ هناك عشرات من العلوم يصعب مراسها، وتستلزم الدرس الطويل لتحصيلها، فهل نترك هذه العلوم بدعوى الصعوبة!
إنّ هذا ما لم يقل به جاهل فضلًا عن عالم!! ولكن دعوى ترك العربية لصعوبتها لها أسباب أخرى، وإن وراء الأكمَّة ما وراءها» كما قال الأمير شكيب أرسلان للرافعي.
واحة الشعر
شعر: محمد أبو دية
علمينا أبجديات النجاح
حدِّثي الأطفال يا أم الشهيد واحرسي الأيتام في ظل الجناح
وازرعي الورد على قبر الحبيب واصبري بالله إن الفجر لاح
وانثري يا أخته ماء العيون أنعشي بالدمع أزهار الأقاح
أيها القادم من أرض الفداء أيها الأتي على متن الرياح
أيها القادم من ساح الوغى من ديار العزم من أرض الكفاح
كيف حال الأهل فيها والشجر والفتى المنصور من غير سلاح
كيف نور النجم فيها والقمر كيف حال الجند في كل النواح
هل سمعت الشعر في ليل السمر يصدح الداعي به بعد الرواح
ويح قلبي كيف قراء السور كيف عليا كيف ليلى وصلاح؟!
يا شهيدًا غاب في ليل الفرح يا عريسًا أثخنوه بالجراح
يا عروسًا فجعت في يومها تلوا ابن العم يا زين الملاح
يقتل الأفراح علج مفسد من بلاد الروم ذو كفر بواح
ليلة الحناء قد أفسدها قاتل أغراه شيطان السلاح
فاصطبر يا شعبنا لا تبتنس كل ليل ينجلي عند الصباح
کشرت صهيون عن أنيابها ترعب الطفل وتشتاق الصياح
حطموا أنيابها بالكاسرات لا تخافوا من عواء أو نباح
زغردي يا أم في ذكرى الشهيد واذكريه في غدو ورواح
أرسلي أخباره عبر البريد علمينا أبجديات النجاح
علمونا فتية القدس الهجوم نحفظ الأوطان من أن تستباح
علمونا خطة عند المساء علمونا غارة عند الصباح
نحن أميون لم نقرأ ولم نكتب النصر بأسنان الرماح
وصفي عاشور أبوزيد
بعد مئة عام على وفاته
الإمام محمد عبده.. «مهندس» حركة الإصلاح الحديث
في العاشر من يوليو ٢٠٠٥م تمر علينا الذكرى المئوية لوفاة رائد الإصلاح وباعث النهضة الإمام محمد عبده (١٢٦٦- ۱۳۲۳ هـ = ١٨٤٩- ١٩٠٥م)، الذي يعتبر أحد رموز الاتجاه الإسلامي والمدرسة الإصلاحية التي فتحها السيد جمال الدين الأفغاني، فتميز بالقوة والثورية حتى يوقظ النُّوَّم، فلما استيقظوا ناسبهم المجدِّد الكبير محمد عبده بدعوته التجديدية الإصلاحية، ثم أتَى دور التنظير والتأصيل الذي أتقنه السيد محمد رشيد رضا، وتطلَّب هذا التأصيل والتنظير عملاً وحركة بلغ بها الإمام حسن البنا آفاقًا رحيبة.
محطّات في حياة حافلة
وُلد الإمام «محمد عبده» في عام (١٢٦٦هـ= ١٨٤٩م) في قرية «محلّة نصر» بمحافظة البحيرة لأبٍ تركمانيّ الأصل، وأمٍّ مصرية.
تعلم القراءة والكتابة في منزل والده، ثم انتقل إلى دار حفظ القرآن الكريم، فحفظه خلال عامين، والتحق بالأزهر الشريف عام 1866م.
منذ وصول الأفغاني إلى مصر عام ١٨٧١م التقى به محمد عبده ولازمه كظلِّه، وبدأ الكتابة في جريدة الأهرام وعمره يومئذٍ سبعة وعشرون عامًا.
وبعد تخرُّجه في الأزهر ۱۸۷۷م مارس الإمام التدريس فيه، ثم درس في دار العلوم، كما درّس في مدرسة الألسن، وانضم إلى صفوف الُمعارضة لمطالبة الخديوي إسماعيل بالحريات الدستورية، وبعد أن خُلع إسماعيل وتولى ابنه الخديوي توفيق تقلّد «رياض باشا» رئاسة النُّظار، واختار الشيخ محمد عبده الرئاسة تحرير صحيفة «الوقائع المصرية» واستطاع أن يجعل «الوقائع»- خلال سنة ونصف السنة- منبرا للدعوة إلى الإصلاح- وهو ما شعر معه الخديوي توفيق بخطر الرجلين، فقام بنفي جمال الدين الأفغاني إلى باريس.
واشتدت معارضة محمد عبده للخديوي توفيق والاحتلال الإنجليزي، فشارك في الثورة العرابية ۱۸۸۲م، وأصبح من قادتها وزعمائها بالرغم من أنّه لم يكن من المتحمِّسين للتغيير الثوري السريع، وأُلقِيَ القبض عليه، وأُودع السجن ثلاثة أشهر، ونُفيَ إلى بيروت، وهناك استدعاه جمال الدين الأفغاني إلى باريس، وأسّسا معًا جمعية «العُروة الوثقى» التي صدرت عنها جريدة العروة الوثقي عام ١٨٨٤م.
وعاد الشيخ محمد عبده إلى بيروت، وشغل وقته بالكتابة والتأليف والتعليم إلى أن عفا عنه الخديوي توفيق وعاد إلى مصر ۱۸۸۹م، وتمّ تعيينه قاضيًا أهليًا ثم مستشارًا في محكمة الاستئناف سنة ١٨٩٥م، ومفتيًا للبلاد ۱۸۹۹م، ثم بدأت علاقته بالخديوي عباس يشوبها الفتور حتى تحولتْ إلى عَداء سافر من الخديوي، بسبب المؤامرات التي كانت تُحاك ضد الإمام، حتى اضطر إلى الاستقالة من الأزهر في سنة ( ١٣٢٣هـ = ١٩٠٥م)، وإثر ذلك أحس الشيخ بالمرض، واشتدت عليه وطْأته، وتبيّن أنّه السَّرطان، وما لبث أن توفي بالإسكندرية في العام نفسه عن عمر بلغ ستة وخمسين عامًا.
في ميادين الإصلاح والتجديد
ارتكزتْ دعوته على محورين:
الأول: تحرير الفكر والعقل من قيْد التقليد والخرافات، وفهم الدين على طريقة السلف الصالح قبل أن ينشأ الخلاف والتمذهُب.
والثاني: إصلاح أساليب اللغة العربية في التعبير والتحرير، وهذه أهم الميادين:
العقيدة وعلم أصول الدين
يعتبر كتابه «رسالة التوحيد» نقلةً نوعيةً في طرح قضايا العقيدة وعلم أصول الدين؛ لأنّ هذا العلم كان قد انتهى مع الدراسات الكلامية والفلسفية في تراثنا إلى أسلوبٍ من المعالجة عقَّد مفاهيم العقيدة الإسلامية وأفقدها وضوحها وسلاستها، فجاء محمد عبده بكتابه هذا ليثور على هذا النمط من التناول، وينْتهِج نهجًا جديدًا استفاد فيه من المنهج القرآني في عرض العقيدة وإيضاح مفاهيمها.
التّعليم والتربية
اعتبر الإمام التّربية والتعليم مفتاح الرُّقي والإصلاح والنهضة، وأبرز سبل الإصلاح الديني؛ ولذلك اهتمّ بهذا المجال اهتمامًا بالغًا، فبعد حصوله على العالمية من الأزهر ۱۸۷۷م مارس التّدريس فيه، وقرأ لطلّابه المنطق والفلسفة والتوحيد، وتهذيب الأخلاق لمسكويه، وتاريخ المدنية في أوروبا وفرنسا لفرانسوا جيزو، وله جهوده البارزة وبصماته الواضحة لإصلاح الأزهر في هذا الميدان، ولم يكتفِ بالتدريس في الأزهر، بل درّس في دار العلوم وقرأ لطلابه فيها مقدمة ابن خلدون لما تحويه من أفكار ناضجةٍ وآراء حرة.
وكانتْ له جهود في إنشاء مؤسسات تعليمية الضبط منهجية التعليم وتوجيهه في مصر.
الدّفاع عن الإسلام
وهو مجال بارز في حياة الإمام حيث نجد له مؤلَّفات ومقالات عديدة ومنها ردّه على بحثٍ كتبه فرح أنطون في مجلة الجامعة: عن فلسفة ابن رشد، ادّعى فيه أنّ المسيحية أكثر تسامحاً مع العلم والفلسفة من الإسلام، فتصدَّى الإمام للرد عليه في مقالات متعددة ضمنها فيما بعد كتابه المعروف: «الإسلام والنّصرانية بين العلم والمدنية».
وقد اتخذ الإمام سُبلًا وَمسالك متعدّدة في الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه منها: إجاباته عن بعض المشكلات، فيما يخص العقائد والأحكام، والقرآن، وغيرها، ومن هذه المسالك کشف شُبهات المرتابين وأغلاط الجاهلين، والردّ على الحاقدين على الإسلام، وكان يتناول الشبهات ويرد عليها بأناة وموضوعية، وحكمة وبصيرة وقدرة فائقة على إزالتها ودحضها بالدليل والبرهان.
صلاح حسن رشيد
اللغوي العراقي د. على القاسمي لـ المجتمع:
الثقافة العربية تعاني من أبنائها المستعجمين أكثر من المستشرقين
أدبنا العربي لن يصل إلى العالمية بالتّغريب بل بالإبداع الذاتي.
وصف الدكتور علي القاسمي- مستشار مكتب تنسيق التعريب بالمغرب والناقد العراقي المعروف وعضو مَجمع اللغة العربية في القاهرة- الأوضاع التي تمر بها بلاده بأنها شبيهة بأيام المسلمين الأخيرة في الأندلس قبيل طردهم من هناك.
وأضاف في حواره لـ المجتمع أثناء حضوره فعاليات مؤتمر مجمع اللغة العربية الخالدين بالقاهرة مؤخرًا: أنّ الثقافة العربية تعاني من أبنائها أكثر من الغربيين الذين فشلوا في النيل منها، لكن الكثيرين من أبنائها المستعجمين دَأَبوا على الطعن في وجودها، والتنكر لأصالتها بدوافع تآمرّية غربية من هذا النفر القليل الذين يمثلون طابورًا خامسًا، وإلى التفاصيل:
بوصفكم من العراق الجريح.. كيف ترى الأوضاع الحالية؟
- العراق بدأ ينزف من الداخل بفعل الأيدي الغربية التي تخطط وتتآمر لكي تكون هناك حرب أهلية وصراعات قبلية، وأعتقد بل أجْزِم أن أصابع الموساد الصهيوني فاعلة فيما يحدث على التراب العراقي، وأنّ هناك عصابات صهيونية اشترت بالفعل أراضي وعقارات في شمال العراق، وهو ما ينذر بالخطر مثلما حدث من قبل في فلسطين والعراق، ويذكرنا بأياّم الأندلس الأخيرة تحت قيادة أبي عبد الله الضعيف المستسلم، ومما لا شك فيه أن التفجيرات والانفلات الأمني والصراعات اليومية القبلية هي من صنع الصهاينة والموساد.
ولكن البعض استبشر بنتائج الانتخابات وراهن على ورقة قيام المؤسّسات تمهيدًا لسيطرة العراقيين على أمورهم بعد إجلاء الاحتلال فهل تتفق مع هذا القول؟
- إطلاقاً.. فأوراق اللعبة انتهتْ وظهرتْ الأسباب الرئيسة التي جاءت بالاحتلال للعراق السبب هو النفط وتغيير الخريطة العربية لصالح الكيان الصهيوني والشرق الأوسط الكبير الذي بشّرتْ به الولايات المتحدة مؤخرًا.
وأؤكد أنّ واشنطن والكيان ينويان تقسيم الأراضي العربية حسب مناهجهما لزعزعة الاستقرار والقضاء على أيّ قوة فاعلة ورئيسة في المنطقة، فهم يحيدون البعض ويزعزعون البعض الآخر حسب سياستهم وطريقتهم.. فمتى نفيق لتخطيطهم الإجرامي؟!
العربية أفضل لغة
وعلى الصعيد الثقافي... لماذا الحملات المسعورة على العربية بالذات؟
- هذه الحملات المسعورة على لغة الضاد ليست جديدة ولا خوف منها بتاتًا؛ لأنّ العربية أفضل وأقوى وأبلغ لغةٍ حيّة الآن على ظهر الأرض، ولذلك يحاولون الشوشرة عليها والتشويه المتعمد لها، إلا أنّ مجهوداتهم تبوء بالخيبة والفشل الذريع، لكن هناك طائفة من المستغربين العرب الحداثيين الذين يروجون للعاميات واللهجات على حساب الفصحى متنكرين لها، وذلك لدوافع تآمرية غربية، وهي كتابات لا قارئ لها برغم البريق الذين يحيطون أنفسهم به والمساحات الرهيبة المخصصة لهم في الصحف والمجلات، لكنها كتابات عقيمة ضدّ الثقافة العربية.
وكيف نصل بأدبنا العربي وثقافتنا إلى العالمية؟
- الأدب العربي المعاصر يخاطب نفسه بأدوات الغرب وتقنياته وبأطُر تقليدية غربية، وهو لا يقدم للآخر قراءة جديدة لبيئات مغايرة بأساليب مبتكرة، ولكنّه يعيد ما أنتجه الآخر للداخل العربي.. وهي مغالطة فظيعة وأما الحديث عن العالمية فطريقه الإبداع الحقيقي بأدواتنا الخاصة وبلُغةٍ فصيحة وبتحليل نقدي وفني مستقَى من كتابات نقادنا الكبار القدامى، أما الحديث عن كتابات حداثية بمناهج معقدة غربية فيها إحصاءات وجداول رياضيّة فهي ليستْ من النقد العربي في شيء- ولكي نصل للعالمية لا بد أنّ نبدع وفق مناهجنا الخاصة وتفكيرنا العربي- وأمّا حوار الحضارات فلا نتيجة فيه؛ لأنّه لن يُثمِر نتائج ملموسة، كما أنّ الولايات المتحدة ساعية في سياستها الاستعمارية ولا تستمع لما يدور داخل أروقة الحوارات الحضارية ولا تؤمن بها.