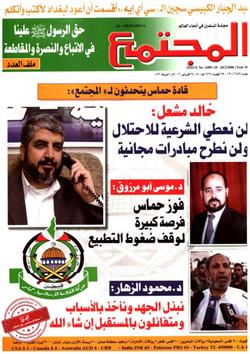العنوان المجتمع الأسرى (1373)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 26-أكتوبر-1999
مشاهدات 11
نشر في العدد 1373
نشر في الصفحة 60
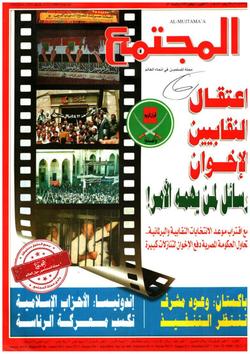
الثلاثاء 26-أكتوبر-1999
طموح .. بدون جموح!
المستوى التربوي للوالدين.. والتشجيع المستمر يدفعان الأبناء للتفوق
إيمان محمود
بين طموح الإنسان وقدرته على تحقيق ما يطمح إليه تقف منظومة من العوامل النفسية، والبيئية، والاجتماعية لتيسر تحقيق هذا الطموح أو تعسره.
ومن المهم أن يكون الطموح شرعيًا ومرنًا يتوافق مع الظروف والإمكانات ولا يتجاوزها ليتحول إلى «جموح».
وحتى لا يصاب الفرد بإحباطات نفسية, وانتكاسات شعورية لفشله في الوصول إلى ما يطمح إليه يقدم لنا د. سيد صبحي أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس- نصائح وإرشادات تكفل للفرد منذ طفولته مناخًا وبيئة يعاونانه على تحقيق طموحاته، ويجنبانه الشعور بالهزيمة والإحباط.
في البداية يرى د. سيد صبحي أن هناك فرقًا بين التطلع والطموح فيقول: التطلع هو شعور الابن بأنه فخور بما يعمل، ويحظى بتقدير جميع من يحيطون به ويلتفون حوله، أما الطموح فهو النتيجة النهائية للتطلع، وقد يكون الترجمة الحقيقية لما يريد المرء أن يكون عليه من إنجاز ورفعة، وعندما يهدف التطلع أو الطموح إلى تحقيق هدف معين ومحدود، فإن الفرد يسعى به إلى أن يرضى الناس عنه ويباركوه، وعلى سبيل المثال يكون الابن في غاية الرضا عندما يمدحه والده على رسم من الرسوم عبر فيه بتلقائية عن موضوع آثار إعجاب والده فهنا يزداد شوق الفرد ويشتعل حماسه فيدفعه ذلك إلى التطلع والإنجاز.
ويضيف د. سيد: لابد من متابعة المرء في تطلعاته حتى لا يخرج بها عن السائد والمألوف فيصطدم بالقدرة المحدودة التي لا توافق هذا التطلع، ولا تحقق له ما يريد من إنجاز، مما قد يؤدي به إلى سوء التوافق النفسي الذي ينعكس بدوره على سلوكه ويؤثر على وضعه النفسي والاجتماعي.
كيفية الإنجاز
والعوامل التي قد تؤثر بدرجة ما على مستوى التطلع، وما قد يتبعه من إنجازات، يحددها د. سيد في النقاط التالية:
- تعرف رغبات الأبناء التي يريدون تحقيقها .
- توفير الخبرة السابقة التي سوف تتعهد هذه الرغبات مثل الآباء، والأمهات، والمربيين.
- القيم الشخصية والاجتماعية التي تعلمها الشخص أثناء عملية التطبيع الاجتماعي.
- المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
- المستوى الثقافي ومدى توافر أدوات الثقافة داخل المنزل، وتوظيفها على النحو الأكمل.
- الظروف البيئية المحيطة.
- تأثير الأقران وعقد المنافسات بينهم.
- وجود الجماعة المشجعة.
- رفض الجماعة للإنتاج الفاشل، خاصة إذا لم تتوافر فيه عناصر الجدة والأصالة، وتتجلى من خلاله المهارة، ويحظى بقبول الجماعة.
ويرى أستاذ الصحة النفسية أن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى عدم تحقيق تطلعات أبنائنا، ومن هذه العوامل ما يلي:
- الظروف الاجتماعية غير الملائمة للمرء التي قد تأخذ شكلين رئيسين:
1 – إحاطة الابن بظروف اجتماعية غير ملائمة لظهور تطلعاته.
٢ – عدم تقدير المجتمع المحيط به لأعماله وإنجازاته.
وبالنظر إلى هذين الشكلين نجد أنه من الصعب علينا دراسة الأفكار التي قد تسبب إهانات للابن أو تقلل من طموحه وتطلعاته، ولكن الذي يمثل خطورة أن الابن قد يجد المدرسة تشجع الفكر التقليدي الذي يعتمد على الاستظهار، مما قد يجعله يرى لا التفوق من خلال التفكير المقيد المحدود الذي يرتبط بالخبرات والمعلومات التي يقدمها المنهج الدراسي، وما على المتفوق في نظر المجتمع المدرسي إلا أن يحفظها ويستظهرها ويقدمها إذا أراد لنفسه التفوق كاملة غير منقوصة، ومن هنا ربما لا نجد للتفكير المنطلق ثوابه، وتقديره.
الوالدان.. والمنزل
ويقول د. سيد صبحي: إن المنزل بالنسبة إلى أي شخص يمر بالكثير من الأحوال التي قد تؤثر عليه انفعاليًا وعقليًا، والتي بدورها قد تؤدي إلى إضعاف جذوة التطلع عند الابن، وتعمل على الحد من ظهوره إلى حيز التحقيق، خاصة إذا كانت هذه الظروف المنزلية غير الملائمة يغلب عليها طابع التسلط، وتتسم بالقسوة في المعاملة، أو التذبذب أو التفرقة أو ما شابه ذلك من اتجاهات والدية مسرفة في الشدة وبعيدة عن الأصول التربوية والنفسية السليمة.
وينبه إلى أن أحوال المدرسة غير الملائمة تؤثر في تطلعات المرء وتحد من قدراته، فكثيرًا ما نجد أن المدرسة كمؤسسة تربوية تجافي هذه الحقائق التربوية التي تعد من أهم أدوارها الاجتماعية، وخاصة أننا نلاحظ أن المدرسة لم تعد تقدم إلا ما هو متاح من خبرات محدودة في شكل المناهج والمقررات الدراسية، وقد يصل الأمر بهذا النوع من المدارس إلى ترسيخ تلك القاعدة في ذهن الأبناء، والتي ترى أن النجاح لا يتم إلا على أساس الحفظ والاستظهار لهذه المقررات، واعتمادا على هذا التصور الخاطئ يصبح الطفل صاحب التطلع الابتكاري في صراع داخل قفص المقررات، مما يحدونا إلى إعادة النظر في أمر المقررات باعتبارها المحك الوحيد للتفوق وإعادة النظر في أمر الأنشطة المدرسية، وتصحيح النظرة الخاطئة إليها باعتبارها مضيعة للوقت، ثم الاهتمام بإعداد الأفراد المؤهلين للتعامل التربوي السليم مع الطموحين منطلقي الفكر.
لا تضغطي على طفلك ليذاكر
سمية عبد العزيز
عبارة متكررة على لسان الأمهات يوميًا, هي: «ابني يذاكر لكنه لا يركز» لذلك تحاول الأم الضغط على الابن ليذاكر فترة أطول، مع أن علم النفس يحذر من هذا الضغط ويفرق بينه وبين عدم التركيز المرضي.
ويفرق د. نجيب حزام - أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس- بين الطفل الذي يعاني من الصعوبة في التركيز والطفل العادي الذي تفرض عليه طبيعة المرحلة العمرية الميل للعب، مشيرًا إلى أن متوسط تركيز الانتباه عند الطفل في بداية المرحلة الدراسية عند عمر ٦ سنوات لا يتعدى ٧ دقائق وهو المعدل الطبيعي، وتظهر بعد ذلك ضرورة تغيير النشاط الذي يقوم به الطفل.
ويؤكد أن استخدام أكثر من مثير في هذا السن شيء مهم, سواء عن طريق استخدام الأشكال المختلفة مثل أدوات الرسم، بالإضافة إلى الألوان، مع استخدام الكتب ذات الأصوات المتنوعة، إذ يساعد ذلك على تركيز الانتباه أكثر من شكل الكتاب المجرد وهو ما يتضح في مرحلة رياض الأطفال.
ويضيف أنه يجب التفرقة بين تشتت الانتباه لأسباب خارجية وتشتته المرضي، فإذا كان الطفل لا يستطيع التركيز بسبب وجود منبهات ومثيرات مثل صوت التلفاز أو الجرس فهي أشياء طبيعية لا تلوم الطفل عليها، لكن تشتت الانتباه المرضي له علامات أخرى أهمها شكل العين وعدم تركيزها وتحركها يمينًا ويسارًا، وفي هذه الحالة يحاول الطفل التركيز لكنه لا يستطيع، وهي حالة أخرى غير الطفل الذي يميل إلى اللعب، ويشير إلى أنه لا يجب أن نضغط على الطفل ليضاعف من مدة تركيزه خاصة إذا كانت مدة هذا التركيز تتناسب مع سنه.
متفقة مع الرأي السابق تؤكد د. سعدية بهادر أستاذة علم نفس الطفولة بجامعة عين شمس أن هناك نوعين من التركيز هما التركيز الإداري وتحسب مدته بحساب عمر الطفل مضافًا إليه، فلو كان عمره ٥ سنوات يصبح معدل تركيزه 6 دقائق وفي عمر ٦ سنوات يكون التركيز 7 دقائق، وهي المدة التي يستطيع الطفل التركيز فيها بإرادته في أي شيء سواء الاستذكار أو غيره من الأمور، وتزيد مدة التركيز والانتباه بعد هذه السن وكلما زاد ذكاء الطفل كان أكثر استقرارًا وتركيزًا.
وتضيف د. سعدية أنه يجب على الأم أن تفرق بين الطفل الذي يتدلل فقط ليتهرب من المذاكرة والطفل الذي يعاني بالفعل من صعوبات في التعلم، فإذا فشلت جميع المحاولات في جذب انتباهه وكذلك فشل استخدام المعززات الإيجابية في زيادة تركيزه وارتبط ذلك بدلالات أخرى مثل عدم قدرة الطفل على التركيز في اللعبة التي أمامه مثلًا لفترة طويلة أو لم يستجب لنداء الأم بسرعة، بالإضافة إلى الحركة الزائدة، مع عدم قدرته على القيام بعمل له خطوات عدة، وهذه الظواهر تتضح في عمر مبكر، فيجب أن نتجه بالطفل إلى المراكز المتخصصة لتشخيص حالته، ووضع العلاج لها.
وتقول: «إن هذه المراكز تقوم بعمل تنشيط لقدرات الطفل الأخرى بحيث تعوض النقص الذي يعانيه من هذه الاضطرابات سواء عن طريق الأدوية أو البرامج التربوية».
كيف نربي الطفل على حفظ لسانه؟
عندما يبدأ ابنك يتلفظ كلمات نابية محرجة، تنم عن وقاحة وسخرية وبذاءة.. ينشأ لدى الوالدين شعور بالأسف والألم تجاه سلوك الابن غير الواعي بما يخرج من فمه من ألفاظ مزعجة.. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقلید للغير.
لذلك كان لزامًا مراقبة عملية احتكاك الطفل ابتداء بعلاقاته الإنسانية واللغة المتداولة بين من يختلطون بالأسرة عمومًا، وبالطفل خصوصًا، ومراقبة البرامج الإعلامية التي يستمع إليها ويتابعها، والأهم من ذلك اللغة المستعملة من طرف الوالدين تجاه أبنائهما وفيما بينهما.
إن الوقاية من هذه المشكلة تتحقق بما يلي:
عامل الطفل كما تحب أن تعامل وخاطبه باللغة التي تحب أن تخاطب بها.
٢- استعمل اللغة التي تتمنى أن يستعملها أبناءك: من هنا البداية وهكذا يتعلم الطفل، قل: «شكرًا» و «من فضلك»، و «لو سمحت» و«تسمح»، و«أعتذر» يتعلمها ابنك
منك مهم أن تقولها، والأهم كيف تقولها ؟ قلها وأنت مبتسم بكل هدوء وبصوت منسجم مع دلالات الكلمة.
٣- تأكد أن اللفظ فعلًا غير لائق: حتى لا تنجم عن ردة فعلك سلوكيات شاذة وألفاظ أشد وقاحة، تأكد فعلًا أن اللفظ غير لائق، وليس مجرد طريقة التلفظ هي المرفوضة فمثلًا لو نطق بكلام وهو يصيح أو يبكي، أو يعبر عن رفضه ومعارضته كقوله: «ولا أريد» «لماذا تمنعونني» «لماذا أنا بالضبط» هذه كلها كلمات تعبر عن رأي وليس تلفظًا غير لائق، فعملية التقويم تحتاج إلى تحديد هدف التغيير وتوضيحه للطفل هل هو اللفظ أم الأسلوب.
٤- راقب اللغة المتداولة في محيطه الواسع: والآن إذا التقط الطفل فعلًا بعض الألفاظ النابية أو نطق بها .. كيف تساعده على التخلص منها؟:
١- لا تهتم بشكل مثير بهذه الألفاظ: حاول قدر المستطاع عدم تضخيم الأمر، ولا تعطه اهتمامًا أكثر من اللازم، تظاهر بعدم المبالاة حتى لا تعطي للكلمة سلطة وأهمية وسلاحًا يشهره متى أراد سواء بنية اللعب والمرح أو بنية الرد على سلوك أبوي لا يعجبه، وبهذا تنسحب عن الساحة، واللعب بالألفاظ بمفرده ليس ممتعًا إذا لم يجد من يشاركه.
٢- امدح الكلام الجميل: علم ابنك نوع الكلام الذي تحبه وتقدره، ويعجبك سماعه على لسانه أبد إعجابك به كلما سمعته منه، عبر عن ذلك الإعجاب بمثل «يعجبني كلامك هذا الهادئ» هذا جميل منك» «كلامك من ذهب».
٣- علمه فن الكلام: علمه مهارات الحديث وفن الكلام من خلال الأمثلة والتدريب وعلمه الأسلوب اللائق في الرد، ولا يهمني تعبير مقبول لو قيل بهدوء واحترام للسامع وتصبح غير لائقة لو قيلت بسخرية واستهزاء بالمستمع.
٤- حول اللفظ بتعديل بسيط: لو تدخلت بعنف لجعلت ابنك يتمسك باللفظ ويكتشف سلاحًا ضدك أو نقطة ضعف لديك ... ولكن حاول بكل هدوء اللعب على الألفاظ إضافة حرف أو حذفه أو تغيير حرف أو تصحيح اللفظ لدى الطفل موهمًا إياه بأنه أخطأ، فلو كانت مثلًا كلمة «قلعب» غير لائقة فقل له: ولا وإنما تنطق «ملعب» وهكذا.
ما لا ينبغي فعله
1 – الرد بعنف وغضب.
٢- تعليمه كلامًا غير لائق في الصغر, وخصوصًا في مرحلة يكون الهدف لدى الوالدين هو نطق الطفل بالدرجة الأولى، وأن يقول أي شيء.
٣- معاقبته وحرمانه، فالعقاب يعلم الخوف، ولا يعلم الاحترام.
٤- قبول اللفظ أحيانًا ورفضه أحيانًا أخرى.
د. مصطفى أبو سعد
استشاري نفسي وتربوي الكويت
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل