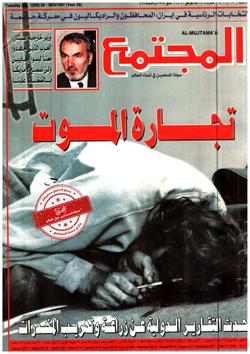العنوان المجتمع التربوي ... العدد 1655
الكاتب أ.د. السيد محمد نوح
تاريخ النشر السبت 11-يونيو-2005
مشاهدات 19
نشر في العدد 1655
نشر في الصفحة 52
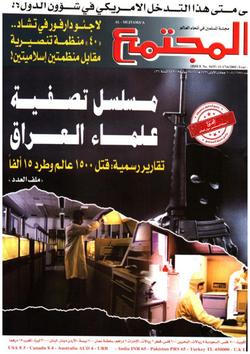
السبت 11-يونيو-2005
آفات على الطريق
ما أكثر الأمراض الأخلاقية والآفات الاجتماعية التي يعاني منها بعض الأفراد والمجتمعات.. حري بنا أن نتوقف عندها ونحذر منها ونقدم علاجًا لها.. وقد اهتم فضيلة الدكتور السيد نوح بهذه القضية، وأصدر فيها أكثر من مؤلف, وهذه المقالات التي بين أيديكم جديدة في موضوعها وطرحها ولم يسبق نشرها.
الخذلان «2 من 2»
الأسباب.. ووسائل العلاج… تناولنا في العدد الماضي معنى الخذلان وصوره وآثاره.. ونتحدث في هذا العدد عن:
أولًا: أسباب الخذلان وبواعثه … للخذلان أسباب تؤدي إليه، وبواعث توقع فيه، نذكر منها:
1- إيثار العافية والسلامة، ذلك أن بعض الناس يرى أن نصرته وعونه لمن هم بحاجة إلى النصرة والعون قد يكلفه كثيرًا من الجهد والوقت والمال، وهو غير مستعد لتحمل هذا، لذا يتراءى له أن يدير ظهره إلى هؤلاء المحتاجين إلى النصرة والعون مؤثرًا العافية والسلامة.
2- البيئة، إذ قد ينشأ المرء في بيئة قريبة -وهي البيت- أو بعيدة -وهي المجتمع-.. شأنها الأثرة، والأنانية، وعدم الاهتمام بإغاثة الملهوف، ونجدة المكروب فيشبُّ على ذلك.
3- نسيان الأجر والثواب، ذلك أن الشرع الحنيف قد أخبر أن هناك أجرًا عظيمًا، وثوابًا جزيلاً لمن يعمل على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وتفريج الكربات. ونسيان ذلك الأجر، وهذا الثواب يجعل المرء لا يحفل بنصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف.
4- خسة الطبع ولؤم النفس، إذ في كل خسة ولؤم، والمطلوب مقاومة هذه الخسة وذلك اللؤم، فإذا لم تتم هذه المقاومة قويت هذه الخسة، ونما ذلك اللؤم حتى يصير جبلة وسلوكًا، بحيث يرى هذا الصنف من الناس المظلومين يثنون، والملهوفين يستغيثون فلا يحرك ذلك فيهم ساكنًا، ولا يدمع لهم قلبًا، ولا تدمع لهم عينًا.
5- الجهل أو نسيان العواقب المترتبة على الخذلان ذلك أن من جهل أو نسي العواقب الضارة، والآثار المهلكة لعمل ما.. أقدم على فعله، ظانًا أن فيه سعادته، ومصلحته، والحقيقة أن فيه حتفه وهلاكه.
6- عدم قيام ولي الأمر بواجبه ذلك أن ولي الأمر من مسؤولياته الحث على نصرة من هم بحاجة إلى العون والنصرة، بل إلزام القادرين بما لديه من إمكانات -على تنفيذ ذلك، وحين يقصر في القيام بهذه المسؤولية... فإنه يفتح الباب أمام الكسالى، والجاهلين والغافلين أن يقعدوا عن نصرة من هم بحاجة إلى النصرة والإعانة.
7- الغفلة عن حقوق الأخوة الإنسانية والإسلامية، ذلك أن لكل إنسان حقوقًا على أخيه الإنسان بمقتضى الإنسانية، وحقوقًا للمسلم على المسلم بمقتضى الإسلام، ومن هذه الحقوق: حُرمة خذلانه، وإسلامه لعدوه، وظلمه وتحقيره، وحين يغفل المرء عن هذه الحقوق وينساها يكون الخذلان وما وراءه مما ذكر آنفًا.
8- خوف المخلوقين ونسيان الخالق، إذ قد يكون السبب في الخذلان هو الخوف من بطش المخلوقين، وأنهم يملكون للمرء ضرًا وشقوة في نفس أو مال أو عرض أو أهل أو عشيرة، في الوقت الذي يأمن فيه جانب الخالق الذي بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله.
9- الأمن من السؤال يوم القيامة، ذلك أن الأمن من ساعة الوقوف غدًا بين يدي الله عز وجل، وسؤاله سبحانه إياك: رأيت الملهوفين والمظلومين والمكروبين، وخذلتهم إلى حد أنك أسلمتهم إلى أعدائهم؟ وقد جاء «من نوقش الحساب عذب[1]». نقول: إن الأمن من هذا السؤال يقود لا محالة إلى خذلان من هم بحاجة إلى العون والنصرة.
ثانيًّا: طريق العلاج بل الوقاية… طريق علاج خذلان الغير بل الوقاية تقتضي إتباع هذه الخطوات:
1. التعريف بالخالق تعريفًا يملك على المرء أقطار نفسه، بحيث يرى هذا المرء ربه: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(آل عمران:26)، ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) ﴾(فاطر:2). فيقدم على نصرة من هم في حاجة إلى النصرة مستعينًا بالله عز وجل الذي يتولى عباده الصالحين، ويؤيد المتقين.
2- التذكير بلحظة الوقوف بين يدي الله عز وجل غدًا، والسؤال عن ترك نصرة المظلومين، وعدم إغاثة الملهوفين، وتفريج كربات المكروبين، وأن من نوقش الحساب عذب، التذكير بذلك كله، فإنه قد يقود مع التقوى والصدق إلى الإسراع بنصرة من هم في حاجة إلى النصرة، وإن كان معها من الشدائد والامتحانات ما معها.
3- دوام النظر في سير النبيين، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يوسف الصديق يرى في رؤية الملك محنة وشدة تنزل بالناس فلا يقول ما قال الملأ: ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾ (يوسف: 44)، بل قال: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ «47» ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ «48» ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ (يوسف: 47-49).
وهذا موسى عليه السلام يجد عند وروده أرض مدين ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) ﴾ «القصص: 23-24». وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تستصرخه امرأة مسلمة اعتدى عليها واحد من يهود بني قينقاع، فيحاصر هؤلاء اليهود حتى يجليهم عن المدينة، وتستصرخه خزاعة حين اعتدت عليها بكر بمعاونة قريش فيجيبها ويكون فتح مكة. إن دوام النظر في سير هؤلاء النبيين سيحمل على الاقتداء والاهتداء بهم: ﴿أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاٰهُمُ ٱقْتَدِهْ...﴾ (الأنعام: 90). وقوله سبحانه: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌۭ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًۭا﴾ (الأحزاب: 21).
4- الوقوف على حقوق الأخوة الإسلامية، ومنها أنه لا يسلمه، ولا يخذله ولا يظلمه، ولا يحقره، فإن الوقوف على هذه الحقوق سيقود الصادقين حتمًا إلى التخلص من كل هذه الأخلاق الذميمة.
5. قيام الأمة بواجبها في مواجهة من يخذلون غيرهم ممن يستحق النصرة ولو بالإنكار القلبي المتمثل في القطيعة، فإن ذلك لو تحقق قد يقود إلى التخلي عن الخذلان، والعمل على الوقوف بجانب الغير نصرة وإعانة.
6. قيام ولي الأمر بواجبه في التحذير من خذلان من يستحقون النصرة بل العمل على تأديبهم وإصلاحهم لئلا يتمادوا في هذا الخذلان على نحو ما صنع النبي ﷺ مع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك من ضرورة مقاطعتهم حتى تاب الله عليهم.
7. إسهام الأسرة في علاج ظاهرة الخذلان لدى أبنائها، أن يقلع الأبوان عن الخلق الذميم، ويعلنوا أن ذلك كان مجافياً للقيم الإنسانية، وأن عليهم ألا يحاكوا الوالدين في ذلك، بل عليهم أن يتحلوا بالشهامة والمروءة، والنجدة وإغاثة الملهوف وتفريج الكربات، ونحو ذلك.
8. دوام النظر في سير المعروفين بخذلان غيرهم وعواقبهم، وخير ما يصور ذلك خذلان أمراء الأندلس بعضهم بعضًا مع الاستعانة بالنصارى في آخر أيامهم على نحو ما صنع بنو عباد، وخلفاؤهم من بني جهور وبني الأفطس ضد خصومهم، الأمر الذي عجل بدولتهم وجعلهم فريسة للنصارى الذين عملوا على ملاحقة المسلمين فيما عرف بمحاكم التفتيش.
9- دوام النظر في سير المعروفين بنصرة غيرهم ومؤازرتهم، هذا المعتصم بالله العباسي تستغيثه امرأة في عمورية: أن روميًّا لطمها طالبة الثأر والإنصاف، ورد مظلمتها لها، فيغزو الروم، وينكؤهم نكاية عظيمة لم يسمع بمثلها أحد، ويشتت جموعهم، ويخرب ديارهم، ويفتح عمورية بالسيف، ويطلب من المرأة أن تلطم النصراني الذي لطمها بمثل ما فعل بها، وهذا مؤمن آل فرعون ينهض لنصرة نبي الله موسى عليه السلام حين ائتمر به الملأ ليقتلوه، وحين ائتمر فرعون بالقتل.
وهذا نور الدين زنكي يصفه الإمام أبو شامة بقوله: «وبلغني من شدة اهتمام نور الدين -يرحمه الله- بأمر المسلمين حين نزول الفرنج على دمياط أنه قُرئ بين يديه جزء حديث له، كان له به رواية، فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يبتسم ليتم السلسلة، على ما عُرف من عادة أهل الحديث، فغضب من ذلك، وقال: إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسمًا، والمسلمون محاصرون بالفرنج[2]. إن دوام النظر في هذه السير يولد في نفس المرء من المروءة والشهامة ما يحمل على التخلي عن خذلان الغير، ويشجعه على نصرة الآخرين وإعانتهم بكل ما يمكن من أساليب النصرة والإغاثة.
10 - تذكر الأجر والثواب الذي ربطه الحق تبارك وتعالى بنصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف على النحو الذي ورد في الأحاديث المذكورة آنفًا.
11- استحضار العواقب المترتبة على خذلان المرء من يستحقون الإعانة والنصرة سواء أكانت فردية أو جماعية، دنيوية وأخروية، فإن ذلك يحمل على جمع الهمة ومضاء العزيمة، والمضي في الطريق إلى نهايتها من نصرة المظلومين وإغاثة الملهوفين وتفريج كرب المكروبين.
12. - معايشة القدوات الحية التي قدمت أرواحها وما تملك نصرة للمخذولين؛ ولعل أصدق تصوير لهذه الخطوة، حال الأمة حين وقعت فريسة بين أنياب الاستعمار خلال القرون الثلاثة الماضية، ومنها أرض الإسلام المباركة الأقصى وما حوله، وتجهيل المستعمر الأمة وإفساد أخلاقها، وتمزيق وحدتها حتى لا تقوم لها قائمة، وكان الأمر عكس ما توقعت الأعداء، إذ ظهرت الحركات الجهادية التي حملت راية الجهاد بأوسع معانيه من بذل أقصى ما في الطاقة والوسع من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، تارة باستحضار النية، وتارة بإشاعة الفقه في الدين والعلم الحياتي، وتارة بالتوسع في العمل الخيري، وتارة بإعانة أسر المجاهدين، وتارة بتجهيز المجاهدين وتارة بالجهاد بالنفس... وهلم جرا.
صحابيات .. أم حرام «شهيدة البحر»
هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنيم بن عدي الأنصارية النجارية المدنية. أخت أم سليم، وخالة أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ، وزوجة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، وأخوها سليم وحرام اللذان شهدا بدرًا، واستشهد يوم بئر معونة، وهو القائل عندما طُعن من خلفه برمح: «فزت ورب الكعبة».
كانت أم حرام رضي الله عنها من علية النساء، أسلمت وبايعت النبي ﷺ وهاجرت، وروت الأحاديث، وحدث عنها أنس بن مالك وغيره. كان رسول الله ﷺ يكرمها ويزورها في بيتها، فقد كانت هي وأختها أم سليم خالتين لرسول الله ﷺ، إما من الرضاع، وإما من النسب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه:« دخل علينا رسول الله ﷺ ما هو إلا أنا، وأمي، وخالتي أم حرام، فقال: قوموا فلأصل بكم، فصلى بنا في غير وقت صلاة».
وكانت أم حرام رضي الله عنها تتمنى أن تكون مع الغزاة المجاهدين الذين يركبون البحر لنشر الدعوة وتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، فاستجاب الله لها وحقق أملها، حيث تزوجت من الصحابي الجليل عبادة بن صامت، وخرجت معه للجهاد في قبرص حيث استشهدت هناك ودُفنت فيها، بعد أن جاز المسلمون البحر. وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعًا. وكان ذلك في سنة ٢٧هـ.
عبد القادر أحمد عبد القادر
الابتلاء الأول: اليتم
شدتني أخبار ابتلائه صلى الله عليه وسلم، وكان لشدة الابتلاءات التي نزلت به دفع شديد, لأتعرف كل بلاء قرأت عنه في القرآن الكريم، أو في سيرته، فوجدته القدوة مثلما هو في جميع أعماله ومكوناته! وأحسبني بهذا البحث قد وقعت على كنز من أثمن كنوز سنته وسيرته! ولقد طالعت بضعة وعشرين ابتلاءً حدث له، وعاناه، فاستحسنت أن أخصها بمتابعة, عسى الله أن ينفع بها الأحبة السائرين في طريق دعوته، وعلى دربه، راجيًّا أن يكون ذلك عونًا للدعاة والمجاهدين، بل للمبتلين. والناس يبتلون حسب دينهم, فمن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء، ثم الأمثل, فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة, ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة». (حسن صحيح, رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي).
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بالتأمل في كلمة ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ التي وردت في سورة البقرة: الآية ١٥٥، وفي سورة محمد: الآية ٣١، وفي كلمة ﴿لَتُبْلَوُنَّ﴾ التي وردت في سورة آل عمران: الآية ١٨٦، نجد الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والاستقبال، ونجد تعدد المؤكدات مع كل فعل «اللام والنون المشددة في الأفعال». هذا التوكيد المتكرر لا يتركنا حيارى أمام هذا الواقع الذي يعيشه المؤمن المبتلى أو الجماعة المبتلاه، ولا نبقى حيارى أمام كثرة الابتلاءات النازلة بعباد الله الصالحين. وقد تحدثت عن ابتلاء العباد الصالحين ها هنا، والموضوع في ابتلاءات سيد المرسلين، كحديث الفرع بعد الأصل.
محمد اليتيم
إن حاجة المولود إلى أبيه لا تخفى على أحد، لا سيما في البيئة العربية, ووفق نظام المراضع اللاتي يحظين بالعطاء الجزيل في مقابل إرضاع المولود, إنه شكل من أشكال العز المبكر الذي يحيط بالمولود, ثم يبقى مع سيرة الولد, فيقال: المسترضع في بني فلان أو بني علان... ويبقى حديث الرضاعة جزءًا من سيرة الرجل، فإذا ما صار للرجل شأن كان ذلك من مفاخر المرضع وقبيلتها!
لا يشعر المولود بهذا الحرمان, ولكن حينما يكبر يتذكر أيامه في المهد على هذه الحال، فغالبًا ما يتأثر، خاصة إذا توالت عليه النوائب... كموت الأم، ثم موت الجد، ثم الوجود التكافلي في بيت العم, رغم حنو هذا العم، ورغم تتابع السنين في بيت عطوف، إلا أننا لا ندري ماذا عانى الطفل محمد مما يعانيه الأطفال في مثل سنه, وفي غير بيته! إن الضعف النفسي والانكسار الوجداني لليتيم، ثم اللطيم «من فقد أبويه»، كان من إرادة الله بهذا المولود, الذي يعده الله لأمر عظيم, على خلاف أحوال المواليد الذين قد يعدون في كنف الآباء ونعيم الأمهات لشؤون دنيوية، بل على خلاف أحوال أنبياء سابقين أعدوا بين آبائهم وأمهاتهم.
روى عدد من كتاب السيرة والمحدثين الثقات أن عبد المطلب أرسل محمدًا ذات مرة في طلب إبل له ضلت, فغاب وقتًا، فحزن عليه جده حزنًا شديدًا، وعندما عاد محمد بالإبل، أقسم عبد المطلب ألا يبعثه في حاجة له أبدًا، ولا يفارقه بعد هذا أبدًا! ولما مات جده، اعتنى به عمه أبو طالب، فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ولا يخرج إلا معه، ويخصه بالطعام، ولا يأكل إلا عندما يحضر, وظل يحوطه بعنايته إلى ما بعد البعثة، حين حاربه قومه جميعًا.
أسأل القارئ: هل يعوض ذلك كله عن عطف الأب وحنان الأم؟
لقد صنع الله للطفل محمد اليتيم شيئًا من عطاء الأبوة والأمومة في قلوب الجد والعم وتوابعهما ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ (الضحى: 6)، ولكن من أعطف من الأب ومن أحن من الأم؟ اللهم إلا أنت, يا خالق العطف, والرب العطوف، ويا خالق الحنان، أنت الذي وصفت نفسك بـ «الحنان». لقد استأذن صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له, فعلام يدل طلب هذه الزيارة؟
روى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم: «أستأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، وأستأذنته أن أزور قبرها، فأذن لي», وعند النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: زار رسول الله ﷺ قبر أمه, فبكى, وأبكى من حوله، وقال: «أستأذنت...... » الحديث, إنه حتى بعد أن غمرته صلى الله عليه وسلم أنوار النبوة، ها هو ذا يعيش لوعة الشوق إلى الأم والتعلق بها, إنها الفطرة السوية وما يتعلق بها من حنين، هذا ما أصابه وبقي في نفسه؛ بسبب فقد حنان الأم حينًا من الدهر في طفولته.
من ثقلت موازينه ولو بحسنة واحدة فاز وأفلح
الصبر وحسن الخلق وبر الوالدين وذكر الله.. من مثقلات الميزان
د. إيمان مغازي الشرقاوي
تجده عادة في المطبخ أو في غرفة الرياضة، أما وجوده في المطبخ فلكي توزن به مقادير الحلوى وبعض الأكلات حيث إن منها ما يحتاج إلى وزن دقيق لتحصل على نتائج طيبة وخاصة عند صنع الحلويات.. ووجوده في مكان الرياضة حتى تزن أجسامنا ونعرف ما إذا كان طولها يتناسب مع وزنها أم لا, وذلك حفاظًا على صحتنا العامة بعد أن عرف الجميع أضرار الوزن الزائد وخطره على الصحة وارتباطه بكثير من الأمراض.
ذكرت كلمة «الميزان» في القرآن الكريم, وفي السنة المطهرة.. وقد أهلك الله تعالى قومًا كانوا يطففون الميزان وينقصون منه، كما أنزل سورة باسم «المطففين»، وافتتحها سبحانه بالويل والوعيد والتهديد لهم، لذا فإن كلمة «ميزان» توحي بالعدل والراحة للمقسطين، وتنذر الظالمين القاسطين بالويل والهلاك, وهي كلمة لا بد أن يقف المرء أمامها طويلًا ولا يمر عليها مرور الغافلين اللاهين.
والميزان التقليدي ذو الكفتين شعار للعدل, لذا فإن صورته تتصدر المنصة في قاعات المحاكم تذكرة للقضاة بالعدل الواجب عليهم, وقد أمر الله تعالى بالقسط فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9), على أن بعض الدول بما أوتيت من قوة وبأس ترجح دائمًا كفة الميزان بما يناسب مصالحها ولو أدى ذلك إلى هلاك غيرها أو ظلمهم فتزن بمكيالين!
حين نتفكر في ذلك الميزان نتذكر قول رسول الله ﷺ: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة» (البخاري: صحيح مسلم)، وقال: اقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (الكهف: 105). وإن كان المرء منا يقف كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر على أرض ميزانه في البيت ليزن جسمه فإنه سيقف على ميزان الحق يوم القيامة: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ (الأنبياء: 47).. وستوزن أعماله, والسعيد من ثقل ميزانه.. فهل مقياس الميزان واحد في الدنيا والآخرة؟ إن بعض الناس يقيسون الآخرين بميزان المال والجاه والمظهر، أما في الآخرة فالميزان مختلف, وقد وضحه رسول الله ﷺ حين ضحك القوم من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، فقال لهم: «والذي نفسي بيده, لهما أثقل في الميزان من جبل أحد».
ودلت السنة على أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، قال تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (المؤمنون: 102- 103). قال القرطبي: قال العلماء: «إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها».
الناس عند الميزان: من ثقلت موازينه ولو بحسنة واحدة فاز وأفلح، ومن خفت موازينه ولو بسيئة واحدة خاب وخسر, ومن تساوت حسناته مع سيئاته فأولئك أصحاب الأعراف على جبل بين الجنة والنار، ثم يتغمدهم الله برحمته.
بم يثقل الميزان؟ يثقل بكل عمل يقربك من الله تعالى: بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, والعمل بمقتضاها، «ولا يثقل مع اسم الله شيء» (الترمذي).
بالحمد: «الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان» (مسلم).
بالتسبيح: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» (البخاري).
بالصبر على موت الولد: «رأيت رجلًا من أمتي قد خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه» (رواه الحافظ الهيثمي).
بحسن الخلق: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» (الترمذي).
البر بالوالدين: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان: 15).
مع الأبناء: «فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم» (متفق عليه).
مع الزوجة: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» (أبو داوود).
مع الناس: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: 90).
مع الأعداء: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ (المائدة: 8).
مع الورثة: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» (متفق عليه).
مع الضعفاء: «وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة»([1]) (أحمد).
مع الأيتام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء: 10).
في البيع والشراء: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).
في الوصية: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» (الترمذي).
مع الحيوان: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» (متفق عليه).
فلببادر بالتوبة والمحاسبة كما قال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا, وتهيؤوا للعرض الأكبر».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل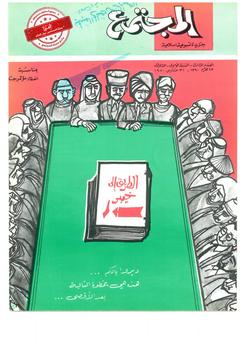

السجل العربي – الإسرائيلي ... هل يُغلق أم أنه لم يُفتح بعد؟ (2من 2)
نشر في العدد 1250
14
الثلاثاء 20-مايو-1997