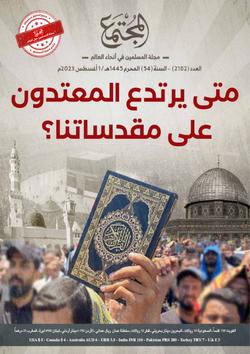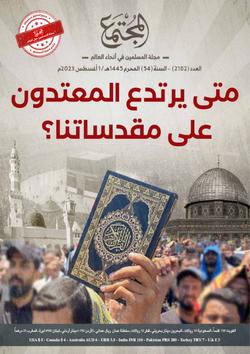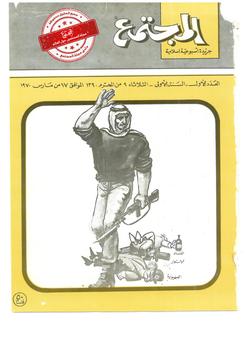العنوان المجتمع التربوي (1628)
الكاتب علاء سعد حسن
تاريخ النشر السبت 27-نوفمبر-2004
مشاهدات 16
نشر في العدد 1628
نشر في الصفحة 54
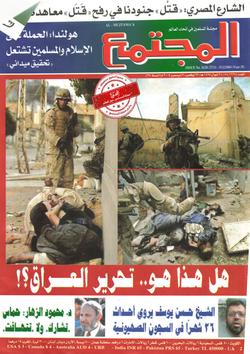
السبت 27-نوفمبر-2004
غزوة أحد مثالًا: أسس المراجعة الذاتية في ضوء القرآن الكريم
المصارحة، التوازن، وعدم التذرع بالأعذار دعائم أساسية لنجاح عملية المراجعة
كان القرآن الكريم دائمًا مع رسول الله ﷺ والجيل الأول من صحابته الكرام -رضي الله عنهم- أجمعين موجهًا ومربيًا، هاديًا ومصوبًا ومعقبًا، وكانت وظيفة القرآن الكريم تتعدى بكثير مجرد إظهار الأحكام الشرعية والقواعد النظرية لدين الله، كان القرآن الكريم يتنزل على بشر بهم ما بالناس من غرائز وأهواء وطموح وأشواق، فإذا به يأخذ بأيديهم خطوة خطوة في تدرج عجيب نحو الربانية السامية، ينقي نفوسهم من النقائص المرة تلو الأخرى، ويزكو بها نحو مدارج العلا.. وكانت الأحداث الجسام تمر على هذا الجيل القرآني الفريد فتنتج فيه فعلًا فريدًا نادرًا، كانت تتيح لهم أن يترجموا التصور النظري إلى واقع عملي ملموس، ويترجموا لنا القرآن الكريم ترجمة حية أو تفسيرًا عمليًا، كما قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تصف رسول الله ﷺ: كان خلقه القرآن، أو كان قرآنًا يمشي على الأرض.
وكانت الأحداث كذلك تتيح للمسلمين الأوائل -رضوان الله عليهم- أن يجتهدوا في حركتهم الدائبة لنشر دين الله تعالى، ثم ينزل القرآن الكريم معقبًا على الأحداث ومعلقًا على التصرفات البشرية المختلفة ومصوبًا ما احتاج منها إلى تصويب، في عمليات مراجعة ذاتية وتقويم مستمر، حتى ارتبط كثير من سور القرآن الكريم بمواقف وأحداث.
ومع هذا المنهج الأصيل، والخط الثابت للقرآن الكريم، نتوقف مع غزوة أحد والتعقيب القرآني عليها في سورة آل عمران.
المنهج القرآني في التقويم والمراجعة
- من ملامح ذلك المنهج افتتاح المراجعة والتقويم بتطييب الخواطر وإيضاح الإيجابيات قبل الخوض في الأخطاء والسلبيات: مع هدهدة النفوس المنكسرة من أثر المحنة المحملة بعبء المصيبة، فلقد هون الله -تبارك وتعالى- المصيبة على نفوس المؤمنين، فذكرهم بأن ما أصابهم من قرح قد أصاب القوم -أي الكفار- قرح مثله، وأن الأيام يداولها الله بين الناس، ثم عدد لهم فضل الله عليهم في هذه المحنة من اتخاذ الشهداء، وتمحيص الصف المؤمن من المنافقين، فيقول -تعالى- في ذلك: ﴿ن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾١٤٠ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ١٤١﴾ (آل عمران: ١٤٠-١٤١).
- عدم التماس المبررات والأعذار: فيرد الله -تبارك تعالى- المصيبة أو القرح إلى الأسباب الداخلية أولًا قبل الأسباب الخارجية على اختلاف أنواعها ومسبباتها، فيقول تعالى: ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أنى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ﴾ (آل عمران: 165)، إن تقديم المبررات والأعذار يعد أقدم الحيل النفسية التي ترفع بها النفس عن كاهلها ثقل موجات اللوم والتأنيب وطرقات النفس اللوامة، وهي الحجاب الساتر الذي يمنعها عن المضي في طريق الإصلاح والتغيير.
- المصارحة بالحقائق: فبينما يحاول كثير من المحللين والكتاب تسمية مصيبة أحد بغير اسمها، فتارة يطلقون عليها نكسة، وتارة يطلقون عليها حربًا سجالًا لما أصاب المشركين فيها في أول الأمر، حياء من ذكر أمر الهزيمة في حق صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، نجد المولى -عز وجل- يسميها مرة قرحًا والقرح هو الجرح الشديد والألم العظيم، وتارة يسميها مصيبة، وفي كلا الوصفين دلالة واضحة على حال المسلمين بعد المعركة دون مجاملة أو مواربة.. وهو في كلا الوصفين يربط بين قرح المسلمين وقرح عدوهم.
- المكاشفة بالعيوب والأخطاء: وأخذ القرآن الكريم يحدد الأخطاء ويجليها في مواقف واضحة محددة، ويحصرها في الفشل والتنازع، ومعصية أمر رسول الله ﷺ، وحب الدنيا ووجودها في قلوب بعضهم، والتولي من الزحف ببعض ما كسبوا من الذنوب، وهذا في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٢).
- المراجعة الإيجابية من أجل التغيير لا لمجرد التقريع السلبي والعتاب الرقيق اللطيف، بل كان الله -تبارك وتعالى- يتلطف بالمؤمنين في كل مقطع من مقاطع الآيات ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ﴾ ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ﴾ ﴿وَاللهُ وَلِيُّهُمَا﴾...
وقد ترفق القرآن الكريم، وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في بدر من آيات، ولا غرو فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر، في المرة الأولى قال: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)﴾(الأنفال: 67-68).
أما في أحد فقال: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٢).
- الإيمان بإمكانية التغيير وعدم تثبيت الصورة السلبية عن أبطال الأحداث، لقد كان كثير من مواقف غزوة أحد جديدًا على الصف المسلم، فهم لأول مرة ينكسرون في المعركة، وهم لأول مرة يعصون أمر رسول الله ﷺ، وهم لأول مرة يشاع بينهم أن الرسول ﷺ قد قتل، فمنهم من ينكص ومنهم من يثبت، ورغم مصارحة المنهج القرآني لهم بكل هذه الأخطاء إلا أننا نلحظ أن القرآن لم يثبت هذه الأخطاء على أبطال الأحداث وكأنها صفات لازمة لا تتغير ولا تتبدل مع الزمن، ولا تمحصها التجارب والخبرات، بل إن المنهج الإسلامي لا يكون صورة نهائية للجندي إذا أخطأ أول مرة، بحيث يتعذر على هذا المخطئ أن يصوب نفسه فيقنط من التغيير والإصلاح.
- الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات وعدم المبالغة والتهويل في جانب على حساب آخر: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٢)، فالمقارنة بين الموقفين: موقف النصر وموقف الهزيمة، موقف الطاعة وموقف المعصية، موقف الوحدة والتماسك والالتحام وموقف التنازع، هذه المقارنة تسجل للمؤمنين ما لهم وما عليهم في غير ظلم أو مجاملة.
- لا ضير من علانية المراجعة دون تشهير، أو سخرية، أو تجريح، أو انتقاص من قدر العاملين: لقد راجع القرآن الكريم المجتمع المؤمن وعالج أخطاء الصفوة من الصحابة رضوان الله عليهم، بل راجع الرسول ﷺ في عدة مواضع ومواقف بصورة علنية صريحة، ولقد كانت هذه الآيات تتنزل على النبي والعدو متربص به والمنافقون في الداخل يتلمسون أسباب الفتنة والفوضى، وكثير من المسلمين هم حديثي عهد بالإسلام، ومع ذلك كان خط المراجعة العلنية خطًا ثابتًا في قرآن يتلى في ذلك الزمن والأزمان التالية إلى قيام الساعة.
الفرح في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
عن أبي سعيد الخدري قال: «دخلت على النبي ﷺ وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حرة بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك، قال: إنا كذلك ويضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر، قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء» (1).
فرح رسول الله بأمن المدينة من شر الدجال اللعين:
عن فاطمة بنت قيس قالت: «صلى رسول الله ﷺ ذات يوم، وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس، فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميمًا الداري (٢) أتاني فأخبرني خبرًا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، إلا أن ابن عم لتميم الداري أخبرني؛ أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوارب السفينة، فخرجوا فيها فإذا هم بشيء أهذب أسود قالوا له: ما أنت؟ قال: أنا الجساسة (۳)، قالوا: أخبرينا، قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئًا ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلًا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم، فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق (٤) شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام، قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب عم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيرًا؛ ناوأه قوم فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع، إلههم واحد ودينهم واحد، قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: خيرًا؛ يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم، قال: فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل عام، قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: تدفق جنباتها من كثرة الماء، قال: فزفر ثلاث زفرات، ثم قال: لو انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضًا إلا وطأتها برجلي هاتين، إلا طيبة ليس لي عليها سبيل، قال النبي ﷺ إلى هذا ينتهي فرحي، هذه طيبة والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة» (٥).
قال السندي: سيعلم أن فرحه كان بسبب أمن المدينة من شر اللعين.
قال رسول الله ﷺ: «اللهم بارك لأهل المدينة» الحديث، وفيه: «إلا أن الملائكة مشتبكة بالملائكة على كل نقب من أنقابها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال»، قال ابن العربي: يجمع بين هذا وبين قوله على كل نقب ملك، إن سيف أحدهما مسلول والآخر بخلافه.
الهوامش
(۱) سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم الحديث: ٤٠٢٤ «١٣٣٤/٢».
(۲) صاحب رسول الله أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة اللخمي الفلسطيني، وفد على النبي سنة تسع، فأسلم «سير أعلام النبلاء» «۲۸۸/۱».
(۳) هي الدابة وسميت بهذا الاسم لأنها تجس الأخبار للدجال.
(٤) الدجال اللعين.
(٥) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم رقم الحديث: ٤٠٧٤ «١٣٥٤/٢».
منهجية الأداء القيادي عند الرسول ﷺ وصاحبيه
توفيق علي
towfeeka@yahoo.com
كان المصطفى ﷺ يترك لقادته حرية الاجتهاد والتصرف في حدود النظام العام للجماعة المسلمة.
حرص رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده على الاستفادة من الطاقات البشرية التي هداها الله -سبحانه وتعالى- للإسلام، وقدمت كل طاقاتها في سبيل الله داخل الصف المؤمن، وكانت على مستوى المطلوب منها من الانضباط والالتزام والطاعة والصبر والإيثار في سبيل الله وإنكار الذات، واستطاعت هذه القاعدة أن تتكيف مع العناصر الجديدة، وتكيفها مع الإسلام من خلال التجارب الرائدة الفذة.
وفي هذا الموضوع نلقي الضوء على منهج النبي ﷺ وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في تربية القادة والتعامل معهم:
أولًا: منهج رسول الله ﷺ في تربية القيادة الجديدة:
تعددت المواقف التي تولى فيها رسول الله ﷺ تربية القادة الجدد على الطاعة والنظام والتواضع إنكار الذات وغيرها من الأخلاق الفاضلة، وهذه بعض المواقف:
- عمرو بن العاص «غزوة ذات السلاسل»:
ذكر الحافظ البيهقي من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من مشارف الشام في بلى وعبد الله ومن يليهم من قضاعة، قال عروة بن الزبير وبنو بلى أخوال العاص بن وائل، فلما سار إلى هناك خاف من كثرة عدوه فبعث إلى رسول الله ﷺ يستمده، فندب رسول الله ﷺ المهاجرين الأولين، فانتدب أبا بكر وعمر في جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، وأمر عليهم رسول الله ﷺ أبا عبيدة بن الجراح قال موسى بن عقبة، فلما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم وأنا أرسلت إلى رسول الله ﷺ أستمده بكم، فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين، فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددته، فلما رأى ذلك أبو عبيدة، وكان رجلًا حسن الخلق لين الشكيمة، قال: تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد إلى رسول الله ﷺ أن قال: إذا قدمت إلى صاحبك فتطاوعا، إنك إن عصيتني لأطيعنك، فسلم أبو عبيدة الإمارة إلى عمرو بن العاص. (٢)
الدروس والعبر:
- دفع النبي ﷺ بعمرو في الإمارة، وهو لم يتجاوز ثلاثة أشهر في محضن الإسلام.
- دفع النبي ﷺ مددًا لعمرو، هم خيرة أهل الأرض وهم: أبوبكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وكيف استطاعوا أن يمتصوا ما حدث من عمرو، ويتنازل أبو عبيدة لأخيه عمرو بالإمارة، وكانت وصية رسول الله ﷺ هاديًا له: «لا تختلفا، تطاوعا» فاستجاب أبو عبيدة على التو، وقال: لئن عصيتني لأطيعنك.
والقيادة الربانية في حاجة إلى هذا المعنى الكبير: لا تختلفا، تطاوعا، فنحن قوامون على دين الله، وإخوة في الله.. ما يضيرني إن كان أخي هو الأمير وأنا الجندي.
- المصلحة المترتبة على الدفع بعمرو، وذلك لإعداد قيادات فذة تستطيع أن تقوم بواجبها داخل الجماعة المسلمة أكبر من المفسدة المتحققة بدفعه وأخطائه، مادام هناك من يمتص هذه الأخطاء ويعالجها ويوجهها الوجهة الصحيحة، وكان هذا هدف رسول الله ﷺ من إرسال ثلة المهاجرين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة والتراضي فيما بينهم على إمرة عمرو.
- خالد بن الوليد:
استطاع خالد بن الوليد -بفضل الله تعالى- إنقاذ جيش المسلمين من مذبحة كبيرة في مؤتة حتى لقب بسيف الله المسلول.
ورغم ذلك كانت هناك بعض الأخطاء له رضي الله عنه، وهذا شأن البشر جميعًا، غير أن القادة تكون أخطاؤهم دائمًا تحت المجهر، وقد تعامل معه رسول الله ﷺ تعامل المربي والمرشد والمعلم، ومن هذه المواقف:
- موقعة بني جذيمة بعثه رسول الله إلى جذيمة داعيًا ولم يبعثه مقاتلًا، ومعه قبائل من العرب فوطئوا بني جذيمة، فلما رآه القوم أخذوا السلاح، قال: ضعوا السلاح، فإن الناس قد أسلموا، فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا، ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله ﷺ رفع يديه إلى السماء، ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد.. ثم دعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم، فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله ﷺ فودي لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال، حتى إذا لم يبق شيء من دم أو مال إلا وداه، وبقيت معه بقية من المال فقال لهم علي -رضوان الله عليه- حين فرغ منهم: هل بقي لكم بقية من دم أومال لم يودكم؟ قالوا: لا، قال فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال؛ احتياطًا لرسول الله ﷺ مما يعلم ولا تعلمون، ففعل ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر: فقال أصبت وأحسنت.
الدروس والعبر:
- إن رسول الله ﷺ لم يغفر لخالد هذا الموقف مع بني جذيمة لأن مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد، ولذلك قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد.
- إن الخطأ الذي أخطأه خالد لم يحرقه، ولم يقض عليه ولم يعزله ولم ينل من كفاءته وطاقته إنما أعلن خطؤه، وسمع التأنيب الضروري، وتلقى الدرس النبوي المناسب، وتابع مهمته في موقعه نفسه في القيادة دون أن يشهر به أو يستغنى عنه، بل طلب رسول الله ﷺ من المسلمين عدم الاسترسال في النقد، وطلب منهم الكف عن الحديث في هذا الأمر وقال: لا تسبوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين(۲).
ولقد بقي خالد -رضي الله عنه- في مركزه وبعد أقل من عشرين يومًا، خاض غزوة حنين وهو بموقفه قائد خيالة المسلمين. (۳)
ونخلص من هذا أن خطأ الفرد سواء كان قائدًا أو جنديًا لا بد أن يعالج المعالجة المناسبة ويحاسب المخطئ على خطئه، ولكن هذا لا يقتضي إسقاطه أو عزله أو التخلي عنه، والجماعة الحكيمة هي التي تحافظ على قيادتها فحسب، بل على أصغر جندي من جنودها، والفرق كبير جدًا بين محاسبة المخطئ في الحدود اللازمة وبين الإجهاز عليه (٤).
ثانيًا: منهج الصديق رضي الله عنه في التعامل مع الولاة والأمراء:
كان من سنته -رضي الله عنه- مع عماله وأمراء عمله أن يترك لهم حرية التصرف كاملة في حدود النظام العام للدولة، مشروطًا بتحقيق العدل كاملًا بين الأفراد والجماعات، فللوالي حق يستمده من سلطان الخلافة في تدبير أمر ولايته دون رجوع في الجزئيات إلى أمر الخليفة (٥).
وكان الفاروق قد أشار على الصديق بأن يكتب إلى خالد رضي الله عنهم جميعًا: ألا تعطي شاة ولا بعيرًا إلا بأمره، فكتب أبوبكر إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك وعملك، فأشار عليه بعزله، ولكن الصديق أقر خالدًا على عمله (٦).
وهذا الإقرار من الصديق لخالد قد شهد به الفاروق، قائلًا: رحم الله أبا بكر، هو كان أعلم بالرجال مني، ويعني أن استمساك أبي بكر بخالد إنما كان على يقين في مقدرة خالد وعبقريته العسكرية التي لا يغني غناءه فيها آحاد الأفذاذ من أبطال الأمم (۷).
منهج الفاروق رضي الله عنه
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرى أنه يجب على الخليفة أن يحدد لأمرائه وولاته سيرهم في حكم ولاياتهم، ويحتم عليهم أن يردوا إليه ما يحدث حتى يكون هو الذي ينظر فيه ثم يأمرهم بأمره وعليهم التنفيذ، لأنه يرى أن الخليفة مسؤول عن عمله وعمل ولاته في الرعية مسؤولية لا يرفعها عنه أنه اجتهد في اختيار الوالي.
وكان يقول: أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم، قال: لا حتى أنظر في عمله، أعمل بما أمرته أم لا؟
ومعلوم أن عمر بن الخطاب عزل خالدًا رضي الله عنهما، خشية أن يفتن المسلمون به ويظنوا أنه سبب النصر.
هذه نماذج ثلاثة عرضتها كمنهج للأداء القيادي، حتى يسترشد القادة في العمل الإسلامي، فنحن مدعوون إلى أن نستن بسنة الحبيب محمد وخلفائه الراشدين وصحبه الكرام.
الهوامش
(١) المنهج الحركي للسيرة النبوية، منير الغضبان ص ١٠٥-١٢٦ نقلًا عن البداية والنهاية لابن كثير ج ٤ / ٢٧٦,٠٢٧٥
(۲) إمتاع الأسماع (٤٠٠/١).
(۳) المنهج الحركي للسيرة، منير الغضبان
(١٥٦/٣) نقلًا عن إمتاع الأسماع (٤٠٥/١).
(٤) المصدر السابق.
(٥) خالد بن الوليد صادق عرجون (۳۲۱)(۳۳۱
(٦) التاريخ الإسلامي (١٤٦/١١).
(۷) المصدر السابق.
«خبيب بن عدي»
أول من سن صلاة الركعتين عند القتل خبيب بن عدي، وقصة هذه الصلاة ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: بعث النبي ﷺ سرية عينًا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت؛ فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي بن هذيل «بنو لحيان» فتبعهم نحو مائة رام، فتقصوا آثارهم حتى وصلوا منزلًا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب، ثم تبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد «اسم مكان»، وجاء القوم فأحاطوا بهم، وقالوا لهم: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلًا، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا مع سبعة نفر بالنبل، وبقي حبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق ونزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم وربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبًا بنو الحارث ابن عامر، وخبيب هو قاتل الحارث يوم بدر، فمكث أسيرًا عندهم حتى أجمعوا قتله، واستعار خبيب موسًا من بعض بنات الحارث لحاجته فأعارته و قالت: غفلت عن صبي لي فدرج إلي خبيب حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني، ورخى يده التي فيها الموسى فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك أن شاء الله، وكانت تقول: ما رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وإنه لموثق في الحديد، وما في مكة يومئذ ثمرة.
وخرجوا من الحرم ليقتلوه فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين، وصلى ثم انصرف إليهم، وقال: لولا أن يروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن الركعتين عند القتل.
رضي الله عنه وأرضاه.
محمد مصطفى ناصيف
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل