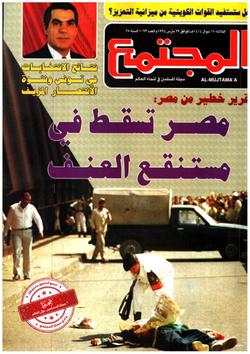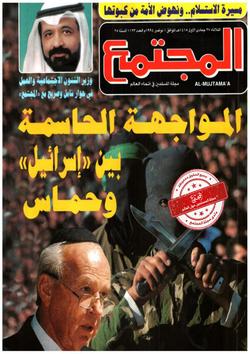العنوان المشكلة الاقتصادية في ضوء «كمنويلث» مالك بن نبي
الكاتب د. حسان عبدالله حسان
تاريخ النشر الأحد 01-يوليو-2018
مشاهدات 69
نشر في العدد 2121
نشر في الصفحة 28
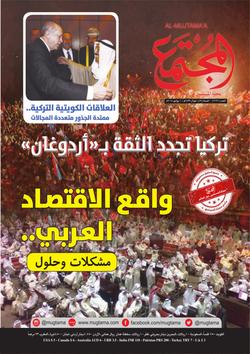
الأحد 01-يوليو-2018
يطرح مالك بن نبي فكرته حول المشكلة الاقتصادية بالعالم الإسلامي في ضوء الظروف العالمية السائدة في هذا الوقت، فإن المشكلة الاقتصادية الإسلامية - العربية وقعت بين القطبين الغربيين الكبيرين الواقعين على متصل النقيض آنذاك (موسكو - واشنطن) فانحصرت المشكلة الاقتصادية في فكرتي «التخلف» و»التنمية»، وهاتان الفكرتان ترتبطان بعنصر المال؛ ففي الماركسية يتحقق الخلاص من التخلف بانتقال رأس المال من طبقة الإقطاعيين إلى العمال، وفي الرأسمالية، فإن التنمية تعني حرية رأسمال وتعاظم الفردية وإحلال المال محل العمل.
تطورت المشكلة الاقتصادية الآن؛ حيث تعتمد بعض الدول العربية على القروض والمعونات الاقتصادية مع تلاشى الطبائع المميزة لها مثل الدول الزراعية أو نصف الصناعية كما كانت في بداية الخمسينيات وما بعدها.
ومن ناحية أخرى، فإن الخطأ الإستراتيجي للفكر الاقتصادي الإسلامي أنه حصر حلول مشكلاته الاقتصادية في هذين الطريقين (الرأسمالي، والاشتراكي)، ووقعت النخبة الاقتصادية بين خيارين بين ليبرالية «آدم سميث»، ومادية «ماركس»، كأنما ليس للمشكلات الاقتصادية سوى الحلول التي يقدمها هذا أو ذاك، دون وقوف وعبرة عند أسباب الفشل، أو نصف النجاح لخطط التنمية التي طبقت على أساس الليبرالية أو المادية في العالم الثالث(1).
وينتقد في الوقت ذاته منهجية التلفيق بين جوهر النظم الاقتصادية الوضعية والتصور الإسلامي، ويرى أن بناء تصور اقتصادي إسلامي لا يمكن أن يقوم على مسألة «التوفيق» أو منهجية التلفيق التي تجمع بين العناصر المؤسسة للاقتصاد الغربي (رأسمالي أو اشتراكي) مع إضفاء مسحة فقهية على هذه المكونات، أما الحل الذي يراه فهو إنتاج طريق ثالث يجب أن يقوم به الاقتصاديون الإسلاميون.
وتبدو المشكلة الاقتصادية في حالتها الإسلامية في جانبين رئيسين، هما(2):
1- الجانب النفسي: ويتمثل في حالة تأثر المسلمين بالغرب في النظر إلى الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تحول المسلمين إلى أدوات عمل تنتج ما يراه الاستعمار؛ «فتحول المسلم إلى قنّ (أي: عبد) يُسخَّر من كل عمل يريده الاستعمار، فينتج المطاط في حقول الهند الصينية، والفول السوداني في أفريقيا الاستوائية، والتوابل والكاكاو في جاوة (إندونيسيا)، والخمور في الشمال الأفريقي.. لقد أجرى على المسلم قانون التقليد كما يجري على كل كائن فقد صلته بعالمه الأصيل فقد أصالته».
2- إشكالية التقليد ونظرية الحاجات: وقع المسلم -أيضاً- في إشكالية التقليد لنظرية «الحاجات» عند الغرب، بعد أن فقد وعيه الحضاري، فيصير في مرحلة أولى مقلداً بقدر استطاعته للحاجة التي أفرزتها حياة غيره، دون أن يفكر في صنع وسيلة إشباعها، ثم في مرحلة ثانية، إذا تحقق استقلال بلاده، يصير إلى تقليد الحاجات الواردة، وتقليد الوسائل المستوردة كيفما اتفق له، ولو على حساب سيادة بلاده.
إن العقبة بالنسبة للعالم الإسلامي ليست في عنصر المال رغم أهميته الاقتصادية، فإنه يأتي في مرحلة تالية للإشكالية النفسية والتربوية الرئيسة للمسلم؛ «إن القضية بالنسبة إلى العالم الإسلامي ليست قضية إمكان مالي، ولكنها قضية تعبئة الطاقات الاجتماعية؛ أي الإنسان والتراب والوقت في مشروع، تحركها إرادة حضارية لا تحجم أمام الصعوبات، ولا يأخذها الغرور في شبه تعالٍ على الوسائل البسيطة التي في حوزتنا الآن، ولا ينتظر العمل بها حفنة من العملة الصعبة، ولا أي مشروع من نوع مارشال»(3).
هذه النظرة الإستراتيجية عند مالك بن نبي بالنسبة للأزمة الاقتصادية أكدتها الظروف الاقتصادية للأمة لاحقاً، حيث توافر عنصر رأس المال ولكن لم تتوافر الإرادة، توافر الغنى ولكن لم يتوافر الاكتفاء الغذائي على سبيل المثال، توافر الدخل القومي المرتفع ولكن لم تتوافر التنمية، وهو ما يثبت التالي فيما يتعلق بحقيقة المشكلة الاقتصادية في عالمنا العربي والإسلامي.
إن معادلة المشكلة الاقتصادية في العالم الإسلامي جوهرها الإنسان الذي يقوم باستغلال التراب في ضوء إرادة جماعية من الشعوب العربية والإسلامية، ومن ثم تصبح المعادلة على الشكل التالي: تهيئة الإنسان + استغلال الموارد المتاحة + تعبئة الطاقات الجماعية.
لذا، لا بد أن يكون هناك تمثيل تربوي في حلول تلك المشكلة؛ لأن الإنسان الذي يمارس هذا العمل المشترك يدرك ما يتحقق على يده في المزرعة أو في المصنع أو في ورش التشييد أنه يستطيع تحويل الجبال ليذوب في مفهومه المستحيل، وتزول من نفسه العقد التي تعطل النشاط المنطلق، ومن فكرة المسلمات الوهمية التي تضع على عمله نوعاً من الرصد يجعله عملاً مشروطاً، أي مقيد بشروط غير طبيعية.
من الضروري الإيمان بالإنسان باعتباره المرتكز لأي نهضة مادية أو معنوية، ولهذا يشغل الجانب التربوي والأخلاقي في أي حلول مقدمة مكان الصدارة؛ «هذا الجانب التربوي الذي يجعل من الإنسان القيمة الاقتصادية الأولى، بوصفه وسيلة تتحقق بها خطة التنمية، ونقطة تلاقٍ تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسة في البرامج المعروضة للإنجاز»(4).
ومن ناحية أخرى، فإن تعبئة أفراد المجتمع نحو عمل مشترك يكون سبيلاً لتكاتف الجهود نحو حل المشكلة الاقتصادية بمعرفة الواجبات نحو المجتمع، وتقديمها على الحقوق في أوقات الأزمات؛ «فالمجتمع ليس مجرد كمية من الأفراد، وإنما هو اشتراط هؤلاء الأفراد في اتجاه واحد، من أجل القيام بوظيفة معينة ذات غاية، كما أن عمل المجتمع ليس مجرد اتفاق عفوي بين الأشخاص والأفكار والأشياء، بل هو تركيب هذه العوالم الاجتماعية الثلاثة، التركيب الذي يحقق معه ناتج هذا التركيب في اتجاهه وفي مداه تغيير وجود الحياة، أو بمعنى أصح تطور هذا المجتمع»(5).
كذلك أيضاً لا بد من تعاظم الجانب الأخلاقي في الحل الاقتصادي –كما هي طبيعة الحياة الاقتصادية في الإسلام- حيث «يرتبط الاقتصاد في الفكرة الإسلامية بالقيم الأخلاقية، هذا الترابط الذي أهملته الرأسمالية في نظرتها الإباحية إلى الاقتصاد، بينما نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا درساً في قضية المتسول، رغم أحقيته بنص من القرآن الكريم في الزكاة في أن يأخذ الزكاة من المجتمع بصفته أحد مصارفها، عندما أشار له النبي أن يحتطب ليأكل من عمل يده»(6).
وبهذا يكون «العمل المشترك» أولاً وقبل كل شيء المدرسة التي تكوّن المسلم الجديد، الذي يستطيع مواجهة كل الظروف الاستثنائية، مثل التخلف؛ لأن مدرسة العمل المشترك تعلمه أن الإرادة إذا حركت الإنسان تجعله يكتشف الإمكان، فالوطن أو المجتمع المسلم الذي يتحول إلى ورشة، سرعان ما يكتشف أن الإمكان الذي ينتظره مما في يد الآخرين لتغيير مصيره هو في يده منذ الآن(7).
إن الإرادة تكشف الإمكان، هذا القانون في المجال الاقتصادي هو في المجال النفسي ما تشير إليه الآية الكريمة: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد: 11)، وما نعبر عنه في المجال الاجتماعي بقولنا: إن الإرادة الحضارية تصنع الإمكان الحضاري.
وهنا تصبح الإرادة قلب الإنقاذ للعالم الإسلامي، الإرادة الذاتية الفردية، والإرادة الجماعية المشتركة، ومتى تكونت لدى العالم الإسلامي هاتان الإرادتان ستتوافر لديه القدرة على التخلص من حالة التخلف الاقتصادي دون الغرق في الرأسمالية أو الماركسية أو صندوق النقد أو المعونات أو القروض الطاحنة للمجتمع والأفراد؛ «إن العالم الإسلامي متى تكونت لديه إرادة واضحة للتخلص من التخلف سيجد أولاً في المجال النظري أن اختياره ليس محدوداً بالرأسمالية ولا بالماركسية، وأنه من ثم يستطيع التعويض للاستثمار المالي المفقود لديه بالاستثمار الاجتماعي»(8).
ومن المسارات المهمة لحل المشكلة الاقتصادية داخل «الكمنويلث» الإسلامي(9) على مستوى الجانب الفني التخصصي، هو توظيف العقول المهاجرة إلى الغرب، ومحاولة طرح خطة لاستعادتها إلى العالم الإسلامي بهدف توظيف هذه الخبرات والكوادر العلمية المتخصصة للإسهام في تقديم حلول فنية في ضوء الأبعاد الثقافية والاجتماعية للبلدان الإسلامية.
إن في استطاعة العالم العربي أن يعيد للتراب وظيفته الاقتصادية بوسائله الموجودة بيده، حتى في الميدان الفني إذا قرر من ناحية أخرى استعادة العقول المغتربة لأسباب مختلفة، منها الأسباب الثقافية التي تتصل بفقدان المسوغات الكفيلة بشد العزائم ورفع الهمم الثقافية إلى مستوى المسؤوليات المنوطة بالعلماء والمثقفين، في نطاق مشروع شامل تتحد فيه الأيدي والعقول والأموال في الرقعة العربية، أو في أكبر جزء ممكن منها بقدر ما تكتمل فيه شروط الاقتصاد التكاملي، حتى تستطيع الدول مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية بتكاتف عقولها وأيديها وأموالها في ورشة عمل مشترك من أجل اقتصاد متحرر لا يخضع لضغط خارجي(10).
ونصل في ختام طرح المشكلة الاقتصادية إلى مجموعة من المتطلبات التي تساهم في حلها في ضوء «الكمنويلث» الإسلامي، التي تتراوح بين الجانب الفني والتربوي والأخلاقي، ومنها:
1- الاعتبار للبعد الاجتماعي؛ فأي مشورة تهدف إلى وضع نظام اقتصادي أو إصلاح نقائصه، ينبغي إذن أن تضع في حسابها العناصر غير الاقتصادية، وبهذا تلتقي مرة أخرى مع أسبقية «عالم الحياة الاجتماعي» على «المهندس الاجتماعي»، وأي تجربة تغفل في بدايتها هذه العلاقات الأساسية لا تكون سوى نظرية مقضي عليها بالفشل.
2- من الضرورات الأساسية لبناء اقتصاد إسلامي التفكير –أيضاً– في الشروط الفنية التي يتطلبها التوفيق بين معادلة إنسانية معنية خاصة بالبلدان المتخلفة والمعادلة الاقتصادية للقرن العشرين.
3- الوعي الاقتصادي، أو تقديم «الواجب على الحق»؛ تنطلق هذه الفكرة من مقولة النبوة: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، فاليد التي تعطي خير من اليد التي تتقبل، عن تحويل التركيز من الحق إلى الواجب ليس بالأمر الذي يأتي عفواً أو بالمصادقة، لأنه تحويل العادات وطبائع منسجمة مع ما في الإنسان من ميل طبيعي إلى منطق السهولة مدعماً من «ديما جوجيا» القرن العشرين التي نصبت من «الأنا» وثناً جديداً يعبده الفرد في المجال السياسي باسم الحرية، وفي المجال الاقتصادي باسم الحقوق(11).
4- مواجهة احتكار الغرب للأسعار التي تناسبه؛ يحدد الغرب الذي يملك الكتلة النقدية الأسعار التي تناسبه، دون النظر إلى من يملك المواد الأولية أو التناسبية بين من يملك المواد الأولية ومن يملك العملة، حيث يقوم الغرب (الاستعمار) بتسعير أسعار السلع التي ينتجها التي يعتمد في إنتاجها على مواد أولية لا يملكها، ولمواجهة هذا الاحتكار يتطلب إنشاء كتلة المادة الأولية في مواجهة الكتلة النقدية، وهو ما في استطاعة البلاد الأفروآسيوية عامة ومن ضمنها البلاد الإسلامية خاصة(12).
إن الإستراتيجية التي يقدمها مالك بن نبي لحل المشكلة الاقتصادية لا تقوم على تكديس المال والأشياء والرغبة في بلوغ الغنى المالي، ولكن تقوم على غنى الإرادة الفردية والرغبة الجماعية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي عبر عملية الإنتاج الحقيقي، مع الانتباه لزيف نظرية «الحاجات» التي لا نهاية لها، التي ظهرت في نزعات الاستهلاك اللامتناهية في المشروع الاقتصادي للعولمة واختراق الإنسان المسلم أيضاً، وهو ما يتطلب تدخل المشروع الأخلاقي والفكرة الأخلاقية والقيم كمرتكز أساس للمشروع الاقتصادي الإسلامي في ظل وحدة حقيقية أو «كمنويلث» إسلامي ينظر إلى تعدد العالم الإسلامي على أنه مصدر غنى وليس مصدراً للاختلاف والتنازع والتطاحن الداخلي.