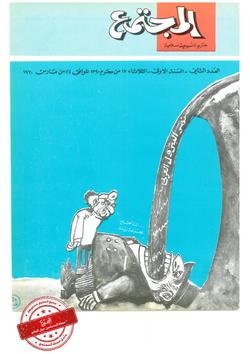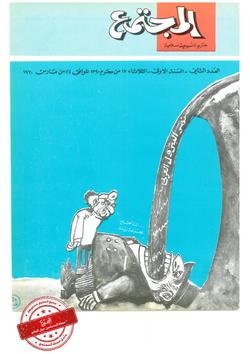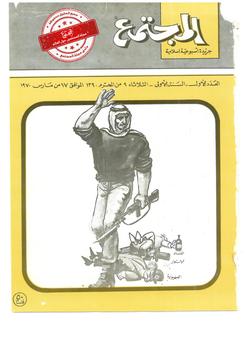العنوان الوقف وفلسفته التنموية في الفكر الإسلامي
الكاتب د. عطية الويشي
تاريخ النشر السبت 01-أكتوبر-2016
مشاهدات 11
نشر في العدد 2100
نشر في الصفحة 15

السبت 01-أكتوبر-2016
الوقف وفلسفته التنموية في الفكر الإسلامي
إذا جاز لنا تعريف التنمية في المنظور الإسلامي بأنها العملية التي تساهم في تحسين معيشة الإنسان وتجويد ظروف حياته، والارتقاء بمستواه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بما يحقق إنسانيته الفاضلة، ويعزز ذاتيته المستخلفة، فإن الوقف يشتبك مع مفهوم التنمية في الوعي الحضاري الإسلامي منذ أن شرع النبي [ في تأسيس الأمة المسلمة وحتى واقعنا المعاصر.
لعل ربط التنمية بمفهوم الوقف سيجعل تركيزنا على مضامين تنموية ذات خصوصية قيمية وأخلاقية منبثقة من ثوابتنا وموروثاتنا الأصيلة، وسيفرض نوعاً من الحماية لمشروعاتنا التنموية من الابتذال والتقزم أو التعطل والتبطل، فالوقف يؤمن استقلالية الفعل التنموي والحضاري الإسلامي في كل حال.
وتشير خلاصات مذهب الجمهور في تعريف الوقف إلى أنه «حبس العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ممتنعة عن جميع التصرفات الناقلة للملكية، وتسبيل منفعتها، بجعلها لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء»(1)؛ وهو ما يعني منع التصرف في أصل العين المحبوسة للانتفاع بها دواماً؛ ومن ثم، فلا يجوز بحقها البيع، أو الرهن، أو الهبة، أو التوريث.. أما منفعتها، فتصرف على غير وجه من وجوه البر والمنافع العامة، وفي إطار محددات شرطية يقررها الواقف نفسه بما يتفق مع الشرع نصاً وروحاً وفهماً وممارسة.
وإن تعريف الوقف ضمن هذه الاعتبارات يتسق مع بنية أي دراسة تتعلق بموضوع التنمية من جميع وجوهها، بناء على أن الوقف تصرف لازم لا يجوز الرجوع عنه، إذ إن الوقف كشعيرة إسلامية متفردة في طبيعتها الخيرية، التي تنتمي إلى القربات، وتبعاً لذلك؛ فإن المال الموقوف يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى عند بعض الفقهاء، أو يبقى على ملك الواقف مع منعه من التصرف فيه بالبيع وغيره، كما عند المالكية؛ فإذا مات الإنسان، لا ينتقل عنه الوقف إلى ورثته وفق آراء أخرى.
وينقسم الوقف تبعاً لأغراضه إلى أنواع ثلاثة:
1- الوقف الخيري؛ وهو ما رصده الواقف لوجه لا ينقطع من وجوه البر، سواء كان على أشخاص، أم كان على صعيد بر عام.
2- الوقف الذري أو الأهلي؛ وهو ما كان ريعه مصروفاً على الواقف نفسه أولاً، ثم على أولاده وذريته والأقربين من بعده، وهكذا إلى حين انقراضهم كلهم، أو حتى جيل معين، ثم يؤول إلى جهة خيرية عامة.
3- الوقف المشترك؛ وهو الحبس الذي حبس على الذرية وعلى جهة من جهات البر في وقت واحد، بمعنى أن الواقف قد جمعها في وقفه، فجعل لذريته نصيباً من العين الموقوفة، وللبر نصيباً محدداً أو مطلقاً في الباقي أو بالعكس.
وتركيزنا في هذا السياق سيكون على ذلك النوع الشائع من الأوقاف، وهو «الوقف الخيري»، الذي رصده الواقف لوجه لا ينقطع من وجوه البر.
ونظام الوقف يختلف بطبيعته عن موارد التكافل الاجتماعي الأخرى من صدقات وزكوات وكفارات ونذور ووصايا ومواريث.. إلخ؛ لأن هذه الموارد في معظمها تمثل علاجات إغاثية استهلاكية آنية موقوتة، وقد يكون نطاقها في كثير من الأحوال فردياً، أما الوقف فهو منذ البدء كان نزوعاً إلى بناء النظام المؤسسي التنموي الإنتاجي دائم النفع والعطاء والتأصيل والتأسيس للعملية التنموية الاجتماعية، لدرجة يمكن معها وصفه بمؤسسة التنمية المستدامة في المجالات جميعاً»(2).
وهذا المفهوم المتسع للوقف، يلتقي مع قول من ذهبوا إلى أن من أبرز ما تستهدفه عملية التنمية: «توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس، والتي من بينها الدخل: تحقيق حياة إنسانية كريمة، يتاح للإنسان اكتساب الصحة والمعرفة، والتمتع بمعيشة كريمة، وتوفر له الحرية السياسية، وتضمن حقوقه، كما تسعى التنمية إلى التركيز على تطوير القدرات البشرية، واستخدام هذه القدرات في الإنتاج»(3).
مفهوم التنمية:
وأصل التنمية من النماء، الذي يعني في ثقافتنا الإسلامية البركة والزيادة، و«النماء: الريع، ونمى الإنسان: سمن، والزرع: التنمية، يقال: زرع الله تعالى الطفل: أي أنبته وأنماه، نمى الخبر: إذا أشاعه(4)، والتنمية المستدامة أو المستمرة هي «التنمية التي تتوافر لها مقومات ناجحة ثابتة تكفل لها الاستدامة والاستمرار»(5).
والتنمية وفقاً لهذه المفاهيم مصطلح معهود في بيئة الفكر الإسلامي منذ قديم، لكنها لم تكتسب شهرته التداولية في العالم إلا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث فرض مصطلح التنمية نفسه كخيار اجتماعي واقتصادي وسياسي من أجل إعادة هيكلة المجتمعات الغربية في إثر سلسلة الحروب المدمرة لبنية كل من المجتمع والدولة في تلك البلدان.
الوقف كإطار تساندي للتنمية:
تبدو علاقات الوقف بالتنمية عبر مجموعة الروابط والتقاطعات الوظيفية؛ فالتنمية تحتاج إلى مدى زمني ممتد عبر مجموعة من المرامي والغايات والأهداف التي تلخصها خطط التنمية بمختلف مساراتها تمددات هذا المدى الزمني، والوقف في هذا السياق يتفرد بخصوصيتي «التأبيد» و«اللزوم»، ومن ثم، يعد إحدى الضمانات المركزية لعناصر الشمول والتكامل والاستدامة التي تمثل عصب أي برامج تنموية على مختلف أصعدة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية وغيرها.
وترمي التنمية إلى تحسين المجتمع وتطويره، والتحول بطاقاته وإمكاناته وقدراته الإنتاجية من حالة الكمون والسكون إلى الحركة الإيجابية الخيرية المنتجة للمعيشة النوعية المتميزة بالبركة والنماء في وفورات الفرد والمجتمع والدولة سواء بسواء.
والتنمية بمختلف أنواعها الشاملة، والمتكاملة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. شريانها الوقف، إذ يرتبط الوقف بالتنمية كذلك من خلال تقاطع الأبعاد الإستراتيجية لكل منهما؛ فالتنمية وفقاً لهذا المفهوم التساندي المشترك مع الوقف تضطلع بعملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعتني بالتطوير الاستخلافي المستند إلى خطط وبرامج ومشاريع بقصد تهيئة المجال الاستخلافي لتمكين الإنسان من تحقيق غايات وجوده.. وهكذا فالوقف هو وقود تلك العملية التنموية التي تتيح للإنسان فرصاً أفضل وأوفر للحياة الطيبة الحرة الكريمة على صعيد الفرد، في حالة الوقف الأهلي، وعلى صعيد المجتمع في حالتي الوقف الخيري والمشترك، والتنمية في المقابل تعبر عن حركة بناء الإنسان بناء يتسق مع غايات وجوده، ويستهدف تمكينه من ممارسة دوره الاستخلافي في عمران الأرض بقيم الحياة الحرة الكريمة.
ومن أبرز التقاطعات الوظيفية المتكاملة بين الوقف والتنمية أن إرادة الواقف تنشأ وفقاً لتقديرات ظروف الموقوف عليهم، ثم يأتي علماء المسلمين ليقرروا مبدأ احترام إرادة الواقفين فيما لا يخل بمصلحة ولا يصادم فطرة ولا يعارض شرعاً، وقد كانت تلك الضمانات الثلاث من أبرز ما وفر للوقف سلاسة التفاعل الإيجابي مع متطلبات المشاريع التنموية وفقاً لحاجات كل عصر.
والأوقاف هي الأداة الناجعة في حالة تراجع دور حكومة الدولة عن النهوض بمسؤولياتها التنموية؛ ومن ثم فالأوقاف من أبرز الوسائل المدنية والأهلية التي يمكن أن تجبر أي قصور يمكن أن ينشأ نتيجة العجز في ميزانية الدولة لأي سبب من الأسباب.
الأهمية التنموية للوقف:
تكمن أهمية الوقف التنموية في كونه يعزز من دور المجتمع المدني في الشراكة بالدولة، وهذا في حد ذاته أمنع من الاستبداد وأدعى إلى تقليص النزعة التسلطية للدولة على حساب المجتمع، وتحقيق نوع من التوازن في مكونات المجال المشترك بين المجتمع والدولة.
- والوقف باعتباره قربى إلى الله، فإن الغالب على حاله الصلاحية المؤبدة لشحن الخطط التنموية والبرامج والمشاريع بمقومات الفاعلية المستمرة.
- كما أن الوقف يرفع كثيراً من الأعباء التي تثقل كاهل الدولة، وتمنحها فرصاً جديدة للحركة الرشيدة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وغيرها.
- وبما أن الوقف يستهدف تمكين الفئات المجتمعية التي قصرت إمكاناتها عن المشاركة في مشاريع التنمية، وتأهيلها للمشاركة؛ فإن هذه الميزة تعيد تصميم بنية المجتمع، وتسهم في ترميم الطبقة الوسطى التي تآكلت في معظم مجتمعاتنا المعاصرة، نتيجة التوحش الرأسمالي الذي لا يزداد معه الغني إلا غنى وطغياناً، أما الفقير فلا يزداد إلا فقراً وقلة حيلة في المشاركة.
- يساهم الوقف في استقلالية الفعل التنموي عن العوز إلى التمويل الأجنبي، والرضوخ إلى الأجندة الاقتصادية الدولية التي لا تنسجم بطبيعتها مع منظومة القيم الحاكمة للنشاط الاستخلافي في المنظور الإسلامي.
وعلى أي حال، ففي نظام الوقف يقترب المجتمع من حالة التوظيف الكامل لطاقاته الحيوية، ومن ثم التنمية التي تقوم على الإنسان المنفق عبر الإنسان الفاعل إلى الإنسان المقصود بالتنمية، وهذا هو المفهوم المركزي الجامع بين الوقف والتنمية في المنظور الإسلامي.
استقلالية الأوقاف كمقوم تنمو رشيد:
تتوافر للأوقاف ميزة الاستقلالية، وهي تعبير عن إحدى أهم السمات القانونية والأخلاقية التي يتميز بها نظـام الوقف، وذلك تأسيساً مع مفهوم الإرادة المنفردة للواقف، وحريته في التكييف الوظيفي للوقف في الإطار العام لمقاصد الشريعة الغراء من ناحية، واستناداً إلى صفة القاضي، باعتباره سلطة قانونية وإدارية مستقلة بالوقف من ناحية أخرى؛ إذ بمجرد إنشائه، يصبح للوقف شخصية معنوية مستقلة، وهذه الخصوصية الاستقلالية للوقف مكنته من ممارسة دور حضاري حيوي ومتطور وفاعل في تحقيق النهضة التنموية الحضارية في المجتمع الإسلامي على امتداد التاريخ، بعيداً عن قيود البيروقراطية والتعقيدات الرسمية»(6).
وتشير رواية البخـاري إلى أحد أهم الثوابت المنهجية لتأسيس الأوقاف، حيث أطلق النبي [ عنان الإدارة الوقفية لما يمكن أن نسميه بـ «نظرية الإدارة المنفردة» أو النمط الفردي/ العائلي؛ فعن نافع عن بن عمر قال: أصاب عمر مرة أرضاً بخيبر، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ فقال رسول الله [: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها»؛ فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ تصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والغزاة في سبيل الله والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وأن يطعم صديقاً غير متمول فيه، وأوصى به إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر(7).
ومن الواضح أن وقف عمر – كما يبدو – كان من نوع الوقف المشترك الذي يشمل الوقف بنوعيه؛ الخيري، والأهلي.
وإذا أمعنا النظر فيما يرفده النص الشريف من رؤية غنية ومنهجية ثرية في أسس البنـاء الإداري للأوقـاف، وماهية الدلالة العظيمة للنص النبوي الشريف، وتنظير عمر (قول الصحـابي) لقضية النظارة أو الولاية على الوقف، ندرك مدى حاجة الأموال الموقوفة إلى من يدير شؤونها ويرعاها، ويحافظ عليها وينميها للإيفاء بالأغراض التنموية الموقوفة لأجلها، حالها في ذلك حال أي مال مملوك لأحد، سواء كان فرداً أو جماعة أو مؤسسة أو دولة، ولكن الذي يفرض إدارة الأوقاف، ويميز شكل ونمط هذه الإدارة عن غيرها من إدارة الأجهزة الأخرى في الدولة هو أن رعاية أحوال الوقف وإدارة شؤونه، فضلاً عن كونها واجباً فردياً مجرداً، فإنها قبل ذلك وبعده واجب ديني محض، والتزام أخلاقي اجتماعي يفرض تقرير الشروط وإنفاذ النصوص وتصريف أمور الوقف حسبما يريد الواقف في إطار المشروع من منهج الله! ومن ثم فإن ذلك لا يكون ولا يتم إلا بولاية إدارية «تقوم على رعاية الوقف وتتعرف إلى مصلحته وتحفظ أماناته وتحقق أهدافه وغاياته، وتعمل على توصيل ريعه إلى مصارفه بالعدل»(8).
الوقف والتنمية في الخبرة الحضارية:
أدى الوقف على امتداد العصور الإسلامية دوراً متميزاً في تفعيل مسارات النهضة الحضارية والتنمية المدنية على صعيدي المجتمع والدولة وعبر مختلف مجالات الحياة، وفي هذا السياق، تعد الممارسة الحضارية المطردة للأوقاف أصدق تعبير عن «سمو النزعة الإنسانية في أفرادها، سمواً يفيض بالخير والبر والرحمة على طبقات المجتمع كافة، بل على كل من يعيش على الأرض من إنسان وحيوان، وبهذا المقياس تخلد حضارات الأمم وبآثارها في هذا السبيل يفاضل بين حضاراتها ومدنياتها»(9).
وعلى الصعيد التاريخي، أثبتت التجربة الحضارية منذ أول وقف تأسس في الإسلام، وحتى يومنا هذا، أن الأوقاف وفقاً للمنصوص النبوي «صدقة جارية» هي الضمانة الوحيدة لجريان برامج التنمية في مسارات الاستدامة والاستمرار بلا معوقات بيروقراطية، ودون ارتهان لميزانيات عمومية ونحو ذلك من معوقات التنمية، ومن خلال علاقة التحدي والاستجابة وتطوراتها بين الوقف ومتطلبات الواقع السياسي والحضاري بمختلف تجلياته، تجاوبت برامج التنمية في مجتمعات الأمة الإسلامية بكافة مكوناتها الدينية والعرقية والطائفية والثقافية والفكرية.
وقد كشف عصر النبوة عن المبادرات الوقفية التي كانت بمثابة مؤشر التأسيس لنهضة حضارية إسلامية عبر مختلف مسارات الحياة.
وتفيدنا الخبرة الإسلامية عن أول وقف في الإسلام، وهو وقف سيدنا عثمان بئر رومة، ذلك الوقف الذي كان بمثابة تأمين موارد المياه لعموم المجتمع، وكسر احتكارها والمتاجرة فيها، كذلك وقف أبي طلحة الأنصاري، الذي وقف بئر «بيرحاء» وكانت طيبة الماء، جعلها «صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تبارك وتعالى»، فقال له النبي [: «حبس الأصل وسبل الثمرة»(10).
وقد توالت أوقاف الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم في سياق فعل تنموي مطرد زماناً ومكاناً، حتى صارت الأوقاف أحد أبرز تجليات الوجود الإسلامي ذات الأثر التنموي على المجتمع ورقيه وازدهاره وتحضره أينما كان من أرض الله.
وقد كان الوقف على الفئات الفقيرة والعاجزة وقليلة الحيلة أحد الدلائل على تفعيل المزيد من الطاقات المعطلة وتمكينها من الحياة الحرة الكريمة وتعزيز دورهم عمليات التنمية، وتشير بعض الدراسات إلى أن مدن مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي، كانت تكتظ بجمهور كبير من الباعة والسقائين والمعدمين، وأشباه المعدمين، ومن يعيشون في ضيق وعسر، فكان الوقف يوفر لهؤلاء الرعاية الاجتماعية، ويخصص لهم نصيباً محدداً من ثروة الأغنياء؛ كما جاء في وثيقة وقف السلطان حسن: «خلاص المسجونين، ووفاء دين المدينين، وفكاك أسرى المسلمين، وتجهيز من لم يؤد فرض الحج لأداء فرضه، وتجهيز الطرحاء من أموات المسلمين، وإطعام الطعام، وتسبيل الماء العذب، والصدقة على الفقراء والمساكين، والأيتام والأرامل، والمنقطعين والعميان، وأرباب العاهات، وذوي الحاجات من أرباب البيوت، وأبناء السبيل، ومداواة المرضى»(11).
ولم يتوقف دور الأوقاف على تمويل عمليات التنمية، بل قدم العلماء المسلمون ضمانات فقهية لحراسة حركة التنمية من مداخلات الفساد والمفسدين، وكانت تلك الضمانات بمثابة مؤشر يعزز بعد الاستمرارية والاستدامة التنموية وتأمين أبعادها الإستراتيجية من التخلخل والاضطراب، فقد عرفت الأمة ما يعرف بأوقاف «مستغرقي الذمة» ابتداء من القرن السابع الهجري، فقد كان للفقهاء موقف ثابت من هذه الأوقاف التي كان يقفها الخلفاء والسلاطين والأمراء من أموال تختلجها شبهات، فقد حدث أن والياً جبا جباية ثم عقد حبساً في ملك اشتراه لأولاد، وكان التساؤل الفقهي المطروح: هل يصح حبسه أم لا؟ فكان جواب الفقهاء مفيداً: إن تبرعات مستغرقي الذمة بالتباعات من حبس على بنيه أو ذوي قرابته أو صدقة عليهم، أو وصية لهم بمال؛ أن ذلك كله مردود غير نافذ ولا ماض(12).
وهكذا، في ظل التجربة الحضارية الإسلامية التي امتدت إلى ثلاثة عشر قرناً ونيف، كان الوقف ومشاريع التنمية بمختلف وجوهها بمثابة مرتكز النهضة الإسلامية عبر هذه العصور، وقد أضفى فقهاء المسلمين على الوقف حماية شرعية وقانونية وأخلاقية، قد أسهمت بشكل كبير في استدامة الفعل التنموي للوقف عبر هذا التاريخ الذي طالما نفخر به، متأملين في إعادة إنتاج الفعل الحضاري الإسلامي من جديد بصورة تصل هذا الماضي العريق بحاضر يكون أكثر إشراقاً بنور حضارة الإسلام العظيم.>
الهوامش
(1) محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971م، ص5، بتصرف.
(2) عمر عبيد حسنة: في مقدمته كتاب أوقاف الرعاية الصحية في المجتمع الإسلامي، سلسلة كتب الأمة، ص17.
(3) إسماعيل إبراهيم الشيخ درة: الاستثمار البشري وأثره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، ص 5.
(4) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 10/6762. لسان العرب: 15/342.
(5) معجم اللغة العربية المعاصرة: 3/2290.
(6) إبراهيم البيومي غانم: الأوقاف والسياسة، دار الشروق، 1419هـ، ص89، بتصرف.
(7) رواه البخاري في الوصايا، حديث 2764.
(8) عبدالملك السيد: إدارة الوقف في الإسلام: ص 205، بتصرف.
(9) مصطفى السباعي: من روائع حضاراتنا: ص 121.
(10) تفسير ابن كثير: 2/73.
(11) محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر: 133 وما بعدها.
(12) المصدر نفسه، جـ6، ص137، 138.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل