العنوان الإسلام بين النظرية والتطبيق
الكاتب محمد حسن بريغش
تاريخ النشر الثلاثاء 03-أغسطس-1976
مشاهدات 47
نشر في العدد 311
نشر في الصفحة 22
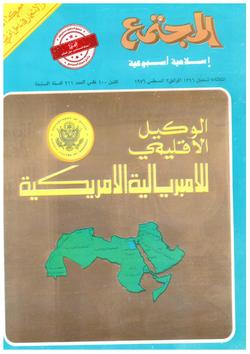
الثلاثاء 03-أغسطس-1976
إن غاية الإسلام الأولى هي إنشاء جيل مسلم متميز عن الناس جميعا، له سمات الإيمان، ويتصف بصفات المسلمين قولا وعملا، ويسلك في الحياة سلوك العبد المؤمن الصالح الذي يعرف أنه مخلوق سيمضي أجلاً في هذه الحياة، ثم يعود إلى ربه- سبحانه وتعالى- فيحاسب وينال جزاء عمله خيرا أو شرا، لذلك يستقيم على الطاعة، ويخشى المعصية، ويحفظ عهد الله في سره وعلنه، ولا يخشى بأساء الحياة، وعقبات الدنيا في سبيل الظفر بموعود الآخرة.
والدعاة إلى الله- عز وجل- في ما يكتبون ويحدثون، أو يدعون ويخطبون يهدفون إلى تحقيق هذه الصورة المشرفة للمسلم المؤمن الصادق فمنهم من يصيب هدفه- ومنهم من يخطئ، وبعضهم يصل إلى غايته وكثير يضلون الطريق، مع توفر النية السليمة، والإخلاص الصحيح، ولكن لنا أن نتساءل عن سبب الخطأ، ومبعث التقصير عن الوصول إلى الغاية، ما دام هناك جهد ودعوة، وإخلاص ودأب، وعلم ومنطق؟ ولعل هناك أسبابا أخرى، لا نود أن نمضي في تعدادها ومناقشتها كلها، وحسبي هنا أن أثير السؤال في أذهان الغيورين على دين الله المخلصين لهذه الدعوة، العاملين لمرضاة الله عز وجل.
وأكتفي بواحد من هذه الأسباب التي أراها، أشرحه وأناقشه مستعينا بالله سبحانه وتعالى، مبتغيا بذلك مرضاته- سائلا إياه أن يرشدني إلى خير القول والعمل.
إن أولى الملاحظات التي نعرفها عن دعوة الإسلام، في صورتها المشرقة يوم أن حملها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى العام، بشرى ونذيرا وهداية ومنهجا، إن هذه الدعوة كانت منهجا متكاملا فاعلا في النفوس والحياة، أنزله الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى ويطبق، وآيات القرآن الكريم هذا لم تنزل دفعة واحدة، لحكمة بالغة، وإنما نزلت منجمة، آيات تلو آيات، وسورة إثر أخرى، بل كانت تنزل على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الآية والآيتان- وربما العشر من الآيات أحيانا.
ولكننا- أيضا- كنا نرى أن هذه الآيات كانت تتوافق مع طبيعة المرحلة وتساير الحياة للمجتمع الوليد بكل ظروفها وشؤونها وتنسجم مع النفس البشرية التي حملت الدعوة، وواجهت الحياة: مرها وحلوها، سلمها وحربها، حزنها وفرحها، هزائمها وانتصاراتها، غضبها واطمئنانها.
وبصورة أخرى فإن هذه الآيات كانت تترسم وقائع الحياة وترسم خطى الدعوة- وتسبر غور النفس، وتراقب نمو المجتمع الجديد، وتتابع إنبعاث الأمة الناشئة حتى ختم الله رسالته وانتصرت دعوة الحق، وجاء نصر الله والفتح، وسبح رسول الله المؤمنون بحمد الله واستغفروه، وكانت نعمة الله كاملة تامة سابغة خالدة، وإعلانه واضحا بينا للناس ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ﴾ الله- سبحانه وتعالى يرعى عباده المؤمنين، ويراقب خطوات الدعوة والدعاة، حتى يرضى عن عباده الذين رضوا عنه وأرضوه، حين اكتمل إيمانهم واستقامت حياتهم لذلك كان ينزل لهم القرآن منجما ليكون مسايرا للوقائع، يضع المعالم واضحة، ويفهمها المسلمون حية مطبقة فلا تنسى، ولا يضل بعدها مؤمن.
وكان ذلك بناء شامخًا سامقًا، دونه كل بناء في هذا العالم وعلى مدى الدهر، ابتدأ بكلمة الوحي الأولى ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (العلق:1-2)
فربط عملية القراءة- وهي عملية إحياء وتربية وبناء- بالخالق عز وجل الرب المهيمن، الموكول إليه وحده أمر الخلق جميعا ومنهم الإنسان، منذ وجود الخلق وإلى مماته، وبعد مماته، وربط بين معنى القراءة بالمعرفة الواضحة للحقائق الإنسانية في الحياة، والتي بها يتفتح وعي الإنسان، ويبدأ طريق الإيمان ليعرف مبدأ الصلة بين الخالق المهيمن المتعهد للخلق سبحانه وتعالى.
والإنسان المخلوق من علق- وهو نطفة مبتذلة- صغيرة مستقذرة ولكنها بإرادة الله خلقت إنسانا سويا سجدت له الملائكة. في انتهاج الحق، ومتابعة الهدى، وهذه الأبعاد هي:
۱ - ارتباط الإنسان بالخالق- في وجوده وحياته وحركاته وعمله ومعرفته وكل شأنه ومصيره.
۲ - معرفة الخالق العظيم المهيمن المنشئ الذي بيده كل شيء.
3 - معرفة مهمة الإنسان بالنظر لمنشأه وارتباطه ذاك ثم انتهى هذا البناء باستجابة المسلمين لهدى الله عز وجل، وتمسكهم بشريعته، بل اكتمل البناء بخلق آخر، لا يقل شأنا عن خلقه الأول عز وجل، إذا كان خلقه الأول للإنسان إحياء من عدم، ومخلوقا من تراب وإنسانا من نطفة، وكان هذا الخلق الجديد:
إسباغا للصفات الإنسانية على هذا المخلوق الترابي، وتكريما له من بين الخلق جميعا، ورفعة له في ملكوت الله سبحانه وتعالى- إذا ما تمسك بالسبب الحيوي للإحياء وهو هدى الله ومنهجه، فاستوى على قدميه خليفة لله في الأرض، أمينا على رسالته، تسجد له الملائكة، وتسخر له السماء والأرض ليعبد الله حق العبادة، وهكذا قام الإنسان يعلن أن لا إله إلا الله منهجا لحياته في الأرض وإقرارا لعبوديته المطلقة لرب العالمين، ويسمو بهذا المنهج حتى يصبح سموه سمة متميزة عن غيره من الذين ضلوا وكفروا واتبعوا الشهوات، واقترفوا المحرمات.
إن هذا الخلق الجديد للإنسان قد أخرجه في صورته المكرمة السوية حتى لا يهبط إلى مستوى الحيوانات والوحوش، بل حتى لا يهبط إلى أدنى من ذلك وأخبث، ما دامت في فطرته نوازع وغرائز قد تتفاقم وتطغى إذا تركت بلا ضبط أو تهذيب حتى تحيل الإنسان إلى قوة غاشمة مهلكة، تضيع معها الحياة، وتفقد الكرامة ويضيع الإنسان.
وكان البعد بين بداية البناء وانتهائه في المقياس الزمني ثلاثا وعشرين سنة من الجهد والصبر والتعب والتضحيات والدماء، كان صبرا أهون منه الموت، وثباتا تهون أمامه الجبال ويقينصا أكثر نصاعة من الشمس- واستعلاء تنحني أمامه الهامات إجلالًا وإكبارًا.
ثم كان تضحية وبذلا لا تدانيه أي تضحية وبذل.
وعند كل حادثة، وبعد كل موقعة، وإثر كل محنة تتنزل آيات: ترسم صورة الخطوات، وتسبر أغوار النفوس، وتكشف خبايا المشاعر والحنايا، وتقوم التصور والنظر، وترشد العاثر وتنبه المتردد، وتقوي العزيمة، وتوضح البواعث والنوايا والأسباب حتى يبقى الطريق واضحا وقويما.
علم المسلمون- وكانوا في علمهم هذا على يقين- بأن الإيمان ليس نطقا بالشهادتين- وأن الإسلام ليس تأدية لشعائر وعبادات فحسب:
﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت:2) ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾. (سورة العصر:1) تلك سنة الحياة، وذلك ناموس الكون.
ولهذا فقد دفعوا- لخطأ في التصور أحياناـ أو خطأ في التطبيق أحيانا أخرى- أو خطأ في فهم مستلزمات الإيمان مرة ثالثة- دفعوا أرواحهم ثمنا، وسقطوا شهداء- ونزفوا دما غاليا، وفقدوا ضحايا أعزاء كرماء، في مواطن عزت عليهم الرجال والأعداد، وبعدها سمعوا آيات القرآن الكريم تكشف لهم عن خلجات النفوس، ووساوس الشيطان، ومداخل الغرور، وبواعث الطمع، ومقاييس الحياة «1»
وعادوا بعدها وهم أكثر يقينا بأن منهج الله هو الطريق وأن وعده الصدق، وأن مرضاته هو الغاية، وأن الآخرة خير من الأولى، وكان دستورهم في ذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الصف:10-11-12-13) أرأيت الطريق، والغاية والنتيجة والثواب؟ فأين بواعث الدنيا الهزيلة من ذلك كله؟
من هذا كله نخلص بنتيجة مهمة، أن الإسلام ليس دعوى تقوم في الأذهان والفكر، وليس نظرية ورأيا وفلسفة تتعاورها العقول، مهما ادعى الناس وكتبوا في ذلك وأطنبوا الإسلام- كما رأيناه في عملية البناء السامقة- تربية وعمل، تربية تأخذ بكيان الإنسان كله: جسده، وفكره، وروحه ونفسه، واهتماماته، وغاياته.
تربية تتعهد الإنسان صغيرا، وشابا وكهلا، في الحياة وبعد الممات.
تربية يستوي فيها الرجل والمرأة سواء بسواء.
وهو عمل وتطبيق وممارسة: في الصغيرة والكبيرة، في السر والعلن في شأن الفرد والجماعة، وفي شئون النفس والمجتمع، وتتصاغر أمامه كل الأقوال والآراء والشروح والتفسيرات وهكذا فهمه المسلمون الأوائل، ولم يفهموه فقها في كتاب، ولا شروحا في مجلدات، ولا آراء وقوانين ونظريات وتفسيرات.
المسلمون الحقيقيون- بناة هذا المجد- فهموا الإسلام كما أنزله الله: عملا وتطبيقا وتربية وبناء عمليا، فهموه من أولى لبناته الثابتة الراسخة ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق:1)وأمن من آمن وهو يعلم أن القراءة هذه معرفة وإدراك ويقين.
والمعرفة موقف، والموقف لا يكون موقفا إلا إذا تمثل برجل يجس ويفكر ويعمل، فيتمثل به الموقف إيمانا، ونموذجا ومنهجا، وشرعا، يتمثل به دينا ليكون بعد هذا كله البناء السامق :: المسلم.
كان هذا الفهم العملي واضحًا بسيطًا لذلك قالت عائشة- رضي الله عنها- عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم «كان خلقه القرآن» وكان هذا الفهم العملي رائعا تمثل: صبرا على الجوع، والأذى وفقدانا للمال والثروة، وعداء من الأهل، وسخرية من الناس، وتسفيها للرأي، ومطاردة من الأقارب واحتمالا للشتم والضرب والتعذيب البالغ، وفقدانا للأمان، وبعدا عن الوطن، و... و..
هكذا فهموه وهم يطبقون إسلامهم أو فهمهم هذا كلمة كلمة، وحرفا حرفا، وآية آية، لأن القراءة كذلك كلمات وحروف، بل حركات يتم منها وبها البناء والمعنى وتنبثق الفكرة، ويشتعل الوجدان.
فهموا ذلك دون تردد- أو تسويف- أو مناقشة.
وانظر إلى صورهم ومواقفهم: موقف أدنى رجل أو امرأة فيهم، موقف صبيانهم، وفتيانهم ونسائهم.
انظر إلى كل حياتهم لن تجد غير هذه الصورة من البناء والالتزام والتميز بلا نظر أو تردد، لأن الإسلام حياة تمارس، ومنهجا يطبق قبل أن يكون فكرا ورأيا ونظرية.
لن ننتقي أي مثال، ففي كل أحوالهم- تلك- شواهد، ترى فيها كيف كان الفهم: تربية عملية، تطبيقا مخلصا، عملا قويما يرتبط في الحياة، لأن إيمانهم بالله كان إيمان من عرف العلاقة القائمة في الحياة بين الخالق العظيم والمخلوقات الضعيفة، وكان إيمان من يعرف المصير حين سيقف الإنسان بين يدي ربه- عز وجل- ليناقش الحساب ويسأل عن كل ما اقترفت يداه، أين نحن من فهم الصحابة للإسلام؟ ما أبعد الفرق، وما أعجب الصورة!
نتعاجب بأفهامنا، ونتفاخر بشروحنا ونظراتنا الجديدة التي نستخرجها من إسلامنا، ونزداد عزورا بعلومنا، ثم نناقش الناس: إن إسلامنا- هذاـ قد سبق العالم في تحقيق العدل والمساواة، الحرية وحفظ الحقوق الرجل والمرأة على السواء... و.. و..
نكتب ونذيع عن عناية الإسلام بالعلم، واهتمامه بالروح والمادة، وتربيته للفرد والجماعة، ونعدد المآثر التي تركها لنا الأجداد، في كذا وكذا..
وبالاختصار: نغرق في الكلام والثرثرة والغرور، حتى يدخل الشيطان إلى نفوسنا، وينضخ في أدمغتنا أدواء العجب والتفاخر وحب الظهور، ويزين لنا أعمالنا، وينسينا كثيرا من واجباتنا، نغرق في الفكر، ونحيل الإسلام «العمل والتطبيق والجهد والإنشاء والتضحية والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد و.. التربية للمسلم».
نحيل ذلك إلى كلام يقال في محفل يصفق فيه المعجبون، أو على صفحات تسيل منها قطرات العسل!
وكم نشاهد من أناس أكلت حياتهم ديدان البحوث والتخصصات حتى أمضوا العمر كله سعيا وراء ألقاب دون أن يتركوا للمسلمين بعدهم عملا أو تطبيقا أو نموذجا يحتزى؟
وكم نرى من أناس أضحى الإسلام عندهم درسا، ونظريات ومقالات «وتفتيقات» وتحليلات ومقارنات واستنباطات حتى ضاعوا في اليم وأضاعوا الساعين إلى معرفة الإسلام، ثم سخروا من ذلك- الغريب المسكين «۱» الذي لم يأبه بهذا كله- بل راح يبحث عن آية يطبقها، أو حديث يعمل به، أو سيئة يتجنبها- أو خير يسعى إليه- أو رجل يدخل إلى قلبه حلاوة الإيمان!
وكم نرى أيضا من صور شوهاء ممسوخة لنماذج من هؤلاء الذين تتباعد الصورة بين ما يعرفون ويقولون، وبين ما يعملون ويطبقون، وكثيرا ما نفتقد أي ظل للإسلام في سلوكهم وأعمالهم الواقعية.
صور قائمة فينا، إذ تحول الإسلام إلى فكر ونظرية، بعد مكائد الأعداء الذين أغاروا عليه، وأثاروا حوله شبهات وادعوا له نقائص ومطاعن، ولهم من وراء ذلك غاية أبعد ومكيدة أدهى، إنهم يريدون جر المسلمين إلى النقاش وإشغالهم في الأبحاث النظرية التي لا فائدة منها للمسلمين فهي لا تهدي ضالا، ولا تطمئن حائرا، بل توقع النخبة منهم بحالة من الفوضى في تفكيرهم، فيندفعون تحت شعور النقص للدفاع عن الإسلام، ورد المفتريات ويكون الأعداء قد نجحوا في استلاب قوة الزمن منا، وإضلالنا عن الهدف وإذا تحول الإسلام إلى فكر ونظريات أو إلى فلسفة وتشريعات فقد غدا سطورا باردة لا يثير حسًا ولا يحرك إنسًا، وإذا تحول الإسلام إلى فكر بحت، فقد أصبح صنمًا لا يقوم إعوجاجًا، ولا يصلح حياة ولا ينشئ أمة «2».
ولا يقولن أحد إن في هذا القول مذمة للإسلام، وإجحافا بحق المسلمين، إذ تسلخ عن الإسلام صفة السداد في الرأي والقوة في الفكر.
لا، لست أقصد هذا، ولكنني أقصد تخليص الإسلام من العميات الذهنية الباردة، وتخليص المسلمين من آثار التفكير النظري، وتحرير الإرادة للعمل والتطبيق، قبل الاستنباط والتفتيق.
والأهم من هذا أنني أود التأكيد على رسالة الإسلام في تربية الكيان البشري كله، ومنهجه العملي في صياغة المسلم الذي يغدو قرآنًا يتكلم ويتحرك ويمارس شتی نشاطات الحياة.
ألم يتنبه أعداء الإسلام إلى هذه الحقيقة؟
ألم يأخذوا فلذات أكبادنا باسم العلم، والثقافة، والتقدمية وهم في بواكير العمر، براعم لم تتفتح، حتى سقوهم سم الإلحاد وصيروهم شبابًا جاهلين، يحملون عقائد الملحدين؟
ألم يضعوا البرامج والخطط، لتربية جيل جديد يؤمن بعقيدتهم- ويمارسها تطبيقًا عمليًا في إطار من الحياة والنشاطات المختلفة تحت أسماء وأسماء وأسماء؟ ألم يعملوا على وضع المراحل العملية لتنفيذ برامجهم حتى يبتعدوا بالجيل الناشئ عن الإسلام، لا بالرأي والفكر، وإنما التطبيق والممارسة، وبمعسكرات ونشاطات متنوعة وباستغلال المواهب والطاقات، وإيجاد المناخات التي تلائم مراحل العمر؟
نعم هكذا يفعل أعداء الإسلام لأنهم رأوا الإسلام نجح يوم أن ربي الأجيال على الإيمان، ونشأهم على الإسلام ممارسة وتطبيقا، فكانوا جيلًا إسلاميًا مؤمنًا، يعيش القرآن فكرًا وسلوكًا، ويقف أمام دعوات الضلال راسخ الإيمان، مطمئن النفس، مليئا بالثقة.
واليوم تنقلب الآية، فيعمد أعداء الإسلام لهذا ونحن ننظر ماذا يصنع بأكبادنا، دون أن يهتز لنا قلب أو فكر أو عاطفة؟ عجبًا كيف نسلم بهذا ونرضى بأن يكون أطفالنا عرضة لمخطط الفساد والإلحاد، وهم عجينة سهلة التشكيل، هينة التحويل في يد هؤلاء حتى يصبحوا أعداء لنا وللإسلام معا، فنبكي بعدها الأيام وسوءات الزمان.
هل كنا أوفياء أمناء على أطفالنا؟
هل نظرنا إلى مستقبلهم بمقياس الجنة والنار، وبمقياس مرضاة الله وغضبه؟
هل وقفنا من أنفسنا موقف الحساب أمام الله يوم يسأل كل راع عن رعيته؟
اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد، ونعوذ بك من الغفلة والضلالة، فلنعد إلى الإسلام عملًا وتطبيقًا وتربية، ولنبحث عن الإسلام تطبيقًا وممارسة ومناهج للتربية من أنفسنا وأهلينا وأبنائنا ومجتمعنا.
ولنضع ميزان الله في حسابنا، ولنضرب ميزان آخر مهما كان براقًا مغريًا.
فالمال، والعلم، والجاه، والمكانة كلها صغيرة صغيرة في ميزان الله إذا كذبت أعمالنا ما نقول.
وكلها ستأتي مع الإيمان إذا صدقنا الله في إيماننا وأعمالنا والله شاهد وسميع، وهو العلي الكبير.
۱۳ رمضان ۱۳۹۵
1975-9-18
۱ - اقرأ عن غزوة بدر وأحد والخندق وخيبر وتبوك وحنين.. وانظر للآيات التي نزلت بعدها.
2- طوبى للغرباء- واحشرني بين المساكين.. من أحاديث رسول الله- صلي الله عليه وسلم.
3-إن هذا لا يغض من قيمة أي بحث، أو عمل باحث مخلص، وإنما يعني ذلك ترتيب الأولويات والاهتمام بالأمر المناسب لإنشاء مجتمع مسلم في وجه المحاولات التي تريد إغراق المسلمين بلافتات وأبحاث ونظريات، وتقريب الإسلام من النظم المعاصرة تحت أسماء مختلفة كالمعاصرة وملائمة الظروف وغير ذلك، أو الهروب من تكاليف الإسلام وضريبة الإيمان.



