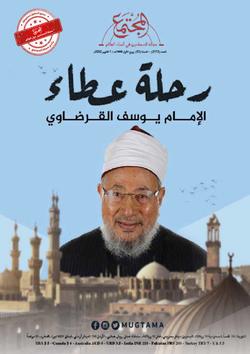العنوان تحدي العصر: بتر الذات الحضارية وضرب الجماعة الوطنية سبل وآليات المواجهة.
الكاتب شيرين حامد فهمي
تاريخ النشر السبت 12-يناير-2008
مشاهدات 3
نشر في العدد 1784
نشر في الصفحة 36

السبت 12-يناير-2008
لا إصلاح دون جماعة وطنية واحدة، ولا جماعة وطنية واحدة دون رسالة حضارية واضحة، ولا رسالة حضارية واضحة دون وعي عميق بالذات الحضارية.
التفكير والعمل بمقاصد الشريعة الإسلامية يعد إحياء لذاتنا الحضارية العربية الإسلامية، وإعادة وعينا بها والاجتهاد بالمقاصد يجب ألا يكون قاصرًا فقط على العلماء.
نحن بحاجة إلى الثقة في قدراتنا على إيجاد حلول مبدعة مستوحاة من داخل بيئتنا بمعزل عن الغرب.
لكل حضارة محور تدور في فلكه، ومحور الحضارة الإسلامية هو القرآن، ومن المستحيل أن نبني ذاتنا الحضارية دون الدوران حوله.
يتسم عصر ما بعد الحرب الباردة بتجليات ثقافية، جعلت من الثقافة محورًا أساسيًا في التنظير والممارسة سواء، فمجتمع العولمة -الذي أفرزه هذا العصر- يرتكز أساسًا على الثقافة وسياسة الهويات أو (Identity Politics) وهي إحدى الإفرازات الأخرى لهذا العصر تدور حول الثقافة، هذا فضلًا عن حروب الأفكار التي أطلقتها الإدارة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱م؛ والتي تتمثل في تغيير الثقافة الإسلامية على المدى البعيد كخطوة مهمة في ظل الحرب الأمريكية على الإرهاب، لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية والعقوبات الاقتصادية.
إن عصر ما بعد الحرب الباردة يتسم بتحالف العنصرين الاقتصادي والثقافي، ومن خلفهما العنصر السياسي الذي يدعم العنصر الاقتصادي من ناحية، ويُطوع العنصر الثقافي لخدمة الاقتصادي من ناحية أخرى، وهو ما يمثل خطرًا جسيمًا على الثقافة التي صارت طوعًا لرجال المال والسلطة؛ والتي باتت تُوظف من قبلهما لخدمة الأغراض السياسية السلطوية والحسابات الاقتصادية الضيقة، بدلًا من أن توظف لخدمة الشعوب ونهضة الأمم.
والعجيب كل العجب أنه في ظل انشغال العالم بالشأن الثقافي، ووضعه على قمة أولوياته، ينحسر لدينا -نحن العرب- هذا الشأن، بل يضمحل حتى صار مهمشًا إن لم يكن منعدمًا، وأكبر دليل على ذلك تولي التكنوقراط القيادات في البلدان العربية، وهم من ليس لهم أدنى علاقة بالشؤون الثقافية والحضارية، ودليل آخر يتمثل في خلو المنظومتين، التعليمية والإعلامية من كل ما يُعرف الفرد العربي بذاته الحضارية، وانتمائه الحضاري على الرغم من كون هاتين المنظومتين معنيتين بالأساس بذلك الأمر.
والخطر كل الخطر أن يبقى ذلك التهميش الثقافي سائدًا في بلداننا العربية فتكون النتيجة هي القبول بما يملى علينا من الخارج من ثقافات وحضارات، وكأننا أمة دون رصيد حضاري أو ثقافي أخطر من ذلك، أن تفضي خسارتنا في معركة الحضارة إلى خسارة رسالتنا الحضارية، ومن ثم عجزنا عن تحقيق وحدتنا الوطنية التي هي السبيل للإصلاح والترقي.
بكلمة أخرى: لا إصلاح دون جماعة وطنية واحدة، ولا جماعة وطنية واحدة دون رسالة حضارية واضحة، ولا رسالة حضارية واضحة دون وعي عميق بالذات الحضارية؛ ومن ثم نجد مناهضي الإصلاح -سواء كانوا من الداخل أو من الخارج- يتربصون لبتر الوعي بالذات الحضارية من ناحية، وضرب الجماعة الوطنية من ناحية أخرى، والسؤال الذي يحاول المقال الإجابة عنه هو:
كيف يتسنى لدعاة الإصلاح قطع الطريق على أولئك المتربصين، حتى تتحقق المعافاة لذاتنا الحضارية وجماعتنا الوطنية؟
إنهاء توظيف الثقافة:
من تجليات عصر ما بعد الحرب الباردة توظيف الثقافة لصالح السياسة، وهو ما تشير إليه د. نادية محمود مصطفى -أستاذ العلاقات الدولية ومدير برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- في أدبياتها عمومًا، التي كان من أهمها دراستها الصادرة عن مركز الحضارة للدراسات السياسية في عام ٢٠٠٠ - ۲۰۰۱م، تحت عنوان: "التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم الإسلامي بروز الأبعاد الحضارية الثقافية".
وهي تصف وتحلل تلك التجليات التي يتم فيها استخدام وتوظيف الذات الحضارية العربية الإسلامية من قبل الخارج، لتحقيق مآربه ومصالحه السياسية، بل والاقتصادية أيضًا، ومن ضمن تلك "التوظيفات" مثلًا، تذكر أستاذ العلاقات الدولية حالة حقوق الإنسان التي شهدت زخمًا واضحًا بعد الحرب الباردة كذريعة للتدخل السياسي في الدول العربية، وضرب ذاتها الحضارية وجماعاتها الوطنية معًا، ولعل مصر والسودان والعراق من أكثر الدول التي تخضع لمثل ذلك التوظيف حيث يتم افتعال أزمة الهوية ليل نهار تحت لافتة حقوق الإنسان الأمريكية، مما يفضي إلى تفتيت الجماعة الوطنية، وتعطيل نهضة وإصلاح البلاد.
ومن ثم فإنه لا سبيل ولا فكاك من هذا "الفخ" إلا بتخليص الثقافة لدينا من التوظيف السياسي، سواء كان هذا التوظيف من الداخل أو الخارج.
بمعنى آخر: لا بد من العمل على إخراج أزمة هويتنا -التي افتعلها الخارج- من التوظيف السياسي، لا بد من فك هذا الالتباس، من أجل إفساح الطريق والوقت والجهد لإعادة الوعي بذاتنا الحضارية العربية الإسلامية، ولم شمل جماعاتنا الوطنية، وإلا سنكون عرضة للوقوع في هوية السوق، كما يحذر د. رفيق حبيب الخبير المصري في قضايا المواطنة.
بناء استراتيجية المواجهة مقاصديًا:
في ظل التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم يتعين على دعاة إنهاض تلك الأمة بناء استراتيجية للمواجهة، ومن أكثر ممن تحدث عن تلك الاستراتيجية د. سيف الدين عبد الفتاح أستاذ النظرية السياسية، ونائب مدير برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويُعتبر تناوله لتلك الاستراتيجية ذا طابع خاص ومميز؛ إذ يجعل من مقاصد الشريعة في الإسلام (حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال) إطارًا للفعل الحضاري، ووسيلة ومنهجًا لبناء استراتيجية المواجهة فيكون الاجتهاد بالمقاصد وللمقاصد.
إن بناء استراتيجيات المواجهة والإصلاح من داخل منهجية المقاصد يمثل الاستجابة الحقيقية لتحديات الأمة كما يوضح أستاذ النظرية السياسية، إنها الاستجابة الحقيقية البنائية، على عكس الاستجابات الانفعالية والاغفالية والافتعالية، فتلك الاستجابات الثلاث الأخيرة لا تسمن ولا تغني؛ فهي إما استجابات مزاجية الفعالية سرعان ما تخبو، أو استجابات اغفالية تلهي عن وجود التحديات، أو تهون من قدرها أو استجابات افتعالية تلتف حول التحدي لتصنع رضًا كاذبًا.
ولكي تُبنى تلك الاستراتيجية مقاصديًا يجب مراعاة ثمانية أمور يراها منظر الاستراتيجية دليلًا ومؤشرًا على مصداقية من ينفذها، ومصداقية عمله لحساب الأمة لا لحساب شخصه، وهي:
1- دراسة المجالات.
2- تحديد الأولويات.
3- تحديد الموازين والموازنات.
4- تحديد أدوات الحفظ والنماء والبقاء.
5- التعرف على فقه الواقع والحادثات.
6- إدراك المناطات.
7- تحديد المآلات.
8- تحديد الوسائل والآليات.
وبوجه عام فإن التفكير والعمل بمقاصد الشريعة الإسلامية بعد إحياء لذاتنا الحضارية العربية الإسلامية وإعادة وعينا بها، كما أن الاجتهاد بالمقاصد يجب ألا يكون قاصرًا فقط على العلماء، بل يجب مده ليصير مسلكًا لعموم الأمة أيضًا، وهو الأمر الذي دعت إليه د. هبة رءوف عزت -أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة- وذلك من خلال محاضرتها تحت عنوان: «عولمة الأمكنة والتداخل في الأزمنة» التي ألقتها من ضمن محاضرات الدورة الثالثة للتثقيف الحضاري (سبتمبر ٢٠٠٧م)، التي يعقدها "برنامج الدراسات الحضارية والحوارات الثقافية" سنويًا، على مدى ثلاث سنوات، فدعت إلى أن تكون المقاصد هم الناس لا العلماء فقط، وأن تكون المقاصد مهارة من أبرز ما نادت إليه، فالتفكير والعمل بالمقاصد سيسهم في تبصير عموم الأمة، وفي جعلهم أكثر عقلًا وحكمة وتمييزًا، وهو أشد ما تحتاجه الأمة في عالم اليوم، ذلك العالم الذي تتداخل فيه الأمكنة والأزمنة، وهو العالم الذي يستلزم عقلًا لفك تلك التداخلات الملتبسة، أو تلك "الشفرة" على حد قولها.
فتح خزائن التراث:
لن يستطيع الإنسان العربي بناء ذاته الحضارية ووعيه الجماعي إلا بفتحه لخزائن تراثه العامر بكنوز حضارته الإسلامية، والتي للأسف يتغافل عنها كاتبو التاريخ، فتاريخنا الاجتماعي الحضاري يتم حذفه عنوةً من كتب التاريخ في عالمنا العربي، ولا يظهر أمام الطالب العربي سوى تاريخ الحكام العرب.
ولكن تاريخ حضارتنا الإسلامية لم يكن تاريخ حكام فقط، كما يؤكد المؤرخ المصري، د. قاسم عبده قاسم، بل هو تاريخ زاخر بالأبعاد الاجتماعية والحضارية التي أفسحت المجال للآخر، وجودًا ومشاركة، في ظل أطول حضارة في التاريخ الإنساني، ولعل عدم أحادية تلك الحضارة كان سر بقائها طيلة ثلاثة عشر قرنًا.
إن إزالة التراب عن تاريخنا الاجتماعي والحضاري سيمكن الإنسان العربي من معرفة قيم حضارته الإسلامية، وأهمها قيمة العيش المشترك التي زخرت بها تلك الحضارة، لا قيم الإرهاب والعنف كما يُروج اليوم، سيمكنه من إدراك تاريخه الحضاري بكل ما فيه من تحضر داع إلى التعددية والاختلاف في إطار الجماعية التي تحقق النفع المشترك، سيمكنه من إعادة بنيته الفكرية، ومن ثم إعادة قدرته على وزن الأمور.
التصدي للظاهرة القطرية:
كان للظاهرة القطرية -التي جلبها الاحتلالات البريطاني والفرنسي إلى المنطقة العربية في القرن العشرين- أثر مدمر على بنية الجماعة الوطنية السياسية في المنطقة، فقد أفضى اتفاق "سايكس– بيكو" و"وعد بلفور" في النصف الأول من القرن العشرين إلى تقسيم وتقطيع المنطقة إلى أقاليم أو أقطار موزعة بين القوتين البريطانية والفرنسية، ولم تأت حركات الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين إلا تابعة لتلك التقسيمات التي قسمها البريطانيون والفرنسيون؛ تلك التقسيمات التعسفية التي لم تراع التكوينات الشعبية والجماعية والعرقية والدينية الموجودة في المنطقة، وإنما راعت فقط المصالح البريطانية والفرنسية بلغة أخرى، لقد تم الاستقلال بناءً على تلك التقسيمات التي لم يكن للشعوب فيها آية كلمة أو قرار.
ومن المفترض -كما يؤكد المؤرخ والمستشار طارق البشري في أدبياته- أن يكون الشعب هو العنصر الأساسي والمكون الأصلي في عملية بناء الدولة، وأن يكون الإقليم والحكومة العنصرين المساعدين، ومن المفترض أيضًا أن تكون الحكومة عاكسة لإرادة الجماعة السياسية الوطنية التي تمثل الشعب والصالح العام، إلا أن تقسيم المنطقة العربية بدد تلك الافتراضات جميعًا، وسواها أرضًا، بل عكس الموازين وقلبها رأسًا على عقب، فلم يعد الشعب هو الأساس، بل صار الإقليم وحكومة الاستقلال (التابعة لقوى الاحتلال) هما الأساس الذي يحدد قيام الدولة.
لقد هيمنت الظاهرة القطرية على الدولة العربية والجماعة السياسية، فكانت النتيجة هي بتر الجماعة السياسية الوطنية، وزرع جهاز حكومي منفصل كل الانفصال عن تلك الجماعة السياسية المبتورة، ومن ثم كانت نشأة الدول العربية "المستقلة" مشوهة، فهي لم توظف لخدمة الجماعة السياسية الوطنية كما ينبغي، وإنما وظفت لخدمة المصالح الغربية.
إن مواجهة تلك الظاهرة وتبعاتها المؤلمة تقتضي إدراكًا وسعيًا: إدراكًا بمساوئ تلك الظاهرة التي أمرضت جماعتنا الوطنية، وعطلت مسيرتها طيلة خمسة عقود كاملة، وسعيًا للبحث في الحلول الممكنة للقضاء على تلك الظاهرة، واستعادة عافية -بل استعادة وجود- جماعتنا الوطنية من جديد. وهو أمر يتطلب -أولًا وقبل كل شيء- إعادة إحياء ذاتنا الحضارية العربية الإسلامية التي تضع الوحدة والجماعة على رأس أولوياتها وقمة أهدافها.
البناء من داخل بيئتنا: لا يمكن لنا أن نبني ذاتنا الحضارية إلا بالتوجه نحو بيئتنا والانطلاق منها، لا يمكن لنا أن نبني ذاتنا الحضارية إلا بإعادة صوتنا والكف عن الاجترار والتقليد، فلن تظهر العبقريات العربية من جديد إلا من خلال انطلاقها في وسط بيئتها ومحيطها.
"البناء من البيئة" شعار رفعه المهندس المصري حسن فتحي الذي أقام قرية كاملة في صعيد مصر، مستعينًا بمواد البيئة من حوله، فوفر المال والجهد، بل وصمم ما يتناسب مع متطلبات الإنسان المصري الصعيدي وما يتماشى مع مناخه وطريقة معيشته، باختصار نحن بحاجة إلى الثقة في قدراتنا على إيجاد حلول مبدعة مستوحاة من داخل بيئتنا، بمعزل عن الغرب.
توليد العلوم حول محور القرآن:
لكل حضارة محور تدور في فلكه، ومحور الحضارة الإسلامية هو القرآن، ومن المستحيل أن نبني ذاتنا الحضارية دون الدوران حول محور القرآن، ودون خدمته ونصرته وتوليد علوم جديدة، سواء الشرعية أو غير الشرعية حول القرآن من أعظم الخدمات لكتاب الله الكريم.
إن توليد العلوم الجديدة حول القرآن يمثل سبيلًا لمواجهة الهجمة الشرسة على ذاتنا الحضارية، فتوليد علم مثل علم الخطاب الإسلامي -على سبيل المثال- يعتبر ضرورة لما تعايشه الأمة حاليًا من أزمات وتحديات.
وتوليد العلوم الجديدة حول القرآن سينعش حضارتنا من جديد، تلك الحضارة التي فهمت الوحي والوجود معًا، التي أدركت كتاب الله المقروء (القرآن) وكتاب الله المنظور (الكون) معًا، وجعلتهما مصدرين للمعرفة والعلم. فكانت تدلل على صدق كتاب الله المقروء من كتابه المنظور وتدلل على صدق كتاب الله المنظور من كتابه المقروء.
كلمة أخيرة:
"إن الثقافة تبقى بعد زوال كل شيء" عبارة أطلقها خبير المعلوماتية في مصر المهندس د. نبيل علي في مدرج كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، وهو يلقي محاضرته عن المعلوماتية والثقافة في خريف ۲۰۰۷م. أطلق هذه العبارة وهو على يقين بأنه لا حل لنهضة المنطقة العربية من جديد إلا من مدخل الثقافة، فإعادة الثقافة إلى القلب بات أمرًا مفروغًا منه، لا سيما أنها أصبحت محورًا أساسيًا في مجتمع العولمة.
وأضم صوتي إلى صوت خبير المعلوماتية وأقول: إن التثقيف الحضاري سيعيد بناء بنيتنا الفكرية من جديد، وسيعيد قدرتنا على وزن الأمور كما ينبغي، ومنها إعادة أهمية الذات الحضارية والجماعة الوطنية إلى قمة أولوياتنا، خاصة في وجه التحديات والفتن التي تحيط بنا اليوم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل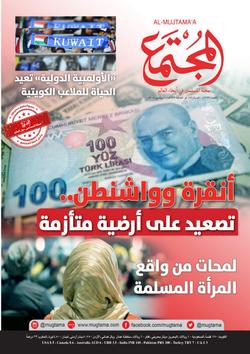
الفكر المقاصدي عند القرضاوي (1 - 2): ملامح التجديد وتجليات التفعيل
نشر في العدد 2172
14
السبت 01-أكتوبر-2022