العنوان بدايات ومآلات الأزمة الصومالية.. رؤية تاريخية لاستشراف المستقبل
الكاتب أحمد جهاد
تاريخ النشر السبت 07-أبريل-2007
مشاهدات 17
نشر في العدد 1746
نشر في الصفحة 19
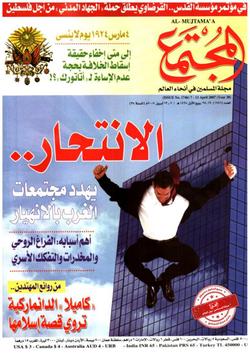
السبت 07-أبريل-2007
أهم أسباب استمرار الأزمة: القبلية والتقلبات الشيوعية على يد العسكر.. والتدخلات الإثيوبية والكينية والإهمال العربي
الدعم العربي والإسلامي للصومال ما زال حبرًا على ورق
سيناريوهات الحل المطروحة تعتمد الفلسفة الأمريكية لضرب مراكز السيطرة والقوة للمحاكم الإسلامية..
منظمات التنصير وتجار البشر استغلوا الانهيار الاجتماعي والسياسي لتطبيق أجندات غربية شردت عشرات الآلاف من أبناء الشعب الصومالي
إثيوبيا وكينيا تسعيان لعلمنة دستور الصومال لسلخه عن انتماءاته العربية والإسلامية
رغم جهود المصالحة الأخيرة، ما زالت الأزمة السياسية في الصومال عصية على الحلول المقدمة من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الأمر الذي يحمل في طياته مخاوف أطراف عدة بتدخل أجنبي أمريكي يعيد الأوضاع إلى عام ۱۹۹۱م..
ولتقييم الحلول السياسية وآفاق تهدئة الصراع، لا بد من وضوح الرؤية التاريخية للأزمة، التي يرجعها البعض إلى انهيار الدولة الصومالية عام ۱۹۹۱م.
الانقلاب على الديمقراطية عام 1969: بدأت أزمة الصومال السياسية عقب فشل تجربة الحكم البرلماني الديمقراطي التي انتهت بصدامات مسلحة، بعد اغتيال رئيس الجمهورية «عبد الرشيد شرماكي» ولم يستطع البرلمانيون أن يختاروا رئيسًا للجمهورية، بسبب سوء إدارة القيادات السياسية وضعف الأحزاب السياسية أيضًا وكانت النتيجة أن استولى العسكر على سدة السلطة بقيادة «محمد سياد بري» عام ١٩٦٩م، وهكذا دخلت الصومال مأزقًا جديدًا بسيطرة العسكر على الحياة السياسية.
وغابت شمس الديمقراطية والحريات الشخصية، بما فيها حرية الرأي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زاد الطين بلة، أن تبنت الحكومة المذهب الشيوعي. ولأن الشيوعية بطبيعتها هدامة، فإن ذلك كان أشد وطأة على الشعب الصومالي صاحب الدين والقيم.
حرب الأوجادين مع إثيوبيا عام ۱۹۷۷:
وفي عام ۱۹۷۷م اندلعت الحرب بين الصومال وإثيوبيا في منطقة أوجادين ولم يكن الهدف منها إلا التدمير والتخلص من المؤسسة العسكرية الصومالية المتنامية مما أدى انهيارها وانتهاء دورها تجاه الوطن والمواطن.
وقد خلقت هذه النكسة العسكرية أزمة سياسية داخلية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أدت إلى هبوط الروح المعنوية للشعب الصومالي..
تسييس القبلية.. نافذة التدخل الأجنبي
وكانت النتيجة إحياء دور القبيلة السياسي، ما أدى لمحاولة الانقلاب عام ۱۹۷۸م، وتوالي ظهور الحركات المعارضة بانتماءات قبلية ما زالت مستمرة إلى الآن وكان آخر إفرازاتها، تشكيل البرلمان الصومالي الحالي على أسس قبلية.
وفي خضم التفاعلات العسكرية والسياسية تتفاقم أخطار القبلية، والتي باتت تشكل النافذة التي يدخل الاستعمار منها ويفتت وحدتها الوطنية.
وقد استخدم الاستعمار أيضًا أسلوبه المعروف «فرق تسد».. وحارب الولاء القومي بينما شجع الولاءات القبلية التي لعبت دورًا أساسيًا في توتير الأوضاع السياسية في ضوء حرص القوى الخارجية على تسليح القبائل الموالية لها.
من جانب آخر، فإن تجارب النظم المختلفة التي حكمت الصومال فشلت في القيادة، ولم تهتم بالتنمية الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية، ولم تنجح في إذابة الولاءات القبلية في نسيج قومي متجانس، مما أدى إلى تفكك الأمة الصومالية.
التدخل الكيني- الأثيوبي
تكمن أسباب التدخل الكيني الإثيوبي في الشأن الصومالي في رغبة كلا البلدين في المحافظة على المكاسب التي حصلا عليها من الصومال من ناحية، وإضعاف الحكومة الصومالية المركزية من ناحية ثانية، وسلخ الصومال عن محيطه العربي والإسلامي من ناحية ثالثة.
فكل من إثيوبيا وكينيا ترغب في بقاء الصومال ضعيفًا، حتى لا يطالب بأراضيه المحتلة من كلا الدولتين: «إقليم أوجادين» المحتل من قبل إثيوبيا، و«إقليم النفد» المحتل من قبل كينيا، كما أنهما ترغبان في سلخ الصومال عن هويته العربية الإسلامية، خوفًا من تواصله مع كل من دول شبه الجزيرة العربية على الجانب المقابل من البحر الأحمر من ناحية ودول الشمال الإفريقي خاصة السودان ومصر من ناحية أخرى. لذا لا غرابة في أن ترفع إثيوبيا تحديدًا بعد أحداث 11 سبتمبر شعار «مكافحة الإرهاب في الصومال» للقضاء على المد الإسلامي المتنامي في أوساط الشعب الصومالي، وكوسيلة لتبرير ممارساتها القمعية ضد «الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين»..
علمنة الميثاق الجديد لأفرقة الصومال
ومن هنا يمكن فهم أسباب حرص كلا الدولتين على صياغة الميثاق الانتقالي بصورة تهدف إلى علمنة البلاد من ناحية وإمكانية تفكيكها أو «بلقنتها»، من ناحية أخرى، فالميثاق الجديد يعطي صلاحيات واسعة للكيانات الجديدة في ظل وجود نظام فيدرالي، مع إعطاء صلاحيات ضئيلة للسلطة المركزية، فضلًا عن تهميش دور الدين في المجتمع الصومالي المسلم.
ومعروف أنه لكي يتم تطبيق النظام الفيدرالي لا بد أولًا من وجود حكومة مركزية قوية، خاصة في ظل وجود بعض الأقاليم الراغبة في الانفصال كإقليم «صومالي لاند» التي أعلنت انفصالها بعد الإطاحة بسياد بري عام ١٩٩٠م، و«إقليم بونت لاند» الذي أعلن انفصاله جزئيًا إذن فالحديث عن نظام فيدرالي وحكومة ذات صلاحيات ضئيلة سيجعل قدرتها محدودة على بسط سيادتها على سائر أنحاء البلاد.
لذا كان ينبغي أولًا الحديث عن دولة مركزية قوية مع تقديم كافة الدعم لها. خاصة من الخارج لكي تتمكن من بسط نفوذها على البلاد. ثم يأتي- بعد ذلك- الحديث عن نظام مركزي.
كما أن الحديث عن علمانية أو تهميش دور الدين لا يستقيم مع شعب متدين بطبعه ولا يوجد من بينه مسيحي واحد أو آخرون يدينون غير دين الإسلام إذ لن يكون هناك خطر على تطبيق الشريعة، بل حتى في حالة وجود مسيحيين- كما في حالة السودان- فإن تطبيق الشريعة يراعي أوضاع غير المسلمين.
ضعف الدعم العربي
وهو ظاهر للعيان، حيث لم تفلح جهود الجامعة العربية في تهدئة الأوضاع المأزومة بالصومال، حتى إن «عبد الله حسن»- مندوب الصومال الدائم بالجامعة العربية- وصفها بأنها «لا حول لها ولا طول»... فلا توجد أي مساعدة اقتصادية في العالم العربي للصومال في الوقت الحاضر.. وكانت «قمة عمان»، قد قررت إعطاء الصومال ٤٥٠ مليون دولار لم يصل منها شيء عدا ١٥ مليون دولار قدمتها المملكة العربية السعودية و٣ ملايين قدمتها دولة قطر خلال فترة حكومة عبد القاسم صلاد السابقة.
أما وزير الخارجية الصومالي- «عبد الله شيخ إسماعيل»، فقد عبر عن صدمته من الموقف العربي تجاه الصومال قائلًا: لا دعم يقدم إلينا اقتصاديًا وماليًا أو سياسيًا من المحيط العربي، ولا تضامن ملموسًا نحس به هناك تقاعس تجاه الشعب الصومالي.
تداعيات الأزمة
سياسيًا: أسفرت عن اضطرابات سياسية ومصادمات دموية بين الجبهات وفقدان الأمن والاستقرار وتفشي الفوضى السياسية.. وأصبح الصومال دون سلطة مركزية، حتى إن العاصمة أصبحت مقسمة بين طرفي النزاع، إضافة إلى انهيار المؤسسات السياسية مثل البرلمان والحكومة والأحزاب الديمقراطية والدستور.
اقتصاديًا: أدت الأزمة إلى تدمير البيئة والبنية الأساسية الاقتصادية، حيث تعطلت المؤسسات الاقتصادية والمشاريع الزراعية والاستثمارية بسبب فقدان الأمن والاستقرار، ما أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية، فتوقفت حركة القطاع العام كالصناعة والزراعة والتجارة وتوقفت أيضًا حركة التبادل التجاري بين الصومال والعالم الخارجي، وترتب على ذلك طلب المعونة الغذائية والطبية من الخارج الذي قد يمنحها بشروط علنية وبأجندة خفية قد لا يظهرها إلا بعد حين.
اجتماعيًا: وإزاء حالة الانهيار الكامل في بنية الصومال انهارت المؤسسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات العامة، ووفاة الآلاف من أبناء الشعب الصومالي وتشريد آلاف آخرين، وانتشرت الأمراض الفتاكة والأوبئة مثل الكوليرا والطاعون والتيفود وغيرها، مما فاقم من انتشار المعوقين واللاجئين والأيتام والأرامل والمرضى النفسيين أيضًا.
وقد استفادت الهيئات التي تعمل لأغراض معينة «كمنظمات التنصير وتجار البشر «الرقيق» والأعضاء البشرية» من هذه الفرصة للعمل بين الشعب الصومالي المسلم لتسجيل أبنائهم تحت عباءة الإغاثة الإنسانية..
صعود المحاكم الإسلامية
وإزاء حالة الانهيار التي ضربت ربوع الصومال، بدأ تصاعد نفوذ المحاكم الشرعية في العاصمة مقديشيو في عام ٢٠٠٤م، وكان لقادتها نظرة ثابتة فيما يتعلق بعلاج مشكلة الصراعات في الصومال وإيجاد الحلول لها، وتتلخص نظرتهم في ضرورة تخليص العاصمة من القوى والعناصر المتسببة في استمرار الشقاق، إذ لا بد من توحيد العاصمة من أدناها إلى أقصاها تحت قيادة موحدة لا عنصرية ولا قبلية ولا مذهبية، وقد تبلورت هذه النظرة وتحولت إلى أهداف ثابتة.
وقد لمست المحاكم الشرعية من الشعب الصومالي في العاصمة ترحيبًا بهذا التوجه. فالناس قد سئموا من الخلافات والعداوات والمواجهات التي لا يدفع ثمنها الباهظ إلا البسطاء والفقراء والأبرياء من أرزاقهم ودمائهم وأرواحهم، ورأى هؤلاء في المحاكم الشرعية أملًا يلوح في الأفق فانحازوا إلى صفها، بعدما ذاقوا ويلات الحكومات المتعاقبة التي أراقت دماءهم وشردتهم في الداخل والخارج.
وكانت المفاجأة أن أحكمت قوات المحاكم الشرعية سيطرتها على العاصمة بعد أن هزمت تجار الدماء، لتصبح في ذلك أول فصيل مسلح يحكم قبضته على العاصمة التي كانت غارقة في الفوضى منذ انهيار الحكومة الصومالية عام 1991م.
وباعتراف الجميع أعداء وأصدقاء وأشقاء فإن حلقة الأمن التي فقدها الصوماليون منذ ١٦ عامًا، باتت حقيقة ملموسة في شوارع العاصمة وفي غيرها من الأماكن التي تسيطر عليها المحاكم الإسلامية، الأمر الذي لم يرق للقوى الإقليمية والدولية ذات الأطماع في القرن الإفريقي، وبدأت الخطط تحاك للتدخل لوقف نفوذ المحاكم، بالرغم من أن المجتمع الدولي لم يعر الشعب الصومالي ومشاكله أي اهتمام منذ انهيار الحكومة الصومالية!
ولا ريب أن التاريخ سيثبت أن الشعب الصومالي في حال توحده قادر على دحر أية تدخلات أجنبية. كما فعل مع الاحتلالين البريطاني والأمريكي سابقًا.
سيناريوهات المستقبل
ولكن ما السيناريو الأمريكي القادم لمواجهة المحاكم الإسلامية في الصومال؟
أولًا: تشويه صورة المحاكم: من خلال وسائل الإعلام الأمريكية التي استخدمت كقوة تفرض ما تريد وإن كان باطلًا..
ثانيًا: الاتصال بزعماء العشائر والمنظمات المدنية لتوحيد مواقفهم وجهودهم في مواجهة المحاكم.. ولا مانع من تقديم ملايين الدولارات من أجل إقناعهم بالتخلي عن دعمهم للمحاكم.
ثالثًا: التدخل العسكري غير المباشر عن طريق إثيوبيا: أو الاتحاد الإفريقي لصعوبة تدخلها المباشر، في ضوء المأزق الراهن الذي تواجهه في العراق وأفغانستان وكوريا الشمالية، وكذا تجربتها المريرة في الصومال سابقًا.
رابعًا: دعم الحكومة الانتقالية لبسط سيطرتها على البلاد.
وفي إطار تلك الاستراتيجية توسعت العمليات العسكرية الإثيوبية ضد فصائل المقاومة الصومالية بالتنسيق مع الحكومة الصومالية التي تحظى بغطاء استراتيجي أمريكي.. إلا أن قوات المحاكم الإسلامية بدأت تنفيذ استراتيجية للدفاع المتنقل من خلال عمليات نوعية ضد القوات الإثيوبية مما يبقي باب الصراع مفتوحًا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل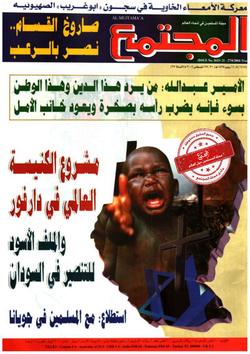
دراسة لمنظمة العمل الدولية: 246 مليون طفل في العالم تحت مطرقة الاستغلال
نشر في العدد 1658
7
السبت 02-يوليو-2005
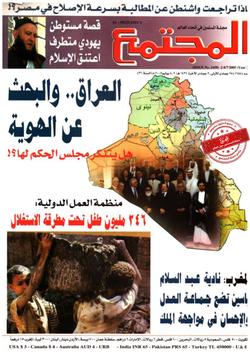
حملات التنصير تغزو القارة السمراء «٢-٣».. الكونغو الديمقراطية « رأس حربة» التنصير في إفريقيا
نشر في العدد 1855
5
السبت 06-يونيو-2009


