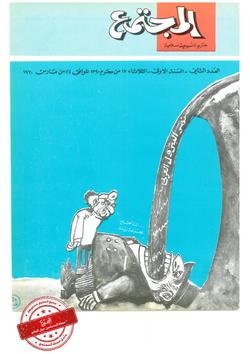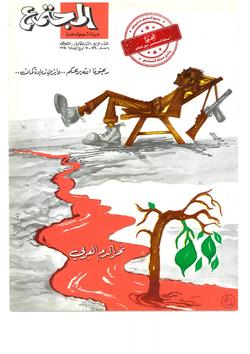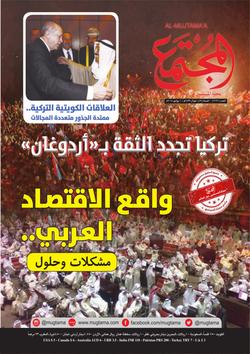العنوان ثقافة الداعية
الكاتب د. يوسف القرضاوي
تاريخ النشر الأربعاء 15-يونيو-1977
مشاهدات 15
نشر في العدد 354
نشر في الصفحة 30
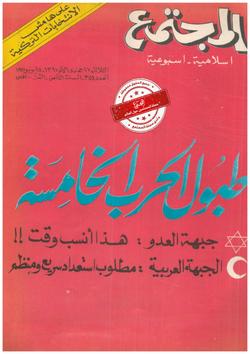
الأربعاء 15-يونيو-1977
ثالثًا- الثقافة الأدبية واللغوية
وإذا كانت الثقافة الدينية لازمة للداعية في الدرجة الأولى، فإن الثقافة الأدبية واللغوية لازمة له كذلك. ولكن الأولى تلزمه لزوم المقاصد والغايات، والثانية تلزمه لزوم الوسائل والأدوات.
واللغة بمفرداتها ونحوها وصرفها لازمة لسلامة اللسان، وصحة الأداء بل صحة الفهم أيضًا؛ فالأخطاء اللغوية إن لم تحرف المعنى وتشوه المراد يمجها الطبع، وينفر منها السمع.
وانظر كم يقشعر جلدك، ويضطرب قلبك، ويتأذى سمعك، حين تسمع داعية يقول: التبعة وهو يريد: التبعة، ويذكر الأهبة وهو يريد الأهبة.
وآخر ينصب المرفوع، ويرفع المنصوب، ولا يفرق بين فاعل ومفعول به، ولا يبالي بإضافة ولا حرف جر، فلا يكاد ينهي سطرًا من الكلام إلا صلك فيه صلة، أو لطمك ولطم الخليل وسيبويه معك لطمة أي لطمة.
وشر ما يكون ذلك إذا كان اللحن في كتاب الله. كذلك الإمام الذي صلى أعرابي خلفه، فسمعه يقرأ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (البقرة: 221) قال: ولا إن آمنوا أيضًا لن ننكحهم! فقيل له: إنه يلحن، وليس هكذا يقرأ. فقال: أخروه قبحه الله لا تجعلوه إمامًا؛ فإنه يحل ما حرم الله.
لقد أخبرني بعض طلابي أنهم سمعوا من يقول بأن حواء خلقت أولًا وأن آدم خلق منها بعد. وأن المرأة هي أصل البشرية.
ولما سألت من أين جاء بهذا الكلام؟ قالوا: من القرآن من أول سورة النساء وما شابهها وهنا أدركت سر الخطأ عند هذا المتحدث وهو جهله باللغة فقد قرأ قوله تعالى من فاتحة سورة النساء ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (النساء: 1) ففهم منها أن كلمة ﴿زَوْجَهَا﴾ تعني الرجل وهو آدم في نظره. ولو كان آدم هو المخلوق أولًا والمرأة هي التي خلقت منه لقال خلقت منها زوجتها، وهذا هو المستعمل عرفًا تقول عن الرجل زوج، وعن المرأة زوجة وغفل هذا الرجل أن القرآن يجب أن تفسر كلماته وفقًا لمدلولها اللغوي لا العرفي؛ لأن العرف دائم التبدل. واللغة تسمي المرأة زوجها كالرجل تمامًا ولهذا قال تعالى في قصة آدم: ﴿يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ (البقرة: 35) ولم يقل وزوجتك. وقال في شأن هاروت وماروت ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (البقرة: 102) وإنما أتي الرجل من جهله باللغة.
والأدب بشعره ونثره، وأمثاله وحكمه، ووصاياه وخطبه مهم للداعية، يثقف به لسانه، ويجود أسلوبه، ويرهف حسه، ويقفه على أبواب من العبارات الرائقة، والأساليب الفائقة، والصور المعبرة، والأمثال السائرة، والحكم البالغة، ويفتح له نافذة على الروائع والشوامخ، ويضع يده على مئات بل ألوف من الشواهد البليغة التي يستخدمها الداعية في محلها؛ فتقع من الفتوى أحسن موقع وأبلغه.
وقد جاء في الحديث: «إن من البيان لسحرًا، وإن من الشعر لحكمة» وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر من أكثر من شاعر، واستجاده واستزاد منه، وكان من أصحابه شعراء معروفون مثل: حسان بن ثابت وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة من الأنصار.
وأذن لحسان أن يذود بلسانه وشعره، ويرد عنه هجو شعراء قريش، وقال له: اهجهم وروح القدس معك.
وروى مؤرخو الأدب كثيرًا من الشعر للخلفاء الراشدين، وخصوصًا لعلي رضي الله عنه فقد روى كثير من الشعر الجيد البليغ، كما رووا أيضًا لكثير غيرهم.
ومن لم يقل الشعر منهم فقد رواه ورغب في روايته.
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل ورووهم ما يجمل من الشعر.
وقالت عائشة رضي الله عنها: رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم.
وقال المقداد بن الأسود: ما كنت أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا فريضة (علم المواريث) من عائشة رضي الله عنها.
وروى عنها ابن أبي مليكة: أنها كانت تنشد قول لبيد:
ذَهَبَ الَّذينَ يُعاشُ في أَكنافِهِم وَبَقيتُ في خَلفٍ كَجِلدِ الأَجرَبِ
وتقول: رحم الله لبيدًا فكيف لو أدرك زماننا هذا؟
ثم قالت: إني لأروي ألف بيت له. وإنه أقل ما أروي لغيره.
وكان ابن عباس من أروى الناس للشعر، حتى حكوا أنه كان يحفظ رائية عمر بن أبي ربيعة وكان يستند إلى الشعر في تفسيره للقرآن، كما يعرف ذلك من محاورته لنافع بن الأزرق.
وقال الشعبي أحد أئمة التابعين بالكوفة: ما أنا لشيء من العلم أقل مني رواية للشعر ولو شئت أن أنشد شعرًا شهرًا، لا أعيد بيتًا لفعلت!
ويروى أن زيادًا بعث بولده إلى معاوية، فكاشفه عن فنون من العلم، فوجده عالمًا بكل ما سأل عنه. ثم استنشده الشعر. فقال: لم أرو منه شيئًا، فكتب معاوية إلى زياد: ما منعك أن ترويه الشعر؟! فوالله إن كان العاق ليرويه فيبر، وإن كان البخيل ليرويه فيسخو، وإن كان الجبان ليرويه فيقاتل.
وهذا يدلنا على مقدار ما للأدب عامة، وللشعر خاصة، من تأثير في النفس البشرية، كما يدلنا على أن العناية بالأدب، والتضلع به، والاطلاع على مصادره والحرص على تقييد أوابده، وترديد فرائده، والاستفادة منها عند الحاجة، أمر لازم للداعية الناجح.
ولا غرو أن جعل الله الآية الكبرى والمعجزة العظمى، لخاتم رسله آية أدبية، ومعجزة بيانية، أثرت في خصومها وأنصارها على سواء: القرآن الكريم.
ولنضرب لذلك مثلًا: هب أنك تتحدث عن صلة الرحم، وبر ذوي القربى وذكرت ما تيسر في الموضوع من الكتاب والسنة، أفلا يكون مما يوسع أفق حديثك ويزيده تأثيرًا على تأثير أن تذكر بعض ما حفلت به كتب الأدب في ذلك من شعر ونثر؟ فمن ذلك قول علي:
أكرم عشيرتك؛ فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير إلخ.
ومن ذلك قول طرفة في معلقته:
وظلمُ ذوي القربى أشدّ مضاضةً
على المرء من وقع الحسام المهنّد
وقول لآخر:
أَخاكَ أَخاكَ إِنَّ من لا أَخاً لَه
كساعٍ الى الهيجا بغير سلاحِ
وإِن ابن عم المرء فاعلم جناحُه
وَهَل ينهضُ البازي بغير جناح
وقول الحماسي:
وإنَّ الذي بيني وبينَ بني أبي
وبينَ بني عَمِّي لمختَلِفٌ جِدَّا
فإن أكلوا لحمي وَفَرتُ لحومَهم
وإن هَدَموا مجدي بنيتُ لهم مجْدَا
وإن ضَيَّعوا غَيبي حِفظتُ غُيوبَهم
وإن همُ هَوُوا غَيِّي هَوِيتُ لهم رُشدَا
ولا أحمِلُ الِحقدَ القَديمَ عليهِمُ
وليس رئيسُ القومِ من يحمِلُ الِحقدَا
وقول لآخر:
قومِي هم قتلوا أُمَيمَ أخي
فَإِذا رميتُ يُصِيبنِي سهمي
فلئن عَفَوْت لأعفونْ جَللا
وَلَئِن سطوتُ لأوهِننْ عظمي
ومن الجوانب المهمة في الثقافة الأدبية: ما تحكيه كتب الأدب من حوار وقصص وأخبار. كثيرًا ما تكون لها قيمة أخلاقية، أو دلالة تربوية، فيلتقطها الداعية ذو الحس المرهف، لينقلها من مجال المتعة بالقراءة إلى مجال الدعوة والتوجيه.
أذكر هنا مثالًا لذلك ما حكاه ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه: «العقد الفريد»: أن رجلًا يقال له: ابن سلكة، دخل على الحجاج يشكو إليه مظلمة حلت به على أيدي رجاله فكان مما قاله للحجاج:
عصى عاص من عرض العشيرة، فحلق على اسمي، هدم منزلي، وحرمت عطائي! يعني الرجل أن هذا كله أصابه بذنب واحد من العشيرة! كما يفعل الطغاة إلى يومنا هذا.
قال الحجاج: هيهات أما سمعت قول الشاعر:
جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب
ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب
فقال الرجل: أصلح الله الأمير، إني سمعت الله عز وجل يقول غير هذا، قال: وما ذاك؟ قال: قال الله تعالى أي على لسان إخوة يوسف: ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ﴾ (يوسف: 78-79)، قال الحجاج: علي بيزيد بن أبي مسلم فمثل بين يديه، فقال: افكك لهذا عن اسمه، واصكك له بعطائه، وابن له منزله، ومر مناديًا ينادي: صدق الله وكذب الشاعر.
فهذه القصة التي ترويها كتب الأدب تدل بوضوح على أن للشريعة الإسلامية سلطانها وهيبتها حتى طغاة الحكام، وهذه خصيصة فريدة تتميز بها الشريعة الربانية عن الأنظمة والقوانين الوضعية، كما تدلنا على أن أطغى الطغاة في العصور الأولى لم يكن ليجرؤ على رفض شريعة الله، أو تحدي نصوصها ولو كان هو الحجاج بن يوسف.
حتى الطرائف والملح الأدبية يجد الداعية الموفق لها مكانها ووقتها، فينتفع بها؛ ليثبت بها معنى معينًا، أو ليروح بها عن سامعيه، كما قيل: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة.
ويستطيع الداعية الملهم كذلك، أن يقتبس كثيرًا من النصوص الأدبية وبخاصة الشعر الرفيع فينقلها من موضوعها الأصلي الذي سيقت فيه إلى موضوع يراه الداعية أليق لها، وأحق بها، وهو كثير.
قال بعضهم: حضرت مجلس الشبلي، فقام إليه رجل من أصحابه، فقال له: أوصني فقال: لقد أوصاك الشاعر بقوله:
قالوا: توق ديار الحي إن لهم
عينًا عليك إذا ما نمت لم تنم.
وكثيرًا ما استعار أهل المحبة لله أشعار العشاق، من أمثال قيس وجميل وكثير فاستعملوها هم في أغراضهم الربانية. ولم يلتفتوا إلى أنها قيلت في ليلى أو بثينة أو عزة. بل ربما بقيت هذه الأسماء فلم يبالوا بها.
وقد أنشد أبو فراس الحمداني أبياتًا من قصيدة يخاطب بها أميره وابن عمه سيف الدولة، فنقلها الصالحون إلى من لا يجوز أن يخاطب بها غيره، وهو الله جل جلاله، هي قوله:
فَلَيتَكَ تَحلو وَالحَياةُ مَريرَةٌ
وَلَيتَكَ تَرضى وَالأَنامُ غِضابُ
وَلَيتَ الَّذي بَيني وَبَينَكَ عامِرٌ
وَبَيني وَبَينَ العالَمينَ خَرابُ
إِذا نِلتُ مِنكَ الوُدَّ فَالكُلُّ هَيِّنٌ
وَكُلُّ الَّذي فَوقَ التُرابِ تُرابِ
ورأيت من الناس من ينسبها إلى رابعة العدوية، والحقيقة أنها لم تنشد إلا بعد رابعة العدوية بزمن طويل...
ونعني بها أن يلم الداعية إلمامًا مناسبًا بأصول ما يعرف الآن باسم «العلوم الإنسانية» مثل علوم: النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والأخلاق والتاريخ وقد فصلنا التاريخ عنها وخصصناه بالذكر لأهميته الخاصة للداعية ولا سيما وقد أدخلنا فيه التاريخ الإسلامي.
وإنما أوصينا الداعية بذلك لعدة أسباب:
1- إن موضوعها له علاقة وثيقة بموضوع الدعوة، أو قل: إن موضوعهما واحد وهو: الإنسان، الإنسان في الماضي أو الحاضر، الإنسان فردًا أو مجتمعًا، الإنسان مفكرًا لنفسه أو مقلدًا لغيره، الإنسان منتجًا أو مستهلكًا.
2- إن الإلمام بهذه العلوم يعين على فهم الناس، وبخاصة الذين تثقفوا بهذه العلوم، وأصبحت جزءًا من تكوينهم الفكري، ومزاجهم الثقافي، والداعية مأمور أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأن يبين لهم بلسانهم ليفهموا عنه، ولا يستطيع ذلك ما لم يكن بينه وبينهم جسر مشترك من الثقافة، يقرب المسافة، ويزيل الهوة أو الفجوة العقلية والنفسية بين عالم الدين والمثقفين بالعلوم الحديثة.
3- إن لهذه العلوم في كثير من الأحيان رشحات ضارة على الثقافة المعاصرة، وسمومًا تنفثها في شتى المجالات، لا يكاد يسلم منها كتاب أو مجلة أو صحيفة، أو إذاعة أو غيرها، ومن لم يعرف مصادر هذه الرشحات والسموم لم يستطع أن يقاومها بأسلوب علمي رصين بل لعلها تتسلل إليه نفسه وتؤثر في فكره وقلبه ولسانه وهو لا يشعر، ولهذا قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه.
تنبيهات لدارس العلوم الإنسانية:
وأود أن أنبه هنا أي في مجال العلوم الإنسانية إلى جملة أشياء:
1- إن هذا اللون من العلوم مهما قيل فيه يخضع لكثير من التفسيرات تبعًا للمدارس المختلفة، وتبعًا لتفكير الدارس وثقافته واتجاهه.
2- إنها بناء على ذلك تتسرب إليها إسرائيليات حديثة، كما تسربت إلى كتبنا من قبل الإسرائيليات القديمة إسرائيليات مثل فرويد في علم النفس، ودوركايم في علم الاجتماع وماركس في علم الاقتصاد.
3- إن للذاتية فيها مجالًا رحبًا للاستنتاج الظني، وميدانًا فسيحًا، لأن موضوعها ليس المادة الجامدة بل الإنسان المتحرك المتغير، ولذا تنقض اليوم ما أبرمته بالأمس، وتنقض في الغد ما تبرمه اليوم، وتهدم مدرسة منها ما تبنيه أخرى، وينفي فيلسوف أو عالم ما يبالغ غيره في إثباته وتأكيده.
4- إن طريقة العرض والسياق للمادة العلمية ولو كانت سليمة ولا غبار عليها تتأثر بعقيدة صاحبها وفكره وثقافته، وتؤثر بالتالي في قارئها، وهذا واقع في عرض العلوم البحتة ذاتها كالفيزياء والأحياء وغيرها؛ فالمادي يقول: خلق الله، هذا في العلوم التجريبية المحضة فكيف بالعلوم الإنسانية وهي كما ترى؟!
5- لهذا كله أقول: إن من المهم، بل من الضروري: أن تقدم هذه العلوم لطلاب الدعوة بأقلام إسلامية مأمونة لا يخشى من تأثير الغزو الفكري والإسرائيليات الحديثة على عقولها، ولهذا يشترط فيمن يقدم هذه الدراسات:
1- أن يكون متخصصًا فيما يكتب، غير دخيل على الموضوع، ولا مقتحم ما ليس له وقد قال تعالى ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (فاطر: 14).
2- أن يكون مسلحًا بثقافة إسلامية ناضجة، غير مبتسرة ولا سطحية، حتى يتمكن من عرض موضوعه في ضوء منطلقات إسلامية صحيحة، منبثقة من عقيدة الإسلام ونظرته إلى الدين والحياة، وإلى الله والكون، وإلى الإنسان والتاريخ.
3- أن يكون وراء هذه الثقافة، وذاك التخصص، روح إسلامية حية، وضمير إسلامي يقظ وإن شئت قلت: التزام بالإسلام وإيمان بأنه أمثل فلسفة للحياة، وأعدل نظام للمجتمع.
علم النفس:
ولا أريد به علم النفس القديم الذي كان جزءًا من أجزاء الفلسفة، ولا علم النفس الذي اشتهرت به مدرسة التحليل النفسي، وما انبثق عنه من نظريات لم يقم دليل على صحتها.
إنما أريد علم النفس التجريبي الذي انتهت إليه الدراسات النفسية الحديثة، والذي تقوم دراسة الظواهر النفسية فيه على أساس الملاحظة والتجربة والقياس والاختبار، والذي يطبق على البشر لا على الورق، ويعتمد على الرياضيات والأرقام لا على مجرد التأمل أو الافتراض.
إن علم النفس بهذا المفهوم يفيد الداعية في أكثر من جانب:
أولًا- أنه يفيده في بيان الآثار الطيبة، والثمار النافعة للإيمان والتدين في نفسية صاحبه وسلوكه في الحياة.
تجد ذلك واضحًا في مثل ما سجله الطبيب النفسي الأمريكي المشهور الدكتور «هنري لنك» في كتابه «العودة إلى الإيمان» وقد طبع كتابه إلى ما قبل سنوات 47 مرة في أمريكا. وقد أجرى أكثر من ثلاثة وسبعين ألف (73000) اختبار نفسي على عشرة آلاف نفس، خرج منها بنتيجة هامة هي:
«إن كل من يعتنق دينًا، أو يتردد على دار العبادة، يتمتع بشخصية أقوى. وأفضل ممن لا دين له، ولا يزاول أية عبادة».
ومثل هذا ما قرره الدكتور «كارل يونج» في كتابه «الرجل العصري يبحث عن روح: أنه لم يجد مشكلة واحدة من مشكلات أولئك الذين بلغوا منتصف العمر. لا ترجع في أساسها إلى افتقاد الإيمان، والخروج على تعاليم الدين، ولم يبرأ واحد من هؤلاء المرضى إلا حين استعاد واستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجهة الحياة.
ويكفي هذا ردًا على الذين يزعمون أن الدين أفيون مخدر للشخصية الإنسانية ويقول الفيلسوف الأمريكي الشهير وليم جيمس «إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان».
وينقل «ديل كارينجي» عن الدكتور (أ. أ. بريل) قوله: «إن المرء والمتدين حقًا لا يعاني مرضًا نفسيًا قط».
ويعقب على ذلك كارينجي بقوله:
«وعندي أن أطباء النفس ليسوا إلا وعاظًا من نوع جديد، فهم لا يحضوننا على الاستمساك بالدين، توقيًا لعذاب الجحيم، الدار الآخرة فحسب وإنما يوصوننا بالدين توقيًا للجحيم المنصوب في هذه الدنيا: جحيم قرحات المعدة، والانهيار العصبي والجنون، إلخ».
ثانيًا- أنه يفيده في فهم كثير من النصوص الدينية والتعبير عنها تعبيرًا يلائم عقلية العصر وروحه.
فقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ (سبأ: 46).
يدلنا على أن التفكير النافع الجدير بأن يوصل صاحبه إلى الحق هو تفكير الإنسان مع رفيق له أو وحده بعيدًا عن تأثيرات العقل الجمعي وإيماءاته التي كثيرًا ما تجرف الإنسان عن الصواب والاتزان وهذا ما يقرره علم النفس.
وقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقضي القاضي وهو غضبان» يشير إلى تأثير الانفعال وخصوصًا إذا اشتد على سلامة الإدراك وصحة التفكير وهو ما يقرره علم النفس.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل