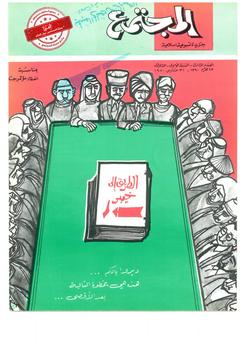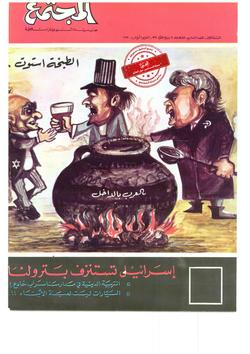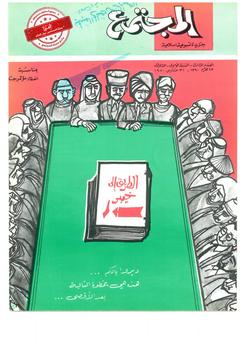العنوان حوار مفتوح.. أزمة المثقفين
الكاتب د. نجيب الكيلاني
تاريخ النشر الثلاثاء 13-أبريل-1971
مشاهدات 73
نشر في العدد 55
نشر في الصفحة 12

الثلاثاء 13-أبريل-1971
حاول البعض أن يركز على أن الحرية الحقيقية لا يمكن أن يبزغ فجرها إلا في ظل تأمين لقمة العيش، أو العدالة الاجتماعية للسواد الأعظم، وقرر آخرون أن الحرية هي الحرية السياسية في القول والعمل والنشاط الاقتصادي، دون قيود أو ضغط من السلطة العليا. وظن البعض أن الحرية تكمن أساسًا في انطلاق النزعات أو النزوات الفردية دون تقيد بدين أو خلق!
يناقش الدكتور نجيب الكيلاني قضية من أهم القضايا المعاصرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وهي الأزمة التي يعيشها المثقفون والمفكرون في تلك المجتمعات.
والأزمة -كظاهرة- موجودة، ولا يختلف في واقعية وجودها مفكران أو مثقفان بيد أن الخلاف يقوم عند ردها إلى أسبابها، يقوم عند تقدير حجمها، وتقديم الحلول لعلاجها.
ولقد استعرض الدكتور نجيب بعض مظاهر الأزمة، وأورد بعض أسبابها خلال مقاله التالي، «والمجتمع» تفتح صدرها للحوار الحر المعتدل لمناقشة هذه القضية الحية؛ لأنها ترتبط بقضايا أخرى كثيرة، ينبغي أن تبعث من مرقدها بعد أن تعمد الكثيرون دفنها وإهالة التراب عليها، بل أن هذه القضايا ذاتها- حين تبعث- ستنهي أزمة المثقفين، ذلك أن هذه الأزمة لم تقم إلا بعد قطع الصلة بين الفكر «والمشكلة» أو بين الثقافة «والواقع».
«المجتمع»
آفة الأمة تكمن في ضياع مثقفيها وتمزقهم، وهي أزمة كثر الجدل حولها، في السنوات الأخيرة، وقلما تجد دولة من الدول الإسلامية إلا وتناولت هذه القضية من قريب أو بعيد، وحاولت الوصول إلى بعض النتائج، وأيًا كان الأمر، فإن تلك القضية قد تشعبت وتعقدت، ولم تبلغ بعد إلى مرحلة الوضوح، وهناك أمر لا يستطيع أي مفكر منصف أن يتجاهله وهو أن المثقفين، لا تقع على عاتقهم وحدهم مسئولية الانحراف الشائن، الذي أحال أمتنا إلى تجمع بشري يفتقد إلى السمات، أو الصفات التي تميز أية أمة أصيلة من الأمم، ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن هو تلويث معنى الحرية في أمتنا، فقد تخبط كثير من المخططين للمسيرة الشعبية، في تحديد معنى الحرية.
وحاول البعض أن يركز على أن الحرية الحقيقية لا يمكن أن يبزغ فجرها إلا في ظل تأمين لقمة العيش، أو العدالة الاجتماعية للسواد الأعظم، وقرر آخرون أن الحرية هي الحرية السياسية في القول والعمل والنشاط الاقتصادي، دون قيود مفرطة، أو ضغط صادر من السلطة العليا، وظن البعض أن الحرية تكمن أساسًا في انطلاق النزعات أو النزوات الفردية، دون تقيد بدين أو خلق أو فلسفة قديمة.
ومن ثم تشعبت السبل، وأصبحت السلطة الحاكمة هي التي تحدد مفهوم الحرية وتطبيقاتها، ونستطيع أن نقول إن المثقف العصري وقف إزاء السلطات مسلوب الإرادة، مقيد الفكر، لا يستطيع أن يختار أي طريق يخالف طريق القوة التنفيذية، كما خضعت السلطة التشريعية بدورها للسلطة التنفيذية، وانعكست الآية، فبدلًا من أن تكون السلطة التنفيذية أداة مرنة في يد السلطة التشريعية، أمست السلطة التشريعية خادمًا أمينًا يسير مرغمًا في ركاب القادرين.
وانطلقت أصوات ضعيفة معلنة رفضها لهذا الخلط الخطير، والانحراف المشين، لكن سرعان ما اندحرت تلك الأصوات، أو كتمت عنوة، وطوردت أعنف مطاردة، وانطلقت الأبواق الحمقاء ترميها بالخيانة لقضايا الشعب تارة، والسير في ركاب الأعداء تارة أخرى، ولو كان الأمر أمر عام أو عامين لهانت الكارثة، ولكنها امتدت لسنوات طويلة، فتخرج في هذا الجو الموبوء جيل فاسد -له عذره- لا يتلقى وحيه إلا من خطب الزعماء، أو برامج التليفزيون والإذاعة، أو مقالات الصحف المدبجة، أو معاهد العلم التي تسير على نفس النسق.
أعداء الشعب:
وملأت الآفاق شعارات رنانة، كان لها قوتها ومفعولها في نفوس السذج والبسطاء والخانعين، وأصبح شعار «أعداء الشعب» يطلق على كل من تسول له نفسه الجهر برأي يخالف رأي السلطة التنفيذية، حتى ولو كان هذا الرأي وجيهًا مُبرَّأً من الغرض الخبيث، أو الطمع الشخصي، فلم يكن غريبًا، أن يأتي يوم، ويطلق نفس الشعار على صانعيه والمروجين له في كثير من دولنا، في أعقاب التغيرات المتعاقبة التي تطرأ على نظم الحكم في مكان أو آخر.
ولم يفكر مصدرو الشعارات في أن أولئك المظلومين -أعداء الشعب- إنما هم الأمناء على شرفه ومسيرته النضالية، وهم سدنة الحرية الحقيقيون، وهم الذين نأوا بأنفسهم عن الذوبان والتشويه والقيود الجائرة، في عالم «القوالب» المصبوبة، التي مسخت إنسانية الإنسان.
الرجعية:
ونفس الشيء حدث بالنسبة لكلمة «الرجعية»، إذ التصقت تهمتها بأولئك الواعين العقلاء سواء أكانوا يساريين أو يمينيين، لأن المهم في الأمر ليس اليسارية أو اليمينية، ولا التقدمية أو الجمود، إن التقاء السلطة التنفيذية على معنى أو مجموعة من الآراء، هو التقدم والازدهار وهو التحرر والانطلاق، وهو العدالة والرفاهية، وما عداهم فهم المعوقون لحركة التاريخ، وهم الثورة المضادة، وهم البرجوازية المتعفنة، وهم الفئات المغرر بها، ولذلك ظهرت في عصرنا بدعة «العزل السياسي»، التي أورثت شعوبنا كثيرًا من الشك والتمزق واليأس، وحرمت كثرة ضخمة من ممارسة حقها في التعبير الحر، والبناء السليم، وكأن الوطن أصبح ضيعة لفئة دون غيرها، وتحول الباقون إلى أجراء أو عبيد.
وهكذا صار المفكرون -كما يقول المفكر الروسي الهارب- مجرد آلة صماء تعزف السلطة على حروفها فتطبع الحروف منمقة وجميلة، وزيفت نماذج البطولات، وشوهت المثل العليا، واتخذت لها أشكالًا ومضامين جديدة أبعد ما تكون عن الإنصاف والصدق.
وكان الإرهاب الفكري أعنف وأقسى من سياط الجلادين، وأسوار المنافي فما أن يطلع على الناس عمل فكري أصيل، أو أداء فني متحرر من أشكال العبودية والتبعية حتى يرمى بالانحراف والتخلف والتبعية، ويعتبر صانعوه مرتدين خائنين، ومن ثم أصبح النقد لونًا من المطاردة العنيفة لكل ما هو جاد وأصيل، حتى وجد المخلصون أنفسهم محصورين في زوايا ضيقة، مرغمين على الاستسلام والصمت، وخلا الميدان إلا من العازفين على أوتار القيثارة الرسمية، فتحول الفن والفكر إلى هتاف وصياح وصرخات تشنجية، وأصبحت الحرية هي تحدي القيم العريقة، والسخرية من القيم الروحية، والتجاهل لبطولاتنا و تاريخنا، وأدخلت على ثقافتنا مثل غريبة، أبعد ما تكون عن آمالنا وتطلعاتنا وشخصيتنا المميزة.
وهكذا بدأ الفكر شعارات مستعارة، وتحول الفن إلى قصائد مدح يترنم بها الخائفون أو الطامعون، وأصبحت الحرية معنى من معاني السيطرة والإذلال لغير السائرين في الركب المتسلط.
تلك هي البيئة التي يعيش فيها المثقفون في أمتنا الكبيرة التي تربو على الستمائة مليون، وهي بيئة لا تسمح للبذور أن تنبت فيها، وإذا نبتت، وظهرت السيقان على وجه الأرض متحدية عوامل الجفاف والتقلبات الجوية، فإن الأيدي الآثمة تمتد إليها لبترها أو لسحقها، بيئة لا ينبت فيها غير العوسج، والشوك، والنباتات المتسلقة.
السخرية من المثقفين:
ولقد فقدت أجيالنا التائهة المخدوعة احترامها للمثقفين من أبنائها، إذ صورهم المغرضون بصورة المتخلفين عن قضايا عصرهم، وبصورة اللاهثين وراء فتات الموائد، والمترددين أو المتقاعسين أمام القضايا المصيرية، ولكي يخفوا هذا الظلم الواقع على هؤلاء المثقفين، أو يداروا وجهه الحقيقي، نادوا بأن هذا العصر عصر العلم، عصر التغيير والتطور السريع لا عصر الشعر والفكر المريض والحريات التقليدية الزائفة.
إن ضيق الأقوياء المسيطرين بوعي الفكر وأمانته، جعلهم يتخبطون في آرائهم ويلقون بالكلام على عواهنه، ويخلطون خلطًا مضحكًا، وينادون بقضايا لم يعد ينكرها أحد، فالعلم ضرورة، وكذلك الفكر أو الفن ضرورة، والحرية ضرورة، وهي كلها نسيج واحد، أو بناء متكامل، وذلك التفسخ الذي يروج له الحمقى، إنما يكون على حساب مستقبل أمتهم ومستقبلهم أيضًا.
بيت العنكبوت:
إن غياب الشخصية المؤمنة المتوازنة، ذات السمات المميزة، الصافية المأخذ والعطاء، قد خلف لنا بناة من نوع غريب، نوع من البشر الهلاميين المتعصبين، يخوضون معارك من الوهم، حيث لا موجب لمعارك، ويضربون يمينًا مع أن عدوهم يقبع لهم يسارًا، ويتراجعون إلى الوراء، من حيث يجب أن ينطلقوا إلى أمام، وينتشون بكؤوس فارغة ليس فيها غير الخداع والسراب، ولم يستطع هؤلاء البناة أن يقدموا للعراة والظماء سوى بيت من العنكبوت، وكيف يثبت بيت العنكبوت أمام خبث العدو ومكره، ودهائه، وفكره، وفنه، وعلمه، ووعيه؟ وكيف يستطيع الخائفون والمترددون ولابسو الأقنعة الزائفة أن يحسموا قضية، أو يستميتوا في معركة، أو يحموا كرامة؟
لكن...
أجل إن تلك البيئة التي تنتشر فيها الأوبئة، لا تهب الصحة والعافية للذين يخوضون في أوحالها ومياهها الآسنة، لكن المثقفين الحقيقيين، يجب أن يضعوا على رؤوسهم «عصابة أبي دجانة»، وأن يتحدوا عوامل الوهن والخوف، وينتصروا على الوباء، وأن يحصنوا فكرهم وفنهم بمضادات الفناء التي يخطط لها عدونا الأكبر، ويجب أن ندرك أن الأوبئة دائمًا تأتي في موجات ومواسم، ولم يثبت طول التاريخ الإنساني، أن أي وباء مهما كانت قوته وعنفه استطاع أن يفني الجنس البشري، المثقفون هم أطباء هذا العصر، ويا ويحنا أن تحولوا إلى طائفة من الدجالين أو السحرة أو كاتبي التمائم والتعاويذ.
وأنا لا أرفض التحيز بالنسبة لأي مثقف، وهذا مجرد رأي، لكن الذي أرفضه أن يكون هذا التحيز منبعثًا من ثقافة ناقصة، أو خبرة متهافتة، إن لكل مفكر موقفًا، ولكي يختار موقفه، يجب أن يتدارس المواقف الهامة والبارزة، فكثيرًا ما قرأت لقوم يهاجمون الأديان دون أن يلموا بأصولها الأولية، دون أن يعرفوا فرائض الوضوء، فما بالك بالبناء الكبير الذي يضم الفكر، والأخلاق، والاقتصاد، والسياسة.. إلخ!!
وكثيرون أخذوا علمهم عن مبشر حاقد، أو مستشرق ناقم، أو كاتب موتور، دون أن يكلفوا أنفسهم مؤنة البحث عن الحقيقة المجردة في منبعها وأصولها، لذا أقول لا بأس أن يكون لكل مفكر موقف، أي أن يتحيز لموقفه على أن ينطلق هذا الموقف عن وعي وفهم ودراسة.
إن المثقفين في أزمة، وأنا أدعو كل قارئ لهذا المقال أن يساهم بنصيب في إضاءة جوانب هذه القضية الكبرى في عصرنا، وأتمنى أن أعود لمتابعة هذا الموضوع في مرات قادمة إن شاء الله.
نجيب الكيلاني
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل