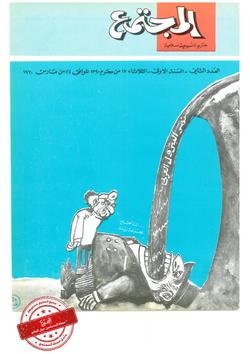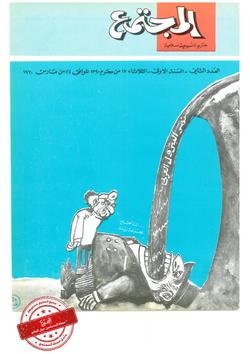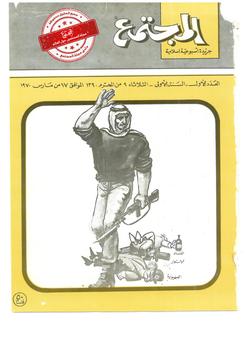العنوان سيرة «الأنا» في «أنا» العقاد (2 - 2)
الكاتب طلال العامر
تاريخ النشر الاثنين 01-أغسطس-2022
مشاهدات 11
نشر في العدد 2170
نشر في الصفحة 55
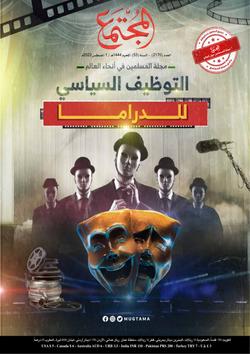
الاثنين 01-أغسطس-2022
سيرة «الأنا» في «أنا» العقاد (2 - 2)
أساتذة العقاد وتجربة العمى الطارئ
هل يُعقل أن كاتباً مثل العقاد لديه كل هذه المهارات وليس له أساتذة أو معلمون أو ملهمون؟
ترجمته الذاتية لا تحفل بالعلاقات الاجتماعية حيث يظهر فيها مترفعاً عن الناس يأنس بالبعد عنهم والخلوة بنفسه
كلمات التشجيع والتنبؤ بالمستقبل الواعد التي تلقاها هي التي قادت دفته للنجاح الثقافي
الأنا عند العقاد جعلته يتجاوز في أثناء حديثه عن تكوينه الثقافي كُتَّاب عصره ويتجاهل نظراءه منهم
نستكمل في هذه الحلقة الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة حول نرجسية العقاد أو ما أسميناه «سيرة الأنا في أنا العقاد».
تطل نرجسية العقاد من برج آخر، حين يظهر بأنه نسيج وحده وفريد دهره، حيث إنك بالكاد تحفل باسم واحد لأساتذة العقاد، حتى إنك لتتساءل: هل يعقل أن كاتباً مثل العقاد لديه كل هذه المهارات التي لا يفتأ في سيرته يحدثنا عنها، وأيضاً لديه هذا الثراء الفكري والتنوع الثقافي ليس له أساتذة أو معلمون أو ملهمون أو حتى زملاء، نفخوا فيه روح الطلب أو صقلوا فيه هذه المواهب، أو علموه ما لم يكن يعلم؟
لكنها، في تصوري، الأنا التي ربما -دون شعور الكاتب- لا تسمح بظهور أحد سواها في مسرح السيرة الذاتية.
بل إن ترجمته الذاتية هذه لا تحفل بالعلاقات الاجتماعية؛ حيث يظهر فيها مترفعاً عن الناس، يأنس بالبعد عنهم والخلوة بنفسه، حدياً في علاقاته؛ فإما أن يحب وإما أن يكره، لا توسط لديه، يقول عن نفسه: ويغلب على المنطوين أنهم لا يألفون الناس بسهولة، وأعترف بأنني واحد من المنطوين في هذه الخصلة.
فهو يعترف أنه مطبوع على الانطواء، لكن تأمل في اعترافه هذا: «إنني مطبوع على الانطواء، وإنني مع هذا خالٍ -بحمد الله- من العقد النفسية الشائعة بين الأكثرين من أندادي في السن ونظرائي في العمل وشركائي في العصر الذي نعيش فيه».
فانطواؤه –بزعمه- لم يكن دلالة على علة نفسية؛ بل إنه يتمتع بالسلامة النفسية، إذ باستطاعته أن يفضي بأي حديث وقتما يشاء ولم يكن انطواؤه هذا حائلاً له عن ذلك، لكنه في الوقت الذي يتبرأ فيه من الانطواء المرضي يرجم نظراءه وأنداده وشركاءه بالعقد النفسية والمعاناة من الأسرار المكبوتة والخوف المرضي من البوح، وإيثار السكوت خشية الكلام؛ فهو أيضاً يعترف أنه لا يعرف التوسط في العلاقات الاجتماعية بين الحب والكراهية، ولا يريد أن يعرفه وشعاره قول الصولي: «واربأ بنفسك أن ترى إلا عدواً أو صديقاً».
حب مفرط للذات لا يدع مجالاً لمخالف أو لمخطئ؛ فهو وإن كان يتعلل لمنحاه هذا بالعلل؛ فإن القرائن السابقة على هذا الافتراض تذهب بالعلل كل مذهب، ثم إنه مخالف لآراء كثير من العقلاء والحكماء، الذي يتمثل في شعرة معاوية، وفي قول على بن أبي طالب رضي الله عنه: «أحب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»، أما الرعونة في العلاقات وإقامة السدود فيها حيناً فهو ليس من مذهب الأسوياء بله الحكماء، والغريب أنه برر مسلكه المتطرف هذا بسلامة علاقاته من المنافع الشخصية، ويزعم أن الدافع إلى المرونة في العلاقات مع الناس والتوسط بين الحب والكراهية هو ما يترقبه الناس من هذه المنافع؛ فهو يستدل على سلامة مسلكه بفساد مسلك المخالف، وهل تبور الحجج إلا بمثل هذه المغالطات؟!
وقد التمس سبباً قد يكون وجيهاً لهذه العزلة، يعود إلى زمن صباه، فحفر حفرة عميقة الغور للوصول إلى المبرر المقنع والسبب الوجيه لإيثاره اعتزال الناس؛ حيث أرجعها إلى وباء انتشر في مدينة أسوان وهو دون السابعة، وقد خلت المدينة حينها من أهلها، واعتزل الناس بعضهم وحجروا أنفسهم في بيوتهم خوفاً من العدوى(1).
ولا أدري ما مدى وجاهة هذا السبب في حبه للعزلة، ولا أدري أيضاً ما حال باقي الناس؟ هل جرى عليهم ما جرى عليه من حب العزلة أم لا؟ لكن لا يخلو ما ذكره من طرافة؛ حيث إنه إن صدق فيما قال فلنا أن نتساءل: ما حالنا بعد عامي الحظر والحجر في ظل وباء «كورونا»؟ وما الآثار النفسية المرتقبة جراء التباعد الاجتماعي الذي قد يحصد ملايين الملايين من الأرواح والعلاقات الإنسانية قبل أن يحصد المرض الحقيقي ملايين الأجساد؟!
تجربة العمى الطارئ
وربما يرتد إلى الأنا أيضاً ما عبر به عن شعور العمى الطارئ الذي أصيب به لما أجريت له عملية جراحية في عينه؛ فهو بالإضافة إلى أنه لم يهتز لها وبدا رابط الجأش غير مكترث للظلام الدامس الذي لفه، بدليل أنه يتباحث -كما ذكر- مع بعض جلسائه ضاحكاً عابثاً حول الاختلاف في التعبير اللغوي عن إطفاء الأنوار بين أهل الشام وأهل مصر؛ إمعاناً في إظهار القوة النفسية التي يتحلى بها العقاد أمام هذه الأزمة التي عادة ينهار أمامها نظراؤه من العقلاء والمفكرين، ويمضي في هذا الاستعراض حتى يلوي عنق البلاء لصالحه؛ حيث إن عماه الطارئ تزامن مع إطفاء الأنوار في بلده لأجل الغارات الحربية يقول: «لأنني أطفأت الأنوار قبل أن تتصايح الأصوات حول الدار: أطفئوا الأنوار.. أطفئوا الأنوار».
وقد قارنت بين موقفه من العمى الطارئ وموقف الكاتب أحمد أمين، حينما أجرى عملية لعينيه اضطر لأن يضع الضماد عليها لأشهر، ظل فيها في ظلام مطبق هيمنت عليه حينها عاطفة صادقة، ساقته لأن يحاكي شعور من تألموا لفقد أبصارهم؛ فبكوا أنفسهم وأبكوا الناس، كبشار بن برد، وأبي العلاء المعري؛ بل كان عماه الطارئ هذا بمثابة الفرصة المثلى لمراجعة النفس ومحاسبة الضمير والعودة إلى الذات لقاء ما فرط، وقد استحضر أثناء هذه الأزمة النفسية التي مر بها اعترافات «تولستوي» ومراجعات الغزالي في «المنقذ من الضلال»؛ فقد كانت فرصة فريدة للتعرف على الذات على حقيقتها متجردة من الأوسمة والألقاب والهالات يقول: «إن الذي يوقعك في هذا التفكير المحزن هو انطواؤك على نفسك وتقويمك لها قيمة أكبر مما تستحق، وهل أنت إلا ذرة صغيرة على هذه الأرض ماضيها وحاضرها ومستقبلها»(2).
لكن للحق أقول: إن كلمات التشجيع والتنبؤ بالمستقبل الواعد التي تلقاها العقاد هي التي قادت دفته للنجاح الثقافي والكتابة المتميزة، فهو لا يفتأ يذكر كلمة للإمام محمد عبده في حقه لما تصفح كراسته في صغره أثناء زيارة الإمام لمدرسته: «ما أجدر هذا أن يكون كاتباً بعد».
يقول العقاد على إثر هذه الكلمة: «لا أبالغ إذا قلت: إن كلمة الأستاذ الإمام هي دون غيرها التي حفزتني إلى الكتابة».
ولا شك عندي أن أعداداً غفيرة من مثل العقاد سواء كانوا في زمنه أم في أزمنتنا هذه يجلسون على قارعة الحياة، تحمل بين جوانحها دفعات هائلة من الإبداع تستحيل بسبب الكبت والتهميش والتنمر والحسد إلى طاقات معطلة ذابلة تؤثر السكون والعزلة، كانت تكفيها كلمة تشجيع كهذه التي ألهمت العقاد فساقته سدة الريادة الثقافية.
إنصاف «أنا» العقاد
صحيح أن الأنا عند العقاد جعلته يتجاوز في أثناء حديثه عن تكوينه الثقافي كُتَّاب عصره، ويتجاهل نظراءه منهم؛ بل ويضرب صفحاً عن ذكر شركائه في المشاريع الثقافية، إلا أنه من المفيد جداً أنه ذكر لنا العديد من الكتب التي كوَّنت قاعدته المعرفية، والأهم من ذلك هو ما ذكره في سيرته الذاتية حول فلسفته في القراءة التي ترتكز على ثلاثة محاور:
1- فهو لا يهوى القراءة ليكتب أو ليزداد عدد سني عمره، إنما يقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيه -على حد تعبيره- لكن القراءة دون غيرها تعطيه أكثر من حياة واحدة ليس بعدد سنواتها طبعاً، وإنما بما تحويه الكتب من أفكار وتجارب أمضى فيها مؤلفوها أزهى سني أعمارهم.
2- شعوره العميق بما يقرأ؛ فهو يعيش في صفحات الكتب التي يقرؤها كأنه يحيا بين أحياء؛ حتى لكأنه يرى تلك الشخصيات الأدبية أو السياسية أو العلمية؛ فتتمثل له ملامحهم وعاداتهم، تجد ذلك مثلاً في قراءته للشاعر ابن الرومي.
3- في صباه حينما كانت الكتب شحيحة في بيئته كان يضطر إلى إعادة ما يقرأ؛ فتعلم من هذه الضرورة دستوراً من دساتير القراءة خلاصته: إن كتاباً تقرؤه ثلاث مرات أنفع من ثلاثة كتب تقرأ كلاً منها مرة واحدة.
الهامشان
(1) الخطر، أنا العقاد، ص 211.
(2) حياتي، أحمد أمين، ص 232.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل