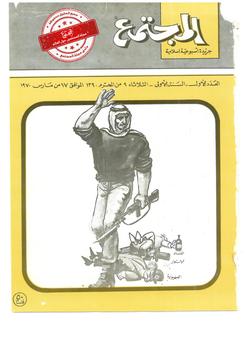العنوان ضرورة إعادة كتابة العلوم من وجهة النظر الإسلامية
الكاتب أ.د. زغلول النجار
تاريخ النشر الثلاثاء 04-مايو-1976
مشاهدات 58
نشر في العدد 298
نشر في الصفحة 26

الثلاثاء 04-مايو-1976
• كيف تكتب العلوم اليوم وأخطار ذلك على العقيدة والمعرفة
• تكتب من منطلق مادي بحت منكر لكل ما هو فوق المادة.
• ادعاءات: مناقضة لعقيدة التوحيد. وغير صحيحة علميًّا
• ادعاء «بأزلية العالم ينقضه العلم
• ادعاء بألوهية الطبيعة. ولدته الخرافة
• ادعاء ينسف منطق الأسباب بمقولة الصدفة
الحلقة ٢
تكتب العلوم اليوم- في غالبيتها- من منطلق مادي بحت منكر لكل ما هو فوق المادة وذلك بحجة أنها- بمفهومها المحدد- تتعامل مع المادة فقط، أو بدعوى أنه إذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغي أن تنسب إلى أسباب فوق الطبيعة، أو انطلاقًا من قاعدة خاطئة مؤداها أن الاعتقاد بدين ما قد يفقد المشتغل بالعلوم قدرًا من حريته في التفكير.
ولقد تعاونت على إبراز ذلك الاتجاه المادي في الكتابة العلمية عوامل عدة منها العداء التقليدي الموروث بين المشتغلين بالعلوم والكنيسة في العالم الغربي والحرب المنظمة التي تشنها الدولة وتتبناها ضد كل الأديان في العالم الشيوعي وتخلف المسلمين عن ركب الحضارة خلال القرنين الخيرين تخلفًا عرض معظم بلادهم للاستعمار من قبل دول علمانية تركت بصماتها على مختلف نواحي الحياة فيها... إستعمارًا فكريًّا جعل منهم أتباعًا لهؤلاء أو أولئك، وهم حملة آخر الرسالات السماوية وأكملها، وأولى الناس بقيادة البشرية وهدايتها.... وقبل ذلك وبعده يأتي نشاط قوى الشر على اختلاف صورها، وتباين أهوائها، وتعدد مواطنها، والتي عملت على تغذية فلك الاتجاه الإلحادي وإذكاء ناره، ودعمه بالفلسفات المادية المتعددة، والحملات الإعلامية المدسوسة، والحركات العنصرية والسياسية المتطرفة والهيئات الاجتماعية الهدامة، والأعمال العسكرية الظاهرة والمستترة من أجل انحسار الدين وسيادة الفكر العلماني وتحكمه في كل منحى من مناحي الحياة.
ولم يكن في مقدور العلم ذاته أن يصحح مسيرته وذلك لأنه بازدياد حصيلة العلوم ازدادت التخصصات عددًا وعمقًا، وتحددت أفقًا بشكل ملحوظ، الأمر الذي جعل من الشمولية اللازمة لعملية تصحيحية كهذه فبقيت العلوم- على الرغم من إنجازاتها الهائلة- تكتب من ذلك المنطلق الخاطئ الذي أضر بالعلم وبالإنسان معًا.
فلقد كان قصر الكتابة العلمية على الجانب المادي فقط سببًا في الدوران بها في دائرة الحس الإنساني المجرد وهي أصغر دوائر المعرفة في هذا الكون الذي يتميز في كثير من أموره بأنه غيبي لا يمكن إخضاعه كلية للمنهج العلمي، ولا تستطيع حواسنا المحدودة إلا إدراك ظاهرًا منه كما يتراءى لنا في حدود زماننا ومكاننا وقدراتنا وطبيعة أجسادنا.
واحتباس الفكر العلمي في حدود الإطار المادي البحت أعاقه عن الانطلاق في آفاق أكبر وأوسع، وتخلف به عن كثير من الغايات التي كان بمقدوره الوصول إليها- فالعلم بالشيء لغة هو إدراكه بحقيقته، والعلم هو إذن أسلوب لاكتساب المعرفة بالحقيقة، والمادة ليست إلا جزءًا يسيرًا منها، وهنا وضعت الكتابات العلمية أمام طريق مسدود حين أريد لها أن تنتهي باستنتاجاتها عند حدود المادة، فاضطرت إلى الانزلاق في كثير من الأخطاء كالادعاء بأزلية المادة والطاقة «المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وكذلك الطاقة» وما قاد إليه من دعوى أزلية الكون ومن ثم انتفاء الخلق...
أو نسبة كل شيء في هذا الكون إلى الطبيعة وقوانينها، وبالتالي عدم جواز إرجاع أي أمر فيه إلى أسباب فوق الطبيعة ومن ثم نكران الخالق....
أو محاولة تفسير التدرج في عمران الأرض بصور الحياة المختلفة مع الزمن على أنها عملية مادية تلقائية بحتة «التطور المادي، التطور الكيميائي والتطور العضوي» وما تبع ذلك من ادعاء باطل يرد الخلق إلى العشوائية والصدفة، ومن ثم انتفاء الحكمة والتدبير وانعدام القصد والغاية...
وما صاحب ذلك من فلسفات مادية اتخذت من تلك الاستنتاجات الخاطئة مبررًا لها في إنكار الله، وإنكار الخلق، ونبذ رسالات السماء والتهجم عليها والكفر بالآخرة والتنكر لضرورتها... فدارت بالإنسان المعاصر في متاهات من الضلال أشقته وأتعسته، بل أخرجته من إطار إنسانيته الحقة، وأبعدته عن درب رسالته النبيلة وحولته إلى كيان أناني لا يعرف إلا حاجته المادية الآنية المحدودة، ولا يحرص إلا على هذه الحياة الدنيا...
وتبقى الفطرة السليمة في صراع مع هذا المد الإلحادي الجارف إلى أن يشاء الله ولولا ذلك ولولا رحمته بنا ورعايته لنا لانتهت الحياة على هذا الكوكب من زمن بعيد؛ خاصة وأن التقدم العلمي والتقني الهائل قد أعطى الإنسان من وسائل الدمار ما يمكنه من القضاء على كل ما حقق من عمران ولكنه لم يعطه من القيم ما يمكن أن يردعه عن ذلك...
وما البؤس والحزن والخوف والضياع والعنف والقسوة والظلم والاستهتار... والأزمات النفسية والروحية التي يحياها إنسان هذا العصر إلا نتيجة حتمية لمجموع المفاهيم الخاطئة التي شاعت في الكتابات العلمية... وروجت زورًا باسم العلم ومنجزاته، وتلقفها المشتغلون بالدراسات الفلسفية والإنسانية فجسدوها كفرًا صراحًا ولقد تسربت هذه التصورات المنحرفة إلى كتاباتنا عندما تلقفنا التراث العلمي الغريب في محاولة للحاق بالركب، ونقلناه كما هو بما يحمل في طياته من خلفية مادية منكرة، وبقيت العلوم- في غالبيتها- تكتب وتدرس في العالم الإسلامي بلغات أجنبية وتنشر في دوريات أجنبية أو محلية على نمط الكتابات الوافدة تمامًا ومن منطلقها وحتى ما ينشر منها باللغة العربية أو باللغات المحلية لا يكاد يخرج في معظمه عن كونه ترجمة مباشرة أو غير مباشرة للفكر الغريب بكل ما فيه من غث وثمين، بل وتعارض واضح أحيانًا مع نصوص الدين.
ولقد عرض ذلك نفرًا من الناس في شرقنا المسلم لشيء من التمزق الفكري بين ما تؤكده عقيدتهم وما يملأ كتب العلوم التي بين أيديهم من أخطاء تنسب زورًا إلى حقائق العلم، والعلم والحقيقة منها براء.
ونظرًا لطغيان الفكر المادي على الكتابات العلمية فقد ضاعت الأصوات القليلة المنادية بالحق وسط ذلك الطوفان الذي تميز بفتنة كبيرة بالعلم والتقنية، ومبالغة في غرور الإنسان بنفسه وبقدرته على مواجهة الطبيعة، والاعتداد بعلمانية التفكير في شتى نواحي الحياة.
وعلى الرغم من ذلك كله فقد برزت جهود فردية لكتابة العلوم من منطلق إيماني صادق أمثال كتابات الأساتذة والدكاترة إبراهيم فرج، محمد أحمد الغمراوي، محمد محمود إبراهيم، خطاب محمد، مالك بن نبی، وحید الدین خان، محمد السعيد كيرة، أحمد عبد السلام الكرداني، محمد جمال الدين الفندي، عبد الرزاق نوفل، أحمد زكي، حنفي أحمد، مصطفى محمود خالص كنجو، حسن زينو، عفيف طبارة قيس القرطاس «من كتاب العرب»، سير جيمس جينز، أ. كریسی موریسون، الكسيس كاريل، جراهام كانون، ألبرت أينشتاين «من الكتاب الأجانب» بالإضافة إلى أربعين متخصصًا أمريكيًّا استكتبهم جون كلوفر مونسما في مؤلف حرره تحت عنوان «الله يتجلى في عصر العلم» نقله إلى العربية الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان وراجعه الدكتور محمد جمال الدين الفندي.
وهذه المؤلفات في غالبيتها تدور في إطار الكتابات العلمية العامة أو الكتابات الفلسفية البعيدة عن مجال التدريس والبحث العلمي، وهنا يبرز كتاب أستاذنا الدكتور إبراهيم فرج في مجال علم الأرض، وكتاب الأخ الدكتور خالص كنجو في مجال الطب «وأولهما مرجع جامعي والثاني رسالة لدرجة الدكتوراه» عملان رائدان على الطريق لإعادة كتابة العلوم من وجهة النظر الإسلامية.
وفيما عدا ذلك تبقى كتب العلوم التي بين أيدينا ومراجعها، ودورياتها ومختلف نشراتها منطلقة من منطلق مادي بحت، منكر أو متجاهل لكل ما هو فوق المادة ومن هنا أتت مليئة بالتعبيرات الخاطئة في حق العلم وحق الإيمان معًا.
وعلى سبيل المثال لا الحصر أورد هنا بعض نماذج لأخطاء شاعت في الكتابات العلمية نتيجة لانطلاق تلك الكتابات من خلفية مادية بحتة، وهي أخطاء تتردد على أنها من حقائق العلم الثابتة بينما نظرة متفحصة لها تؤكد بعدها عن الحقيقة وتورطها في الضلال. ومن أمثلة تلك الأخطاء:
١- الادعاء بأزلية العالم:
وهو افتراض قديم تنادي به زعماء الإلحاد وأدعياؤه على الرغم من أن العلم يثبت أن هذا الكون مستحدث فإن كانت له في الأصل بداية، ولا بد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية، فمن المعروف اليوم أن العناصر في مجرتنا قد تكونت في الفترة من سبعة آلاف إلى ستة آلاف مليون سنة مضت، وأن الشمس قد تكثفت على هيئتها الحالية منذ ستة آلاف مليون سنة، وأن الكواكب الابتدائية قد تحولت إلى كواكب عادية منذ حوالي خمسة آلاف مليون سنة، وأن الفصل الكيميائي في أجسام الكواكب قد تم منذ أربعة آلاف وخمسمائة مليون سنة، وأن القشرة الخارجية للأرض قد جمدت علي هيئة صخور منذ أربعة آلاف مليون سنة، وأن أقدم أثر للحياة على الأرض يرجع إلى ثلاثة آلاف مليون سنة، وأن الحياة قد ازدهرت على الأرض منذ ستمائة مليون سنة، بينما يقدر عمر أقدم بقايا للإنسان على الأرض بأقل من مليون سنة كذلك فإن قانون الطاقة المتاحة يثبت أن الكون لا يمكن أن يظل موجودًا إلى الأبد لأن الحرارة تنتقل دائمًا فيه من وجود حرارى إلى وجود غير حراري والعكس غير ممكن وبذلك لا بد من أنه سيأتي على هذا الكون وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات وحينئذ تنتهي العمليات الكيماوية والطبيعية وتنتهي تلقائيًّا الحياة. وانطلاقًا من ذلك فإن وجود الحياة الآن واستمرار العمليات الكيماوية والطبيعية يثبت بطريقة قطعية أن الكون لم يكن أزليًّا، إذ لو كان كذلك لكان من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد، ولما بقي فيه بصيص من الحياة إلى اليوم، وهنا يتقدم أحد العلماء الأمريكيين المعاصرين فيقول: وهكذا أثبتت البحوث العلمية- دون قصد- أن لهذا الكون بداية فأثبتت تلقائيًّا وجود الله، لأن كل ذي بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته ولا بد أن يحتاج إلى المحرك الأول ألا وهو الخالق العظيم. (٤٦)، (٤٧)
۲- قوانين المادة والطاقة:
من وضعها؟ وهل يعقل أن تكون المادة الصماء هي التي وضعت القوانين التي تحكمها وتحد من حريتها وإذا لم يكن ذلك معقولًا، أفليس من الأفضل أن تسمى فطرة المادة التي فطرها الله عليها حتى يستقيم تعريفنا لها؟ فمن تلك القوانين ما ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وكذلك الطاقة بينما يعلمنا الإسلام بأن الله- جلت قدرته- قد أوجدها كلها من العدم فقد كان- سبحانه وتعالى- ولم يكن معه شيء ويؤكد لنا العلم أن هذا الكون كانت له في الأصل بداية وسوف تكون له في يوم من الأيام نهاية كما سبق أن أسلفنا وعلى الرغم من كل ذلك نرى هذين القانونين للمادة والطاقة يرددان في مختلف الكتب وعلى مختلف المستويات وهما بمنطوقهما الحالي وعقيدته. ويمكن أن يستقيم منطوق هذين القانونين بجملة تصحيحية بسيطة كما يلي: في حدود طاقة الإنسان المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وكذلك الطاقة.
أما قدرة الخالق- سبحانه وتعالى- الذي أوجد كل شيء من العدم فلا تحدها حدود وربما كان كثير من العلماء المسلمين الذين كتبوا هذين القانونين أو تحدثوا عنهما مؤمنين تمامًا بهذا الفهم ولكنه التقليد للكتابات الغربية والنقل الحرفي بلا تصرف وأمثال ذلك كثير كثير.
٣- التحدث عن حقيقة الطبيعة وقوانين الطبيعة:
وهذه عبارات قد نقلت إلى كتابات المسلمين دون وعي حقيقي لأبعادها، فما هي الطبيعة؟ وما هو تعريفها؟
يختلف العلماء في تعريف الطبيعة فمنهم من ينادي بأنها الصفات الأساسية للأشياء ومنهم من يقول بأنها القوى الطبيعية التي تسبب ظواهر العالم المادي. وهنا يبدو واضحًا أنه قد يكون من الأفضل أن تسمى فطرة الله التي فطر الأشياء عليها أو أنها مجموع القوانين التي وضعها خالق الكون وأودعها المادة الصماء وكل الأحياء، وعلى أساسها يدور الكون كله من أدق دقائقه إلى أعظم وحداته. وفي ذلك يقول أحد العلماء الأمريكيين (٤٦) أن الطبيعة لا تفسر شيئًا من الكون، وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير... فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانينًا؟؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه الصورة المفيدة المدهشة حتى أن العلماء يستطيعون أن يستنبطوا منها قوانين علمية؟ (۹)
والحقيقة أن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس سوى خدعة لنفسه- فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة الأخيرة ثم يزيد- ومن المستحيل أن يتحقق وجود هذا النظام المدهش باتفاق محض فقد صار حتمًا علينا بعد هذه المشاهدات أن نؤمن بأن الله يعمل بقوانينه العظمى التي خلق بها الحياة. فهي إذن قوانين الله وسننه وليست قوانين الطبيعة.
٤- الادعاء بأن أصل الحياة عملية مادية بحتة حدثت بمحض الصدفة:
وهو ادعاء كثر تردده مؤخرًا وجاوزت الكتابات فيه حدود المنطق، فقد انفردت مجموعة من الكتاب وعلى رأسهم الكاتب الروسي أ. ى. أوبارين بحمل لواء الادعاء الباطل بأن أصل الحياة تفاعل كيميائي حدث بمحض الصدفة دون تخطيط مسبق، وتحدثوا عن التطور الكيميائي كعملية سبقت التطور العضوي وحاولوا في جهود مستميتة تفسير إمكانية نشأة الحياة عن طريق ذلك التفاعل الكيميائي، ولكن هؤلاء قد تناسوا قدرًا هائلًا من الحقائق التي لو تفحصوها بدقة ما انزلقوا إلى ما تهادوا إليه، ولتكشفت لهم الأمور بصورة أصدق ويكفي أن نسطر في هذا المعرض ما يلي:-
ا- من الثابت علميًّا أن الخلايا الحية تتركب من مادة هلامية تعرف باسم البروتوبلازم وهذه المادة تتركب بدورها من جزئيات معقدة لمركب كيماوي يعرف باسم البروتين، وجزئ البروتين بدوره يتكون من سلاسل طويله من الأحماض الأمينية وهذه يدخل في تركيبها خمسة عناصر رئيسية وهي الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت وأن الجزيء البروتيني الواحد يحتوى على ما يقرب من أربعين ألف ذرة من ذرات هذه العناصر والتي يمكن تجميعها في حوالي (۱۰) ٤٨ صورة وطريقة، وقد حسب رياضيًّا أن تكون جزئ بروتيني واحد عن طريق الصدفة يتطلب مادة تبلغ بليون ضعف مادة الكون الحالية كلها، بحجم يزيد محيطه عن (۱۰) ۸۲ سنة ضوئية وفي زمن يزيد عن (۱۰) ٢٤٣ بليون سنة «أي بلايين الأضعاف المضاعفة لعمر الأرض التي نعيش عليها والذي يقدر بخمسة آلاف مليون سنة ثم أن من الفرص المتاحة لتجمع ذرات الجزيء البروتيني ما يجعلها سمًّا زعافًا أو مادة صالحة لتقبل الحياة، والاحتمالات في هذا المجال أكبر من أن تسجل فكيف إذن قدر لهذه المادة الصماء أن تختار بذاتها الصورة والطريقة التي تسمح لها بأن تكون صالحة لتقبل الحياة؟؟ ثم إن هذا الجزيء البروتيني في حد ذاته ذو وجود كيماوي لا يتمتع بالحياة.. فكيف إذن دبت فيه الحياة وهو جزء من الخلية الحية؟ وكيف ظهرت الحياة على هيئة مليون نوع من أنواع الحيوان وأكثر من ربع مليون نوع من أنواع النبات على ظهر الأرض في مدة قصيرة نسبيًّا؟ (۱)
ب- منذ مطلع القرن الحالي والمحاولات العديدة تبذل لاستحداث الحياة في مركبات صناعية لها نفس التركيب الكيميائي للخلية الحية ولكن باءت كل هذه المحاولات بالفشل وذلك لجهل العلم التجريبي بسر الحياة ذاتها.
ج- إنه من المعروف اليوم أن بجسم الإنسان- وهو أرقى المخلوقات- أكثر من ألف مليون خلية في المتوسط، تتجدد منها في كل ثانية من عمره ١٢٥ مليون خلية تقريبًا. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن خلايا جسد الإنسان تتجدد كلها مرة في كل عشر سنوات تقريبًا، وهذا يعني أن يبقى الإنسان في الداخل كما كان من قبل بقدراته الذهنية ومواهبه المختلفة وعلمه وحافظته وصفاته الشخصية المميزة وعاداته وأمانيه وأفكاره وعواطفه... تبقى كلها كما كانت دون أن تتأثر بتبدل جسده التدريجي.. أنه يشعر أنه هو هو نفس الإنسان الذي وجد منذ عشرات السنين ولا يحس بأن شيئًا من حقيقة وجوده قد تغير وهذا المثل وحده كاف ليقطع بأن في الإنسان شيئًا آخر أخطر من هذا الجسد وهو الذي يحدثنا عنه الإسلام بأنه الروح، ولما كانت الروح أمرًا غير مادي فلا يمكن للعلم التجريبي أن يتمكن من التعرف على حقيقة كنهها وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. (الإسراء:85). (٩، ٣٧، ٣٩)
د- على الرغم من ذلك كله فإن الإسلام يمنع من التصدي للإجابة على جميع التساؤلات بكل الأساليب المشروعة ومنها الأسلوب التجريبي وفي ذلك نجد التنزيل ينطق﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (العنكبوت:20).. فالإسلام لا يمانع في البحث في أصل الحياة وكيف بدأت ولكنه يلزمنا بالإيمان بما يقتضيه المنطق بأن هذه المادة الصماء لا يمكن أن تكون قد تحولت إلى مادة حية بمحض إرادتها أو بمجرد الصدفة.
ه – تفسير نشأة الحياة وتطورها على أنها تمت تلقائيًّا بالانتخاب الطبيعي: وما صاحب ذلك من تعبيرات مثل- الانتخاب الطبيعي-، التطور بالانتخاب الطبيعي -،- انتخاب الطبيعة وهي عبارات انتشرت في كتابات المشتغلين بعلوم الحياة عامة وبقضية التطور بصفة خاصة ولكن دون فهم حقيقي لمدلولها، فمن الذي يختار أو ينتخب؟ هل هي الطبيعة؟
وإذا كان ذلك فما هي الطبيعة؟ وما هي قدرتها على الاختيار؟ هل هي كيان عاقل يمكنه أن يختار وينتخب؟ وإذا كان كذلك؛ فهل يعقل أنها قد أوجدت نفسها بنفسها ثم وضعت من القوانين ما يحدها ويحيط بها؟ هذا كلام لو دقق فيه الإنسان ما قبل أن يردده أبدًا. ولكن على الرغم من ذلك فإننا نجد هذه العبارات وأمثالها تملأ صفحات كتب العلوم، وتردد في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والفلسفية بل تتناقلها الصحف والمجلات والمنابر والإذاعات دون أن يحاول كاتبوها أو الناطقون بها أن يقفوا عندها وقفة قصيرة متبصرة.
ولو استعيض عن ذلك بالتعبير «تطور بواسطة التوجيه الإلهي» أو تطور بواسطة الانتخاب بالفطرة الإلهية فضلًا عن الانتخاب الطبيعي لكان أقرب إلى تفسير الواقع وفي ذلك يقول أحد العلماء الغربيين المعاصرين: إن الاستدلال بقانون الانتخاب الطبيعي قد يفسر عملية بقاء الأصلح ولكنه لا يستطيع أن يفسر حدوث هذا الأصلح- ويقول آخر أن الانتخاب الطبيعي كان في عمل العلماء أنفسهم- (٩)
يتبع