العنوان فتاوى المجتمع- العدد 2160
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 01-أكتوبر-2021
مشاهدات 17
نشر في العدد 2160
نشر في الصفحة 60
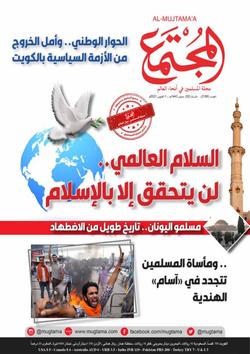
الجمعة 01-أكتوبر-2021
الإجابة للدكتور
عجيل النشمي حفظه الله
المعيار الشرعي لاختيار الزوج
• فتاة تقول: إنه تقدم لخطبتها أكثر من شخص، وتسأل: ما المعيار الشرعي لاختيار الزوج؟ هل هو الخُلُق أو الدين أو المال أو النسب أو الوجاهة؟
- معيار اختيار الزوج هو الدين والخُلُق، أما المال والنسب والوجاهة فأمور تابعة أو ثانوية وجودها أفضل من عدمها، لكن المعيار هو الدين والخُلق وحُسن المعاملة والعِشرة، وذلك لقوله صلوات الله وسلامه عليه: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فانكحوه»، وكلما كان هناك تقارب بين مستوى الزوج والزوجة كان أفضل، والتقارب أو التكافؤ مطلوب بالنسبة للمال والنسب والوجاهة أو المستوى الاجتماعي، كل ذلك أدعى لحُسن العِشرة بينهما، وإذا انعدمت فلا تمنع من قبول الزواج إذا توافر الدين والخلق.
ظهور آثار النعمة على العبد
• رجل وسَّع الله عليه بالخير الكثير، ولكنه يقتر على نفسه، ولا يظهر بمظهر حسن ويقول: إن هذا من التقشف الذي أمر به الإسلام، فهل هذا جائز؟
- إذا أنعم الله تعالى على امرئ نعمة فينبغي أن يظهر أثرها عليه، لقوله تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} (الضحى: 11)، ولما روى فضلة بن مالك الحبشي قال: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني سيئ الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل لك من شيء؟»، قال: نعم، من كل المال قد أتاني الله، فقال: «إذا كان لك مال فليُرَ عليك»، (سنن النسائي، 1998)، وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده..» (التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي، وقال: الحديث ضعيف عن الموسوعة 170/5)، والإسلام يرغب في المسلم أن يكون وسطاً بين الإسراف والتقتير، أو بين البذخ والتقشف، والإسلام لا يقبل التقشف الذي يعود على صاحبه بالضرر في صحته، أو ضياع حق من يعولهم، أو حق الفقير والمسكين.
نفقة الزوجة إذا غادرت البيت
• سيدة خرجت من بيت زوجها وذهبت إلى بيت أهلها مدعية أنها لا تأمن على نفسها وبناتها بسبب أن زوجها سيئ السلوك ويأتي ببعض زملائه السيئين إلى البيت، ولما ذهبت إلى بيت أهلها امتنع الزوج عن دفع مصروفاتها مع أولادها، فما حكم الشرع في ذلك؟
- إذا كان خروجها بسبب خوفها كما تقول على نفسها وبناتها فلها النفقة ويلزم الزوج بها، ولا تعدّ الزوجة ناشزاً في هذه الحال، والأمر عند النزاع يحتاج إلى حكم القاضي.
الاستعاذة عند قراءة القرآن
• قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}(النحل: 98)، يفهم من الآية أننا دائماً إذا أردنا أن نقرأ القرآن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان كذلك فلماذا لا يفعل ذلك كثير من قراء القرآن الكريم؟
- جمهور الفقهاء، قالوا: إن الآية لا تفيد وجوب الاستعاذة، بل تفيد أن الاستعاذة مندوبة، وقالوا: إن الذي منع الوجوب هنا هو إجماع السلف على أن الاستعاذة سُنة، ولأنه رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الاستعاذة، بل كان يتركها أحياناً، وفي هذا إشارة في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» (رواه مسلم، 307/1).
تفاوت الشريكين بالربح
• أنا وزميل لي شريكان في شركة، وكل منا شارك في نصف رأس المال، فهل يجوز أن نتفق بالتراضي على أن أحدنا يأخذ ربحاً أكثر من الآخر؛ مثلاً يأخذ واحد الثلث والآخر الثلثين؟
- الفقهاء مختلفون في هذا، فمذهب الحنفية والحنابلة أن الربح بين الشريكين على حسب ما يتفقان عليه، فيجوز أن يتساويا في الربح مع تفاضلهما واختلافهما في نسبة رأس المال، ويجوز أن يتفاضلا في الربح مع تساويهما في رأس المال، وذهب المالكية والشافعية أن شرط صحة الشركة أن يكون الربح بينهما على قدر مشاركة كل واحد منها في رأس المال، فإذا تساويا في المشاركة في رأس المال فيكون الربح بينهما حسب تفاضلهما، وعللوا لذلك بأن الربح هو ثمرة اشتراك المالين، فلا يجوز أن يشترط أحدهما ربحاً أكثر من نصيبه في المال، بغض النظر عن تساويهما في العمل أو تفاوتهما في العمل بأن يكون أحدهما أقوى على العمل وأكثر قدرة على إدارة الشركة وأكثر خبرة في العمل التجاري، لكن لو أن أحدهما تكفل بإدارة الشركة لكونه مثلاً متخصصاً أو متفرغاً فينبغي في هذه الحال أن يُعقد بينهما عقد آخر مستقل عن عقد الشركة، وينص فيه على استحقاق هذا الشريك بنسبة معينة نظير الإدارة.
الإشهاد عند مراجعة الزوجة
• سيدة زوجها طلقها ثم راجعها قبل أن تنتهي العدة، ولكنه لم يحضر شهوداً على الرجعة، وقيل لها: إن هذه الرجعة باطلة إلا إذا أحضر شهوداً على ذلك، فما الحكم الشرعي؟
- جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين ذهبوا إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب، وذلك لأن الرجعة من حقوق الزوج، فهي حينئذ باختياره، ولا يشترط قبول المرأة، فلا يشترط أيضاً الإشهاد حتى تكون صحيحة، وقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} (الطلاق: 2)، المراد بطلب الإشهاد ليس الوجوب، بل المراد الندب، فالإشهاد مندوب لقطع النزاع عند اختلاف الزوجين في حدوث الرجعة.
الخطبة على خطبة آخر
• شخص يقول: إنه تقدم لفتاة ليخطبها فتمت الخطبة، ثم تبين أن الفتاة مخطوبة، فهل عليه إثم في هذه الحالة؟
- نقول للأخ: إنه ما دمت لا تعلم بالخطبة الأولى فلا شيء عليك، وإنما تحرم الخطبة على الخطبة إذا علم الخاطب الثاني بخطبة الأول، وتكون خطبة الأول مقبولة بأن يجيبوه إلى خطبة ابنتهم، ويقبل أو يرفض أو يترك، أو يأذن الخاطب الأول للثاني حينما يتقدم.
• تاجر غنم يقول: هل يجوز أن يبيع الماعز دون ولدها المحتاج إليها لحداثة ولادته، ولكنه يعوضه عن أمه بحليب صناعي؟
- نص المالكية على جواز التفرقة بين الحيوان وولده المحتاج إليه، وذهب الشافعية وابن القاسم من المالكية إلى حرمة التفرقة إذا كان الولد محتاجاً لأمه لم يستغن عنها بالرعي وحده، ولذلك حرم الشافعية ذبح الأم إن لم يستغن ولدها عن لبنها ولا يصح حينئذ بيعها، وأما إن استغنى الولد عن لبن الأم فيكره ذبحها، وهذا سواء أكان الحيوان مما يؤكل أو من غير المأكول، وهذا يمنع أيضاً بيع الولد إذا كان من اشتراه إنما اشتراه ليذبحه، فإن شرط البائع على المشتري ذبحه صح البيع عند الشافعية، ومن خلال كلام الفقهاء هذا نقول للأخ السائل: إنه يكره بيع الأم دون ولدها المحتاج إلى لبنها إذا كنت متكفلاً بسقائه ما يعوضه عن لبن الأم ويحفظ حياته مراعاة لما يحدث هذا التفريق من هياج للأم وألم، ولاحتمال عدم قبول اللبن من غير أمه، وأما إن استغنى عن لبن أمه ولم يستغن عنها معه فلك ذلك، ولا كراهة في التفرقة ولا البيع، وأما إن كان البيع للذبح مباشرة فهذا جائز مجتمعين أو منفردين.حكم الوصية الواجبة
• ما حكم الوصية الواجبة في الشرع التي يقرها القانون الكويتي؟ وإذا كانت غير جائزة، فماذا يفعل من ورث من جده بعد وفاة والده وصرف هذه الأموال بجهل منه بالحكم الشرعي وعرف به لاحقاً؟
- تجب الوصية بحكم القانون لأولاد الابن الذي مات في حياة أبيه، أو أمه، وأولاد أبنائه، وأولاد أبناء أبنائه مهما نزلت درجتهم، وتجب أيضاً لأولاد البنت الصلبية التي ماتت في حياة أبيها أو أمها، ذكوراً كانوا أو إناثاً دون أولادهم.
فإذا مات رجل في حياة أبيه أو أمه، وترك أولاداً، أو أولاد أبنائه مهما نزلوا، فإنهم يستحقون وصية في تركة جدهم، أو جدتهم، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وإذا ماتت امرأة في حياة أبيها أو أمها، وتركت أولاداً؛ ذكوراً أو إناثاً، فإنهم يستحقون وصية في تركة جدهم، أو جدتهم، أما أولاد أولاد البنت فلا تجب لهم الوصية.
والوصية كما تجب لأولاد من مات في حياة أبيه أو أمه؛ ذكراً أو أنثى، فإنها تجب كذلك لأولاد من مات مع أبيه، أو أمه في حادث واحد، ولا يدري أيهما مات قبل الآخر، كما إذا غرقا معاً، أو هدم عليهما بيت فماتا، أو احترقا في وقت واحد، ولم يعلم أيهما مات قبل الآخر، وإنما وجب الوصية في هذه الحالة، لأن الفرع لا يرث من الأصل، بسبب عدم العلم بتحقق حياته عند موته، فتجب الوصية لأولاد ذلك الفرع، تعويضاً لهم عما كان يمكن أن يؤول إليهم لو أنه ورث.
والسند الفقهي في وجوب الوصية هو ما ذهب إليه جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، من وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين، استناداً إلى قول الله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 180)، إذ قالوا: إن الوصية للوارثين قد نسخت، وبقيت الوصية لغير الوارثين على حكمها، وهو الوجوب، والسند الفقهي في وجوب الوصية قضاءً إذا تركها من وجبت عليه، هو رأي ابن حزم الظاهري، وبعض فقهاء التابعين، ولقد قررت الوصية الواجبة في كثير من القوانين، منها قانون الوصية الواجبة الكويتي في 4 مواد لعام 1971م.>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل



