العنوان فقه الحدود في الإسلام
الكاتب حجازي إبراهيم
تاريخ النشر الثلاثاء 02-ديسمبر-1997
مشاهدات 16
نشر في العدد 1278
نشر في الصفحة 58
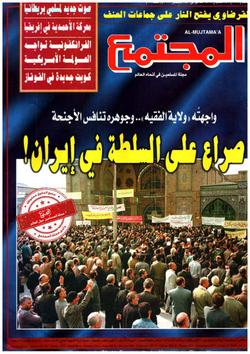
الثلاثاء 02-ديسمبر-1997
▪ العقوبة يجب أن تكون رادعة وزاجرة حتى تجتث جذور الرذيلة وتمنع الجريمة من المجتمع
▪ ومع ذلك حرص الإسلام على تضييق دائرة الحدود بما كان يتم من مراجعات للمُقر والمُعترِف
صدر بيان عن برلمان الاتحاد الأوروبي يستنكر على دولة الإمارات العربية المتحدة الحكم بإعدام مجرمين قتلا ستة أشخاص بطريقة مروعة، حيث كانا براقبان ضحاياهما من المتعاملين مع البنوك، وعندما يخرج الضحية يوهمانه بأنهما من رجال الأمن ويقتادانه إلى مكان خال بعيد في الصحراء، ويأخذان ما عنده من نقود ويطلقان على رأسه الرصاص ويدفنانه في الرمال وقد اعترفا بجرائمهما في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة ومثلا الجريمة ودلا بنفسيهما على أمكنة قتل ودفن المجني عليهم، وقد قامت الدولة بالرد المناسب، كما نشر بالصحف استنكار حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا البيان، ونحن بدورنا نحاول بموضوعية أن نبين هذا الجانب المهم في التشريع الإسلامي، ألا وهو الحدود في الإسلام.
الإسلام يعني بطهارة المجتمع:
إن الإسلام يعني بنظافة المجتمع وطهارته وسلامة الأعراض والأخلاق، والمحافظة على الأموال، ويحرص أشد الحرص على أن تعم الطهارة نواحي المجتمع، ومن ثم شرع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة آل عمران: 110).
وينتشر الخير ويعم المعروف بين الناس، وتجتث بذور الشر من جنيات المجتمع، إلا من فئة قليلة تأصل الشر في نفوسها، وضرب بجذوره في أعماقها فلم يعد يجدي معها العظة، ولا ينفعها القول البليغ ومن ثم باتت مصدر خطر يهدد أمن المجتمع واستقراره.
ولحماية المجتمع من تلك الفئة، شرع الإسلام الحدود بما فيها القصاص قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (سورة البقرة: 178 – 179).
الحكمة في الحدود: وحين أوجب الإسلام هذه الحدود، إنما أراد الحفاظ على وجه الحياة المشرق لسائر أفراد المجتمع بما فيها المجرمون.. ولم يرد بذلك إهدار إنسانية أحد ولا تقييد حريته.
لقد شرع الله هذه العقوبات للذين يعتدون على الأعراض، وينتهكون الحرمات، والإسلام لم يهنهم ابتداء، وإنما هم الذين أهانوا أنفسهم، وأهدروا كرامتهم يوم أن سولت لهم أنفسهم أن يعتدوا على أعراض الآخرين وحرماتهم وأموالهم، كما أن الإسلام لم يتدخل في حرياتهم ولم يحد منها إلا بعد أن أضرت بالمجتمع وأذت الآخرين.
وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة: 179)أي لعلكم تتقون القتل فتسلمون من القصاص «1».
قسوة العقوبة تتناسب مع قسوة الجريمة: إن القول بقسوة بعض العقوبات لما فيها من بتر وقطع لبعض الأعضاء إنما هو محض افتراء، لأن القائلين بذلك يحنون على المجرم، مع الإغفال التام للمجني عليهم، وكان عليهم أن يتصوروا فعل السارق وهو يدخل على الآمنين في بيوتهم من نساء وأطفال ورجال، وبيده السلاح يزهق روح من يقاومه، ويسلب المتاع، وينهب الأموال، ويريق الدماء ويلقي بالرعب والفزع والهلع في النفوس، إنهم لو تصوروا ذلك، أو حدث لهم مثله لما أسفوا على قطع اليد الآثمة.
ومثل ذلك يقال عن قطاع الطريق الذين يتربصون بالمارة ويهاجمونهم ويسلبونهم أموالهم وأرواحهم، وكذلك القتلة المعتدين على حياة الآخرين، إن العقوبة معاملة بالمثل ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ (سورة البقرة: 194).
شروط عقوبة الردع والزجر: إن العقوبة يجب أن تكون رادعة وزاجرة حتى تجتث جذور الرذيلة وتمنع الجريمة من المجتمع، وهذا لا يتحقق إلا في العقوبات التي شرعها الإسلام، لأنها من وضع رب الناس الذي يعلم ما فيه زجرهم وردعهم:
﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (سورة الملك: 14)
وأما العقوبات التي يضعها البشر من حبس وغرامات فلا تملك هذا القدر من الردع، ودليل ذلك الواقع فإن جرائم السرقة في ازدياد، ولم تقللها عقوبة الحبس، بل إن السجن صار نزلًا لأصحاب السوابق يترددون إليه، ويعتبرونه مأوى أمينًا لهم، بل ومحلًا للقائهم، وتبادل خبراتهم في عالم السرقة والإجرام، ويوم أن قام الإسلام وطبقت أحكامه أمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، حتى إن الراكب ليسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى أحدًا.
ولعل هذا ما حدا ببعض البلاد التي كانت قد ألغت عقوبة الإعدام أن ترجع عن إلغائها، لأنها لم تر في العقوبة البديلة ردعًا ورجزًا للمجرم.
فتح باب المتاب
ومن رحمة الله بعباده أنه يقبل التوبة ممن اقترف حدًا، أو ارتكب ذنبًا قال الله تعالى في حق قُطاع الطريق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة المائدة: 34)
وقال في حق السرقة: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة المائدة: 39).
الحدود كفارة وطهارة: والإسلام لا يقيم الحد إلا إذا ثبت بأدلة قطعية لا تحتمل الشك، وفي بعضها يتعذر أن تتحقق في الواقع، على سبيل المثال حد الزنى لا بد له من أربعة شهداء يرون ذلك رأي العين وهيهات أن يتحقق ذلك، عن واصل عن المعرور قال: أتي عمر بامرأة قد زنت- فذكر الحديث قال ثم قال عمر: إنما جعل الله أربعة شهداء سترًا يستركم دون فواحشكم فلا يتطلعن ستر الله أحد، ألا وإن الله لو شاء لجعله واحدًا صادقًا أو كاذبًا، قال الشافعي: ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ولا يعود لمعصية الله، فإن الله يقبل التوبة عن عبادة «2».
فالحدود كفارة وطهارة لأصحابها، ولذلك كان جل الحدود التي أقيمت بالإقرار من أنفس مؤمنة بالآخرة، راغبة في التطهر من ذنبها في الدنيا لتنجو من عذاب الآخرة.
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله طهرني فقال: ويحك أرجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله ﷺ ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي ﷺ مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ﷺ أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، قال: فقال رسول الله ﷺ: أزنيت فقال: نعم فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز إنه جاء إلى النبي ﷺ فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله ﷺ وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله ﷺ: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي، إليه، فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنى، فقال: أنت؟ قالت: نعم، فقال لها حتى تضعي ما في بطنك، قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي ﷺ فقال: قد وضعت الغامدية، فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه مقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها «3».
روي أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إني سرقت جملًا لبني فلان، فطهرني، فأرسل إليهم النبي ﷺ فقالوا: إنا افتقدنا جملًا لنا، فأمر به النبي ﷺ فقطعت يده، قال ثعليه: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار «4».
درء الحدود بالشبهات
والإسلام ليس كما يرميه البعض متعطش للدماء، تواق لتقطيع الأطراف، يهدر إنسانية الإنسان، وإنما جاء الإسلام يحمل التكريم الحقيقي للإنسان: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (سورة الإسراء: 70)، كما أن فيه الصيانة التامة لدمه وماله وعرضه بما شرّع من حدود لا يقيمها إلا إذا لم يجد مخرجًا لدفعها، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة».
وتلمح حرص الإسلام على تضييق دائرة الحدود المقامة بما كان يتم من مراجعات للمقر والمعترف، وكان أشبه بالتلقين بالرجوع عن إقراره، بل سماء بعض العلماء استحباب تلقين المقر بالحد بأن يستر على نفسه ويكفي أن يتوب منه ويستغفر.
حدث أبو أمية أن رسول الله ﷺ أُتي بلِص، فاعترف اعترافًا، ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله ﷺ «ما إخالك سرقت» قال: بلى، ثم قال: «ما إخالك سرقت» قال: بلی، فأمر به فقطع فقال النبي ﷺ: «قل: أستغفر الله وأتوب إليه» قال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: «اللهم تُب عليه» مرتين «5».
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إن رجلًا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- فقال إن الآخر «6» زني، فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا: قال أبو بكر فتُب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل عن عباده، فلم تقره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب، فقال له كما قال لأبي بكر، فقال له عمر كما قال له أبو بكر، فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله ﷺ فقال: إن الآخر زنى قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله ﷺ مرارًا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا كثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي به جنة؟ قالوا: والله إنه لصحيح، فقال رسول الله ﷺ: أبِكر أم ثيب؟ فقالوا بل ثیب، فأمر به رسول الله ﷺ فرجم «7».
يقول الإمام ابن حجر: ولقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب.
وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي ﷺ اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه، وقال أيضًا: في هذا الحديث إنه لا يكشف عن الحدود، بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه، فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد، فلم يكشفه النبي ﷺ عن ذلك لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسس المنهي عنه، وإما إيثارًا للستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعًا، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ الحد.
يقول الإمام النووي: فيه استحباب تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك، لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء، بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه، وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ﷺ وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه «8».
وقيل للناس في هذا الحديث ثلاثة مسالك.
أحدها: أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به.
الثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة.
الثالث: أن الحد يسقط بالتوبة، قال: وهذا أصح المسالك، وقواه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها، لأن حكمة الحدود الردع عن العود، وصنيعه ذلك دال على ارتداعه، فناسب رفع الحد عنه لذلك، والله أعلم «9».
الهوامش
«1» الجامع لأحكام القرآن 2 / 172.
«2» سُنن البيهقي 8 / 330.
«3» مسلم بشرح النووي 11 / 199 / 1695.
«4» سُنن ابن ماجه 2 / 863 /2588.
«5» سُنن ابن ماجه 2 / 866 / 2597
«6» الآخر: معناه الأرذل والأبعد والأدنى. وقيل: اللتيم. وقيل: الشقي وكله متقارب. النووي على مسلم 11 / 195.
«7» سُنن البيهقي 8 / 238.
«8» النووي على مسلم 11 / 195.
«9» فتح الباري 12 / 134 بتصرف.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل

