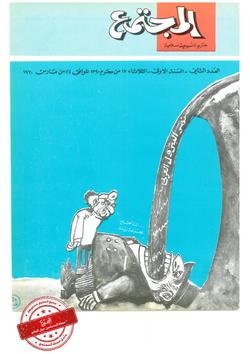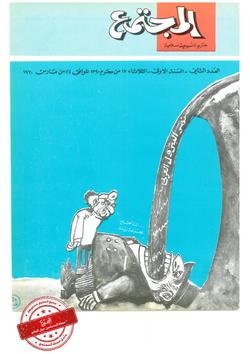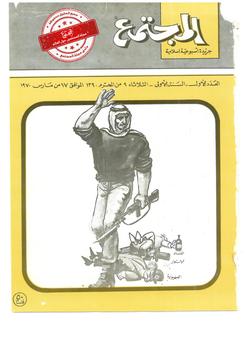العنوان كيف كان؟» رؤية في منهجية الفلسفة الإسلامية للتاريخ (2 - 2)..
الكاتب د. عطية الويشي
تاريخ النشر الأربعاء 01-مارس-2017
مشاهدات 688
نشر في العدد 2105
نشر في الصفحة 53
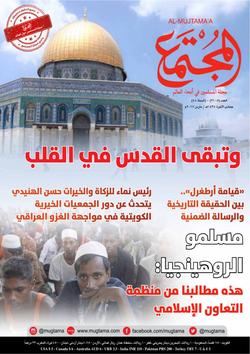
الأربعاء 01-مارس-2017
كيف كان؟» رؤية في منهجية الفلسفة الإسلامية للتاريخ (2 - 2)..
تفسير الحوادث التاريخية
«كيف كان» نوع من الإثارة الدائمة للذاكرة البشرية وتجديد حيوي في التفسير الفلسفي للتاريخ
الوعي بكيفية التاريخ يغنينا عن اختصاراته المُخِلّة ويكفينا تفصيلاته المُمِلّة
كانت «كيف» فتحاً منهجياً في حقل تفسير التاريخ وفلسفته بما يحقق غاياته المعرفية ومقاصده التربوية
الدرس التاريخي كان أحَدَ الموضوعات في لقاءات جبريل والنبي في كل موسم دراسي بينهما حول القرآن الكريم
حين يتحدث الوحي عن الإنسان يجعله عَلَماً على الزمان تارة ويجعل من الزمان عَلَماً عليه تارة أخرى
من لطائف الدلالات التاريخية للفعل «كان» كإعراب عن كينونة الماضي الناقص، تلك الدلالة التي تبعث على التأمُّل المتفلسف(1): أنَّ «كان» المُخبِرَةَ إذا سُبِقَتْ بِـ«كيف» المستفسرة عن أحوال الماضي، المتأملة فيه، المستنطقة أسراره، فَثَمَّ الحَثُّ القرآني على تعبير التاريخ وتفسيره وعَبْرَنَتِهِ وفلسفته؛ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ) (الروم:٤٢)، وقال تعالى: (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ {51} فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {52}) (النمل).
إذا أخذنا بمذهب القائلين بأنَّ «كان» تُذكر كدلالة على الزمان مجرداً من الحدث؛ فإنَّ ذلك يفتح للعقل منافذ أوسع لاستعمال التفكير الكيفي في تفسير الحوادث التاريخية، ويجعل المؤرّخ في حِلّ من الارتهان بحادثة واحدة؛ كوحدة للقياس والإسقاط والتنزيل في تفسير التاريخ وروايته ودراسته، فالتاريخ ليس مجرد تراكمات خبرية بحوادث مجردة أو واقعات عارضة ومنفصلة عن بعضها بعضاً بلا رابط.. كلا، بل إنَّ جوهر التاريخ: تُعَبّرُ عنه مجموعة من العلاقات التي تتكون منها ظاهرة العمران البشري وتطوراتها المتراكمة عبر امتدادات الزمان والمكان.
ولعلنا نلحَظُ أنَّ محاولة الإجابة عن السؤال الفلسفي التاريخي «كيف كان؟»، يمكن أن تُسهم في عقد نوع من المقاربات السببية والمقارنات التحليلية بين الأحداث التاريخية وبعضها بعضاً؛ قال تعالى: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) (الروم:٩)؛ وإنَّ «كيف» هنا تبحث عن تكاملية الخلفية التاريخية للأحداث باستجلاء علاقة التأثير التفاعلي المُتبادَل بين كافة العناصر المكونة للأحداث سواء المسببة لها أو الفاعلة فيها أو المنتهية بها وإليها تلك الأحداث، وقد سبقت الإشارة إلى قول الله تعالى مُخبِراً عن ثمود قوم عاد، مُرشِداً إلى بيوتهم كَمَظانّ لاستلهام الوعي واستقاء الخبرة التاريخية؛ (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ {51} فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {52}).
ونحن إذا أضفنا لفظة «عاقبة» للسؤال الفلسفي «كيف كان»؛ فسنجد في هذه العبارة القرآنية تمريناً للفكر الإسلامي على النظر المآلي من خلال الاستقراء المتكرر في كيفيات عواقب التجارب البشرية المتنوعة من خلال المنظور القرآني للتاريخ.
وفي سياقٍ آخر، نجد من خلال بيان قرآني مُقْتَضَب، ينوّه الوحي بما مَضَى من قوانين الربوبية الثابتة المُطَّردة في معاملة الأمم السابقة على امتداد التاريخ؛ (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ {137}) (آل عمران)؛ ولعل هذا التنويه الإلهي بالسنن هو أحد المفاتيح المهمة لإجابة السؤال التاريخي الجوهري «كيف كان؟» الذي ما فتئ الوحي يردده على الإنسان في غير مناسبة، مُدللاً على عنايته الخاصة بترتيب الوعي المعرفي بالتاريخ من خلال موردَيْنِ اثنين رئيسين:
الأول: النظر المتأمّل في الآيات المنظورة عبر امتداد آفاق الأرض والآلاء الكونية، وذلك من أجل الاستبيان والتحقُّق التاريخي والاستيثاق.
المورد الثاني: النظر في الآيات المسطورة عبر فضاء النص القرآني، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي «كيف كان»؟
ومن خلاصة المَوْرِدَيْن كليهما، تتشكل حركة عقلية أخرى موازية، حركة منشغلة بالمقابلة بين المسطور والمنظور، والمطابقة بين المعطيات التاريخية للذكر الحكيم، وما يستنتجه الإنسان من حصيلة السير في الأرض والنظر الاستقرائي في آثار الأولين.
إنها حركة التحرّي الدؤوب بحثاً عن الحكمة الموضوعية للحوادث، وتفتيشاً في أسرارها التي تهدينا إلى إجابات شافية عن المسائل التاريخية المطروحة باستفهاماتها الكيفية والكمية على السواء.
وإذا تأمّلنا التعبير القرآني المتعلق بكيفيات التاريخ «كَيْفَ كَانَ»، نجده يبحث باستمرار في السؤال الفلسفي للتاريخ حاملاً في طَيّاتِهِ إشارات الحَثّ على تَدَبُّرِ سببية الأحداث التاريخية، تلك السببية التي لم يُولِها أصحاب المطوَّلات التاريخية الشهيرة عنايتهم، ولم يجهدوا أنفسهم في تحقيق غايات السرد القرآني وتوضيح مقاصده من أجل تحقيق الوعي التاريخي النافي للغفلة، قال تعالى: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ {3}) (يوسف)، (لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ {7}) (يوسف).
فرغم التنويه بما تضمنه القرآن من «أَحْسَنَ الْقَصَصِ»، وبرغم التساؤلات النوعية والقضايا الحيوية التي أثارها الوحي وتعرّض لها وعلّق عليها من خلال تناوله عديداً من أنباء الرسل وقصص الأولين، بيد أنَّ غالبيةَ المؤرّخِين قد قَصروا عن بيان معالم تلك الأحسنية التاريخية القرآنية، ولم يُوَظّفوا دلالاتها التاريخية بما يشفي غليل السائلين في كل جيل ورعيل! وهو الأمر الذي جعل من «كيف كان» نوعاً من الإثارة الدائمة للذاكرة البشرية، وتجديداً حيوياً في حقل التفسير الفلسفي للتاريخ.
وهكذا، فإنَّ «كيف» ليست لفظة سؤالية مجردة، وإنما هي تعبيرٌ عن تساؤلات مُركَّبة تستصحب مع أجوبتها كافة الممكنات التفسيرية للحوادث التاريخية، وتفتح أمام الفؤاد البشري آفاق التأويل الكيفي المتأمّل بلا حدود ولا قيود، تعزيزاً لمنطق الوحي، الذي هو منطق الحكمة والموعظة الحسنة بكل تأكيد! فحِكْمَةُ الوعي التاريخي: أن تبحث دائماً في «كيف كان؟»، ولا شك أنَّ الوعي بكيفية التاريخ يغنينا عن اختصاراته المُخِلّة، ويكفينا تفصيلاته المُمِلَّة!
ولقد كانت «كيف» ولم تزل فتحاً منهجياً في حقل تفسير التاريخ وفلسفته بما يحقق غاياته المعرفية ومقاصده التربوية، من أجل إصلاح شأن الوجود وتعديل أوضاعه وترتيب أموره وأحواله؛ قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ {6} إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ {7} الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ {8} وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ {9} وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ {10} الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ {11} فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ {12} فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ {13} إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ {14}) (الفجر)، وقال: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ {1} أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ {2} وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ {3} تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ {4} فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ {5}) (الفيل)، فلنتأمّل قولَهُ تعالى: «أَلَمْ تَرَ»، وهو يستلفت نَظَرَ المتلقّي إلى آياتِ الله في أحداث التاريخ مشيراً إليه بالتفكُّرِ في كيفية حدوثها.
ألم تَرَ عاداً كيف أضحت ديارُها
وَمِنْ بَعْدِ عادٍ كيف دُمّرَ تُبَّـعُ؟(2)
ويجدر بي أنْ أسجّل خواطري المتعلقة بتفسير بعض الآيات التي تبدأ بمطلع سورة «الفيل» تفسيراً تاريخياً؛ فمن المعلوم أنَّ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، أي إنه لم يحضر حادثة الفيل، فكيف يقول الله تعالى له: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟!».
الراجح لَدَيَّ أنَّ الدرس التاريخي كان أحَدَ الموضوعات الحيوية في لقاءات جبريل والنبي في كل موسم دراسي بينهما حول القرآن الكريم، وقد صَحَّ عن ابْن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَوله بشأن هذه اللقاءات: «.. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ..»(3)، وليس أدَلّ على تلك المدارسات التاريخية من أنَّ لفظ «ألم تر؟» قد تكرر بدلالته «الكيفية» التي نعنيها في بِضْع وعشرين مناسبة؛ منها قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ {1})، وإنَّ هذا التكرار لم يكن في الآيات المسطورة فحسب، بل كان في «كمّية» الحوادث التاريخية المتراكمة التي تنطوي على هذا المعنى المتكرر، قال تعالى: (أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ) (الأنعام:٦).
لطيفة قرآنية ولفتة تاريخية
إذا تأمّلنا الآية الأخيرة التي تتحدث عن «القرون»، نجد أنَّ الوحي استعمل تعبير «القرون» للدلالة على «أمّة أو جماعة تعيش في عصرٍ أو زمانٍ واحد»(4)، وهو التعبير التاريخي الأوفق دلالة على امتزاج حياة الأمم والشعوب والحضارات والقبائل والجماعات الخالية بأحوالها وآجالها ومآلاتها؛ وهو ما يعني أنَّ حركة الزمان المرتبطة بحركة الإنسان وانتشاره في الأرض إنما هي في حقيقتها حركة تتناول موضوع الوعي المعرفي بالتاريخ البشري؛ (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {41} ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ {42} مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ {43} ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ {44}) (المؤمنون)، وهكذا، نجد الوحي حين يتحدث عن الإنسان فإنما يجعله عَلَماً على الزمان تارة، ويجعل من الزمان عَلَماً على الإنسان تارة أخرى في سياق تاريخي يتغيّا تذكرة أولو الألباب.
وإنَّ «القرون» بدلالاتها المتنوعة لتعكس لنا العبرة المبنية على تراكمات التجربة البشرية في الأجل الممتد، وهي ذات الدلالات التي تسمح لنا بتوظيف لواصق مصطلح «القرون» الواردة في القرآن في بناء أدوات القياس التاريخي المستند إلى السنن والقوانين المطردة في العمران البشري؛ فمثلاً لو تأمّلنا قوله تعالى: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً {17}) (الإسراء)، (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ {36}) (ق)، سنجد «كم أهلكنا»، في حَدِّ ذاتها، مُسَوّغاً للحكم باطّراد الحوادث التاريخية في هذا السياق؛ فالظلم ببديهة الحال يجعلنا نستحضر توقعات الهلاك الوشيك كتعبير عن مآلات الظالمين، ويجعل حدس المؤرخين أقرب إلى الصواب حين يرتبط نزول الهلاك وحلول الخراب بوقوع الظلم سواء من فاعليه أو الراضين به أو الساكتين عنه، وسواء نَصَّتْ كتب التاريخ على نهايات الأمم ومآلات الشعوب بسبب الظلم أو الذنوب أو الإجرام أو بسبب آخر، فهذه الأسباب راجحة على غيرها في تفسير مآلات الظالمين والمجرمين.
وقد ذهب ابن خلدون إلى أن «الظلم مؤذِنٌ بخراب العمران»(5)، وإلا لَما نعى الله على الأمم الهالكة خلوهم من بقية تعظهم وتنذرهم بأس ربهم؛ (فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ {116}) (هود)؛ وعلى هذه الوتيرة يسترسل الوحي ممعناً في الوعظ التاريخي، فيقول: (أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ {6}) (الأنعام).
وهكذا، نجد الوحي تارةً يُتْبِعُ «ألم تر» بِـ«كيف»، وهي إشارةٍ إلى أنَّ مجرد الحكي القصصي القرآني لم يكن مقصوداً بذاته، بقدر التحفيز الحثيث على البحث في كيفيات الحوادث التاريخية، واستنطاق أسرارها، والكشف عن حِكَمِها ومقاصدها ولطائفها، وبيان مواعظِها والعِبَرِ التي تنطوي عليها.
ثم نلحظ تارةً أخرى السياق يُتْبِعُ «ألم يروا» بِـ«كم»، لبيان مدى الاطِّراد الكمي المتمثل في الحوادث التاريخية، ومدى إمكانية الإفادة بهذا الاطّراد في تقييم الحوادث المتشابهة، وتعميم الحكم عليها من خلال إخضاعها لقوانين القياس التاريخي وسنن الاجتماع البشري.
الهوامش
(1) هذه مجرد مقاربات تأمُّلية تَصوَّرْتُها كمؤرّخٍ، دون مزايدة على جهود أهل الاختصاص اللغوي بطبيعة الحال!
(2) صفيّ الدين عيسى بن البحتري الحلبي (ت: بعد 625هـ): أنس المسجون وراحة المحزون، تحقيق: محمد أديب الجادر (دار صادر، بيروت، 1997م) ص329.
(3) أخرجه البخارِيُّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث رقم: 3220.
(4) أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل: معجم اللغة العربية المعاصرة (عالم الكتب، القاهرة، 1429هـ/2008م، جـ3، ص1805.
(5) عبدالرحمن بن خلدون: العِبَرِ، جـ1.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل