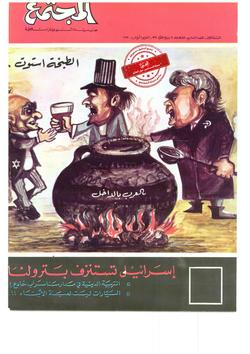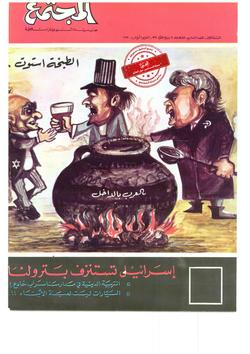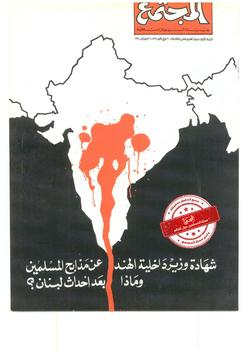العنوان محاولة لإلقاء الضوء على رسالة الشاعر
الكاتب عبد الرحيم حمودة
تاريخ النشر الثلاثاء 10-أكتوبر-1972
مشاهدات 19
نشر في العدد 121
نشر في الصفحة 14

الثلاثاء 10-أكتوبر-1972
هل يتعادل في الصفات من خارت قواه بعد معركة واحدة مع من يقاوم بالصمود والسير على مسالك من الأشواك والعذاب؟
في لقاء مع أحد أدباء هذا العصر والمعروفين بإيمانهم الكامل بالقيمة الفنية والفوائد المجدية لما يطرح بالمكتبات من دواوين شعرية وما ينشر من قصائد تتضمن المنهج الجديد في صياغة الشعر الحديث.. كان هذا اللقاء. وعلى قصره فقد خرجت منه بانطباع مفيد وجميل أعترف معه أنه يوجد - مع وضوح الرؤية - من الشعر الحديث ما يمكن أن يكون شعرا يؤدي الغرض الذي سيق من أجله والدور المطلوب منه. إلا أن هناك عبارة قد وردت على لسان محدثي الكريم وهي في حد ذاتها تحوي مضمونًا خطيرًا وفكرة قاصرة عن رسالة الشاعر وواجبه نحو وطنه وأمته.
والصيغة اللازمة له تلك العبارة هي:
«أن الشاعر الجاد هو الإنسان الذي يبرز إلى الوجود ولو بقصيدة واحدة» ... ولكي يؤكد صاحبي قوله أضاف: «أن بشار بن برد كان قليل المقال في الشعر، ولكن ما أن يلقى بقصيدة من قصائده إلا وتتناولها الألسنة بالتداول وتذكرها الأفواه بين القبائل والبطون العربية». ومن هنا كان لزامًا على التوضيح لصاحبي لما خفي عنه وأزيل الأستار التي غطت على رسالة الشاعر وواجباته وصفاته التي يستحقها.
وليكن بداية الحوار السؤال التالي: ما هي الأعمدة التي تلزم الشاعر أثناء تدرجه من الهبوط إلى العلو خلال مرحلة حياته الشاعرية؟
والإجابة: لعل من أيسر الأمور التي تسرع العقول الواعية إلى تفهمها أن أهم الأعمدة التي تلزم الشاعر هي:
- نفسية شفافة ذات صبغة حساسة.
- دراسة لغوية تستمد جذورها من تراثنا العربي والإسلامي.
- معرفة بقوانين العروض والقافية «مع ملاحظة أنه لا يستعمل منها شيء في كثير من الشعر الحديث».
- الثقافة الواسعة التي تخرج بالشاعر نحو آفاق عالمية وتجول به في ساحات الفكر حيثما كان.
- متابعة الأحداث الجارية حتى يظل طرفاً فيها محدثا عنها ومسجلا لعظائمها وموجها للشعوب ومحفزا لهمتها:
تلك هي الأعمدة التي يجب على الشاعر أن يلتزم بها، بل يجب أن تتوفر فيه حتى يستطيع التعبير بالطريقة الشعرية السليمة، وأن يجتاز المراحل التي يمر بها أثناء دورانه في الملكوت الشعري. وقد يكون من الصواب أن نتدارك الأمر قبل الأوان فنسقط من الحساب معرفة المعروض الخ.. لأن كثيرا من الشعراء قد نبغوا في الشعر دون دراسة لها. ومع قولنا هذا فليس هناك ما يمنع مطلقا من دراستها لمعرفة خصائصها حتى يكون الشاعر على بينة منها؛ فقديما قيل: «العلم بالشيء أفضل من الجهل به».
وإذا ما انتقل بنا الحديث إلى سؤال آخر: إلى أي الدرجات من الصواب بلغ صاحبي في حديثه عن الشاعر ومكانته؟
والجواب: لا نريد أن نستبق الأحداث فنحكم بالخطأ الذي يغلف نظرته من جميع الوجوه؛ إذ إن جميع الدراسات الأدبية تثبت خطأ نظرته على النحو الذي رآه وما تفوه به. ومع احترامنا لرأيه لا يسعنا إلا أن نناقشه القضية بعقل وفكر مفتوح.
ففي معتقدنا أن الشاعر في الماضي يختلف كثيرًا عن الشاعر المعاصر ذلك.. لأن اللغة العربية في الماضي كانت لغته الأساسية التي ما كانت تزايله أو تفارقه أينما سار، بل عاشت في نفسه كجزء لا يتجزأ منه. أما اليوم -وحالنا كما هو معروف- فقد أصبح الحديث بالعربية تكلفًا ولا نستعملها إلا في بعض أغانينا التي تحتوي على قصائد شعرية وفي بعض التمثيليات القصيرة التي تعبر عن مشاهدات العصور العربية القديمة. هذا بالإضافة إلى القليل من المسرحيات النادرة التي تقدم بامتعاض وعلى غلبة من الأمر لأن الجمهور الغفير لا يمكنه استيعاب مفهومها ومضامينها. ولهذا نستطيع التأكيد بأن العربية الآن تعيش حياة الغربة بين أبنائها ومن هنا كان من الواجب تعلمها والإلمام بما تحمل من ثقافات ولغويات تذكي خيال الشاعر وتضع أمامه النماذج والخصائص التي تساعد ملكته الشاعرية على البروز والترقي الدائم والقفز إلى الأمام بصفة مستمرة. كما أنها تزرع في نفسه خاصية التذوق اللغوي بحيث يمكنه إدراك الفارق في الوضع بين كلمة وأخرى ولتوضيح الأمر بمثال نذكر: «جاء في دراسة عن أمير الشعراء أحمد شوقي أنه أرسل إلى جريدة الأهرام بقصيدة يقول في مطلعها»:
يا أخت أندلس عليك سلام *** هوت الخلافة «فيك» والإسلام
وعند مرورها على الشاعر الكبير خليل مطران أدخل على الشطر الأخير تعديلًا قبل نشرها حيث تناول لفظ «فيك» ووضع بديلاً عنها «عنك» فاستحسن ذلك شوقي وعلق عليها قائلا: هكذا كنت أحس وأريد ولا أدري كيف جنح بها الخيال.
ومثال آخر: بينما كان أحد الشعراء يلقي بقصيدة - في شبه ندوة ضمت مجموعة من أصدقائه - يقول فيها:
حديث الناس مرعاك وبين العين «مثواك».
فقال أحد الأصدقاء معلقا على اللفظة الأخيرة بقوله: قبحها الله من عين.
هلا قلت: وبين العين «مغناك».
ويستطيع الدارس الواعي إدراك الفارق الكبير بين اللفظين.
ولو نظرنا بإمعان وتدبر إلى الدكتور إحسان عباس ومقدمته في ديوان «الأعمى التطيلي» الذي قام بتحقيقه فإننا نراه ينقل لنا الصفة اللازمة لكل شاعر تنبض عروقه بالشاعرية فيقول: «ننسى جلالة زكاشمها، لو نادى الليل لما أسفر، أو نظر الصباح في المشرق لما فر، أي بحر زاخر، وأي سیل منحدر لا يرده زاجر». وما كان لشوقي مكانة عظيمة بين الشعراء إلا لاطلاعه على الثقافات العربية وغيرها حتى استحق بلا خلاف ذلك اللقب المعروف «أمير الشعراء» والتي استطاع من خلالها أن يقدم للعربية أفضل التراث ويحفظ للشعر مقوماته وأصالته.
أما عن قول صاحبي: إن الشاعر أو المستحق لأن يكون شاعرا هو من قال أو يقول ولو قصيدة واحدة في حياته فإننا نخالفه الرأي في جهة ونوافقه في الأخرى. ولبيان ذلك نقول:
إن لكل شاعر جاد رسالة ينبغي أن يقوم بها حتى يصل معها إلى درجات الكمال. فإذا ما وجد الشاعر الذي يقدم لنا العديد من القصائد الحية الناضجة التي تخدم القضايا المعاصرة ثم انحدر به الطريق إلى مهاوي الإسفاف الشعرى ولم يعد قادر على الإجادة عند ذلك يكون الحكم عليه صادقا وهو «الإفلاس» الشعري ونضوب شاعريته تعفيه من الخوض في المعارك اللاحقة بعد ذلك. وتكون صفة «الشاعر» التي ظلت تلازمه في الماضي قد أخذت سبيلها لمزايلته والبعد عنه. فهو في تلك الحالة أشبه بحالة التراث القديم الذي يرجع إليه وقت الحاجة.
وتستطيع سرد هذا الرأي بإيجاز شديد بقولنا: «كان شاعرا في الماضي ومستحقا للصفة أما الآن فإنه أمرؤ مثقف» لأن ما يأتيه ـ في حالة النضوب لا يستحق الالتفات إليه أو الانتفاع به أو منه. ولأن رسالة الشاعر ـ كما هو واضح - تبدأ مع أولى مراحله الشعرية وتناوله له مع نمو ملكته ولا تنتهي تلك الرسالة إلا بانتهاء الأجل. فعلى امتداد السنين يمثل الشاعر قبسا يستضاء به في الليالي الحالكة ويفرز الإشعاعات بين الجماهير ليريهم الدرب الصحيح وهم سائرون.
وإذا ما صدقنا الرأي القائل بأن صفة الشاعرية يستحقها كل إنسان ينظم ولو قصيدة واحدة جيدة ثم تمضي حياته بعدها على هوامشها بعيدة عن مشاركة الجماهير في نضالها ومعاركها فإن ذلك يعني بكل بساطة تشويه رسالة الشاعر وخلق آلاف من الناس الذين يصطلح على وضعهم في تلك المكانة ثم الانحدار بهم نحو طريق «الوصوليين والانتهازيين» فلا يكاد الرجل منهم يلقى بقصيدته «الفريدة» حتى تتناولها أقلام الكتاب والنقاد «وشلل الطبالين والزمارين» بالصحف والمجلات. فتصبح القسمة حينئذ قسمة ضیزی بينه وبين غيره من الشعراء الذين يعايشون المكافحين ويواكبون الثوار ويشاركون المناضلين معاركهم اليومية يمدونهم بطاقات حيوية زاخرة بكل معاني الحياة الحرة الشريفة هادية لهم السبيل وفاتحة لهم أبواب المستقبل الذي يرجونه.
فهل يتساوى أمثال هؤلاء الشعراء مع غيرهم من «الشعراء» الذين يستأهلون صفة «الشاعرية» ولو بقصيدة واحدة كما يقول صاحبنا الكريم؟؟ ولا نغرب بعيدا وبين أيدينا الأمثلة والشواهد العديدة:
فعندما كان أحد شعراء فلسطين المحتلة «محمود درويش» يصارع الطغاة والمستعمرين الصهاينة ويعايش المعارك في الداخل. نقول: آنذاك كان يأتينا بروائع القصيد ولا نبالغ إذا قلنا إن قصائده الماضية كانت بمثابة طلقات المدافع وأهازيج الحروب التي تثير في نفوس المحاربين الشجاعة وحب التضحية والفداء.
أما اليوم - وبعد أن حط به الترحال بين الجدران والمكاتب الفاخرة؛ فقد انقطع به الزئير ولم يعد قادراً على الإثراء بالكلمة وتقديم الجيد مثلما كان في ماضيه. ونزيد الأمر إيضاحا بأنه: كان شاعرا في الماضي أما اليوم فقد فَقَدَ تلك الصفة وأصبح مجرد كاتب فحسب.
ومثال آخر: شاعرنا المعروف «معين بسيسو» الذي وقف ذات يوم لينشر بين الملأ والشعوب المناضلة أروع القصائد التي تستحث القلوب إلى الوقوف بصلابة أمام الظلم والطغيان وتبعث الحياة في الأفئدة الميتة. نراه في السنين الأواخر يسقط هو الآخر في آماد سحيقة من الإسفاف والاضمحلال ولم يعد لديه القدرة الكاملة على تقديم الأفضل والأصلح الذي يساير قضايانا المعاصرة. حتى نبصره يعترف بنفسه بأنه «أصبح عاجزاً عن الكتابة» في قصيدته التي تحمل عنوان: «أصبحت عاجزًا عن الكتابة» والتي ألقاها هنا الكويت وهللت لها الصحافة وقد جاء في قصيدته تلك:
- أصبحت عاجزا عن الكتابة.
- الآخرون يكتبون...؟!
- يجرد العصفور من نيشانه ويكتبون:
- زور أشعار امرئ القيس ونشرة الطقس.
وفي نفس القصيدة يقول أيضًا:
- لم يبق غير مركب من الورق.
- فنوح قد غرق.
- والسندباد قد غرق.
- وجسد البحار يحترق.
- الغرق.
- الغرق.
- الغرق.
ولو تتبعنا تلك القصيدة التي وصفتها الصحافة «بالروعة» وأمثالها لوجدنا أنها خالية تماما من كل الأحاسيس التي ينفعل بها الشاعر أثناء المعاناة كما أنها عارية من الخصائص الفنية اللازمة للشعر الحي الذي ينبض بالحياة والذي يخلق في النفوس حب البلاد والتضحية.
وإننا على طريق التحدي على استعداد تام لنظم دیوان کامل تزيد مقطوعاته عن أربعين «قصيدة» إن صحب تلك التسمية كما يزعمون خلال ساعات قلائل وبذلك ندخل التاريخ من أوسع الأبواب وسط التهليل المفضوح والضجات المفتعلة. لقد انتهى «معين» شاعرًا وابتدأ كاتبًا منذ زمن طويل.
وشبيه حال «المفلسين» من الشعر الجيد والذين نضب معينهم الشعري بحال المحارب الذي قدم نفسه لمعركة واحدة من المعارك العديدة الطويلة. ثم انتهى به الأمر إلى الانزواء خلف الخطوط ليعيش عيشة المرفهين الذين يحيون على ظل من الماضي القصير وعلى حساب من الجهاد الأقصر. ناسين أو متناسين أن معركتهم الفاصلة لم تنته بعد تاركين الغير يصطلي بنار البغي والقهر والدمار. فهل يتعادل في الصفات من خارت قواه بعد معركة واحدة مع من يقاوم بالصمود والسير على مسالك من الأشواك والعذاب؟؟ وهناك العديد من النماذج من أمثال «العقاد» و «المنفلوطي» وغيرهما من الكتاب الذين تعاطوا الشعر في بداية حياتهم ثم انتهى بهم المطاف إلى أنواع أخرى من الكتابة فهل يصدق على أمثال هؤلاء صفة الشاعرية؟ وهل تلازمهم رغم النهاية المعروفة؟؟
إننا حينما نتعرض للشعراء وما يستحقونه من القاب لا نبتغي هدم القصور الباذخة العالية التي بناها لهم - في الخيال - المهرجون والمداجون. وإنما نرید إظهار الحقيقة عارية حتى يراها كل ذي لب وبصر فيتخذ من عيوب الآخر منهجا مخالفا، ويبحث في تؤدة وتأني خلف تراثنا العربي عن كل ما يحويه من كنوز المعرفة والعلوم.
ولا نجد عذرًا لصاحبنا الكريم لما قاله سوى قولته الرائعة في ختام الحديث:
إن حياة الشعر الحديث لا تتجاوز العشرين عاما وهي فترة قصيرة لا يمكنها أن ترسخ في الأذهان الطرق الصحيحة لما يكتبون..
وتلك حقيقة ناصعة نوافقه عليها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل