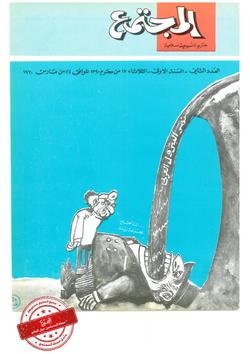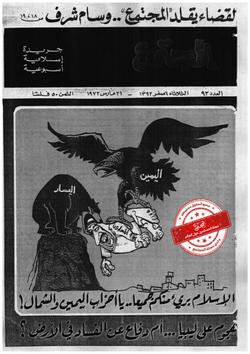العنوان محمد الحسناوي: النقد الأدبي لا يخلق أديبًا عظيمًا من العدم
الكاتب أحمد رمضان
تاريخ النشر الثلاثاء 22-مايو-1990
مشاهدات 13
نشر في العدد 967
نشر في الصفحة 32

الثلاثاء 22-مايو-1990
- للنقد
دور مؤكد في تطوير الحركة الأدبية ونهوضها وتوجيه مساراتها.
- الإعلام
الإسلامي اليوم جزء من الصحوة الإسلامية وعامل من عوامل ظهورها.
- الشعر
الحر أقل غنى موسيقيًّا من عروض الشعر التقليدي.
- أدونيس
يستخدم موهبته الشعرية في الهدم والتخريب والتغريب.
الحوار
مع الأستاذ الأديب محمد الحسناوي يتسم بالعمق والاتزان..
العمق.. نظرًا
للخبرة الحياتية والحضارية التي يتمتع بها.
والاتزان.. لأن
الأستاذ الحسناوي يطرح كلماته بحذر ودقة.
في
هذا الحوار يتطرق الأديب الحسناوي إلى بداياته الأدبية، ورأيه في الشعر الحديث،
والسبيل نحو تكوين مدرسة شعرية متميزة، والدور الذي يتوجب على النقد أن يمارسه ضمن
إطار الأدب الإسلامي، إضافة إلى رؤيته للصراع الحضاري الدائر اليوم بين الإسلام
والمدنية الغربية، إلى جانب دور الإعلام الإسلامي المعاصر.
وفيما
يلي نص الحوار:
المجتمع: هل من الممكن أن تحدثونا عن
بداياتكم الأدبية، والشخصيات التي أثرت في حياتكم واتجاهكم الأدبي؟
الأستاذ
الحسناوي: منذ بداية حياتي كنت مدمنا على مطالعة المجلات الأسبوعية، تلك المجلات
التي تجتذب المراهقين، وكنت أطالع الشِّعر الغزلي للأخطل الصغير بشارة الخوري،
وجميل بثينة، ونزار قباني، إلى أن دخلت طور الوعي الفكري والاجتماعي واندمجت في
التيار الإسلامي في الخمسينيات وتعرفت على كتابات سيد قطب، وعلي أحمد باكثير، وفي
الوقت نفسه كنت أطالع المجلات الأدبية الشهرية مثل «الأديب» و«الآداب» اللبنانيتين،
وعلى الرغم من إعجابي بعدد من الأدباء والشعراء لم أتأثر بأسلوب واحد منهم بشكل
مباشر، ثم جاء دور الجامعة وتخصصي في قسم اللغة العربية في كلية الآداب،
كل هذا مضافًا إليه رصيد المطالعة، ومتابعة المعارك الأدبية على صفحات المجلات
وأجهزة الإعلام ترك آثاره على ثقافتي واتجاهي الأدبي.
المجتمع: المتتبع لمسيرة حياتكم الأدبية،
يلحظ وجود انعطافات عدة هامة، فقد بدأتم بكتابة الشعر مبكرًا، وعرفتم به، ثم
ولجتم - إلى جانب ذلك - عالم القصة القصيرة، وفي الثمانينيات
طرأ على مسيرتكم الأدبية انعطاف حاد، إذ تراجع الشعر أمام الكتابات النقدية
الأدبية، وربط ذلك بالحضارة ونشوئها وانبثاقها، ولا يمكن أن نغفل في هذا المجال
دراستكم القيِّمة حول «الفاصلة في القرآن الكريم».
أولًا: ما تفسيركم لهذه التحولات؟
ثانيًا: ألا ترون أن تشتت الأديب المسلم
يقلل من إبداعاته في مجال معين؟
الأستاذ
الحسناوي: ما أشرت إليه- على العموم- من تحولات في مسيرتي الأدبية صحيح،
بدأت شاعرًا وأصبحت الآن أكتب القصة: قصيرة وطويلة، أما الاهتمامات
النقدية فلم تكن طورًا مستقلًا، ولولا انشغالي بشؤون تصرف عن الأدب وشؤونه
لما انقطعت عن الكتابة النقدية، بل إن هذا الانشغال نفسه هو أكبر سبب في تحوُّلي
عن الشعر إلى القصة، فضلًا عن أسباب أخرى ترجع إلى المزاج الشخصي وإلى الظروف
الشخصية والعامة، مثل السجن والهجرة والسفر والغربة وضيق ذات اليد.. ولعل
التطور الذي اتخذته مسيرتي الشعرية- من شعر ذاتي إلى شعر قصصي- كانت
سببًا آخر في هذه التحولات.
أما
أن توصف هذه التحولات بأنها تشتت، وبأن التشتت يقلل من الإبداع، فالأمر بالنسبة إلي- في
الأقل- مختلف، لأنني أستجيب لدواعي الإبداع بعفوية ولا أفرض على نفسي ألوانًا
أدبية محددة، ولم يكن بوسعي الاقتصار على لون واحد لأنني نهب لعوامل متعددة وظروف
متقلبة ليس أقلها ضيق الوقت وعدم الاستقرار.
إن
المتأمل لأعمالي الشعرية والقصصية والنقدية يجد خلفية واحدة في التصور والنظر إلى
الإنسان والكون والحياة، وهذا أمر متوقع لدى كل أديب، حتى إن رسالتي
الجامعية «الفاصلة في القرآن الكريم» هي ثمرة اهتماماتي بالأدب الإسلامي
ومعارك الشعر الحديث «شعر التفعيلة» ودور القافية في الشعر، والسجعة في
النثر، والفاصلة في القرآن «وهي كلمة آخر الآية»، وكشفت عن أبعاد وجوانب
موسيقية يمكن للشعر العربي أن يفيد منها وأن يصحح مسيرته الحديثة على ضوئها.
أما
إشارتك إلى «الحضارة ونشوئها وانبثاقها» فهي مثيرة بغموض مرادها، فقد
تعني أن الشعر يظهر في المجتمعات البدائية ويقل أو يضمحل في المجتمعات المتقدمة في
المدنية أو الحضارة، ومثل ذلك الإنسان في شبابه وكهولته، وقد تعني أنني انشغلت
بالكتابة عن الحضارة والأدب الحضاري، أيًّا كان ذلك فالتفسير صحيح، لكنني غير
مرتاح لانحسار الشعر في إنتاجي وفي المجتمع المعاصر.
المجتمع: من المعروف عنكم أن لكم رأيًا
خاصًا حول الشعر الحديث أو الشعر الحر، وقد كانت أولى محاولاتكم حوله
منذ ربع قرن تقريبًا، هل يمكن أن نرجع ذلك إلى تأثركم بشخصية باكثير ونازك
الملائكة، أم أن هناك عوامل أخرى؟! وما هو رأيكم الحالي بمسيرة الشعر الحر
وشعرائه؟!
الأستاذ
الحسناوي: كانت مجلة «الآداب» اللبنانية حقلًا خصبًا لقصائد الشعر الحديث
ومعاركه النقدية، وكنت معجبًا بهذه المجلة ومتابعا لمسيرتها، هذا سبب، وسبب آخر
ميلي الشخصي للتجريب، وأخيرًا كانت تجربة الاعتقال عام (1967) السبب
المباشر لتأليفي مجموعة شعرية كاملة «في غيابة الجب» على طريقة الشعر
الحديث «شعر التفعيلة» وتجربة السجن أغنت لدي حس الحرية
وحب الحرية، وكانت الثمرة ملحمة من الشعر الحر، أما اهتمامي بعلي أحمد باكثير
فكان من باب المسرح، ثم اكتشفت أنه رائد الشعر الحديث لا بدر شاكر السياب ولا نازك
الملائكة، وكان ذلك بعد إنجازي ديواني الشعري المذكور، أما نازك الملائكة فقد وجدت
نقاطًا مشتركة بين آرائها النقدية وآرائي مع سبقها وتقديري لفضلها، وقد خالفتها في
بعض الآراء حول التكرار حول تشكيلات التفعيلة الأخيرة في السطر الشعري، يمكن
الاطِّلاع عليها في كتابي «الفاصلة في القرآن».
إن
رأيي الحالي والماضي بمسيرة الشعر الحر وشعرائه هو رأي نازك الملائكة، وهو أن هذا
الشعر أقل غنًى موسيقيًّا من عروض الشعر التقليدي، وأنه سوف يتحول إلى رافد من
روافد الشعر العربي العام مثل الموشحات الأندلسية، وأنه يصلح أكثر ما يصلح للمسرح
الشعري، ومن الطريف أن ظهور هذا اللون من الشعر كان في المسرح على يد رائده
المرحوم الشاعر علي أحمد باكثير.
أما
بالنسبة إلى الشعراء الذين كتبوا الشعر الحديث فالحديث يطول، وسأوجز ما
استطعت.
أولًا:
من كان متفوقًا في الشعر التقليدي أو كانت له ممارسة أصيلة فيه تفوق في الشعر
الحديث، وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق على رواده الأوائل القلائل أمثال نازك الملائكة
وبدر شاكر السياب- رحمة الله عليه- وصلاح عبدالصبور، ونزار قباني، وعلي
أحمد باكثير، أما أدونيس فقد شذَّ عن هذه القاعدة لأسباب منها تعمده الإغراب
والتغريب، وهو للأسف يستخدم موهبته للهدم والتخريب، ويعلن انحيازه إلى الموتورين
الهدَّامين في أمتنا القدامى والمحدثين.
ثانيًا:
إن الشعر الحديث اليوم في أزمة لأن شعراءه المتأخرين أساءوا إليه بالتقليد للرواد
أو بالتعسف في استعمال الأساطير والرموز لاسيما الموروثات الإغريقية والمسيحية،
وأخيرًا تعمد الغموض والإغراب غير المسوغين.
المجتمع: في كتابك «عودة الغائب» طرحت
سؤالًا حارًا: «أين الشعر الإسلامي المنشود؟» وفي معرض إجابتك على السؤال،
عددت بعض العوائق والمشكلات التي تعترض انبثاق شعر إسلامي متميز وناضج، ودعوت إلى
عدم الانحصار في تجارب الأقدمين.. هل يمكن أن توضح وجهة نظرك الحالية في
الشعر الإسلامي المعاصر؟ وما السبيل إلى تكوين مدرسة شعرية إسلامية متميزة؟
الأستاذ
الحسناوي: بالمناسبة إن «عودة الغائب» ديوان شعر، وإن كلامي المذكور ورد في مقدمته
المطولة التي أنصح بالرجوع إليها، وإن كان زمن كتابتها مضى عليه ثماني عشرة سنة،
ففيها أشرت إلى غياب الشعر الإسلامي- عمومًا - قديمًا وحديثًا وعللت
لذلك، كما اجتهدت في استنباط مواصفاته من حرية في الشكل والتزام في المضمون، تلك
الحرية التي لا تصل إلى نقض العربية الفصحى، وذلك الالتزام النابع عن قناعة طوعية
بالتصور الإسلامي كما يقول المرحوم سيد قطب: «لست أعنِي التوجيه الإجباري على نحو
ما يفرضه أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ، إنما أعنِي أن تكيف النفس البشرية
بالتصور الإسلامي للحياة، وهو وحده سيلهمها صورًا من الفنون غير التي يلهمها إياه
التصور المادي، أو أي تصور آخر، لأن التعبير الفنِّي لا يخرج عن كونه تعبيرًا عن
النفس، كتعبيرها بالصلاة أو السلوك في واقع الحياة».
والذي
أضيفه بعد هذا الزمن هو أن الإنتاج الشعري في الأدب الإسلامي قد اطَّرد منذ ذلك
الحين، وأعترف بأنني انقطعت- لأسباب قاهرة- عن المتابعة النقدية لهذا
النتاج الخصب المبارك، وآرائي حول تكوين مدرسة شعرية إسلامية متميزة لا تزال هي
هي، وقد أشرت إلى بعضها عما قريب.
المجتمع: ألا ترى أن الفجوة القائمة بين
الشعراء والنقاد والأدباء بصورة عامة في ميدان الأدب الإسلامي- بمعنى عدم
التواصل الأدبي كتابة ونقدًا- يؤثر على اضمحلال حركة التقدم والنهوض بالنسبة
إلى الأدباء الإسلاميين بشكل عام؟!
الأستاذ
الحسناوي: للنقد دور مؤكد في تطور الحركة الأدبية ونهوضها، وأحيانًا في توجيه
مساراتها، لكنه ليس كل شيء، بمعنى آخر إن النقد الأدبي لا يخلق أديبًا عظيمًا من
العدم، كما أنه لا يستطيع أن يحكم بالإعدام على عبقرية مبدعة، هذه هي القاعدة
العامة ولا تخلو من استثناءات، وبوسعنا أن نضرب أمثلة، فالأديب الكبير علي أحمد
باكثير لاقَى من اضطهاد النقاد الماركسيين وأشياعهم ما لاقى حتى توفِّي
مقهورًا شبه معزول، لكنه لم ينقطع عن الإبداع، كما أن إبداعه لم يلقَ التقدير
المكافئ لدرجة أنه سلب أشياء منها ريادته الشعر الحديث، وعلى العكس هناك من
الأدباء من لقي الدعم والتشجيع والترويج فذاع صيته وأدبه أكثر مما يستحق، وهناك من
النقاد من يرى أن اهتمام النقاد الماركسيين بنجيب محفوظ نمَّى لديه اتجاهات فكرية
وأدبية لم تكن لتظهر لو كان هناك اهتمام مكافئ من نقاد إسلاميين يبرزون الجوانب
الإسلامية في أدب محفوظ! هذا عن دور النقد إذا كان مجردًا من سلاح المال
والسلطان، أما إذا تسلح بهذه الأسلحة فإن الحديث يتحول إلى شهداء وجلادين، وقد عرف
أدبنا هذه المعادلة الإرهابية وما بينهما أيضًا.
المجتمع: هناك من يعتقد أن خلو الساحة في
الماضي من هيئة أدبية تجمع شمل الأدباء الإسلاميين كان له أثره البارز في بطء حركة
الأدب! ما رأيكم في ذلك؟ وهل أنتم راضون عن أداء رابطة الأدب الإسلامي؟
الأستاذ
الحسناوي: خلو الساحة في الماضي من هيئة أدبية تجمع شمل الأدباء الإسلاميين ذو أثر
في بطء حركة هذا الأدب، أما الرضى عن أداء رابطة الأدب الإسلامي فلا يمكن
التعبير عنه بكلمة «نعم» أو «لا»، لأنها ما تزال في خطواتها
الأولى وبإمكانات محدودة، وهكذا شأن البدايات المخلصة غير المفتعلة وغير المرتهنة
لغير أهدافها النبيلة وإسلامها العظيم.
المجتمع: في ضوء مطالعتكم وتقديمكم
لرواية «الثعابيني» هل تعتقدون أن هذه الرواية إسلامية المنحى والتوجه.. بمعنى
هل يمكن تصنيفها ضمن دائرة الأعمال التي تخدم الأدب الإسلامي؟ هل ترون أن الرواية
قد أساءت للحركات الإسلامية عامة، وهشمت جميع «النماذج» و«الصور» والآراء
الإسلامية، وذلك من خلال صور وخيالات غير واقعية ومفترضة افتراضًا؟!
الأستاذ
الحسناوي: إن هذا السؤال يوحي بالحاجة الماسَّة لتعريف الأدب الإسلامي، فعلى الرغم
من صدور عدد من الكتب النقدية «النظرية والتطبيقية» وظهور عدد كبير من
الأدباء والشعراء الإسلاميين وقيام «رابطة الأدب الإسلامي» يطرح مثل هذا
السؤال؟ وبودي لو يتاح لي الإسهام المستمر في هذا المضمار، ومع ذلك أقول: إن الأدب
الإسلامي غنيٌّ جدًّا، وما نشر منه حتى الآن- على أهميته- لا يساوي نقطة
من بحر ذلك الأدب المنشود، أسمح لي أن أوضح بعدًا من أبعاده- ها هنا- كان
المرحوم الشيخ عبدالرحمن الكواكبي يهاجم قومه العرب ويندد باستنامتهم للذل والهوان
حتى يشبههم بالحيوانات، وأن أيديهم أصبحت قوائم لكثرة الخضوع، وأن النبات يطلب
العلو وهم يطلبون السفول.. ولم يُتهم بنيته ولم يطرد من دائرة الأدب
العربي.. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه السلام عن الخير
وكان الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأله عن الشر، فما زجره الرسول ولا
أُخرج من دائرة الصحابة، وفي مسرحية «عطيل» ينتصر الشر في نهايتها على
الخير «حيث يقتل عطيل زوجته البريئة ويقتل نفسه جزاء ما اقترفت يداه، ويبقى
الشرير «ياغو» قيد الحياة، ولم يتهم شكسبير في عمله ولا في عبقريته، ذلك لأن
العبرة للانطباع الأخير كما يقول النقاد، ولأن انتصار «ياغو» محرض للناس كي
يتألموا ويغضبوا أو يعملوا على إعدام «ياغو» في الحياة بعد أن تعرفوا
عليه وعلى جرائمه في مسرحية «عطيل»، هذا جواب غير مباشر على سؤال حول رواية
«الثعابيني»، وأضيف أن للأديب عبدالله عيسى السلامة- صاحب الرواية- مزاجًا
خاصًا به، ربما لا نوافقه عليه، لكن ليس بوسعنا أن نحجر عليه، حتى الورد ذلك
المخلوق الجميل اللطيف ليس له لون واحد ولا حجم واحد ولا رائحة واحدة، وهذا سر آخر
من أسرار جماله وجمال خالقه، تبارك الله أحسن الخالقين.
المجتمع: ما هو سر اختياركم موضوع «الفاصلة
في القرآن الكريم» لأطروحة الماجستير مع أن المتوقع أن يكون المنحى
أدبيًا؟!
الأستاذ
الحسناوي: إن تعريف «الفاصلة» هو: «كلمة آخر الآي» كقافية الشعر وسجعة النثر،
وبكلمة أخرى إن موضوع الماجستير أدبي صرف، وإن كان مصنفًا ضمن علوم القرآن الكريم،
لأن هذا الكتاب المعجز، الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه، هو كتاب في قمة الأدب في
الوقت الذي هو كتاب تشريع وفقه وموعظة وتربية... والتفسير البياني هو أحد
أنواع التفسير المشهورة للقرآن الكريم عرف منه كتاب «الكشاف» للزمخشري،
كما أن أبرز مظهر من مظاهر الإعجاز في القرآن هو الإعجاز البيانِي الذي أفحم بلغاء
العرب وأسر ألبابهم فاستسلموا له مؤمنين منيبين، فالكتاب يدرس جانبًا أدبيًّا
جماليًّا من جوانب القرآن الكريم من خلال كلمة آخر الآية «الفاصلة» وعلاقاتها
القريبة والبعيدة بالآية التي وردت فيها، والمقطع الذي يضم مجموعة آيات، والسورة
كلها، فهناك سور ذات فاصلة «موحدة: وحدة في الروي» مثل قصار السور، وهناك
سور «متنوعة الفواصل: متعددة حروف الروي» مثل طوال السور، وهناك سور تتألف من
مقاطع ذات فواصل متتابعة مجموعات مجموعات، وهناك التكرار للفاصلة الواحدة في
السورة الواحدة «فبأي آلاء ربكما تكذبان» «ويل يومئذ للمكذبين» وهو التكرار
الفنِّي البليغ الذي يزعم الشعراء المحدثون أنه لم يوجد قبلهم في شعر ولا في
نثر.. وشتان شتان!
إن
سبب اختياري «الفاصلة في القرآن» موضوعًا لرسالة الماجستير يرجع فيما يرجع
إلى اهتماماتي الأدبية النقدية فضلًا عن ميولي الأدبية واختصاصي الجامعي، ومن يقرأ
هذا الكتاب سوف يجد الصلة العميقة بينه وبين الأدب العربي قديمه وحديثه، على
حد سواء لاسيما المعارك الأدبية النقدية: الالتزام- الشعر الحديث- موسيقى
الشعر- القافية- علم الجمال.
المجتمع: في كتابكم في «الأدب
والحضارة» ذكرتم بأن الصراع الدائر في العالم اليوم هو صراع بين العالم
الإسلامي والحضارة الغربية، وتجاهلتم الأيديولوجية الاشتراكية التي كانت تسيطر على
نصف الكرة الأرضية تقريبًا! هل كان هذا تنبؤًا من قِبَلكم بسقوط العالم
الاشتراكي الماركسي واندحاره، كما نرى الآن؟! وكيف تنظرون إلى خطى الصراع
الدائرة بعنف الآن بين الحضارة العربية الاسلامية العائدة بقوة، والحضارة الغربية؟
الأستاذ
الحسناوي: أولًا أفضل أن أقول المدنية الغربية لا الحضارة الغربية، لأن المدنية هي
الرقي في عالم الأشياء، على حين يراد بالحضارة الرقي في عالمي الأشياء
والأفكار (أي القيم).
ثانيًا:
نحن ننظر إلى مدنية دول أوروبا الشرقية على أنها جزء من المدنية الغربية كلها،
مدنية تغلب عليها المادية، وتعاني من فصام بين العقل والأخلاق، ومن فصام بين الدين
والحياة أو العلم، وما سقوط الجناح الشرقي من هذه المدنية إلا نذير باقتراب سقوط
الجناح الغربي منها، وهذا ليس رأيي وحدي، بل هي آراء كبار كُتاب الغرب وفلاسفته
مثل شينغلر في كتابه «سقوط الغرب» وكولن ولسون في كتابه «سقوط الحضارة»
وفي كتب أرنولد توينبي مثل «الغرب والإسلام والمستقبل»، على أن خطى الصراع
منها ما هو خفي لا يلحظه إلا الخبراء والمعنيون، ومنها ما هو معلن مكشوف بدءًا
بتحرر الأقطار المستعمرة ومرورًا بالتحرر الثقافي والصحوة الإسلامية وعودة الحجاب
وانتهاء بمحاربة المخدرات في أوروبا واعتناق مفكريه للإسلام، والمهم أن مسار
الصراع قدري كمسيرة الحياة في الإنسان من الطفولة إلى من الشباب فالكهولة
والشيخوخة ثم الموت، والسؤال المحير للمفكرين: هل يمكن لحضارة ما ألا تشيخ؟
وكيف؟! قال الله تعالى: ﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ
جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة:251).
المجتمع: ربما لا نكشف سرًّا إذا قلنا: إنكم- إلى
جانب عطائكم الأدبِي- تعتبرون أحد الإعلاميين البارزين في الساحة الإسلامية..
كيف تقيمون مسيرة الإعلام الإسلامي؟ وما الأسس الكفيلة برفع مستوى هذا
الإعلام وإعلاء شأنه؟
الأستاذ
الحسناوي: إن الإعلام الإسلامي اليوم جزء من الصحوة الإسلامية وعامل من عوامل
ظهورها، وهو يتصدى لدور بارز في هذه الصحوة المباركة ولمقتضيات الدعوة والتبليغ
الإسلاميين في هذا العصر سواء في ذلك القارئ أم المستمع الإسلامي وغير الإسلامي،
وبوسعنا أن نقرر أن هذا الإعلام قطع أشواطًا بعيدة منذ ظهور المطبعة والمطبوعات في
المشرق العربي حتى يومنا هذا، وأصبح صناعة مطلوبة بعد أن كان هواية أو أدوات
مقموعة، ومع ذلك فإن الثورة التقنية التي دخلت الإعلام في العالم وعمليات القمع
التي لم تنقطع والطاقات الفنية والمالية غير الموظفة حتى الآن والتحدي الكبير الذي
يواجه الإسلام والمسلمين فضلًا عن العرب والقضايا العربية، كل ذلك يدل على أن هناك
أشواطًا أخرى ما تزال أمام الإعلام الإسلامي لابد من قطعها حتى يكون مكافئًا
لما هو مطلوب منه ولما هو قادر على تحقيقه ضمن الإمكانات المتاحة، وما أكثرها
وما أغناها من إمكانات! فالتيار الإسلامي جماهير مثقفة وطليعة متخصصة، والشعوب
الإسلامية عطشى، والأقطار الإسلامية تختزن الثروات المالية والاقتصادية، فما الذي
يمنع من جمع هذه الطاقات بعضها إلى بعض؟! وهذه الأحكام كلها صحيحة حتى على مستوى
الربح والخسارة بالمعيار التجاري، اسأل دور النشر تجيبك بأن الكتاب الإسلامي هو
الأشد رواجًا والأكثر مبيعًا هذا بالنسبة إلى العمل الإعلامي على وجه العموم، أما
بالنسبة إلى رجل الإعلام الإسلامي- وهو أهم عنصر في الإعلام- فبوسعي أن أقترح
بعض التوصيات، أولًا: لابد من التخصص سواء في الجوانب التقنية «التحرير- الإخراج- العلاقات- النشر- البث- التصوير...» أم
في الجوانب الفكرية «الاقتصاد- الفكر-السياسة- الاجتماع- التاريخ- الإعلان...».
ثانيًا:
الرسالية: أي اتخاذ الإعلام وسيلة لخدمة أهداف يؤمن بها رجل الإعلام لا مجرد وسيلة
للعيش مع مراعاة الشروط الفنيَّة والتقنية لئلا يتحول العمل من فن صحفي أو إعلام
إسلامي إلى مسألة وعظية، والوعظ له ميادينه الخاصة غير الإعلام.
ثالثًا:
الوعي، أو التسلح بقدر غير قليل من الوعي لقضايا الساعة والقضايا المصيرية وعلاقة
كل منهما بالأخرى، وطريقة التعبير الناجح عنهما أو عن كل منهما، وأول الوعي وعي
العقيدة أو التصور الإسلامي، ثم الوعي الفنِّي فالسياسي وهكذا دواليك، وهذا يتأتى
بالدراسة أو المطالعة كما يتأتَّى بالممارسة، مع التحذير بأن العمل الإعلامي قد
يستهلك صاحبه فيشغله عن الدرس أو المطالعة، لذلك أوصي بالتمكن قبل الممارسة، كما
أوصِي بمراجعة الذات ونقدها بين حين وآخر من هذه الناحية، وفرق كبير بين الإعلامي
الموظف والإعلامي الحقيقي.
المجتمع: هل هناك من جديد لكم في مجال
الشعر أو النقد أو القصة؟!
الأستاذ
الحسناوي: أرسلت إلى المطبعة رواية بعنوان «خطوات في الظلام» تتناول مرحلة
مهمة من تاريخ بلادي من جهة وحياتي وحياة أحبابي في تلك المرحلة من جهة ثانية،
وتحت يدي الآن إحدى عشرة قصة قصيرة لم تنشر بعد أنوي ضم قصص أخرى إليها لتنشر- إن
شاء الله تعالى- في مجموعة مستقلة، وهي في خط مشابه لخط الرواية المذكورة من
حيث المضمون والأهداف.. ومنذ فترة قريبة صدرت مجموعة قصصية اشتركت فيها مع
الإخوة الأدباء «محمد السيد - عبدالله عيسى
السلامة - محمد وليد جداع»، وكانت بعنوان «خط اللقاء»، أما
مؤلفاتي المنشورة سابقًا فقد أعيد طبعها للمرة الثانية أو الثالثة
مثل «الفاصلة في القرآن» «الحلبة والمرآة» «في غيابة الجب» «عودة الغائب»
«أصوات»، أما آخر ما نشر من إنتاجي فهو: «بين القصر والقلعة» مجموعة
قصصية «في الأدب والأدب الإسلامي» دراسات نقدية «في الأدب
والحضارة» دراسة نقدية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل