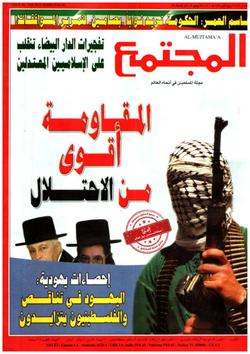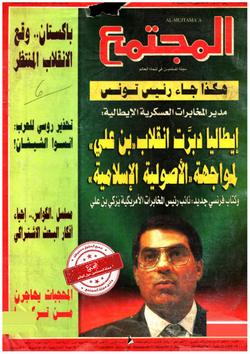العنوان مشكلة تلوث البيئة من زاوية أخرى
الكاتب عبدالوارث سعيد
تاريخ النشر الأربعاء 15-يونيو-1977
مشاهدات 20
نشر في العدد 354
نشر في الصفحة 14
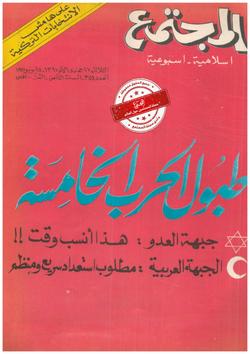
الأربعاء 15-يونيو-1977
برزت منذ أوائل العقد الحالي مشكلة «تلوث البيئة» بعد أن كثر الحديث عن أخطارها وتعددت الدراسات التي تتناول تحديد هذه الأخطار الواقعة أو المتوقعة. وعقدت المؤتمرات للنظر في أبعاد المشكلة وفي الوسائل الفعالة التي يمكن اتخاذها للحد من أخطارها التي تحدد حياة البشرية. وظهر ما سمي بـ«يوم الأرض» و«اليوم العالمي لحماية البيئة» وتكونت الجمعيات في العديد من الدول لتوعية المواطنين بأبعاد المشكلة وبأخطارها ولدعوتهم إلى تحمل مسئولياتهم نحو الحد من تفاقمها.
معهم .. ولكن ..
إن المسلم وهو يؤمن بأن خليفة الله في أرضه وظيفته التعمير لا التدمير يقدر هذه الدعوة ويتعاطف معها ويشغل نفسه بها أكثر من سواه، إذ البيئة في نظر المسلم مستودع نعم الله رب العالمين، وحق النعم أن تصان وتشكر، ولا يكون ذلك إلا بالتزام ما أمر الله به حيالها في التصور والتصرف. ومن هنا ورغم تقدير المشكلة والتعاطف معها نرى أن موقف المسلم منها يجب أن يكون مختلفًا في أبعاده وتصوراته عما لدى الآخرين ممن تناولوها بالدرس والتحليل من الغربيين أو الشرقيين. بل قد أذهب إلى أن المشكلة بالنسبة إلى دول العالم الثالث عمومًا تختلف أبعادها عنها في العالم الغربي؛ فالغرب ذو الحضارة المادية المستعلية له منطلقات فكرية وأهداف وظروف تختلف كثيرًا عما لدى المسلمين أو الدول النامية منها. ومن ثم فلا مناص إن أنصفنا الحقيقة وأخلصنا النية من طرح القضية من وجهة نظر أصيلة نابعة من ديننا ومن ظروفنا الواقعية وأهدافها التي يحكمها هذا الدين.
الإنسان .. الغاية الأخيرة:
مما لا خلاف عليه أن الهدف من الاهتمام بمشكلة تلوث البيئة إنما هو في النهاية حماية الإنسان مما يهدد استمرار حياته واستمراره في أداء رسالته في هذه الحياة، وإن كان ثمة خلاف جوهري بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية في تحديد طبيعة هذه الرسالة وأهدافها. ولكن أيًا كانت هذه الرسالة فهي لن تتحقق إلا إذا ظل الإنسان إنسانًا بكامل عناصره ومكوناته المادية وغير المادية. فهو جسم وروح أو جسم وعقل وسلوك، والنظر إليه من زاوية واحدة فقط وإهمال ما عداها فيه قضاء عليه ككل فضلًا عن كونه تصورًا مضللًا ومجافيًا لأصول البحث العلمي الصحيح.
أية بيئة ..؟!
أول ما يرد إلى الذهن عند ذكر قضية «البيئة» سؤال عن المقصود بهذه الكلمة .. «البيئة».
انطلاقًا من المنظور الغربي للحياة انحصرت كل الدراسات والدعوات في نطاق البيئة المادية وعناصرها من ماء وهواء وغذاء. ولكن «البيئة» عند التحقيق هي كل ما يحيط بالإنسان ويؤثر سلبًا وإيجابًا في مختلف مكوناته وملكاته ما كان منها منتميًا إلى الجسم أو إلى العقل أو إلى السلوك والخلق. والجانب المادي من البيئة وما له من آثار على صحة الإنسان جسميًا لا ينبغي رغم أهميته أن يستأثر وحده بكل الاهتمام بحيث يصبح العنوان الوحيد لمشكلة كبيرة متعددة الجوانب والأبعاد. بل إن هذا الجانب المادي مع خطورته ليس أهم جوانب المشكلة التي تهدد وجود الإنسان ومستقبله. إن الإسلام في تصوره للإنسان لا يرى قيمة لجسم صحيح إذا ما اعتلت الروح وفسد العقل فلم يهد صاحبه إلى الحق في الفكر والسلوك. وأي فضل يبقى للإنسان على الحيوان إذا هو حرم نعمة الإيمان والنظر القويم للحياة والسلوك الخير فيها؟! ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ (محمد: 12) إن العقل الذي ميز الله به الإنسان على كثير من خلقه يفقد قيمته ودوره الفذ حين يخضعه الإنسان لشهواته ونزواته ويسخره في خدمة متطلبات الجسد وحده، إذ يصبح حينئذ أقرب إلى بعض الملكات والغرائز التي زود الله بها بعض الحيوانات والحشرات للحفاظ بها على حياتها دفاعًا وانتفاعًا.
وأي تلوث ..؟
المصدر الأعظم للخطر في «مشكلة البيئة» هو ظاهرة «التلوث» الذي يتزايد باستمرار في الهواء والماء نتيجة للتزايد المستمر في عدد وحجم الآلات وفي عدد المصانع التي تقذف إلى الهواء والماء يوميًا بآلاف الأطنان من المخلفات والعوادم في صورة غازية أو سائلة تنتج عنها أضرار صحية عديدة تصيب الإنسان وغيره من الكائنات الحية على هذه الأرض، وقد تؤدي إلى القضاء على بعضها .. وأخطر من ذلك تلك الكميات الهائلة من الإشعاعات القاتلة التي تنطلق من المفاعلات والتفجيرات الذرية والنووية لتلوث الهواء. هذا بالإضافة إلى ما يساهم به الأفراد في تلويث البيئة بإهمالهم في الالتزام بالسلوك الصحي وقواعد النظافة.
ترتفع نسبة التلوث كثيرًا في البلاد المتقدمة في ميداني التسليح والصناعة بشكل يتميز بالإسراف الرهيب استجابة لجنون التفوق والرفاهية اللذين تتهالك عليهما. أما الدول المسماة بـ«النامية» فإن نسبة التلوث فيها من هذين المصدرين الرئيسيين أقل، ولكنها تسعى جاهدة معصوبة العينين وراء التوسع فيهما رغم مخاطرهما الواضحة، وكأنها تستهين بتلك الأخطار لقاء ما تتطلع إليه من قوة وتقدم مزعومين، وكأنما هي لا ترى إلى القوة والتقدم من سبيل إلا هذه السبل المحفوفة بالمهالك والويلات التي أهونها تلوث البيئة.
مشكلة «التلوث» بهذا المعنى المادي جسيمة الخطر، وتستحق كل ما يبذل في مقاومتها من جهود. لكن ثمة نوع آخر من «تلوث البيئة» هو أخطر وأولى بالدرس والتحليل وبإعداد الخطط للحد من انتشاره ومن أضراره، ذلكم هو «التلوث» الفكري والروحي الذي يسود الجانب غير المادي من البيئة بمعناها المكتمل. إن أخطار هذا الضرب من التلوث تقتصر على الإنسان وتصيبه في صميم ما هو به إنسان فيستحيل بتأثيرها إلى كائن خطير يتوجه بما لديه من طاقات وإمكانيات هائلة إلى ما يعود عليه وعلى ما حوله بالتدمير.
ومن الجدير بالتأمل والنظر الجاد أن «الغرب» المادي المتقدم (!) هو المصدر الأكبر لهذا النوع من التلوث أيضًا. فمن يرصد الأمور بوعي وعقل متحرر من عقدة الإعجاب بالغرب وعبادته ير أن ما يتهدد بيئتنا في ميادين الفكر والدين والخلق والسلوك من تيارات ضالة وصرعات وتشنجات ومخططات إفساد وتخريب إنما مصدرها ذلك الغرب «المتقدم» الذي اتخذ من المادة إلها ليقدم نفسه وغيره قربانًا على مذبحها. «والغرب» هنا ليس بمدلوله الجغرافي وإنما بمضمونه الحضاري الذي ينسحب على ملحدي «الشرق» أيضًا.
وكما أشرنا بصدد «التلوث المادي» نلاحظ هنا أيضًا أن الشعوب النامية ويهمنا منها هنا الإسلامية بشكل خاص لا تزال، رغم ما تعانيه من «تلوث» فكري وروحي ناتج عن تأثيرات الغرب ومخططاته، أحسن حالًا من المجتمعات الغربية المادية الضالة، ولا يزال الأمل في إنقاذها قائمًا شريطة أن تستيقظ من ذهولها وتتدارك الأمر قبل فوات الأوان: تدرس واقعها من منظور إسلامي صحيح لتعرف ما طرأ عليه من «ملوثات» وتتأكد من مصادرها الحقيقية وتعمل في إخلاص وجدية لتطهير هذا الواقع الموبوء.
وإذا كان هناك مجال للزعم بحتمية أخذ الشعوب الضعيفة بأساليب الغرب في التقدم المادي رغم ما يرتبط به من أخطار التلوث المهلك، إن هي أرادت لنفسها مكانًا ولو متواضعًا في هذا العالم المتصارع، فليس هناك أي مجال لمثل هذا الزعم بالنسبة للتقدم في مجالات الفكر والدين والأخلاق، خاصة بالنسبة للمسلمين. لقد حذرهم منذ أربعة عشر قرنًا ربهم العليم ورسولهم الكريم من مغبة التخلي عن منهج دينهم القويم والأخذ بما عند غيرهم. ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الأنعام: 153) «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» .. وإذا صرفنا النظر عن الحاقدين والمخدوعين، فليس هناك من يجرؤ على ادعاء أن نهضة الشعوب الضعيفة رهن بالأخذ بأساليب الغرب في الفكر والدين والأخلاق. العكس تمامًا هو الصحيح؛ فالعقلاء والمنصفون حتى من مفكري الغرب نادوا بأنه لا علاج لأمراض مجتمعاتهم ومشاكلها سوى الحد من هذا السعار المادي والعودة إلى حظيرة الدين والخلق الإنساني.
إن مواقف الغرب المتناقضة من الشعوب النامية والإسلامية بخاصة، لتبعث شكًّا قويًّا في قيمة ذلك التقدم المادي المزعوم الذي يلوح لنا به، وهي في نفس الوقت تؤكد بقوة خبث نيته تجاه مستقبلنا. فعلى حين نراه شديد الفن بأسرار التفوق العسكري والصناعي حريصًا على عرقلة المشاريع الجادة للتطوير الحقيقي في حياتنا، حتى مبيعاته وقروضه ومساعداته لنا لا تأتي إلا مثقلة بالشروط والقيود التي تدعم سيطرته وتدخله المقيت في خاص شئوننا، نراه من ناحية أخرى جادًا في التخطيط لنشر كل سمومه الفكرية والسلوكية بين شعوبنا ... الموقفان متناقضان شكلًا، أما الهدف فواحد .. أن تحرم الشعوب الضعيفة من مقومات ومصادر القوة بكل معانيها حتى لا تنازعه السيادة على الأرض أو تقاسمه ما يتمتع به من ترف ورفاهية.
منهج البحث يقتضي هذا الشمول:
هذا المفهوم الشامل المتكامل لمعنى «البيئة» و«التلوث» لم نذهب إليه من باب الرغبة في الوعظ أو ربط الدين بأية قضية تثار، كما قد يظن البعض، وإن كان التذكير واجبًا على المسلم والدين الحق موقفًا إيجابيًا من كل قضايا الحياة ومشاكلها في أي مجال، وإنما أملاه المنهج القويم في البحث والدراسة. إن الذين تناولوا مشكلة «تلوث البيئة» على مستواها المادي قرروا «أنه من الخطأ أن ننظر إلى مشكلة البيئة على أنها مشكلة فيزيقية بحتة، بحيث نغفل أبعادها الاجتماعية والإنسانية» و«أن الكثير من العلماء يعتبرون ما نسميه الآن بمشكلة البيئة إنما هو مشكلة سلوكية في المحل الأول، ولذا فإن علاج الموقف يجب أن يبدأ بالإنسان نفسه باعتباره هو العامل الأساسي في الاستفادة من البيئة، كما أنه هو السبب المباشر في تلويثها، وأنه هو الذي يعاني هذا التلوث في آخر الأمر». ولا مفر والأمر كذلك من ضمان صحة الإنسان عقلًا وروحًا حتى يستقيم سلوكه أفرادًا وجماعات. وكل محاولة لإلزامه بسلوك معين تجاه البيئة مصيرها الإخفاق ما دام ذلك الإنسان خرب العقل والروح. وليس يجدي معه حينئذ أي ضغط باسم القانون أو العقاب أو الخطر الذي يتهدده مهما كان شديدًا.
والأمثلة التي تبرهن على صحة ذلك من واقع الحياة لا تحصى. ويكفينا أن نذكر ما عاناه البشر من ويلات الحروب المحلية والعالمية وأهوال القوة الذرية والنووية مما لا تزال آثاره قائمة حتى الآن، ومع ذلك لم يتحسن بل ازداد سوءًا سوء المالكين لآلات الحرب والمتاجرين في دماء الشعوب.
لو أن القيم الروحية والفكرية الصحيحة كما يعرضها الإسلام هيمنت على تصورات البشر وتطلعاتهم وسلوكهم أفرادًا وجماعات، خاصة أولئك الذين يمسكون بأيديهم أزمة التوجيه بين الشعوب، أي لو تطهرت بيئتهم الروحية والفكرية، لأصبح من اليسير، بل الطبيعي أن يتخلصوا من كثير من مصادر «التلويث المادي» الخطرة.
إن سعار الرغبة في التفوق الحربي والتفوق الاقتصادي «الاستغلالي» طلبًا لمزيد من التسلط والرفاهية، ليقف وراء عدد كبير من أخطر مصادر تلويث الماء والهواء، بل والقيم أيضًا. ومن ناحية أخرى، نجد أن هذا الصراع «الغابي» المنبعث من الأنانية وحب التسلط هو ذاته الذي دفع بالجزء الأكبر من سكان هذا العالم إلى دركات التخلف والجهل وفساد التصور، وبالتالي إلى المساهمة دون وعي في تلويث البيئة. ولو تخلى عبيد الأنانية والتسلط عن مسلكهم هذا وسخروا ما يهدرونه من طاقات وإمكانيات، في هذه السبيل المهلكة، لتحقيق تقدم إنساني فيما يحتاج إليه البشر فعلًا من غذاء وكساء ومسكن وعلم نافع ورقي في الفكر والأخلاق لانصلح الحال وتطهرت البيئات من هذا التلوث.
وإذا كان التلوث المادي يهدد البشر بالضياع في هذه الحياة، فإن التلوث الفكري والروحي يهددهم بالضياع في الدنيا والآخرة معًا. ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: 72).
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (الكهف: 103-105).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل