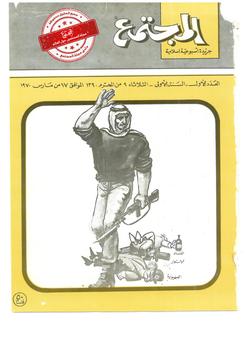العنوان مصادر التشريع الإسلامي وتطور الفقه في ظلها
الكاتب د. محمد الصادق عرجون
تاريخ النشر الثلاثاء 17-نوفمبر-1970
مشاهدات 50
نشر في العدد 36
نشر في الصفحة 7
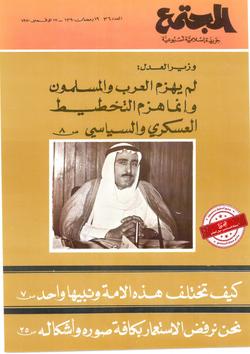
الثلاثاء 17-نوفمبر-1970
مصادر التشريع الإسلامي وتطور الفقه في ظلها
عمر بن الخطاب يتساءل:
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟
لفضيلة الشيخ محمد الصادق عرجون عميد كلية أصول الدين سابقًا
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
وبعد، فإن الحديث عن «مصادر التشريع في الإسلام وتطور الفقه التشريعي في ظلها» يقتضي أن ننظر إلى حياة المسلمين التشريعية نظرة عابرة تصور لنا كيف كان المسلمون يحيون في ظل تشريعهم النابع من مصادره الأصيلة، يَقودون، ولا يُقادون، ويُتبعون ولا يَتبعون، ويملون ولا يملى عليهم، يوم أن كان الفقه التشريعي المسلم هو المهيمن على حياة المسلمين، يوجهها ويصبغها بحيويته وقوته، ومرونته وسماحته ويسره، ويسيرها قدمًا في طريق التوثبات الفكرية الواعية الفاضلة.
كما يقتضي أن ننظر هذه النظرة العابرة لنعرف كيف عاش المسلمون بعد أن تركوا تشريعهم الإلهي جهالة منهم لمكانة هذا التشريع، وجمدوه في صور جافة قاصرة، لا تسعف الوقائع والأحداث المتكاثرة التي تجري في المجتمع الإسلامي العريض في رقعته على هذه الأرض، بما تتطلبه من أحكام تشريعية، تحقق للناس موازين العدالة والتعاون المتكافل بين الأفراد والجماعات، فاضطروا إلى أن يعيشوا يلتقطون الفتات من بقايا موائد غيرهم ممن لا يجمعهم معهم دين ولا لغة، ولا أي عنصر من عناصر الخصائص الإنسانية الفاضلة، وقبلوا راغمين أن يستعيروا أو يستعار لهم تشريعات أجنبية، جعلوها قوانينهم التي يتحاكمون إليها في حياتهم ومعاملاتهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخلقية، كما باعد بينهم وبين روح التشريع الإسلامي الذي يحمل في طبيعته عناصر التوافق المادي والروحي في حياة الناس، على خلاف التشريعات الوضعية المادية التي تحكم بها هذه الحضارات المادية المظلمة الظالمة.
إن الإنسانية تعيش اليوم في جو قائم، يتنكر للدين ومبادئه، ويسخر من القيم الروحية والفضائل الخلقية، جو مليء بالشبه والشكوك في العقائد وأصول الأديان، جو مفعم بالشحناء والبغضاء، تصبغ أوطانه الدماء المسفوكة ظلمًا وعدوانًا، جو يضم بين آفاقه أممًا وشعوبًا مثقلة كواهلها بالأزمات النفسية والأزمات الفكرية، والقلاقل الاجتماعية، وتتقاذفه توثبات عقلية، لا تعرف الإيمان بالله ورسالاته، جو طغت فيه ظلمات الإلحاد على نور الإيمان، وانحسرت عن شطآنه موازين القيم الروحية والفضائل الخلقية التي صفرت منها حياة الناس، ولم توضع في كِفّة ميزان أعمالهم بعد أن كانت هي الفيصل في توجيه حياتهم.
الإنسانية المريضة
فالإنسانية اليوم مريضة على الرغْم من ما يتراءى في مسيرتها من توثبات هنا وهناك، فهي في حاجة شديدة إلى أن تجد تجرِبة جديدة لعلاجها من أمراضها المادية وشهواتها الجائحة غير هذه المسكنات الخادعة التي يجرعها لها العلم المادي المدمر في صور حضارية براقة، تزيدها مرضًا على أمراضها القاتلة، وتقربها في كل لحظة تمر عليها خطوات من حافَة الهاوية.
والإسلام وهو دين الله الخاتم لشرائعه الإلهية، الجامع لأصول ملل الأنبياء والمرسلين أقدر النظم التشريعية على تقديم العلاج الناجع لأمراض الإنسانية التي يستأصل من جسمها سرطانات هذه الحضارات المادية المخبولة، لأن الإسلام شريعة إلهية عامة خالدة، أنزلها الله نظامًا عامًا، يقيم للناس نواميس الحياة الفاضلة على دعائم العدالة الرحيمة، يقول الله تعالى لرسول الإسلام خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، ويقول لأمة الإسلام: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾. (المائدة: ٣)
بهذه الصورة العامة الخالدة الرحيمة حملت الأمة الإسلامية في انسياحها مبشرة بفجر الحرية والعدالة وبين الله وشرائعه إلى الناس كافة، فأقبلت عليه الإنسانية بفلذات أكبادها أينما حل في أوطانها ومحافلها، لأنها عرفت فيه نظام الحياة الفاضلة المتكامل بين طرفي العدل والرحمة، وعلى دعائم هذا الدين النقي من شوائب التطرف المنطلق والجمود البليد أنشأ المسلمون حضارات فكرية واجتماعية لم يشهد التاريخ لها مثيلًا، فيما أضفته على البشرية من نعمة الأمن والسلام، ورغد العيش في ظل ظليل من العلوم والمعرفة والفلسفات الحية، والأفكار الحرة المستقيمة إلى أن انحرفت حياة المسلمين عن نهجها المستقيم، وانحسر المَدّ الحضاري المسلم، ووقف تيار الحرية الفكرية التي كانت تستهدي في مسيرتها بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وسبحات العقول المسلمة الهادية المهدية لتحمل إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها ثمرات العقل المسلم المهذب في الفقه التشريعي الذي كان ولا يزال سراجًا يضيء الحياة لولا سحائب الجهالة والجمود التي تراكمت في آفاقه؛ فحجبت عن الحياة أشعة إشراقه وأنوار هدايته.
وعموم الإسلام دينًا وشريعة ونظامًا اجتماعيًا متكاملًا يقوم بتحقيق مصلحة الأفراد والجماعات والأمم والشعوب يقتضي بالضرورة بقاء سلطانه التشريعي ما بقيت الدنيا عامرة بالجنس البشري المطبوع على التخالف والتنازع في الأغراض والمقاصد، والوسائل والأسباب مما يستدعي وجود شريعة تقيم الوزن بالقسط بين الناس، وتنصب لهم منائر العدل، لينكف الظالم عن ظلمه، ويأمن كل ذي حق على حقه، وهذا ما يعنيه علماؤنا من الأصوليين بقولهم: إن وضع الشرائع الإلهية إنما جاء لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، والمقصود المصالح الحقيقية التي يصلح عليها حال الفرد والجماعة في الدنيا، وتفضى إلى رضاء الله تعالى في الآخرة، وذلك يوجب لهذه الشريعة أن تكون وافية بحق هذا العموم والبقاء السرمدي في استمداد أحكام الحوادث التي تجرى بين الناس في معاملاتهم وفاءها بحقهما في العقائد والتعبدات.
وتعتمد الشريعة الإسلامية في ذلك على أصلها الأصيل الذي ترجع إليه لتستمد منه جميع مصادرها التشريعية قوة قانونيتها، ذلك الأصيل هو القرآن الكريم، الدستور الأعظم لشريعة الإسلام والمسلمين ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ٢)، يقول الإمام الشاطبي في الموافقات «فكتاب الله أصل الأصول، والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار، ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، لأنه كلام الله القديم، ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾ (النجم: ٤٢) ، وقد قال تعالى: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ﴾ (النحل: ٨٩) وقال تعالى ﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ﴾ (الأنعام: ٣٨).
وهو -أي القرآن- كلية الشريعة وعمدة الملة، وينبوع الحكمة وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، وهو مع كونه معجزًا على أي وجه من وجوه الإعجاز فهو جار على أسلوب العرب، ميسر للفهم لمن عرف أساليب الكلام العربي، وتدرب على فهمها، إذ لو أخرجه الإعجاز عن إدراك العقول لأحكامه وفهم معانيه لكان خطابهم به وتكليفهم أحكامه تكليف ما لا يطاق، وذلك باطل مرفوع عن الأمة، وتيسره مع إعجازه وجه من وجوه إعجازه، إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني، مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على أن يأتوا بسورة مثله، ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرًا.
وجريان القرآن في عبارته على مقتضى مألوف العرب في كلماتهم، وتراكيبهم يقتضي من الناظر فيه ليفهم معناه ومدلولاته أن يكون عليمًا باستعمالات العرب في أساليبهم، عارفًا بنظم كلامهم، خبيرًا بحقيقته ومجازه، وسائر مجازيه البيانية التي تختلف باختلاف مقتضيات الأحوال في المخاطبات، وهذا كان عند الصحابة رضوان الله عليهم سليقة لا يحتاجون فيها إلى فن موضوع، كما يقتضي من الناظر فيه أن يكون عليمًا بمواقع عمومه وخصوصه، ومطلقه ومقيده، ومبهمه ومفسره، ومجمله ومفصله، وناسخه ومنسوخه؛ حتى يستقيم له استنباط الأحكام منه على وجه صحيح، وهذا أيضًا كان عند الصحابة موفورًا، إما بالمشافهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بنقل من لم يشافه منهم عمن شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول ثقات مرضيون عند كافة الأمة، ولا عبرة بشذوذ ملحد مرتاب.
كيف تختلف أمة نبيها واحد
أما غير هم ممن تأخر عنهم ولم يلقهم أو لقيهم ولم تكن له سليقتهم ودقة فهمهم فلابد له عند النظر في القرآن من معرفة ذلك كله مضبوطًا في قواعد يرجع إليها، ولذلك وضعت أصول الفقه لضبط القواعد التي يرجع إليها المجتهدون.
كما يقتضي النظر في القرآن لاستنباط الأحكام منه معرفة أسباب تنزيله، لأن الجهل بها يوقع في الاشتباه والإشكال ويؤدي إلى الغلط في أخذ الأحكام اكتفاء بظواهر النصوص وعموماتها، وهذا كالذي يروى عن الخوارج، فإنهم عمدوا إلى آيات من القرآن نزلت في الكفار والمشركين، فأخذوها بظاهر عمومها وجعلوها في المؤمنين، روى ابن وهب أن نافعًا مولى عبد الله بن عمر سئل: كيف كان رأى ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، وهذا منهم محض الرأي والهوى، يفسر ذلك ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال:
خلا عمر ذات يوم، فجعل يحدث نفسه، كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين: إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يدرون فيم نزل، فيكون لهم رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، فزجره عمره وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال فعرفه، فأرسل إليه، فقال: أعد علي ما قلت، فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه.
وقد أشكل بعض الآيات بحسب عمومها على بعض الناظرين من السلف ولم يرفع عنهم الإشكال إلا معرفة سبب النزول، روى الشيخان أن مروان ابن الحكم أرسل إلى ابن عباس يقول له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا لنعذبن جميعًا، فقال ابن عباس مالكم ولهذه الآية؟ إنها نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، ثم قرأ ابن عباس الآية التي قبلها
﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ (آل عمران: ١٨٧ـ١٨٨).
بيانًا لارتباط الآيتين فيما وردوا فيه، ولذلك يقول الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، ويقول ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، ويقول ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن معرفة السبب يورث العلم بالمسبب.
التخبط في القول والتفسير
وبهذا الذي يقوله أئمة الهدى يتبين موقف المغرورين الذين يخبطون في القرآن بآرائهم لمجرد الهوى اعتمادًا على النظر إلى ظاهر الآيات ومعرفة معنى مفرداتها اللغوية، دون علم.
البقية في العدد القادم