العنوان معنى الإيمان بالقدر
الكاتب محمد عبد العزيز جبر
تاريخ النشر الثلاثاء 11-يوليو-1972
مشاهدات 18
نشر في العدد 108
نشر في الصفحة 14
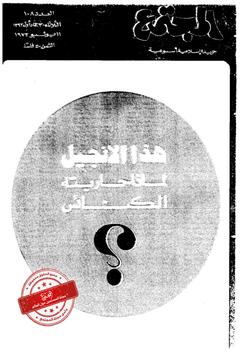
الثلاثاء 11-يوليو-1972
صفحات حرة
«2»
معنى الإيمان بالقدر
بقلم الأستاذ: محمد عبد العزيز جبر
فإن قلت:
قد تبين في المقال السابق أن الإيمان بالقدر خيرهِ وشره من شرائط الإيمان التي لا يتم الإيمانُ إلا بها مجتمعةً، ولكن لم تبين ما هو معنى الإيمان بالقدر الذي ينجو معتقده من الزيغ والضلال ويدخل في عداد الفرقة الناجية من المسلمين؟
قلت: الإيمان بالقدر أن تعتقد اعتقادًا جازمًا، وأن تؤمن إيمانًا راسخًا، أن كل ما كان وما هو كائن وما سيكون كله من عند الله، أراده أن يكون فقدره، ثم أوجده من العدم بقدرته فجاء على وفق ما سبقت به مشيئته وقدره، على كمال الحكمة وتمام العدل، فلا ظلم ولا عبث، بل كل ما خلق سبحانه من خير وشر، فهو حق خالص لا لعب فيه، عدل محض لا ظلم فيه، كمال صفو لا نقص فيه، كيف وقد خلقه العليم الحكيم، الذي سبقت رحمته غضبه، والذي كتب على نفسه الرحمة، والذي وسعت رحمتهُ سبحانه كل شيء.
قال الإمام الغزالي« رحمه الله":
»أنه مريد للكائنات، مدبر للحادثات، فلا يجرى في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر إيمان أو کفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيانًا، إلا بقضاء الله وقدره، وحكمته ومشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتةُ ناظر، ولا فلتةُ خاطر، بل هو المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، لا راد لأمره، ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيتهِ إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة على طاعته إلا بمشيئته وإرادته، فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين، على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنونها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك، وإن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوف بها مريدًا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دَبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تربص زمان، فلذلك لم يشغلْ بشأنٍ عن شأن» انتهى بنصه، إحياء علوم الدين ج(1) ص (٩٦.(
فإن قلت: فما الفرق إذن بين هذا القول وبين من يقول بالجبر، ومعلوم أن أحدٍا من أهل السنة لا يقول بالجبر.
قلت: صدقت. وسأبين لك-إن شاء الله- أما القائلون بالجبر، فيعنون بذلك أن الإنسان يتحرك بخلق الحركة فيه كما يتحرك الحجر لو خلق الله فيه حركة وقيام وقعود وكلام، لا فرق في ذلك بين الحجر والإنسان، فالإنسان عندهم محل لحركات مخصوصة خلقت فيه جبرًا عنه، فهي تنادى بواسطته دون شعور منه البتة، والحجر كذلك محل لحركات مخصوصة حدثت فيه جبرًا عنه، فهي تتأذى بواسطته دون شعور منه البتة.
وزيادة في البيان أقول: الإنسان عند الجبرية إذا تكلم مثلًا فهو كشريط للتسجيل يؤدى ما أودع فيه جبرًا عنه، وليس له خيار، والإنسان كذلك إذا تحرك فهو كالآلة حين تحركًا فتتحرك وتعمل جبرًا عنها دون وعي منها، فالإنسان عند الجبرية «آلة» لا يزيد ولا ينقص.
أما مذهب أهل الحق فهو أن الإنسان -وإن كان كل فعله وما يجرى عليه وبه ومنه بتقدير الله وخلقه- إلا أن له اختيارًا في أفعاله الاختيارية بمعنى أنه يحس ويشعر أنه يمارس حريته ويتصرف بإرادته فالله سبحانه منحه الشعور بإتيان العمل مختارًا حتى ليستطيع أن يميز بسهولة ويسر بين فعلين وقعًا منه، أحدهما رعشة اضطرارية، والآخر قيام اختیاری، وإن كان الأمران لو كُشف الغِطاء يستويان في كونهما من خلقِ الله وتقديره.
وفي تقرير هذا المعنى، وبيان الفرق بين الجبر والاختيار، وتبرئة مذهب السلف عن تهمة القهر والإكراه، يقول الإمام الغزالي في الإحياء ج (4) ص (٢٤٨) ما نصه: «لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثةِ أوجه، إذ يقال:
1. الإنسان يكتب بالأصابع
2. ويتنفس بالرئة والحنجرة
3. ويخرق الماء إذا وقف عليه بجسمه.
فينسب إليه الخرق للماء. والتنفس، والكتابة، وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والجبر واحدة، ولكنها تختلف وراء ذلك في أمور، فأعرب لك عنها بثلاث عبارات.
1. فنسمى خرقه للماء عند وقوعه على وجهه «فعلًا طبيعيًا»
2. ونسمی تنفسه «فعلًا إراديًا»
3. ونسمي كتابته «فعلًا اختياريًا »
والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي، لأنه مهما وقف على وجه الماء، أو تخطى من السطح للهواء، أنخرق الهواء لا محالة، فيكون الخرق بعد التخطي ضروريًا، والتنفس في معناه، فإن نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل البدن، فمهما كان الثقل موجودًا وجد الانخراط بعده، وليس الثقل إليه، وكذلك الإرادة -أي إرادة التنفس- ليست إليه، ولذلك لو قصد عين الإنسان بإبرة طبق الأجفان اضطرارًا، ولو أراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تغميض الأجفان اضطرار «فعل إرادي» ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدة بالإدراك، حدثت الإرادة بالتغميض ضرورة، وحدثت الحركة بها، ولو أراد أن يترك ذلك لم يقدر عليه، مع أنه فعل بالقدرة والإرادة، فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في كونه ضروريًا. وأما الثالث: وهو الاختياري فهو مظنة الالتباس، كالكتابة، والنطق، وهو الذي يقال فيه: إن شاء فعل، وان شاء لم يفعل، وتارة يشاء، وتارة لا يشاء، فيظن من هذا أن الأمر إليه، وهذا للجهل بمعنى الاختيار فلنكشف عنه، وبيانه: إن الإرادة تبع للعلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك، والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة بأنه يوافقك من غير تحير وتردد، وإلى ما قد يتردد العقل فيه، فالذي تقطع به من غير تردد أن يقصد عينك مثلًا بإبرة أو بدنك بسيف، فلا يكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خير لك وموافق فلا جرم تنبعث الإرادة بالعلم، والقدرة الإرادة وتحصل حركة الأجفان بالدفع، وحركة اليد بدفع السيف ولكن من غير روية وفكرة، ويكون ذلك بالإرادة، ومن الأشياء ما يتوقف التمييز. والعقل فيه فلا يدري أنه موافق أم لا؟ فيحتاج إلى روية وفكر حتى يتميز الخير في الفعل أو الترك، فإذا حصل بالفكر والروية العلم بأن أحدهما خير، التحق ذلك بالذي يقطع به من غير روية وفكر، فانبعثت الإرادة ههنا كما تنبعث لدفع السيف والسنان، فإذا انبعثت لفعل ما ظهر للعقل أنه خير سميت هذه الإرادة اختيارًا مشتقًا من الخير، أي «هو انبعاث إلى ما ظهر للعقل أنه خير»
ثم عرف الاختيار بعبارة أوضح فقال رحمه الله: «الاختيار عبارة عن: «إرادة خاصة وهي التي انبعثت بإشارة العقل فيما له في إدراكه توقف» وعن هذا قيل: إن العقل يحتاج إليه للتمييز بين خير الخيرين وشر الشرين» ثم انتهى الإمام الغزالي إلى القول الفصل في المسألة فقال رحمه الله: «معنی ک وأنه «مجبورًا» أن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لا منه، ومعنى كونه «مختارًا» أنه محل لإرادة حدثت فيه جبرًا بعد حكم العقل بكون الفعل خيرًا محضًا موافقًا، وحدث الحكم أيضًا «جبر» فإذا هو «مجبور على الاختيار»
ولكن ما معنى هذا يا إمام؟
قال رحمه الله «فعل النار في الإحراق «جبر محض» وفعل الله تعالى «اختيار محض» وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين فإنه «جبر على الاختبار» فالحاصل من كلام الإمام الغزالي أن الجبرية يرون صدور الأفعال من الإنسان كما يرون صدور الإحراق من النار، بينما يرى أهل الحق أن الله قد ميز فعل الإنسان بكونه صادرًا عن رضا وطواعية منه، وذلك الرضا المسمى «اختيار» يخلقه الله في قلبه ثم يليه الفعل، فمن حيث إن الله خلق فيه الرضا بفعل معين هو «مجبور» لأن لا يملك إلا أن يفعل بعد أن خلق الله في قلبه إرادة الفعل، ومن حيث أن يشعر بإتيانه الفعل عن رضا وطواعية واختيار فهو «مختار» وإن كان ذات الاختيار مخلوقًا فيه، وبعبارة وجيزة «للإنسان اختيار، ولكن لا خيار له في الاختيار» يعني لا يختار إلا ما اختار الله له.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه «شفاء العليل» الباب العاشر في بيان مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر قال رحمه الله: «وهي أربع مراتب:
المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها.
المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها.
المرتبة الثالثة: مشيئته لها.
المرتبة الرابعة: خلقه لها.
ثم قال رحمه الله في بيان المرتبة الثالثة:
«وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان، وليس في الوجود موجبًا ومقتضيًا إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»
ثم قال في بيان المرتبة الرابعة:
«وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفِطر والعقول والاعتبار»
ثم قال في المخالفين:
«فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدى ضالًا ولا يضل مهتديًا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلم والكافر والمصلي مصلي، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك، لا يجعله تعالى وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض، وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وعسكرة التصانيف في الرد عليهم وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله» انتهى كلامه بنصه قلت: وممن خالف في التسليم ببعض مراتب القدر كثير من علمائنا المعاصرين، غير أني سأناقش آراء ثلاثة منهم كمثال يجمع أقوال الجميع، وهؤلاء الثلاثة هم: «الشيخ سيد سابق، -الشيخ محمد الغزالي - وأخيرًا وبأدب أستاذي الكبير الشهيد سید قطب رحمه الله».
ولولا أن آراءهم مبثوثة في كتبهم الواسعة الانتشار، ولولا أن آراءهم لها وزن وقيمة عند شبابنا المسلم، لولا ذلك، لما استبحت لنفسي أن أجرؤ على مناقشتهم، غير أني ملزم بهذا البيان حيث إني لستُ متفردًا بهذا الرأي ولا مبتدعًا له، ولكني متبع إن شاء الله وناقل لإجماع الأمة على ما أقول والله المستعان.
اقتراح لمصلحة السجون
ما هو المقصود من عقوبة السجن؟ هل المقصود أن يُحبس المذنب لفترةٍ زمنيةٍ طويلة كإجراءٍ أمني للسيطرة على الجريمة، ولمنع حدوثها وكعقاب للمجرم بسلب حريته الخاصة هذه المدة الطويلة الأديبة على ما فعل؟ أم المقصود هو الحكم عليه بالإعدام لفترة مؤقتة حيث يتوقف عن الحياة الخاصة والعامة لمدة قد تصل إلى عشرين عامًا وبالتالي خصم مدة طويلة من عمره؟ قطعًا الجواب الأخير ليس هو الجواب. إذن فلماذا لا تتاح للسجين فرصة الاستفادة من وقته وهو رهن الحبس؟ فلو حول السجن إلى مدرسة أو مجموعة مدارس لتخصصات مختلفة أو وفق برامج التعليم العام فإننا ولا شك نقدم خدمة كبيرة للسجناء وهي بالتالي خدمة للمجتمع الكبير ومن وجهتين:
1- نكون أولًا قد ساهمنا في حركة التعليم العامة برفع الوعي الاجتماعي والثقافي في قطاع كان من الصعب أن ننهض به تعليميًا نسبة لظروفه الحياتية الشاذة.
2- نكون قد قدمنا حًلا عمليا ناجحًا في القضاء على الجريمة وعلاجًا فعالًا لكثير من الظواهر المرضية في المجتمع. ذلك لأن السجين حينما يشغل وقته في السجن بالحصول على شهادة تؤهله لمواجهة مسؤوليات الحياة، وأداء واجبه كمواطن في المجتمع، أو بتعلم صنعة فنية مفيدة أو على الأقل شغل نفسه باهتمامات علمية راقية ترفعه من القاع الآسن إلى مستوى المواطن المستنير. وبالتالي يكون أبعد عن دوافع الجريمة ويكون أقدر على العطاء بالنسبة لمجتمعه.
في ألمانيا الاتحادية نفذت التجربة وتقدم (۱۳) سجينًا لامتحان الابتدائية نجحوا جميعًا بتفوق كبير فبدأت مصلحة السجون تفكر جديًا في تعميم التجربة على السجناء. والاقتراح مقدم لمصلحة السجون هنا للنظر في هذه التجربة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
انظر إلى آثار رحمة الله - هذا التعليل لخلفية أفكار سيد ليس صحيحًا
نشر في العدد 102
33
الثلاثاء 30-مايو-1972



