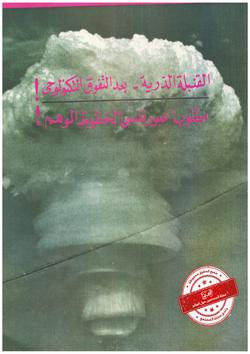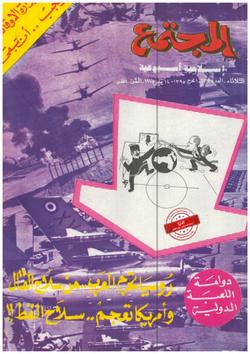العنوان مقدمة في تجديد الفكر الإسلامي مـحــاولــة لتشخيص الــداء (1من2)
الكاتب أحمد عبد الرحمن العماري
تاريخ النشر الثلاثاء 10-سبتمبر-1996
مشاهدات 10
نشر في العدد 1216
نشر في الصفحة 54
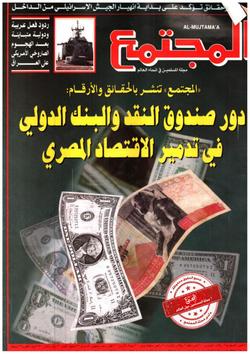
الثلاثاء 10-سبتمبر-1996
- طه حسين قاد الداعين إلى التخلي الكامل عن التراث الإسلامي ولغته العربية وإحلال الفكر الأوروبي واللغة الأجنبية محلهما.
لا يختلف المفكرون المسلمون اليوم في أن الفكر الإسلامي يعاني أسقامًا عدّة، وإن اختلفوا في ماهية تلك الأسقام ومدى خطورتها، وفي حدود علمي، لم يُعن أحد بمحاولة تشخيصها تشخيصًا علميًا دقيقًا، قبل الشروع في وصف العلاج، ويسلم كُتابنا تسليمًا بذيوع السطحية، والجمود، والعقم، دون أن يتحروا على وجه الدِّقَّة حقيقة هذه المثالب وأسبابها، ومجالاتها وآفاقها.
ويمكن القول إن الشروع في علاج مثل هذه المشكلات دون تشخيص هو أحد الأسقام التي يعانيها المفكر الإسلامي الحديث، ففي كثير من الحالات يُغفل التشخيص كلية، وفي بعض الأحيان، توصف المشكلة موضع البحث، بعبارات سريعة موجزة في المقدمة، يقفز بعدها الباحث إلى صلب البحث، ويشعر القارئ بالحيرة والاضطراب بسبب ذلك، ويُخيل إليه أن الكاتب يمطره بوابل من الإجابات عن غير سؤال معلوم!!.
ومثل هذا الباحث لابد أن يُخفق في التزام موضوعه فهو يخرج منه إلى غيره، كما يغفل منه أجزاء ظانًا أنها ليست منه، وفي نهاية المطاف يغلب أن يصف الباحث حلولًا لمشكلات أخرى غير مشكلته، أو يخفق في الوصول إلى أي حل لأي مشكلة.
ونحن لا نريد لأنفسنا أن نقع في هذا الخطأ، ونحن نعالج قضية التجديد، فتندفع إلى وصف العلاج دون تشخيص دقيق واسع، لم يكن لنا كبير رجاء في عمله العلمي، إنه عندئذ يتخلى عن دوره العلاجي، ويفقد القدرة على مجرد الإشارة إلى العلاج، ومن المحتمل أن تكون نتائج عمله أبعد ضررًا من علاج طبي دون تشخيص.
أسقام الفكر الإسلامي الحديث:
إن أسقام الفكر الإسلامي الحديث عديدة، فهناك اختلافات جذرية حول مفهوم التجديد ذاته، وهل هو «إحياء» أم «إحلال» وهناك فوضى المرجعية، والاضطراب الشديد حول الأصول وهناك التيارات التي تبتغي «تغيير الثوابت» وفي مقابلها أخرى تبتغي «تثبيت المتغيرات» وهناك قضية «الاستمداد من التراث» ومعها أو ضدها إرادة الابتداء من الصفر أو «إعادة اختراع البارود» وهناك «اتجاه يمدد نفوذ الخبرة البشرية إلى مملكة الوحي»، وآخر يريد عكس ذلك وهناك «مفهوم الوسطية الإسلامية»، وهناك «الظروف السياسية التي تحكم على الفكر الإسلامي بالظهور الجزئي» وهناك «غياب المعمل الاجتماعي للتجريب»، وما يسفر عنه من سجن الفكرة الإسلامية في عالم النظر، وحرمانها من التصحيح والتقويم والتطوير وهناك «العزوف عن الآليات الأدبية والفنية الحديثة»، كالسينما والمسرح لوصل الفكرة الإسلامية بالجماهير، والحفاظ الشديد على منهج «أخطب وأخطب، ثم أخطب، وهناك الكثير من غير هذه الأسقام والعقبات أيضًا.
وقد اخترت المشكلات الثلاث الأولى موضوعًا لهذه الدراسة، أعني هل التجديد إحياء أم إحلال؟ ثم فوضى المرجعية، ثم الاتجاه إلى تغيير الثوابت وتثبيت المتغيرات، ولعل الفرصة تتاح في المستقبل القريب لبحث بقية المشكلات.
هل التجديد «إحياء» أو «إحلال»؟
لعلي لا أبالغ إذا قلت إن الاضطراب في مفهوم التجديد هو أخطر الأسقام التي عانى منها الفكر الإسلامي الحديث، فخطة التجديد مرهونة بذلك المفهوم، والتردد أو الاضطراب فيه ينتقل مباشرة إليها، وإذا تعارضت المفاهيم والخطط كان "التهادم"، نتيجة حتمية لذلك، فما يصنعه فريق بوصفه تجديدًا، يحاربه فريق آخر بوصفه تهديمًا، أو تضليلًا وينطبع هذا كله في أنشطة المجتمع التربوية والثقافية والإعلامية، فتعيش الأمة في حرب أهلية ثقافية.
ونحن نعرض هنا لمفهومين للتجديد، أحدهما يرى أنه إحياء للفكر الإسلامي واللغة العربية، والآخر يعتقد أنه إحلال للفكر الأوروبي واللغة الإنجليزية -أو الفرنسية- محل الفكر الإسلامي واللغة العربية. وأحسب أنهما يفيان بغرضنا هنا، أعني الكشف عن هذا السقم أو المرضى، ومحاولة تشخيصه، وأما المسح الشامل لكل المفاهيم فهو موضوع واسع يستغرق كتابًا أو بابًا في كتاب.
رأي الشيخ محمد عبده:
وفي اعتقادي أن الشيخ محمد عبده يمثل القائلين إن التجديد إحياء لا إحلال تمثيلًا جيدًا، على الرغم من أنه ليس الاعتقاد الذي يوافقني فيه الكثيرون.
لقد واجه محمد عبده تدهورًا شديدًا في الفكر الإسلامي واللغة العربية، وعاء الفكر وأداته كان الفكر الإسلامي متوقفًا عند الموروث، بمتونهوشروحه عاجزًا عن الإضافة إليه.
وكانت الخلافات المذهبية في الأصول والفروع هي الشغل الشاغل للزمر المحدودة من المتعلمين، وأما خارج تلك الزمر، فقد كانت الخرافة تسيطر على الجماهير، ويمتد نفوذها إلى كثير من الخطباء والمدرسين والعلماء، وفي اللغة العربية، وجد محمد عبده ثلاثة أنواع من الأساليب كانت مسيطرة كلية: أسلوب المكاتبات الحكومية «وهو رث خبيث غير مفهوم» وأسلوب الشيوخ الأزهريين، ويتحكم فيه السجع والجناس «ولا ينطبق على آداب اللغة العربية». وأسلوب الكُتاب السوريين المهاجرين في تحريرهم لجريدتي «الجنة» و«الجنان» تحت قيادة بطرس البستاني. (1)
وكان محمد عبده على يقين من إمكان تجديد الفكر الإسلامي واللغة العربية، فتلك الأسقام ليست طبيعية فيهما، وإنما هي عارضة، وبالوسع البر منها، ولم يقبل النمط التركي العلماني للتجديد، وكان هو المثال المعروض للتجديد في المشرق العربي هذا على الرغم من ثقافة محمد عبده الواسعة التي ألمت باللغة الفرنسية والفكر الأوروبي نادى محمد عبده بتحرير الفكر الإسلامي من قيود التقليد أي التراث المذهبي، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف وتبلوره في مذاهب عقدية وفقهية، ثم تحجره في متون وشروح وهوامش وحواش، وتقديس آراء السابقين كأنها وحي من السماء..
وعُني محمد عبده بممارسة التجديد بهذا المفهوم، ولم يقف به عند مرحلة التنظير والاقتراحات، وكان ذلك من أهم معالم مشروعه التجديدي، وكان غياب الممارسة هو أخطر المثالب في محاولات تجديدية أخرى تحجرت عند النظرية واستغرقت كلية في الاقتراحات، دعا محمد عبده المثقفين إلى التجديد، ومارسه في الفكر واللغة فكتب، وحاضر وأفتى، وحاور، وجادل على هذا الخط التجديدي، وقد مكنه التحرر من قيود المذهبيات من الاتصال الحر المباشر بالكتاب والسنة وأعانه على مواجهة الحاجات الجديدة للأمة، وعلى التصدي للتنصير والاستشراق، وبذلك قدم الأمثلة على جدوى التجديد، وجذب إليها أعدادًا كبيرة منالتلاميذ والأتباع والأنصار الذين شكلوا مدرسته كذلك أثارت ممارسات محمد عبده في الإفتاء ثائرة الكثيرين، واستفاد هو من الذين عارضوه، ومنالذين أيدوا، فكان المجتمع المصري معملًا لتجديد محمد عبده فيه يثبت الصحيح صحته، والخطأ خطأه، فيعتمد الأول ويستبعد الآخر.
وصف العقاد:
ويصف الأستاذ عباس محمود العقاد بعض تلك الممارسات فيقول إن محمد عبده: «كان يُعين جماعة إحياء الكتب العربية بعلمه ووقته وماله ونفوذه» وكان ينشر نماذج البلاغة السلفية ويشرحها بقلمه أو ينوه بها في دروسه وتفسيراته، من قبيل نهج البلاغة، ومقدمات البديع، ودلائل الإعجاز وأسرارالبلاغة» (۲).
وقد كتب محمد عبده بالعربية الفصحى المتجددة، المتحررة، الكثير من المقالات في «الوقائع المصرية»، وألف بها: «رسالة التوحيد» و«الإسلام والنصرانية»، و«تفسير جزء عم» وأجزاء أخرى من القرآن الكريم نشرتها مجلة «المنار»، وكتب بالفصحى المتجددة مقالات عديدة في السياسة والاجتماع والفكر في مجلة «العُروة الوثقى» وكانت «العروة الوثقى» مدفعية ثقيلة ضد الاحتلال الإنجليزي، فحاربتها السلطات الاستعمارية وحظرتها وعاقبت كل من تضبط في حوزته. (۳).
التجديد «إحلال» لا «إحياء»:
لكن على الرغم من الأثر الواسع لمدرسة محمد عبده التجديدية، ظهر المفهوم الآخر للتجديد بوصفه إحلالًا للفكر الأوروبي واللغة الإنجليزية محل الفكر الإسلامي واللغة العربية، وإحقاقًا للحق نقول إن التخلي عن التجديد على أنه «إحياء» وفهمه على أنه «إحلال» لا يمكن أن تقع مسؤوليته على عاتق أي شخص معين أو دولة معينة، لأنه إفراز طبيعي لجهود جبارة بذلت من قبل المؤسسات التنصيرية والاستشراقية، في حماية الاستعمار، وبتمويله، في مجالات التعليم والإعلام والآداب والفنون في تركيا والهند ومصر، وإيران، والشام، وشمال أفريقية، على امتداد قرنين من الزمان، وقد أثمرت تلك الجهود فتولدت زُمر ثقافية عديدة، تعتقد بأن التجديد في عالمنا العربي والإسلامي مرهون بالتخلي الكامل عن التراث ولغته العربية، وإحلال الفكر الأوروبي واللغة الإنجليزية محلهما.
الإحلال عند زكي نجيب محمود:
وقد عبر عن هذا الاتجاه الدكتور زكي نجيب محمود فقال: «لا أمل في حياة فكرية معاصرة إلا إذا بترنا التراث بترًا وعشنا مع من يعيشون في عصرنا علمًا وحضارة ووجهة نظر إلى الإنسان والعالم، بل إني تمنيت عندئذ أن نأكل كما يأكلون «يعنى الأوروبيين والأمريكيين» ونجد كما يجدون، ونلعب كما يلعبون، ونكتب من اليسار إلى اليمين كما يكتبون» وقال الأستاذ إنه قد انتهى إلى «نظرات في التحول من قديمنا إلى الحديث بأنه: لا تحول إلا إذا بدأناه من الجذور -من المبادئ نقتلعها لنضع مكانها مبادئ أخرى، فنستبدل مثلًا عُليا جديدة بُمثل كانت عليا في أوانها، ولم تعد كذلك» (٤) والدكتور زكي يعبر عن آراء أستاذه الدكتور طه حسين مع إضافة يسيرة، فطه حسين لم يطالب بإحلال أي لغة أجنبية محل العربية، وطه حسين أيضًا يردد أفكار الأتراك العلمانيين مثل ضياء كوكأدب (١٨٧٥- ١٩٢٤) (٥).
وقد عبر الدكتور طه حسين عن مفهوم التجديد هذا فقال إننا يجب أن: «نسير سيرة الأوروبيين، ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومُرها، وما يحب منها وما يُكره، وما يُحمد منها وما يُعاب (٦)، وهو تعبير متهور كما ترى وربما شعر طه حسين بذلك فأراد أن يخفف من غلوائه فقال في الكتاب نفسه بعد صفحات قليلات، إننا: «إذا دعونا إلى الاتصال بالحياة الأوروبية ومجاراة الأوروبيين في سيرتهم التي انتهت بهم إلى الرقي والتفوق، فنحن لا ندعو إلى آثامهم وسيئاتهم، وإنما ندعو إلى خير ما عندهم وأنفع ما في سيرتهم، لا ندعو إلى أن نكون صورًا طبق الأصل للأوروبيين كما يُقال، فذلك شيء لا سبيل إليه، ولا يدعو إليه عاقل» (۷) وكلامه هذا يحتمل تفسيرات عديدة، غير أن مواقف الدكتور طه وآراءه ظلت حتى وفاته ترجح كلامه الأول.
أما تلاميذ الدكتور طه حسين فقد اختاروا الإحلال الثقافي التام كطريق وحيد للتجديد، وقد تأدي بهم وبنا معهم إلى أسقام مهلكة للفكر الإسلامي، فالبديل الأوروبي يتمثل في مذاهب عدّة، كالعقلانية والوضعية المنطقية والتجريبية، والبراجماتية والوجودية، وقد انتقل هذا التعدد إلى ساحتنا الفكرية، وأخذ كل فريق يناصر مذهبًا ويرشحه للإحلال محل الفكر الإسلامي، ووقعت خلافات ومجالات، وتراكمت حزازات وسخائم، فإذا وصل فريق إلى مقاليد التوجيه والقيادة في بعض المجتمعات، أخذ يترجم أصول مذهبه وينشرها في الجامعات، ويحاول تطبيقها في الحياة، ولم يستطع أي فريق أن يعلن صراحة أنه قرار إحلال الفكر الأجنبي محل الفكر الإسلامي، واضطر إلى القبول الجزئي بالعقيدة والعبادة وقانون الأحوال الشخصية.
وهكذا نشأ «هجين ثقافي» من عناصرمتشاكسة متنافرة، ووقعت أجيال من المتعلمين فريسة للتمزق والحيرة نتيجة لذلك، ولا يزال هذا الداء يعمل عمله المخرب في فكرنا إلى اليوم.
وإزاء المقاومة العنيدة للغة المضادة الضاربة بقوة وعمق في التربة العربية، اضطر المنادون بإحلال الإنجليزية محل العربية إلى اللوذ بالصمت والتخلي عن مخططهم بعد أن ثبت لهم أن ذلك مستحيل والعربية هي خزانة الفكر الإسلامي ورافده الأعظم، ووعاؤه وأداته، ولا مفر أن يبقى ببقائها، ويزدهر بازدهارها، وهذا هو ما حدث، فمع توسع التعليم، أقبل الناس على كتب التراث إقبالًا عظيمًا، وترددت أسماء الغزالي وابن تيمية وابن القيم في القرى النائية، وحبطت مشروعات الترجمة الواسعة للبديل الأوروبي حبوطًا ذريعًا.
ولقد حمل أنصار الإحلال بعنف على اللغة العربية، وظنوا أن بوسعهم قتلها عن طريق اللهجات العامية، أو اللغات الأجنبية، وبذلك يقطعون الصلات بين الأجيال الجديدة وبين منابع الفكر الإسلامي في تراثه الموروث كله.
ونجد التعبير الأخير عن هذا التوجه عند الدكتور زكي نجيب محمود الممثل الأخير لهذا التيار إذ يقول: «إن العربية كما نراها في التراث الأدبي، وكما لا تزال عند كثيرين ممن يظنون أنهم يكتبون أدبًا توشك ألا تنتمي إلى دنيا الناس، فلا تكاد ترى علاقة بينها وبين مجرى الحياة العملية، ولذلك لم يجد المتكلمون بالعربية مفرًا لهم من أن يخلقوا -إلى جانب الفصحى- لغات عامية يباشرون بها شئون حياتهم اليومية».. لأن الفصحى: «أداة عروج إلى السماء، لا وسيلة اتصال بالواقع» (۸) فالقصور ليس طارئًا على الفصحى كما فهم محمد عبده، بل هو في طبيعتها ذاتها، ومن ثم فهي جهاز عاجز عن التعبير، ولا جدوى من تجديده، فلا مناص من «الكتابة من اليسار إلى اليمن» حسبما قال هو، ثم أدرك الرجل مؤخرًا ومعه فريقه أنهم عاشوا في وهم كبير، وأخذ يواسي بعضهم بعضًا، فقالوا: إن لكل شيء أوانه، ولكل تطور مرحلة، فلنعمل على إحلال الفكر وندع إحلال اللغة، وقد بذرنا البذرة، ولسوف يأتي جيل من أحفادنا يتمم ما بدأناه، ويرطن بالإنجليزية، ويرجع إلى مصادرها، وينقل فكر أهلها. وينجز مشروع الإحلال الثقافي التام، وهذه المواساة قد تحفظ ماء الوجه، وإن اخترمها البطلان من أقطارها جميعًا، فكل الظواهر تشير إلى سقوط البديلين الشيوعي السوفييتي، والبراجماتي الأمريكي في الاتحاد السوفييتي وأمريكا..
الهوامش:
(*) كاتب ومفكر مصري
1- مذكرات الإمام محمد عبده، نشر دار الهلال، مصر، دون تاریخ، ص ۱۸، ۱۹
2- عباس محمود العقاد: محمد عبده، نشر دار نهضة مصر، سنة ١٩٦٢م،
ص ١٨٦، «وانظر: الموسوعة العربية الميسرة دار نهضة لبنان سنة ١٤٠١ هـ - ١٩٨١».
3- مقدمة الطبعة الحديثة للعروة الوثقى بقلم: مصطفىعبد الرازق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 3.
4- د. زكي نجيب محمود: الفكر العربي، دار الشروق، ط 5 سنة ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨م، ص 204.
5- د. أحمد عبد الرحمن: نقد الثقافية الإلحادية دار هجر للطباعة والنشر القاهرة، سنة ١٤٠٦- ١٩٨٥م، ص: ٦٤- ٦٨.
٦- د. طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر، «ضمن مجموعة أعماله الكاملة» جـ 9 ص ٤٨.
7- نفسه، ص ٦٣.
8 - د. زكي نجيب محمود، السابق ص ٢٢١، ص ٢٠٦- ٢٠٧.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلهل تتوفر الاستقامة الفكرية لشخص.. لا تزال كتبه تحمل الاعوجاج الفكري؟ طه حسين أَلف كتبا تهاجم القرآن والإسلام.. ولا تزال موجودة!
نشر في العدد 177
28
الثلاثاء 27-نوفمبر-1973