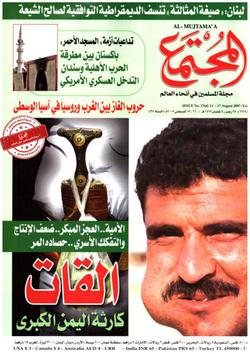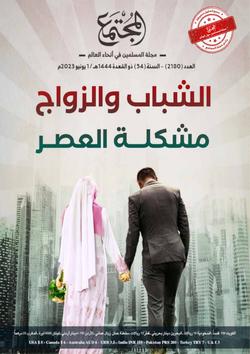العنوان من أين نأخذ ثقافتنا؟
الكاتب الأستاذ أنور الجندي
تاريخ النشر الثلاثاء 11-أغسطس-1970
مشاهدات 168
نشر في العدد 22
نشر في الصفحة 12
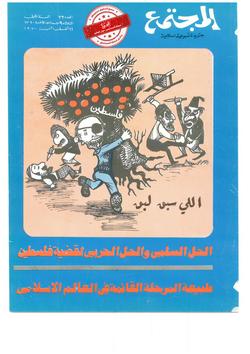
الثلاثاء 11-أغسطس-1970
البطل هو العمل.. لا الفرد
لن يسقط الإسلام أمام التيارات الإلحادية
· على المثقَّفين العرب أن يفكِّروا بلُغتهم، وأن يتحرَّكوا من داخل تراثهم وفكرهم، وأن يتجاوزوا سارتر وفرويد وماركس جميعًا.
· ليس الإسلام سبب التخلُّف، وإن قيل في أوروبا إنَّ الدين كان سبب تخلّفها.
· من أخطر الاتِّهامات الَّتي يوجهها التغريب القول بأنَّ عظماء الفكر الإسلاميِّ لم يكونوا عربًا، والحقُّ أنَّه في مجال الحضارة الإسلاميَّة لم يكن هناك عرب ولا عجم، ولكن المصدر الأوَّل هو الفكر الإسلاميّ المستمدّ من القرآن، والذي أنشأه الإسلام والذي اعتنقه العرب والترك والفرس وغيرهم.
يواجه الفكر الإسلاميُّ والثقافة العربيَّة اليوم حملة ضارية من خصوم العرب والمسلمين، حيث تجري وضع مقوِّمات الأمَّة العربيَّة كلِّها على مشرحة النقد والتشكيك والاتِّهام وتصدر مؤلّفات مختلفة وصحف متعدّدة ذات طابع تغريبي، تحمل بين جوانحها هذه الشبهات وليس في المُستطاع مواجهة هذه الاتِّهامات بالنقد واحدة بعد أخرى، ولكن في الاستطاعة «إقامة قاعدة أساسيَّة» تنطلق منها نظرة المثقَّف في الأُمَّة العربيَّة إلى هذه النظرات والدعوات في مجال تصحيح المفهومات:
1- إنَّ كلَّ محاولة لهدم مقوِّمات ديننا أو لغتنا أو إثارة الشبهات حول طابع أُمَّتنا في الصمود والمقاومة والحفاظ على المقدَّسات، كلُّ هذا يُنظر إليه على أنَّه دعوة تغريبيَّة، ومن ثمَّ فيجب النظر إلى ما يُقال وإلى من يقول في تحفّظ تامٍّ.
2- إنَّ عددًا كبيرًا من الكتاب قد أكسبتهم ظروف الولاء الاستعماريّ شهرة، ومن ثمَّ فإنَّ شبابنا ينظر إلى ما يكتبون بإعجاب، وآية ثقتنا في الكاتب هو إيمانه بأمَّته ودعوته إلى وحدتها وغيرته على لغتهـا ودينها وتاريخها. فإن فقدت كتابته هذا الوجه يجب النظر إلى ما يقول بحذر. بل إنَّ من أبرز علامات المنهج العلميِّ الإسلاميِّ العربيِّ ومنهج المعرفة الإسلاميِّ هو: أن يقول قائل فإنَّه يؤخذ منه ويترك وهو عرضة للخطأ والصواب، إلَّا ما ورد محقّقًا على لسان سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
3- إنَّ أُمَّتنا لن تستطيع تحقيق النصر واستئناف النهضة إلَّا إذا كانت ثقة كتابها ومُفكِّريها صادقة عميقة بالارتباط بقيمها وتاريخها وتراثها، فهذه هي القاعدة الأصيلة الثابتة الَّتـي منها نبعث أعمال المقـاومة للغاصب، وأعمال البناء الفكريِّ والاجتماعيِّ.
4- على المثقَّفين العرب أن يفكِّروا بلغتهم، وأن يتحرَّكوا من داخل تراثهم وفكرهم، وأن يتجاوزوا سارتر وفرويد وماركس جميعًا.
ذلك أن أبرز أعمال المفكرين العرب والمسلمين في هذا العصر ومنطلق كفاحهم وغايته الحقَّة، هو تحرير الفكر الإسلاميِّ والثقافة العربيَّة من هيمنة الثقافة الغربيَّة والعقليَّة الوثنية اليونانية والباطنية القديمة. وهي نفس المهمَّة الَّتي واجهت من قبل أساطين العلماء: ابن حزم والغزالي وابن تيمية.
5- علينا أن نفرّق دائمًا بين الحضارة والاستعمار، وأن نعرف أنَّ الغربيَّ لم يفد إلى الشرق کممدن بل كمستعمر.
6- ليس الإسلام سبب التخلُّف، وإن قيل في أوروبا أنَّ الدين كان سبب تخلّفها.
7- إنَّ الفكر العربيَّ الإسلاميَّ على استعداد دائم للنموِّ عن طريق الأخذ والعطاء، وله قدرته أيضًا على رفض كلِّ ما لا يتَّفق مع ذاتيَّته ومقوِّماته. وهو يصهر ما يأخذ في بوتقته ويحيله إلى كيانه، ويتمثَل ما يأخذ بحيث يصبح هذا المأخوذ جزءًا من واقعه.
8- إنَّ للعرب ثقافة خاصَّة بهم لا تستطيع أن تنصهر في الثقافات الأخرى، لأنَّ لها مقوِّماتها الخاصَّة المتميِّزة والمختلفة، ومن الحقِّ أن يُقال إنَّ التفاعل في حدود القيم الأساسيَّة ممكن، ولكن الامتزاج مستحيل.
9- إنَّ الأمَّة العربيَّة الآن في واقع فرض نفوذ استعماريٍّ وغزو صهيونيٍّ، ومن هنا فإنَّ من حقِّها أن تكون حذرة في مواجهة النظريَّات والمذاهب المختلفة، وألا تستسلم لكلِّ ما يعرض عليها، والفكر الإسلاميُّ يختلف عن الفكر البشريِّ كلِّه، لأنَّه يقوم على أساس التوحيد والقرآن.
10- هناك خلاف أساسي وجذري بين الفكر الإسلاميِّ والفكر الغربيِّ، فالفكر الغربيُّ يؤمن أساسًا بالتجزئة والفصل بين القيم ولا يقبل التكامل الذي هو أبرز معالم الفكر الإسلاميِّ القائم على الترابط بين القيم والعناصر.
11- إنَّ الأُمَّة العربيَّة قد رفضت النزعة العلمانيَّة اللَّادينيَّة بعد أن أخفقَت تجربتها في أقطار أخرى، وإنَّه في الحقيقة لا يوجد جفاء بين الإسلام وبين العروبة.
12- يرفض الفكر الإسلاميُّ أبرز أسس الفكر الغربيّ في إقامة الحياة كلِّها على أساس لا دينيِّ، وفي أنَّ الإنسان خاضع للحسِّ وحده، وفي التصوُّر المادِّيّ في الفكر والحياة ومن هنا خطأ الاعتماد على مصادر الغرب واتِّخاذها حقائق مقرَّرة.
13- تربط الثقافة العربيَّة بين الإسلام والمجتمع، ونرى أنَّ الثقافة العربيَّة مستمدَّة أساسًا من الإسلام غير منفصلة عنه.
14- علينا دائمًا أن نلحظ الفوارق العميقة بين العلم والثقافة وبين العلم والفلسفات.
§ العلم مشاع لكلِّ الأمـم، لكن الثقافة ذاتيَّة وقوميَّة لكلِّ أُمَّة ثقافتها المستمدَّة من دينها وقيمها وذوقها وفطرتها.
§ العلم ما تنتجه المعامل ولا يختلف فيه اثنان، أمَّا الفلسفات فهي فرضيَّات فرضها المفكِّرون تصحّ وتُخطئ، وتختلف باختلاف الأقطار والعصور والأُمم وما يصلح منها لقومٍ يكون سما لآخرين.
15- علينا أن نؤمن بأنَّ لنا ذاتيَّة ثقافيَّة لها مقوِّماتها وفلسفتها ومنهجها، وفي ضوء هذه الذاتيَّة نقتبس أو نرفض من فِكر الأُمم، على أن نتذكَّر دائمًا أنَّ القوى الأجنبيَّة تحاول أن تفرض فكرها، وأن علينا أن نحمي أنفسنا من الذوبان في بوتقة العالميَّة.
16- المعرفة غير الثقافة، والخلاف بينهما هو الخلاف بين الرأي والعقيدة، فلنحذر من اعتناق معارف الأمم، ولدينا عقائدنا ولنحذر الكلمات الغامضـة المبهمة، والمفهومات الدخيلة التي لا تلتقي مع فطرتنا.
17- طبّق أجدادنا علم الجرح والتعديل على كلِّ متصل بالعلم والثقافة وحذَّرونا من أصحاب الأهواء، والعاجزين عن التحقيق والمخدوعين والمضلِّلين.
18- من أخطر الاتِّهامات الَّتي يوجهها التغريب القول بأنَّ عظماء الفكر الإسلاميِّ لم يكونوا عربًا والحقُّ أنَّه في مجال الحضارة الإسلاميَّة لم يكن هناك عرب ولا عجم، لكن المصدر الأوَّل هو الفكر الإسلاميّ المستمدّ من القرآن، والذي أنشأه الإسلام والذي اعتنقه العرب والترك والفرس وغيرهم.
19- علينا أن نحتاط في اتخاذ كتب المحاضرات والفكاهات مصادر للبحث، كالأغاني وألف ليلة ومحاضرات الأدباء، وقد تنبّه علماؤنا إلى ذلك فعرضوا لهذه المصادر الضالة: اقرأ تلبيس إبليس لابن الجوزي والعواصم من القواصم للقاضي العربيّ والانتصار للحسين الخيّاط.
20- هذا الاهتمام بالحضارات القديمة السابقة للإسلام اتجاه قد يكون نافعًا، ولكنّه يحتاج إلى النظر إليه في احتياط، فإنَّ التغريب يحمل في مخطَّطه محاولة دائمة إلى ردِّ العرب والمسلمين من واقعهم الفكريِّ الذي عاشوا به خمسة عشر قرنًا إلى ما قبل ذلك من وثنيَّات وحفريَّات ويعمل التغريب في ثلاثة مجالات معًا لحجب المسلمين والعرب عن ثقافتهم الأصيلة «في الجاهليَّة العربيَّة» أو «الوثنيَّة الإغريقيَّة» أو «الغربيَّة المادِّيَّة».
21- خطر القول بوحدة الثقافة العالميَّة، فهذه الوحدة لا تعني بالنسبة للأُمة العربيَّة اليوم إلَّا مركز التبعيَّة والضعف بالنسبة للثقافات العالميَّة ذات القُوى والنفوذ والسيطرة وليس هناك وحدة ثقافة، ولكن هناك تقارب في مجال الفكر لا يخضع ثقافة لثقافة، ولا أُمَّةٍ لأُمَّة، ولكن يحفظ لكلِّ أُمَّة مقوّماتها ويفتح لها الطريق إلى أخذ ما يتَّفق مع طابعها وذاتيَّتها.
22- لقد كان الفكر الإسلاميُّ والثقافة العربيَّة ولا تزال مركز «الوسطيَّة» بين فكر العالم وثقافته، بين الروحيَّة الخالصة القائمة على الإشراقيَّات والتراث الباطنيّ والمجوسيّ القديم، وبين المادِّيَّة الخالصة القائمة على الوثنيَّات والفلسفات اليونانيَّة القديمة، ولذلك فقد جاء الإسلام جامعًا بين الروح والمادَّة، والعقل والقلب، مبرئًا من الوثنيَّة والباطنيَّة جميعًا.
وهنا موضع الحذر ممَّا يُسمَّى تراث الأساطير الشرقيّ والغربيّ والملاحم وغيرهما ممَّا ينقل المثقَّف العربيَّ من طابعه الواقعيِّ الجامع بين الروح والمادَّة إلى عالم من الزخارف والطقوس والاستعراضات المسرحيَّة الَّتي لا تتَّفق مع مزاجه وصميم عقيدته القائمة على التوحيد.
23- مفهوم البطولة في الفكر الإسلاميِّ مفهوم عمليٌّ، وليس مفهوم الأحجار والتماثيل فالبطل في الإسلام هو العمل لا الفرد، وتخليد البطولة هو إثبات الفكرة الصالحة وتنفيذها وإيجادها، وليس تخليدها بالتماثيل أو كلمات الثناء الفارغة أو الاحتفالات الوهميَّة، وتأكيدًا لهذا المفهوم جعل عمر رضي الله عنه، عند بدء التاريخ الإسلاميِّ بالهجرة، وليس بمولد محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم أو وفاته. والذاتيَّة العربيَّة الإسلاميَّة تكره التعلُّق بتقديس المادَّة، ولا ترى في الشخصيَّات الكُبرى إلَّا أعمالًا خالدة، فالعبرة بعمل عمر مثلًا وليس بشخصيَّته أو إقامة تمثال له. ولذلك فإنَّ تقدير البطولة في عمر هو التماس مفهوماته وتطبيق خططه ومناهجه.
24- اللُّغة العربيَّة الفصحى هي مصدر المصادر في النهضة العربيَّة، والدعوة إلى العاميَّة أو تبسيط اللُّغة أو التقريب بين اللَّهجات يتجاوز مفهومًا صريحًا واضحًا، هو أساس الأسس في أمر اللُّغة وهو الاقتراب من بلاغة القرآن، أو الابتعاد عنها، وكلُّ دعوةٍ إلى الابتعاد عنها هي محاولة تغريبيَّة واضحة.
٢٥- رفض الفكر الإسلاميِّ الفلسفة الإغريقيَّة الهلينيَّة، والمنهج الأرسطيّ وأقام منهجه الذاتيَّ المستمدّ من مقوِّماته: المنهج العلميّ التجريبيّ.
وقد عجزت الفلسفة اليونانيَّة أن تستوعب الإسلام بعد أن استوعبت بعض الأديان الأخرى.
26- رفض الفكر الإسلاميِّ إغراق العقلانيِّين والوجدانيِّين، رفض استعلاء العقل وجبريَّة التصوُّف وكشف عن جوهره على أساس أنَّ مفهوم المعرفة الإسلاميَّة له جناحان: العقل والوجدان معًا.
27- خطران علينا أن نتفَّهمهما: ألَّا نأخذ معلوماتنا من كتب المبشِّرِين ولا من الكتب العربيَّة في مرحلة الضعف كنزهة المجالس وبدائع الزهور، وغيرهما، ولنأخذ فكرنا من المصادر الأساسيَّة الأولى الموثوقة، ومن آراء العلماء من غير ذوي الأهواء، ولنعمل دومًا على تصحيح ما دسّته الفرق والباطنيَّة والشعوبيَّة في تاريخ العرب والمسلمين وفكرهم من سموم، ولنجعل مقياسنا وميزاننا: القرآن وما صحَّ من حديث رسول الله. ولنذكر دومًا قول رسول الله: «يحمل هذا العلم من كلِّ خلف عدو له، ينفون عنه تحريف الغالية، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».
ولنذكر أنَّ الشعوبيَّة والباطنيَّة قد دسَّت في تفسير القرآن، وفي تاريخنا الفكريِّ والسياسيِّ والاجتماعيِّ: أساطير ووثنيَّات وإسرائيليَّات وأقاصيص غير عربيَّة وغير إسلاميَّة من تراث اليونان والفرس والهند واليهود، وهي مليئة بالأهواء المُضلَّة، فعلينا تحرير فكرنا وتحرير ذاتيَّتنا بالكشف عن هذه الأخطاء ولنحذَر رواة الأدب وأهل الغفلة والهوى الذين اعتمدوا في تاريخهم على كتب الأدب ومؤلّفات المبشِّرين والمستشرقين. وقديمًا وصف القاضي أبو بكر بن العربيّ أهل الأدب فقال إنَّهم حين غلبت عليهم صناعة الأدب مالوا إلى كلِّ غريب من الأخبار دون أن يتحرُّوا الصدق أو يهتمُّوا بالرواية والإسناد، وإنَّ كلَّ ما أورده كذب صراح، فما جرى منه حرف قط، يقول: ذكرت لكم هذا لتحذَروا من الخلق وخاصَّةً المُفسِّرين والمؤرِّخين وأهل الأدب، فإنَّهم أهل جهالة بحُرمات الدين أو على بدعة مصريِّين فلا تبالوا بما رووا ولا تقبلوا رواية إلَّا عن الأئمَّة الثقات. ونحن الآن نقول بما قال القاضي أبو بكر بن العربيّ ونحذر في العصر الحديث ممَّا حذر منه.
وآية الآيات في ذلك الإيمان الأكيد بأنَّ الفكر الإسلاميَّ لا يعمل إلَّا ضمن النطاق الذي حدَّده القرآن ورسمه الإسلام ولا شكَّ أنَّ هذه التغطية والمتابعة المتَّصلة هي التي تحول بين الفكر الإسلاميِّ والثقافة العربيَّة وبين الاستسلام للنظريَّات الغربيَّة، فقد ظلَّ الفكرُ الإسلاميُّ دومًا وجيلًا بعد جيل يواجه هذه النظريَّات ويُدلي برأيه فيها ولا يتوقَّف عن معارضة كلِّ خطأ منها، ولا يتقبل كلَّ شيء كما هو، ويعارض قبول كلِّ قيم ليست من أسسه مع سماحته المعهودة في تقبُّل ما يجدِّده دون أن يخرج عن مقوِّماته.
والثقافة العربيَّة هي إسلاميَّة الجذور، ولم توجد إلَّا بالإسلام وأبرز ما يتميَّز به الفكر الإسلاميُّ هي قدرته على أن يأخذ حاجته من أيِّ ثقافة تُفرض على أفقه ويردُّ الباقي.
وقد أكَّد العارفون بهذه المعاني أنَّ الإسلام لا يسقط أمام التيَّارات الإلحاديَّة والماديَّة (1)، وأنَّ قد أحدث رقيًّا عظيمًا حين أطلق العقل الإنسانيُّ من قيوده الَّتي كانت تأسره حول المعابد وبين أيدي الكهنة، فارتفع إلى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة، وأنَّ تحريم الإسلام الصور والأصنام قد خلّص الفكر الإسلاميَّ من وثنيَّة القرون الأولى، وأنَّه: «ما من دين استطاع أن يُوحي إلى المتديِّن شعورًا بالعزَّة كالشعور الذي يخامر المسلم. أنَّ العربيَّ لا يفهم الإسلام حقَّ الفهم إلَّا إذا أدرك أنَّه أسلوب حياة يصطبغ به معيشة المسلم ظاهرًا وباطنًا وليس مجرَّد أفكار وعقائد يناقشها بتفكيره (2)».
وأنَّ الإسلام ليس مجرَّد نظام من العقائد والعبادات، ولكنَّه مدنية كاملة (3) هذا الإسلام، ذاتيَّة خاصَّة، مخالفة للفلسفيَّات والأديان وهو في حاجة دائمة إلى تحريره من انحرافات الفلسفات اليونانيَّة والوثنيَّات والمجوسيَّة والتصوُّف البرهميّ وضلالات، وحدة الوجود، والاتِّحاد، والحلول. وانحرافات الإلحاد والإباحة في مذاهبها القديمة المُنبعثة والمتجدِّدة في الوجوديَّة والفرديَّة وغيرها.