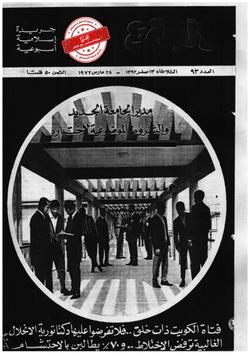العنوان من بحوث مؤتمر التعليم الإسلامي- تدريس القرآن الكريم.
الكاتب الدكتور ناصر بن سعد الرشيد
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1977
مشاهدات 11
نشر في العدد 357
نشر في الصفحة 26
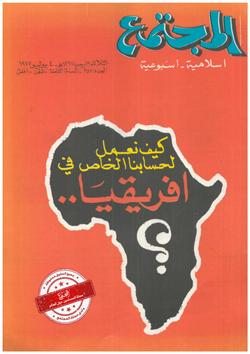
الثلاثاء 05-يوليو-1977
كان عند المسلمين طرق كثيرة لتحمل العلم كالقراءة والاستماع والوجادة وغيرها- وهذه الطرق كانت معتبرة في علوم كثيرة أخصها علم الحديث، أما في القرآن الكريم فلا يعتبر منها سوى القراءة وقد يعتبر الاستماع على ضعف، ذلك لأن القرآن لابد من استمرار تواتره وقراءته على الشيخ جيلًا بعد جيل، وهي الطريقة المعتادة، وحينما قارن العلماء بين أوجه تحمل القرآن وأوجه تحمل الحديث قالوا:
«وأوجه التحمل عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه بقراءة غيره والمناولة والإجازة والمكاتبة والعرضية والوجادة، وأما عند القراءة فلا يتأتى غير الأولين، وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفًا وخلفًا وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا لأن الصحابة-رضي الله عنهم- إنما أخذوا القرآن من فم النبي- صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأخذ به أحد من القراء لاحتياجهم على التمرن في الأداء وعدم احتياج الصحابة إلى ذلك لنزول القرآن بلغتهم وقدرتهم على الأداء لفصاحتهم».
إذن فالقراءة على المعلم أفضل وجه لتحمل القرآن العزيز، وطريقة ذلك أن يقرأ المعلم أمام تلاميذه بطريقة سليمة- كما سنبينها إن شاء الله- ثم يعيدها عليه كل تلميذ على انفراده إن كان هناك متسع من الوقت أو كان عدد الطلاب يسمح بذلك حتى يتأكد المعلم من سلامة نطق تلاميذه ومراعاتهم لأحوال التجويد وحسنالأداء.
أما إذا كان الوقت ضيقًا فإن المعلم يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه جميعًا دفعة واحدة، ويحكى أن الشيخ شمس الدين ابن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق، لم يتسع وقته لقراءة الجميع فكان يقرأ عليهم الآية ثم القراءة يعيدونها عليه دفعة واحدة، فلم يكتف بقراءته.
أما الطريقة المثلى فإن المعلم يُقرئ كل واحد من تلاميذه على انفراد حتى يعرف قويهم من ضعيفهم وحتى «لا يخفى عليه حالهم» وجوزوا للمعلم أن يُقرئ أكثر من واحد في وقت واحد- ولكنهم تشددوا- بشرط ألا يخفى عليه حالهم فإن توفر هذا الشرط جاز إقراء أكثر من واحد وإلا فلا، وممن تشدد بهذا الشرط القابسي في إجابته على السؤال الذي مفاده: هل للصبيان الصغار أو الكبار البالغين أن يقرأوا في سورة واحدة وهم جماعة على وجه التعليم؟ فقال: «إن كنت تريد يفعلون ذلك عند المعلم فينبغي على المعلم أن ينظر فيما هو أصلح لتعلمهم فيأمرهم به ويأخذ عليهم فيه لأن اجتماعهم في القراءة بحضرته يخفى عنه قوى الحفظ من الضعيف»، وكان علم الدين السخاوى يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة وهو يرد على كل منهم دون أن يخفى عليه حالهم .
ويستحسن أن يبدأ المعلم بتلقين المبتدئ بما يحتاجه في صلاته بنفسه أو ما يحتاجه لأن يؤم غيره، نص على ذلك الغزالي ويكون الأخذ على حسب استعداد المتعلم واستيعابه، وقد ركز المسلمون على قدرة الأخذ كما أسموها ووزعوا الدرس حسب هذه القدرة وطالبوا المعلم بأن يتعرف عليها عند كل متعلم فيراعيها سواء كان الموضوع المعلم قرآنًا أم غيره من العلوم، قال الخطيب البغدادي قال لنا البرقاني كان أبو بكر الإسماعيلي يقرأ لكل واحد ممن يحضره ورقة بلفظه ثم يقرأ عليه وكان يقرأ لي ورقتين ويقول للحاضرين إنما أفضله عليكم لأنه فقيه والذي استقر عليه الأمر في الصدر الأول ألا يتجاوزوا عشر آيات ولا ينقصوا عن خمس.. ذكر أبو عمر الداني في كتابه «البيان» بإسناده إلى عثمان وابن مسعود وأبي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشرٍ أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمنا القرآن والعمل جميعًا».
وهناك أحاديث تفيد أن تعلم القرآن خمس آیات خمسًا لا يزاد عليها، فعن أبي العالية قال: «تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسًا خمسًا» وفي رواية «من تعلمه خمسًا خمسًا لم ينسه»
وأما من بعد الصدر الأول فبقدر قوة الأخذ، ولابن الجزري رأي مستقل هو «الأخذ في الإقراء بجزء من أجزاء مائة وعشرين، وفي الجمع من أجزاء مائتين وأربعين» أما الأكثرون فلم يحددوا له حدًا معينًا وإنما تركوه لقوة الآخذ وهو اختيار السخاوي وأحسب أن هذا الرأي الأخير هو الأولى لما فيه من مراعاة- قدرة الأخذ واستعداد المتعلم وهو مذهب-وأيم الحق- حسن، فكلما قل قدر الآخذ كانت القدرة على استيعابه أقوى وكان حفظه أسهل، والقرآن خاصة لا بد من حفظه كما رأيت من قبل إلا أنه يجب على المعلم تصحيح ما يكلف المتعلم من حفظ لئلا يقع في التحريف والتصحيف، وكلما قل المقدار كان التصحيح أكمل.
ويجب على المعلم أن يبذر في قلوب طلابه أن القرآن يقرأ تعبدًا وتدبرًا وأن قراءة التدبر أفضل وأقرب إلى قصد الشارع وقد حض العلماء على ذلك فقال النووي رحمه الله تعالى: «وتسن القراءة بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب».
وقال ابن جماعة: «وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وليحذر من نسيانه بعد حفظه».
وقال الزركشي: «تكره قراءة القرآن بلا تدبر وعليه محل حديث عبد الله بن عمر: لا يفقه القرآن في أقل من ثلاث، وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة: أهذا كهذ الشعر».
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيركز على فهم معاني القرآن بل ويرى أن يكون ذلك همة القارئ والحافظ ويقول: «والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين».
وصفة التدبر «أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن مما قصر عنه فيما مضى واعتذر واستغفر وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذاب أشفق وتعوّذ أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء تضرع وطلب».
ومن تمام التدبر أن يقرأ القرآن بترتيل وتوسل ويتجنب الإسراع الذي يفوت معه إدراك المعنى كما يتجنب التمطيط والتمديد والتغني نص على ذلك العلماء.
قال ابن مفلح: «ويستحب ترتيل القراءة وإعرابها وتمكن حروف المد واللين من غير تكلف، قال أحمد تعجبني القراءة السهلة، وكره السرعة في القراءة، قال حرب سألت أحمد عن السرعة في القراءة فكرهه إلا أن يكون لسان الرجل كذلك أو لا يقدر أن يترسل، قال القاضي: أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، ومعناه أنه إذا بين ما يقرأ به فقد أتى بالترسل وإن كان مستعجلًا في قراءته وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها ما لم يخرجه ذلك إلى التمديد والتمطيط فإذا انتهى إلى التمطيط كان ممنوعًا».
وقال الزركشي- رحمه الله تعالى-: «فحق على كل مسلم قرأ القرآن أن يرتله، وکمال ترتيله تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه والإفصاح لجميعه بالتدبر حتى يصل بكل ما بعده وأن يسكت بين النفس والنفس حتى يرجع إليه نفسه وألا يدغم حرفًا في حرف لأن أقل ما في ذلك أن يسقط من حسناته بعضها، وينبغي للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم فهذا الذي وصفت أقل ما يجب من الترتيل. وقيل: أقل الترتيل أن يأتي بما يبين ما يقرأ به وإن كان مستعجلًا في قراءته وأكمله أن يتوقف فيها ما لم يخرجه إلى التمديد والتمطيط، فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله فإن كان يقرأ تهديدًا لفظ به لفظ المتهدد وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم» ومهما يكن من أمر فقد كره العلماء قراءة السرعة، رغم أن الحديث الشريف قد جاء «بكل حرف كذا وكذا حسنة» وبالسرعة يتمكن القارئ من قراءة حروف لا تتأتى لقارئ الترتيل، ذلك لأن المقصود الأعظم ليس الهذ؛ وإنما هو التدبر والتفكر ولذلك قال الشيخ تقي الدين: «والتفهم فيه والاعتبار فيه قلة القراءة أفضل من إدراجه بغير تفهم» وقد رأيت من النص السابق أن أحمد كره السرعة في القراءة، وقد أنكر عبد الله بن مسعود على الرجل الذي كان يقرأ المفصل في ركعة واحدة وقال له :هذا كهذ الشعر إن قومًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وأخرج الآجري في حملة القرآن عن ابن مسعود قال: «لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، وفي شرح المهذب: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع قالوا وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل، قالوا واستحباب الترتيل للتدبر لأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرًا في القلب».
ومن تمام التدبر أيضًا أن يقرأ القرآن الكريم بالتفخيم والإعراب لأنه روى عنه صلى الله عليه وسلم: «نزل القرآن بالتفخيم»، وصفة التفخيم كما قال ذلك الحليمي والحافظ أبو موسى «أن يقرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام الناس، ولا يدخل في ذلك كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء» وفي قراءة القرآن بالإعراب فقد روى البيهقي من حديث ابن عمر: «من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرفعشر حسنات».
وعلى المعلم أن يتجنب تعليمهم القراءة بالألحان فقد كره ذلك أكثر العلماء ومنهم مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في موضع، قال سحنون: «ولا أرى أن يعلمهم التغبير لأن ذلكداعية إلى الغناء وهو مكروه، وأن ينهي عن ذلك بأشد النهى، ولقد سئل مالك عن هذه المجالس التي يجتمع فيها للقراءة: فقال: بدعة وأرى للوالي أن ينهاهم عن ذلك ويحسن أدبهم».
وقال القاضي عياض: «اختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والفهم وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث ولأنه سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه» وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: «قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة».
ولقراءة القرآن أربع طرق: هي التحقيق والحدر والتدوير والترتيل، أما التحقيق فهو «إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات، وتوفية الغنات وتفكيك الحروف وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل واليسر والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف ولا يكون غالبًا معه قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن وتوليد الحروف من الحركات وتكرير القراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات كما روينا عن حمزة الذي هو إمام المحققين أنه قال لبعض من سمعهيبالغ في ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط وما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق القراءة فليس بقراءة، وأما الحدر فهو: «إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية ووردت به القراءة مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ وتمكن الحروف» وأما التدوير فهو «عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة وهو المختار عند أكثر أهل الأداء».
وأما الترتيل: فقد سبق أن تناولناه بما فيه كفاية المعهود فإنه توقيفي، وقد ورد عن ابن مسعود: سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسًا قال: ذاك منكوس القلب»، وعن الحليمي من الآداب ترك خلط سورة بسورة قال البيهقي: وأحسن ما يحتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن جبريل، فالأولى بالقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول المجتمع عليه، وقال ابن سیرین: «تأليف الله خير من تأليفكم»، وقال صاحب شرح المهذب: «ترتيبه لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة «بـ ألم تنزيل» و «هل أتي» ونظائره.. أما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب» ويقول أبو عبيد: «أما من ابتدأالقراءة وهو يريد التنقل من آية الى آية وترك التأليف لآي القرآن فإنما يفعله من لا علم له لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك.
وعلي الرغم من أن الابتداء من آخر القرآن خلاف السنة إلا أنه مرخص في ذلك في تعليم الصبي والعجمي، نص على ذلك أبو عبيد وعلل ذلك بصعوبة السور الطوال عليها وهذا هو المتبع في تعليم القرآن للصبيان ومن في حكمهم كالأعجمي والأمي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
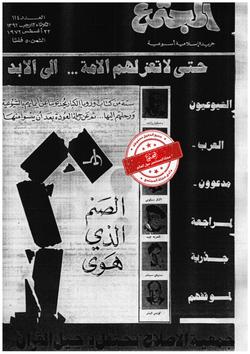
دراسة فكرية.. المنهج الإسلامي بين الوسيلة والغاية (العدد 93)
نشر في العدد 93
29
الثلاثاء 28-مارس-1972