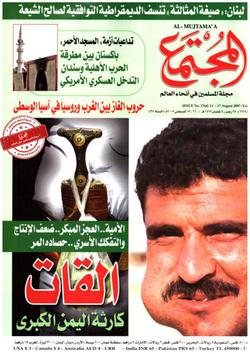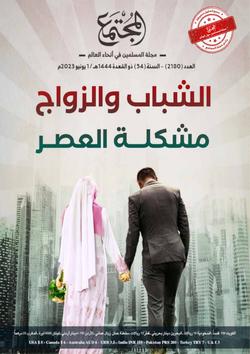العنوان موقف الفكر الإسلامي من الثقافة الغربية
الكاتب د. علي محي الدين القرة داغي
تاريخ النشر الثلاثاء 06-ديسمبر-1988
مشاهدات 27
نشر في العدد 894
نشر في الصفحة 54
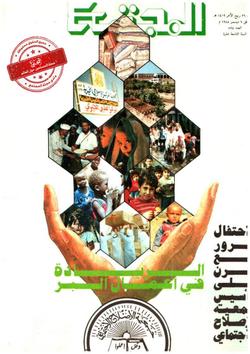
الثلاثاء 06-ديسمبر-1988
قبل أن نخوض في غمار الموقف لا بد أن نبين المراد من «الثقافة» حتى لا نقع في خلط ولبس، كما يقع فيه دعاة التبعية الثقافية، حيث يتكلمون عن الجانب المعنوي لها، ويوردون الأمثلة المقنعة للجانب المادي لها.
فالثقافة لغة –كما في لسان العرب– تعني الحذاقة والذكاء والفطنة، ولم تكن هذه الكلمة تطلق على ما نفهم من معارف وفنون، ثم أصبحت في الآونة الأخيرة مصطلحًا له مدلوله الخاص، ولكنه ثار في تحديدها جدل كثير، وفي التوسع فيها أو تحجيمها نقاش كبير، فاتجه بعض المفكرين إلى حصرها في عالم الأفكار المعنوية، في حين ذهب آخرون منهم «وليام أوجيرون» إلى التوسع فيها لتشمل: «الثقافة المادية» وهي مجموع الأشياء وأدوات العمل والثمرات التي تخلقها، أو «الثقافة المتكيفة» أو المعنوية، وهي الجانب الاجتماعي كالعقائد والتقاليد والعادات والأفكار واللغة ونحوهما مما ينعكس في سلوك الأفراد (۱).
ويرى الأستاذ مالك بن نبي أن الثقافة يدخل فيها العنصر النفسي لكل شعب وأمة، كما أنه يرى أن القيمة الثقافية للأفكار والأشياء تقوم على علاقتها بالفرد، فالثقافة هي التعبير الحسي عن علاقة الفرد بهذا العالم، أي بالمجال الروحي الذي ينمي فيه وجوده النفسي، فهي إذن حياة المجتمع التي بدونها يصبح مجتمعًا ميتًا، ولذلك فكل مجتمع له جذوره الخاصة تؤثر في سلوك الفرد مع قطع النظر عن منهج الدراسة أو المؤسسة التعليمية. (٢).
ونحن لسنا بصدد مناقشة ما أثير من تعريفات، وما أثير حولها من جدل، ولكننا نميل إلى شمولية لفظ الثقافة للعلوم والمعارف وعلاقتها الوثيقة بتفكير الشعب الذي نبعث فيه.
ومن هذا المنطلق نرى أن الجانب المادي والعلمي من الثقافة الغربية لا شك أنه قد قطع أشواطًا كبيرة في الجانب الصناعي والتكنولوجي وتقدم تقدمًا هائلًا في مجالات الصناعة والطب، والفضاء، والمواصلات والاتصالات ونحوها، ولكن هذه الثقافة أفرزت فكرًا ماديًا بحتًا اعتنى بالجانب المادي دون العناية الكافية بالجانب الروحي الذي لا يقل أهمية عنه بل هو الأساس، ولذلك نتج عن ذلك إخلال، وعدم توازن ترتب عليه ذلك القلق الذي يهدد سعادة الفرد والمجتمع الغربي، حتى أدى ذلك إلى نسبة كبيرة في الانتحار، وأصبح مراجعة الطبيب النفسي شيئًا ضروريًا بالنسبة لهم إلى غير ذلك من المشاكل والاضطرابات الروحية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الجانب المادي أيضًا من ثقافة الغرب لم يتخل عن الفكر النفعي والمصلحي لهم مع قطع النظر عن مصالح بقية الشعوب، كل ذلك دفعهم إلى الاستعلاء والاستكبار والاستعمار، وجعل مصالحهم هي الميزان، ولذلك لم يفكروا في إسعاد البشرية، ولا نقل أسرار التكنولوجيا إلى غيرهم، فقد دخلت بريطانيا شبه القارة الهندية، وبقيت فيها حوالي ثلاثة قرون، فأقامت إمبراطورية عظمى على أكتاف هؤلاء الهنود الذين كانوا جنودًا وعمالًا يحققون آمالها ويوسعون رقعتها، ولكن ماذا قدم الإنجليز لهذا الشعب من علوم وصناعة وتقدم وتطور لا شيء! بل تركهم بعد حروب الاستقلال والتضحيات يعانون أمية وفقرًا، وقد فعل الاستعمار بالشعب العربي أكثر، حيث بالإضافة إلى ذلك فقد مزقهم شر ممزق، وكون داخل القلب بؤرة فساد المتمثلة في دولة الصهاينة، ناهيك عما يعاني منه شعوب العالم الثالث من مشاكل التضخم وأزمات الديون، والحروب المدمرة حتى تعود بالنفع عليهم وإن كنت لا أنفي أننا سبب مباشر فيها.
ومهما يكن من أمر الثقافة والحضارة الغربية فإن فيهما جوانب إيجابية من حيث الصناعة والطب والمواصلات ونحوها، كما أن فيهما جوانب سلبية كثيرة لا تخفى من حيث الأفكار الإلحادية، والوجودية، والتحللية والإباحية.
فما موقف الفكر الإسلامي من هذه الثقافة أو الحضارة؟ فهل نأخذ بخيرها وشرها، وحلوها ومرها؟ أم نهجرها هجرًا مطلقًا ونولي ظهورنا لها، أم أن هناك طريقًا وسطًا بين هذا وذاك؟!
لقد اختار الطريق الأول بعض مثقفينا الذين تشبعوا بالثقافة الغربية، وعاشوها وأشربت قلوبهم بها وما فطموا عنها، وهم قد قصروا طرفهم عليها فلا يرون غيرها، ولم ينظروا إلى ما لدى أمتهم من فكر ثاقب وتراث أصيل، بل كان السبب لدى بعضهم هو جهلهم بما لدينا، ولذلك لما اطلعوا على بعض كتب التراث الأصيلة استغربوا وعجبوا، لهذه الفئة دعاة التبعية للغرب، ويرون أن التقدم يمر عبر التقليد المشبع للغرب، وأنه لا فكر يعلو على فكر الغرب، وأن الانصهار لا بد أن يتم في بوتقته، وإلا فلا ثقافة ولا علوم ولا تقدم، فقد كان أغلب هؤلاء –إن أحسنا الظن بهم- فارغي القلوب عن الثقافة الإسلامية، ثم احتكوا بالثقافة الغربية من خلال دراستهم في الدول الغربية، ولا سيما قد بهرهم الجانب المادي من هذه الحضارة وما فيها من تقدم صناعي، ثم ما هو عليه أحوال المسلمين من تخلف وضعف وجهالة وخرافات نتيجة ابتعادهم عن منهج الله تعالى في تعمير الكون، وقد أشار إلى هذا الجانب الإمام الغزالي حينما تكلم عن علوم الفلاسفة ولا سيما العلم التجريبي، فقال: «أعلم أن علومهم -بالنسبة إلى الغرض الذي تطلبه- ستة أقسام: رياضية، ومنطقية وطبيعية، وإلهية وسياسية، وخلقية. أما الرياضية فتتعلق بعلم الحساب والهندسة، وعلم هيئة العالم، وليس يتعلق بشيء منها بالأمور الدينية نفيًا وإثباتًا، بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها» ثم بعد أن ذكر ذلك بيّن بوضوح بعض المشاكل التي نتجت بالنسبة لغير المتعمق فقال:
«وقد تولدت منها آفتان: الأولى: أن من ينظر فيها يتعجب من دقائقها، ومن ظهور براهينها فيحسن سبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة، فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح، وفي وثاقة البرهان كذا العلم» فحينئذ تزداد ثقته بجميع أقوالهم فقد تضعف ثقته –عن جهد– بأقوال الشرع، «وكم رأيت من يضل عن الحق بهذا القدر، ولا مستند له سواه» ثم يناقش الغزالي هذا التقليد الأعمى قائلًا: «وإذا قيل له: الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقًا في كل صناعة فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقًا في الطب،.... بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق، وإن كان الحق والجهل قد يلزمهم في غيرها، فكلام الأوائل في الرياضيات برهاني –أي قائم على التجربة والبحث العملي الذي في مقدور الإنسان– وفي الإلهيات تخميني»(۳) أي قائم على الظن وتشبيه المعقول بالمحسوس».
فهذه النظرة المتعجلة النابعة من هذا القياس الفاسد، ومن عدم دراستهم للتراث الإسلامي تؤدي إلى مخاطر جسيمة وإلى أن تفقد الأمة ذاتيتها وأصالتها واستقلالها الفكري والثقافي الذي يترتب عليه على مدى بعيد فقدان الاستقلالية بكل ما تحتمله هذه الكلمة من معان. وهل تسمى بالأمة إذا فقدت أصالتها وذاتيتها وأصبحت تبعًا لغيرها.
لا شك أن هذا التفكير نابع من الشعور بالانهزامية والتخلف والضعف، يقول ابن خلدون في المقدمة: «إن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره، وزيه، ونحلته، وسائر عوائده» وذلك ظنًا منه أنه ناقص ولها غُلب، وأن الغالب كامل ولهذا غَلب. ولكن عكس ذلك قد حصل أثناء غلبة المغول والتتر على المسلمين، ولكن قوة الإيمان والثقافة والحضارة الإسلاميتين دفعتهم إلى الدخول في الإسلام.
وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى خطورة هؤلاء المقلدين لغير المسلمين فحذر المسلمين منهم فقال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا، وذراعًا ذراعًا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال: فمن؟» (رواه البخاري ومسلم).
ومن الناحية العملية فهل تضمن التبعية لحضارة الغرب وثقافتهم التقدم والازدهار؟
الواقع الآن القائم على تجارب الشعوب يحكم بغير هذا. فتركيا في عهد الاتحاد والترقي تخلت قيادتها عن الإسلام، فألغت الخلافة، وأعلنت رفضها الكامل لكل ما يمت بصلة بالإسلام، ودخلت في أحضان الغرب، حتى ألغت الحروف العربية وربطت لغتها بالحروف اللاتينية، ومنعت الأذان بالعربية، والحجاب والعمامة إلى آخر المواد التسع من ثورتهم، فهل التحقت من حيث التقدم والازدهار بالغرب؟ الواقع يشهد على غير ذلك، فقد أصبحت تركيا في عهد هؤلاء تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية، لا حصر لها، حتى أصبحت بعض أراضيها قواعد عسكرية للأجانب، ومن الغريب أن دول السوق الأوروبية لم تقبلها كعضو كامل في السوق على الرغم أنها تلهث وراء ذلك منذ نشأتها. وقد تعبت تركيا كثيرًا إثر هذه التبعية نتج عنها سوء العلاقة مع جيرانها المسلمين ومشاكل اقتصادية، حتى لم تنهض أخيرًا اقتصاديًا إلا عندما نشطت علاقتها وتجارتها مع الدول العربية، وكذلك الشعب الهندي –كما ذكرنا– استعمره الإنجليز حوالي ثلاثمائة سنة، وبنوا على أكتافه حضارتهم وتوسعاتهم، وكان المقابل هو التخلف والجهل والجوع والحرمان.
وفي مقابل ذلك لدينا تجارب أمم أخرى في هذا الميدان نجحت فيه، مثل الصين حيث تحصنت ضد تأثير الثقافة الغربية فيها، فاعتمدت على سواعد أبنائها، ولم تعتمد على أن تستورد من الغرب شيئًا، بعد أن عرفت أن الغرب عند استعماره لها كان يريد تخدير الشعوب من خلال ترويج المخدرات والأفيون ونحوهما، فأقامت مشاريعها الكبرى على أكتاف الشعب، دون أن تعبأ بتكنولوجيا الغرب، حتى على سبيل المثال كانت تقاوم الذباب والحشرات والفئران بتشجيع الشعب على قتلها دون استعمال المواد القاتلة المستوردة من الغرب «د. د. ت»، وأما تجربة اليابان فهي قائمة على أخذ الجانب المادي والعلمي من الحضارة والثقافة الغربية، ثم النهوض به بروح يابانية، وبروح التحدي.
وفي مقابل هذا الاتجاه يوجد اتجاه مضاد له يتمثل في موقف سلبي بحت من هذه الثقافة والحضارة الأوروبية، فينبذونها وراء ظهورهم كلها، ويعتبرونها شرًا لا ينبغي قبوله ولا الالتفات إليه.
وهذا الموقف أيضًا غير سليم لا يتفق مع قواعد الإسلام العامة، ولا مع مبادئه الكلية - في نظرنا- وذلك لأن الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- قال: «الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها» رواه الترمذي وابن ماجه، والتعبير بـ «ضالة» يعني أن المفروض أن يكون المؤمن هو صاحب الحكمة، وكل ما يفيد المجتمع باعتبار أنه مكلف بتعمير الكون على ضوء منهج الله، وكيف يعمر الكون بدون قوة وإعداد، واستعمال الوسائل الفعالة؟! ومن هنا فإذا سبق أحد إلى حكمة، أو صنع ما يفيد المجتمع فإن ذلك يعني أنه ضاع منه هذا الشيء، فحين يجده فهو أحق به.