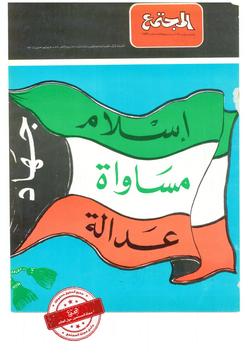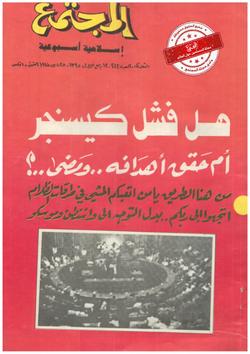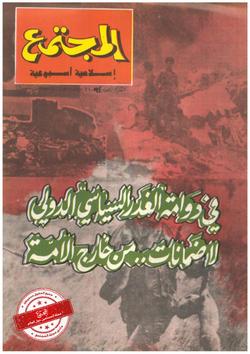العنوان نزار قباني وقصته مع الشعر.. الحلقة الأخيرة
الكاتب الدكتور محمد مصطفى هدارة
تاريخ النشر الثلاثاء 05-فبراير-1974
مشاهدات 22
نشر في العدد 186
نشر في الصفحة 20

الثلاثاء 05-فبراير-1974
ويتحدث نزار عن محاولات الشعر الحر في الأربعينيات حديث الغائب، ولكنه حين يذكر دمشق بين العواصم التي كانت مراكز لهذه المحاولات، كان يعني نفسه، ويعلم الله أنه كان بعيدا عن هذه المحاولات، وأنه في الطبعات اللاحقة لدواوينه الأولى كان يحشر قصيدة من الشعر الحر ليعد من بين الرواد الأوائل لهذه الحركة.
وقد أراد في كتابه أن يلبس ثوب الناقد المحلل فيعرف الشعر، فإذا به مرة يقول إن الشعر هو الرقص «ص ۱۹»، وتارة يقول إنه حصان «ص ۲۱»، وثالثة يقول إنه وحش خرافي «ص ٥٣»، ولكن أصدق تعريف ينطبق على شعر نزار هو ما قاله عن ديوانه «قالت لي السمراء»: «إنه شهوة وعصيان ووحشية»، ولكن هذا التعريف خاص بشعر نزار وحده، ولا يمكن أن يكون تعريفا للشعر بوجه عام. كذلك حين يتحدث نزار عن خصائص القصيدة العربية الحديثة، ينمق عبارات إنشائية فضفاضة، ويستخدم مهارات بلاغية زئبقية، لا تكاد تصل إلى معنى محدد كقوله مثلا: «لم تعد وظيفة القصيدة الحديثة أن تعلمنا ما هو معلوم، وتنظم لنا من جديد ما هو منظوم، صارت وظيفتها أن ترمينا على أرض الدهشة والمتوقع، وتسافر بنا إلى مدن الغرابة» ما مفهوم ذلك بلغة الواقع؟ لا شيء.
كذلك نراه في بعض ما أورده من خصائص يغالط دون استحياء، من ذلك مثلا حديثه عن خروج الشعر الحديث من الموالاة إلى المعارضة، وأنه استقال من وظيفته القديمة كمغن في جوقة الملك. والشعر القديم لم يكن كله موالاة، كما أن الشعر الحديث ليس كله معارضة، بل لعل المعارضة قديما كانت أوضح بكثير وأشد جرأة من المعارضة الحديثة.
أما مخاوف نزار على الشعر الحديث - وتتركز في تشابه نماذجه واصطلاحاته ورموزه بحيث أصبحت قصيدة واحدة من هذا الشعر تغني عن قراءة بقية النماذج - فهي ليست مجرد مخاوف لشيء سوف يحدث، بل هي انتقادات صريحة سبق بها الدارسون نزار وفاته أن يشير إليهم.
أما أن الشعر الحديث لا يزال واقعا في حالة تعدد الجنسيات وازدواج الشخصية فهذا أمر صحيح: إنه مكتوب بلغة عربية، إلا أن مناخه العام لا يشبه مناخ دمشق أو الكويت أو إمارات الشاطئ المتصالح «ص ۱۹۹». وهذه الملاحظة التي سجلها نزار، كانت أيضا مدار بحث دارسي الشعر الحديث، وموضع تأملهم قبل صدور تاب نزار بسنوات. ومن العجيب أن نزار الذي انتقد هذا الاتجاه، هو نفسه الذي أبرزه بين خصائص الشعر الحديث حين تحدث عن تجاوز الشاعر الحديث حدود القبيلة وتفكيرها المحلي وهمومهــــا الصغيرة، وكيف أن وسائل الحضارة الحديثة ساعدته على أن يفكر تفكيرا كونيا. وهذا التفكير الكوني لم يكن معناه عند كثير من الشعراء المحدثين غير التقليد الأعمى والمضاهاة الغبية، بحيث ابتعدوا عن مناخ بيئتهم ومشكلات مجتمعاتهم وواقع حياتهم، وكثرت في أشعارهم - تبعا لذلك - الرموز والمصطلحات الأجنبية التي تتنافى في أحيان كثيرة لا مع ثقافتهم فحسب، بل مع دينهم ومعتقداتهم أيضا. ونثر نزار في كتاب سيرته خير شاهد على ذلك التأثر الأعمى: يشهد على فقدان الشخصية العربية المسلمة، وعلى تكرار الرموز والمصطلحات بصورة تدعو الى الملل. فاسم «لوركا» الشاعر الإسباني يتكرر في كلام نزار أكثر من عشر مرات للتعبير عن أغراض مختلفة، كذلك نراه يقول «لم أسرق نار السماء كبرومثيوس» «ص ۷۷» مستوحيا الأسطورة الإغريقية. أما الألفاظ المسيحية التي تجسد بعض المعاني الدينية التي لا يؤمن بهــا المسلمون - وأظن أن نزار منهم - فكثيرة جدا: «صليب المتاعب نحمله على أكتافنا» «ص ١٤»، «حين أفكر في جراح أبي خليل، وفي الصليب الذي حمله على كتفيه» «ص 3٩»، «خشبة صليبي» «ص ۸۹»، «هذا الحب بيني وبين الجمهور صار صليبيا ثقيلا على كتفي» «ص ١٦٠»، «يتحول الشاعر إلى شماس في أبرشية القرية» «ص ۲۰۲» وغير ذلك كثير.
ومن قبيل الفعل وعكسه هجوم نزار على «ديكورات البلاغة القديمة وبراويزها المذهبة» «ص ٤٨»، وإيمانه بأن «هذه المرحلة المسرفة في تألقها وجمالياتها قد استنفدت أغراضها وفقدت أهميتها بدخول عصر الاشتراكية، وسقوط مؤسسات الإقطاع والطبقية» «ص ٤٩» وأنا معه تماما في وجوب تطور لغة الشعر وتطور أساليب الكتابة بصفة عامة، واعتمادها على عناصر جمالية جديدة، بعيدة عن التعبيرات البلاغية القديمة التي استهلكت وفقدت جمالها وإيجابية تأثيرها. ولكن ما الجديد الذي أحدثه نزار في لغة الشعر أو في لغة الكتابة من الناحية البلاغية؟ هل أسقط الاعتماد على عناصر البلاغة القديمة من تشبيه واستعارة وما إليهما؟ إنني أراه في الحقيقة لم يصنع جديدا، بل أكاد أقول إنه مسرف في التأنق اللفظي واستخدام العناصر الجمالية القديمة بصورة مكثفة، فهو يقول: «الشعر نبات داخلي من نوع النباتات المتسلقة التي تتكاثف وتتوالد في العتمة، إنه غابة من القصب لا يعرف خريطتها إلا من راقبها وهي تكبر في داخله شجرة شجرة» «ص ۱۰» ويقول: «القصيدة جسر ممدود على كل الأزمنة» «ص ۱۱» ويقول: «من رحم الصبر يخرج الأدب» «ص ١٥»، ويقول: «الشعر مزروع في الشاعر حربة من البرونز المشتعل» «ص ٥٠»، ويقول: «اللغة الإسبانية شديدة الشبه براقصة إسبانية يحترق المسرح تحت ضربات قدميها» «ص ٥٧»، ويقول: «صار قلبي مليئا كحقيبة امرأة، وكرويا كالأرض، ومزدحما كمدينة من مدن الصين» «ص ۹۸»، ويقول: كنت دائما حصانا يركض على أرض الفرح، ويصهل مغتبطا بالشمس والعشب والحرية» «ص ۱۱۲»، ويقول: «وفي الصين تفتحت زهور الشحوب على دفاتري، وكبرت حتى صارت أوراقي غابة من الدمع» «ص ۱۱۲»، ويقول: «أصبحت القصيدة ثمرة من الخشب لا عصير فيها» «ص ۱۷۷» إلى ما سوى ذلك من التشبيهات والاستعارات المتراكمة التي تدل على التأني الشديد للتزين والتذهيب والتزويق وكل ما يرفضه نزار من الصور البلاغية القديمة، وإن ظهر طابع التطور الحضـاري والثقافي على ما أتى به من صور، وهذا أمر طبيعي . بل أرى نزار في بعض الأحيان يستخدم عنصرا جماليا عتيقا كالسجع في مثل قوله: «لقد جنبنا هذا الشاعر الكبير بذوقه المترف وإحساسه المرهف،» وكقوله: «لم تعد وظيفة القصيدة الحديثة أن تعلمنا ما هو معلوم، وتنظم لنا من جديد ما هو منظوم،» وغير ذلك من العبارات التي تدل على الرغبة في الزخرفة والتنميق مما يدعونا إلى القول بأن نزار لم يستطع أن يبتعد كثيرا عن المرحلة المسرفة في تألقها وجمالياتها.
بقيت مسألة أخيرة في قصة نزار مع شعره وهي مسألة وجود مهاجمين له مع اتساع قاعدة جمهوره «الذين يملأون القاعات ويشدون الأبواب، وتمتد أيديهم بالاوتوجرافات» «ص ١٥٥». وقد فسرها نزار في ضوء ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون خادعا، والثاني أن يكون الجمهور مخدوعا «الاحتمالان شيء واحد لأنه إن كان خادعا فلا بد أن يكون جمهوره مخدوعا» والثالث أن يكون المهاجمون جنودا مرتزقة هوايتهم القتل «ص160» ونزار يصل بالقارئ إلى الاحتمال الثالث لأنه لا يريد أن يكون خادعا، ولا يحب أن يكون جمهوره مخدوعا، وإني أسأله: ومن جمهورك؟ وهو يجيب عن ذلك من خلال كتابه حين يقول: «قصيدة نهداك»، كانت الشرارة الأولى التي أطلقتني، والمفتاح إلى شهرتي. الطلبة العراقيون كانوا يسكرون عليها على ضفاف دجلة، واللبنانيون كانوا يمزمزونها على موائد العرق في زحلة، لقد كان الطلاب خلال تاريخي الشعري كله جنودي وكتائبي وراياتي، فبهم شددت أزري، وبهم أسرجت خيولي، وبهم أكملت فتوحاتي» «ص ٩٥».
لقد حدد نزار «أو نابليون الشعر» بنفسه جمهوره «أو جنوده ورعاياه» أنهم الطلاب؛ أي الشباب في سن المراهقة، ويخص منهم المستهترين الذين استباحوا ما حرم الله. ومن أباح لنفسه منكرا، فلا عذر له في الإعراض عن شعر نزار، ولا فرق عند المتحلل بين فاحشة وأخرى، فهل عرف نزار الآن تفسير المعادلة الصعبة التي وضعها: وجود مهاجمين له مع اتساع قاعدة جمهوره؟
ليته عرف!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل