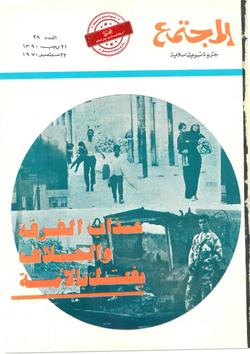العنوان نزار قباني وقصته مع الشعر (٢)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-يناير-1974
مشاهدات 15
نشر في العدد 185
نشر في الصفحة 20
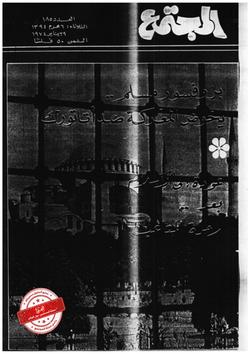
الثلاثاء 29-يناير-1974
* («أنا ضد الشرعية» في العدد الماضي كتب هذا العنوان في الجزء الأول من هذا الموضوع خطأ «أنا ضد الشيوعية» والصواب «لأنها ضد الشرعية»)
ويقع نزار في كثير من مواضع كتابه في مثل هذا الخلط والتدليس والادعاء؛ من ذلك مثلًا ادعاؤه في أول كتابه بأن «السيرة الذاتية تكاد تكون مجهولة في أدبنا» (ص ١٥). وقبل نزار بقرون كتب أسامة بن منقذ سيرة حياته في كتاب «الاعتبار»، ولم يتبجح بمثل دعواه. ثم كتب كثيرون من كتابنا المحدثين - قبل أن يولد نزار وأبوه وجده- سير حياتهم، ولكنه يبدو بعيدًا عن المكتبة العربية والتراث العربي. وحتى ما حاول أن يثبته بإلحاح -وهو سعة اطلاعه على الآداب الأجنبية- أمر مشكوك فيه، أما دليلي على الشطر الأول فيؤيده جهله بما كتب من سير ذاتية في أدبنا العربي قديمه وحديثه. ويؤيده كذلك رضاءه عن أستاذه خليل مردم لأنه جنبه «السير على حجارة أكثر الشعر الجاهلي وبياناته الصحراوية الشائكة» (ص ٤٥) ولا يصدر مثل هذا القول إلا عن جاهل بالشعر الجاهلي، لأنه نبع صاف من الفن، أكثر واقعية من شعر نزار. وإذا كان يقصد بنباتاته الصحراوية الشائكة لفته، فيكون بذلك أشد جهلًا به، لأنه يؤثر العافية ولا يريد أن يتعب يده الرقيقة بتناول أي معجم للبحث عن كلمة، لا يسعفه بفهمها محصوله اللغوي الذي تبدو نزاراته واضحة. وبعد العصر الجاهلي بقرون، كان لشكسبير في الأدب الإنجليزي لغته الخاصة التي تدق عن فهم الإنجليزي المثقف المعاصر، ولهذا ألغوا معاجم اللغة الشكسبيرية، ولم يصف أحد شعر شكسبير بانه نباتات صحراوية شائكة. ولعل نزار لا يقصد بهذا التعبير مجرد الألفاظ الوحشية، بل يقصد تصوير الشعر الجاهلي للروح البدوية الصحراوية التي تزكم خياشيمه المليئة بالمطر النسائي، وهو في ذلك أيضًا بعيد كل البعد عن تذوق الفن الأصيل، وملامسة الواقعية البعيدة عن تهاويل الدونجواشوتية.
ومن قبيل التخليط والادعاء أيضًا هجومه الغريب على اللغة العربية حيث يقول: «كانت اللغة أملاكًا خصوصية، واللغويون جمعية منتفعين، وكانت الفتوى بشرعية كلمة أو تعريب مصطلح علمي أو تقني، تستغرق المجامع اللغوية ثلاث سنوات من التنجيم والاستخارات، والألوف من كؤوس الشاي ومحلول البابونج» (ص ۱۱۸). وامتدادا لهذا التخليط يسمى اللغة العربية «اللغة المتعجرفة» بناء على شعوره بغربة لغوية بين الفصحى والعامية. ويصف لنا هذا الازدواج المتوهم فيقول: «هذه الازدواجية اللغوية التي لم تكن تعانيها بقية اللغات، كانت تشطر أفكارنا وأحاسيسنا وحياتنا نصفين، لذلك كان لا بد من فعل شيء لإنهاء حالة الغربة التي كنا نعانيها، وكان الحل هو اعتماد «لغة ثالثة» تأخذ من اللغة الأكاديمية منطقها وحكمتها ورصانتها، ومن اللغة العامية حرارتها وشجاعتها وفتوحاتها الحربية» (ص ۱۱۹). ثم يقول نزار: «لن يصل بي الغرور إلى الحد الذي أزعم به أنني اخترعت لغة، ولكني أسمح لنفسي بأن أقول إنني طرحت في التداول لغة موجودة على شفاه الناس، ولكنهم كانوا يخافون التعامل بها» (ص ۱۲۱) بماذا أسمي هذه المجموعة من المغالطات والتخليطات والادعاءات؟
أولًا، لقد صور اللغة الفصحى بأنها ملك خاص للمجامع اللغوية، وصور المجامع اللغوية بأنها «بابا» العصور الوسطى الذي يمنح صكوك الغفران أو الحرمان «اضطررت لاستخدام هذا التعبير ليفهمه نزار لأنه من قبيل ما يستخدمه بكارة في كتابته»، وهذا غير صحيح على الإطلاق. فاللغة الفصحى كانت، وما زالت، ملك الناس جميعًا وعلى رأسهم الشعراء والكتاب، ولكن نزارًا يصطنع هذا الوهم لينطلق منه إلى الحكم على اللغة بانها «أكاديمية» و«متعجرفة» لا تصل إلى جماهير الناس، وليثير قضية قديمة حول الازدواج بين الفصحى والعامية، ويبدو من حديثه كأنه هو مكتشف هذه الازدواجية. ولا شك أن نزارًا يغالط قراءه من ناحيتين: الأولى تجسيمه لهذه الازدواجية ومبالغته في تصويرها، والثانية حين يقول إن هذه الازدواجية لا تعانيها بقية اللغات بصورة أو بأخرى. فاللغة التي تستخدم في حانات لندن الشعبية ليست هي على الإطلاق التي يستخدمها علية القوم والأدباء الإنجليز. وإذا كانت هناك فروق بين العامية المستخدمة في كل بلد عربي، وبين اللغة الفصحى، فهي آخذة في الاضمحلال، لأن القرون الطويلة من القهر والاستعمار، وتفشي الجهل والأمية، وما إلى ذلك من أسباب، بعضها انقضى أمره، وبعضها الآخر آخذ في الزوال، كان من آثاره تعميق الهوة بين العامية والفصحى.
ومنذ الثلاثينات أثيرت هذه القضية بين كتاب القصة والمسرح، من ناحية طريقة إجراء الحوار على لسان الشخصيات الشعبية، وهل يكون بالعامية أو الفصحى، وكان اصطلاح «اللغة الثالثة» مما جرى به قلم توفيق الحكيم، وهي لغة فصيحة مبسطة، تستخدم في العامية من كلمات فصيحة، تشتبه على الناس فصاحتها، لكثرة تداولها بين العامة، كذلك تعتمد على بساطة تركيب العبارة والبعد عن التأنق والتكلف وبذلك تكون مفهومة للعامة ومقبولة من الخاصة، فلا ينبغي إذن أن يأخذ الغرور نزارًا باعتباره «مخترع» هذه اللغة. بل أذهب إلى أبعد من ذلك حين أقول: إن المفكرة قديمة جدًّا تصل إلى القرن الثاني الهجري، حين وقع الصراع بين المتمسكين بعمود الشعر القديم.. وبين المولدين الذين أرادوا التجديد، فأطلق أصحاب القديم على أسلوب المجددين اصطلاح «لغة المولدين» وهي لغة متطورة في ألفاظها، وطرائق تعبيرها، وتركيب جملها. وقد سئل السيد الحميري: مالك لا تستعمل في شعرك من الغريب ما تسأل عنه، كما يفعل الشعراء؟؟ فقال: لأن أقول شعرًا قريبًا من القلوب، يلذه من سمعه، خير من أن أقول شيئًا متعقدًا تضل فيه الأوهام. لقد كان معظم الشعراء المجددين في هذا العصر البعيد يحرصون على أن تكون لغة شعرهم هي لغة الحياة اليومية نفسها، أو على الأقل، أن تكون قريبة منها، ولهذا وجد من بين هؤلاء الشعراء كثيرون، قال عنهم النقاد - بعد أن لاحظوا سهولة شعرهم: إن نظم الشعر عليهم أهون من شرب الماء. ومن هؤلاء الشعراء أبو العتاهية، وأبو الشيص، وربيعة الرقي، وإبراهيم الموصلي، وأبو الشمقمق. ولا أعتقد أن نزارًا سمع عن كثير من هؤلاء الشعراء، ولا عن طريقتهم في الشعر، ولهذا أدعوه لأن يقرأ الفصل الأول من الباب الثالث من كتابي «اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، وعنوانه «الأوزان ولغة الشعر» ليدرك أن «اللغة الثالثة» اختراع قديم جدًّا، ولعله يجد فيما سوف يقرؤه ردًّا على تساؤله الذي لا محل له: «هل التعتيم هو الشرط الأساسي لتأكيد ثقافة الشاعر وغنى عوالمه الجوانية؟، وبكلمة أخرى: هل غموض الرؤية: وغموض الوسيلة، وغموض طريقة المرض هي معيار أهمية الشعر وأهمية الشاعر؟» (ص ٥٣).
وهناك مجموعة مغالطات أخرى لنزار في كتابه، منها قوله: «التجريد والتأمل الذهني الصرف أشياء لا نتعامل معها في هذه المنطقة من العالم» (ص ۱۳۳) ولا أظن أن نزارًا تغيب عنه جهود الفلاسفة والمتكلمين المسلمين، كما لا تغيب عنه تأملات أمثال أبي العلاء المعري في القديم، ولا تأملات أمثال التيجاني يوسف بشير في الشعر الحديث.
ويقول أيضًا: «الحديث عن الحب في شرق يرفض الحب ويعتبره طفلًا غير شرعي، ومادة كالمواد المخدرة ممنوعة من التداول، يعتبر بحد ذاته خروجًا على قيم المجتمع ومؤسساته» (ص ۱۳۳) وأنا في الحقيقة لا أجد فيما قرأته من الآداب الأجنبية قدرًا من شعر الحب يوازي ما نجده في الأدب العربي، وكذلك يزخر تراثنا بالكتابة عن الحب، ويكفي أن أذكر في هذا المجال كتاب «طوق الحمامة» لابن حزم وهو من هو في علمه وورعه. أما إذا كان نزار يقصد شيوع شعر الجنس وأدبه بصفة عامة، فهذا موضوع آخر.
ويقول نزار: «شعراء المنزل الحسي في أوروبا وكتاب الروايات المسرحية لا يخوضون حربًا صليبية مع مجتمعهم كما يخوضها الكتاب العرب» (ص ١٣٤) ومن العجيب أن يذكر نزار من أدباء الجنس الأوروبيين د.هـ. لورنس، وأوسكار وایلد، والأديبان لقيا الأمرين من مجتمعهما الرافض لأدبهما المكشوف، وقد قدما للمحاكمة، واصطدما بغضب الكنيسة، وظلت كتبهما - بيت القصيد - ممنوعة من التداول فترة طويلة من الزمان، فكيف يدس علينا نزار هذه الأقوال التي يجانبها الصواب، إلا لمحاولة التمويه والخداع؟
وإذا كان نزار قد ذكر أن الحديث عن الحب محرم في الشرق - وهو يقصد كما ذكرت ابتذال الحب بالخوض في الجنس - فلا بد أن يلسعه الشعر العذري بصفته ومثله العليا، ولهذا يقول عنه: «هذا الشعر كان جسمًا غريبًا عن المطبع العربي ومتنافيًا مع البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية التي تتعامل مع المرأة تحت أشعة الشمس، والنظر إلى الأشياء من زواياها الحادة» (ص ١٩٦) ولا أكاد أجد تفكيرًا أشد من ذلك التواء: التعامل مع المرأة تحت أشعة الشمس يجب أن ينتج أدبًا جنسيًّا صارخًا، ومستحيل أن ينتج أدبًا عفًّا: وهل الأدب الجنسي بحاجة إلى أشعة الشمس لكي تذكى ناره؟. . إن بلاد شمال أوروبا غارقة في الجنس والثلج معًا، وهي لا تصافح أشعة الشمس إلا نادرًا.
إن نزارًا لا يفكر إلا في عامل المناخ ويسقط من حسابه أثر الدين والوراثة والعادات والأعراف والتقاليد وغيرها من العوامل الموروثة أو المكتسبة.
إنني لأعجب من نزار حين يدعي أنه شاعر الحب، والحقيقة إنه شاعر الجنس. وفرق كبير بين المعنيين.
إنه لا يتحدث عن المرأة بقدر ما يتحدث عن جسدها. إنه لا ينظر إلى المرأة إلا بوصفها دمية ومتعة، لا هم لها إلا الجنس وقضاء رغباتها. إنه لا يتحدث عن العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة، إلا من زاوية الجنس.
المرأة ليست الشهوة العابرة، وليست العشيقة الشاذة الفاجرة، إنها الأم، والأخت، والابنة والزوجة. إنها رفيقة الكفاح والصبر، إنها مثال التضحية وضبط النفس، إنها.. إنها كل هؤلاء، فلماذا التفكير في الجنس وحده؟، وحسبان المرأة رمزه، وتعريتها بدعوى معناها في الواقع، وكأن الواقع يخلو من كل النماذج التي ذكرتها. إن الكوخ القذر المتهدم واقع لا شك فيه، والقصر الباذخ الوضيء واقع أيضًا لا شك فيه، والذي ينكر وجود القصر ولا يرى إلا الكوخ قد يخرج عن حدود الواقعية، لأنه يتعمد إبراز واقع معين ولو كان وجوده شاذًا.
ونزار يعترف بصراحة واضحة أنه لا يعرف في المرأة غير الجنس، يقول: «دعوني أعترف لكم أنني بالرغم من سمعتي كشاعر حب فإنني نادرًا ما وقعت في الحب» (ص ٤٠)، ويقول: «وكشهريار كانت الوفرة «وليمة الجنس المتكررة» تصيبني بالقرف والاشمئزاز، وكلما ارتفع عدد النساء في حياتي أزداد شعورًا بغربتي وتوحدي» (ص ١٥٥). ومن الواضح أن هذا الاشمئزاز نتيجة التخمة لا نتيجة تغير مسار التفكير بعيدًا عن الجنس فالجنس لا يمكن أن يتخلى عن نزار حتى في حديثه العادي، فهو يقول: «إلى كل فنادق العالم التي دخلتها، حملت معي دمشق ونمت معها على سرير واحد» (ص ٣٦) ويقول: «أحيانا أشعر أن الورقة مستعدة، فأمارس الحب معها بنجاح، وأحيانا كثيرة أشعر أن الورقة لا تريد، فألبس ثيابي وأنصرف» (ص ۱۹۱). أرأيت كيف يستخدم نزار ألفاظ الجنس حتى مع مسقط رأسه دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية، وحتى مع الورقة التي يكتب فيها شعره.
ومن بين ادعاءات نزار الكثيرة في كتابه قوله: «غالبية القصائد العربية كانت في حقيقتها قصيدة واحدة، تنقل عن نموذج محفوظ في الذاكرة وسابق للتجربة» (ص ١٧٦) وما أشك في أن هذا الادعاء نتيجة الجهل بالشعر العربي في عصوره واتجاهاته وألوانه المختلفة. إن أي إنسان عادي يستطيع أن يميز بين قصيدتين لشاعرين مختلفين - من الشعراء الأعلام- من ناحية الأسلوب والمذاق واتجاه التفكير، فما بالك بالشاعر الذي يدعي لنفسه رهافة الحس، والقدرة على تمييز الخصائص التي تفترق بها لغة عن أخرى؟ «انظر حديثه عن خصائص اللغتين الإنجليزية والإسبانية».
وإلى جانب ما عرضته من نماذج التخليط والادعاء في كتاب نزار، توجد بعض المتناقضات التي ترجع في الغالب إلى ضعف الذاكرة، أو محاولة تنميق السيرة في غيبة الحقيقة. من ذلك مثلًا أن نزارًا ذكر في ص ۲۹ أنه الولد الثاني بين أربعة صبيان وبنت ذكر اسمها، ثم ما لبث أن فاجأنا في ص۷۱ بوجود أخت أخرى اسمها وصال «قتلت نفسها بكل بساطة وبشاعرية منقطعة النظير، لأنها لم تستطع أن تتزوج حبيبها». ولا أدري كيف فات الشاعر أن يذكرها من قبل، وأن يذكر لنا؛ لماذا لم تستطع أن تتزوج حبيبها، مع أن أباها - كما ذكر نزار- كان ذا شخصية ثورية ضد التقاليد والمجتمع؟ إن نزارًا يوجز جدًّا في تفصيلات هذا الموضوع، مع أنه يذكر له تأثيرًا خطيرًا في تكوين شخصيته وشعره، فقد أراد أن ينتقم لأخته من مجتمع يرفض الحب. وواضح أن نزارًا وفي بما أراد، وبما عبر عنه جيدًا بلفظ الانتقام، لأن شعره الهدام هو في الحقيقة «انتقام» من المجتمع.
فاذا كانت أخته قد حرمت من «الحب» بسبب المجتمع، فليغرق هو هذا المجتمع بـ «الحب».
ونرى نزارًا في (ص ٣٤) ينفي أن يجلس في المقاهي، ثم لا يلبث في (ص ٩٩) أن يتحدث عن ضجره وهو جالس في المقاهي، ويقول في (ص۱۸۷) أن القصيدة تدخل عليه وهو جالس في المقهى:
ويقول في ص ۱۱۰: «ولم أستطع -بسبب طبيعة النظام وقسوة القيود المفروضة على الدبلوماسيين- أن أتواصل مع الإنسان الصيني، وأدخل في أي نوع من أنواع الحوار معه».
ثم يدعي في (ص ١٥٢) أنه أحب من كل الجنسيات حتى الصينية، فكيف كان ذلك برغم كل القيود التي ذكرها؟
ومن العجيب أيضًا أن يذكر نزار في (ص ١٤٣) أنه لم يدخل في علاقة حب مع أية امرأة أجنبية، ثم يدعي بعد ذلك أنه أحب من كل الجنسيات، أليست هذه هي الدنجواشوتية بعينها؟
ولعل نزارًا يضع فارقًا وهميًّا بين الحب والجنس، غير أننا لا نرى الوهم، فالحب عند نزار ليس له إلا معنى واحد وهو الجنس.
«البقية في العدد القادم»
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلاللغة.. الباب الواسع الذي استهدفت منه فرنسا الهوية العربية
نشر في العدد 2148
41
الخميس 01-أكتوبر-2020