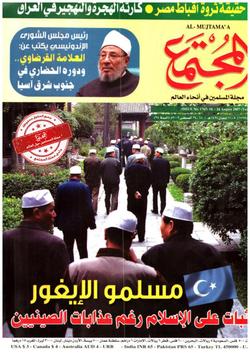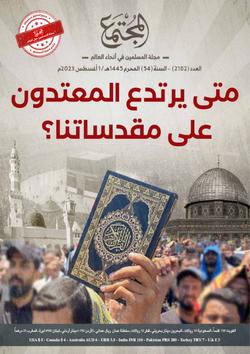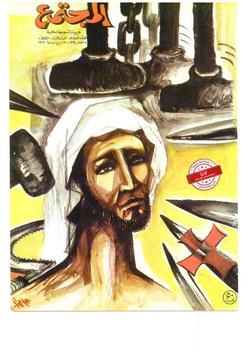العنوان نَظَرات في فِقه الحَركة الإسلامَيّة
الكاتب عبد الكريم مطيع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-فبراير-1977
مشاهدات 24
نشر في العدد 335
نشر في الصفحة 26
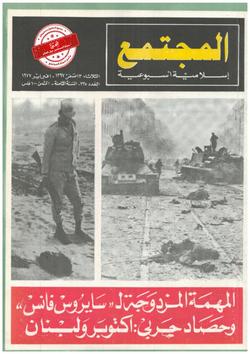
الثلاثاء 01-فبراير-1977
إن فهم القيادات الإسلامية لحقيقة ما تدعو إليه، وحقيقة مقتضياته في ميادين التربية والفكر والتنظيم، واستيعابها لظروف عصرها وملابساته، ومعرفتها لقوة خصومها فكرًا وخبرة وتنظيمًا، مما يعتبر مرتكزات ضرورية لخوض أي معركة عقدية والانتصار فيها.
وما النصر إلا من نصيب أولئك الذين يدركون طريقهم من أولها إلى آخرها، ويقدرون خصمهم حق قدره، ويتحلون بالشجاعة والنظام والانضباط والإخلاص، والذين يفهمون أن الإسلام في صميمه عقيدة فاعلة حركية تقوم أولًا وقبل كل شيء على الإيمان ثم على الإرادة، وإن القوة «قوة الإيمان وقوة الإرادة» هي الفيصل الحاسم، وإن التدخل المدروس المنظم لتغيير بنية النفوس وعلاقات المجتمع وفق منهج الله هو حجر الزاوية في كل عملٍ إسلامي.
إن الله، سبحانه، قد وضع لكل شيء في هذا الكون نظامًا وسننًا، وجعل التوفيق حليفًا لمن يفقه نظام الكون، ويتخذ لأهدافه أسبابها. لذلك كان لزامًا على كل جماعة تسعى لإخراج نفسها من حيز الركود والخمول إلى الميدان الفسيح للحركة والفعل أن تتحلى بالعلم الضروري للعمل: علم بالهدف وحقيقته، وعلم بالأسلوب وطرائقه، وعلم بالخصم وقوته، وعلم بالسنن الإلهية ونظمها، وما العلم إلا مقدمة نتيجتها العمل.
كما أن العمل مقدمة نتيجتها الهداية ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ والمجاهدة بالعلم والعمل، والهداية مواهب الله في كل الأحوال.
وما دام الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، أي أنه النتيجة العملية الأسمى لجهود الدعوة الإسلامية، وخلاصة العمل التربوي والفكري والسياسي والتنظيمي للجماعة المجاهدة؛ فإن الخلاف القائم حول أحقية كل من العمل التربوي أو الفكري أو السياسي أو التنظيمي بالأولوية يتهاوى من أساسه، إذ ما كل هذه الأعمال إلا عناصر في عملية واحدة هي عملية تكوين الداعية الإسلامي الحق، ومتى أغفل أحد هذه العناصر ظهر ذلك نقصًا في سلوكه، وأسلوب عمله، ونتائج جهده، وتدهورت بذلك عملية الجهاد التي هي ذروة سنام الإسلام وزبدة عمل الدعوة.
من ذلك نرى أن تركيز أعداء الإسلام في كل قطر منصب على تصفية العناصر الإسلامية التي تبلورت لديها العملية التربوية متكاملة أو أقرب إلى التكامل، بجوانبها الروحية والسلوكية والفكرية والسياسية والتنظيمية.
وسواء كانت محاولة تصفيتهم بالتشويه والعزل والمحاصرة، أو بالإغراء والاستخدام، واستدراجهم للتعامل والخيانة، أو بالسجن والقتل، أو بالإبعاد والتغريب، فإن الهدف يبقى واحدًا ووحيدًا هو تجريد الحركات الإسلامية من العناصر القيادية الصالحة الواعية، ثم لهذه الحركات بعد ذلك أن تلتجئ إلى الزوايا والتكايا، تاركة الدنيا لأهل الدنيا، والناس لأرباب الناس!
إن الحركة التي لها هدف وقتي محدود ربما لا تهتم بكل هذه الأبعاد ومقتضياتها، لكن الأمر يختلف اختلافًا شديدًا عندما يكون الهدف ذا بعد مكاني «هو الأرض كلها» وبعد زماني «يمتد إلى يوم الساعة»، وبعد بشري «هو الإنسان كل الإنسان»، أي عندما نسعى لإعادة أمر الإسلام وإرساء دعائمه.
وهنا مفترق طرق بين نوعين من العمل: نوع بسيط يعتمد على انتظار التطور التلقائي للقوى الإسلامية، ونوع آخر من العمل المخطط يعتمد على التنظيم المحكم القادر على أن يصير طليعة مجاهدة مرتبطة بالجماهير المؤمنة، وعلى أن يرفع حالة التأهب في المجتمع الإسلامي للدفاع عن العقيدة ونشرها، والوقوف في وجه الانحراف كلما دعت إلى ذلك الحاجة.
لذلك كان واجبًا أن يعمل الدعاة الإسلاميون لإعادة تشكيل بيئتهم بتكوين مراكز حركية تضاعف فائدة عملهم، وتجعل جهودهم وأشكالهم التنظيمية في مستوى التصور الإسلامي بخصائصه وموازينه وشموليته، ومنهاجه المتفردة في الحكم والتشريع والأخلاق.
إن عجزنا المتوالي عن تكوين حركة إسلامية قوية تسهم في إعادة الثقة إلى النفوس، وفرض الإسلام داخل دار الإسلام، يرجع في كثير من أسبابه إلى أن كثيرًا من التنظيمات الإسلامية ينقصها عنصر التوازن بين الجانب الفكري والتربوي في جهة، والجانب التنظيمي من جهة أخرى.
إذ أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المستوى الفكري والتربوي لأي حركة وبين مستواها في ميدان التنظيم.. بل أقول إن هناك أكثر من التلازم.. هناك الانبثاق الذاتي، فالتنظيم يعتبر انبثاقًا ذاتيًا من نوع التربية التي يتلقاها أعضاؤه.
وإذا تأكدت ضرورة وجود حركة إسلامية عالمية قوية تقوم بالشهادة على هذا العصر، بما يفرضه واقع الإنسانية ومشاكلها وهمومها، وتفرضه المرحلة التاريخية التي تمر بها البشرية في سعيها الحثيث نحو يوم الساعة، ويفرضه واقع التحديات اليهودية وهجومها الدنس على أقطارنا وقيمنا ومقدساتنا، وتفرضه قبل كل هذا وذاك- طبيعة تحملنا للأمانة في عالمي الغيب والشهود، فإن ارتفاع مستوانا التنظيمي بما يناسب مكانة عقيدتنا في الأرض وفي السماء، وسمو أهدافها وخطورة شأنها يعتبر عاملًا ضروريًا من عوامل النصر وتحقيق الأهداف.
لقد بذلت محاولات جادة وموفقة لتغيير الفكر والتربية لدى الأمة الإسلامية وطليعتها المؤمنة من الدعاة بما يناسب أصول العقيدة ونبعها الصافي، من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن نظرتنا التنظيمية ما زالت تعاني من موروثات عهود الذلة المسكنة والاستعمار والانحراف لذلك لا بد من التفكير في تغيير منطلقاتنا التنظيمية طبقًا لطبيعة تصورنا الاعتقادي ومنهجنا الرباني.
والتفكير في التغيير سواء كان تغييرًا لأحوال النفوس أو لأوضاع الأمم والشعوب يجب أن يبدأ بالأساس الذي يعيش عليه الإنسان.
فإذا تغير هذا الأساس، وحل محله الأساس المقطوع بصحته وصوابه؛ تغيرت تبعًا لذلك المقاييس والمفاهيم والقناعات، وأمكن بالتالي تغيير المجتمعات والأوضاع.
ولئن تغيرت نظرتنا إلى العقيدة الإسلامية في بعديها الفكري والتربوي؛ فأخذنا نتخلص من مختلف الانحرافات في ميداني الفكر والسلوك، فإن البُعد التنظيمي للدعوة الإسلامية ما زال محتاجًا إلى جهود.. وإلى دراسة وإلى تنوير.. أي أنه ما زال مفتقرًا إلى مهارات فنية وإدارية، تقريرية وتنفيذية، وأشكال تنظيمية مباشرة وغير مباشرة، رئيسية وموازية في منتهى الدقة والأحكام.
ولكن هذه المهارات وتلك الأشكال، لا يمكن أن تتوافر في أي حركة بعفوية وتلقائية، إذ لا بد لها من عملية سابقة أساسية، هي عملية تكوين النواة الأولى للدعاة، النواة التي تتكون- بادئ الأمر غالبًا- من مجموعة إسلاميين عاديين، يتجهون بمحض إرادتهم لدراسة الإسلام وتطبيقه، ثم لا يلبثون أن يصبحوا أداة متحركة رائدة في ميدان العمل الإسلامي.
إن هذه العملية- عملية تكوين النواة الأولى من الدعاة- تُعتبر من أشق المراحل في وقتنا الراهن، لأن كثيرًا من العراقيل الحادة تعترضها، وتعوق أعمالها الخاصة بتربية الدعاة في المحاضن تربية هادئة متأنية مركزة.. ولعلنا لا نحيد عن الموضوع إذا ما لخصنا بعض هذه العراقيل في ست نقط:
1 - طبيعة التركيبات الإسلامية القائمة في البلد الواحد:
ولعل أهم ما في طبيعة أغلبها انطلاقها في مفاهيمها وتطبيقاتها الحركية من أحد ثلاثة منطلقات: منطلق غربي مجرد لم يتم استيعابه، أو منطلق دراسي ثقافي تطبعه الأكاديمية والانتظارية، أو منطلق صوفي تنقصه الشمولية ويطبعه الحرص على السلامة والتضخم الروحاني.. ولهذا غالبًا ما يكتشف خصومها ثغراتها ومقاتلها؛ فيحققون أهدافهم بتخريبها أو تشويهها والقضاء عليها.
إن قطاعات من العمل الإسلامي أعرضت عن الأسلوب الذي تمتلك الاستعداد الكافي لإتقان استعماله، وهو الأسلوب النبوي الذي حدد كل أبعاد العمل ومراحله، ثم ترك لنا أن نستفيد من عقولنا ومن تجارب غيرنا في حدود أخلاقنا ومبادئنا وكرامتنا، ثم انتحلت طرائق للدعوة مستوردة تطبقها بمبادئها وغاياتها، وتسير على سننها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، مضفية عليها حلة شفافة من بعض الأخلاق والشعارات الإسلامية، فظهرت بذلك نشاطات إسلامية غير سليمة، وكانت النتيجة أن ذبح دعاة الإسلام وشردوا واضطهدوا وانتكست حركاتهم، وأفلح أعداء الإسلام في أن يمسكوا بالقيادات وبالشعوب، وأن ينفردوا بتوجيه الأمة وتنظيمها.
۲- الظروف السياسية التي تمر بها أمتنا:
وقد وضعت العمل الإسلامي أمام عدة واجهات وأولويات يصعب تأجيل النظر إليها والبت فيها: واجهة التربية وإعادة التربية ونشر الدعوة، واجهة التحدي العلمي والصناعي الأوروبي، واجهة تحرير أرض الإسلام، واجهة تحديد العلاقة الحاضرة والمستقبلة- سلبًا أو إيجابًا- مع بعض حكام الأمة الإسلامية، هذه الأولويات تفرض جملة على أي عمل إسلامي ينبثق، وتطلب منه بإلحاح، بل بقهر أحيانًا، أن يحدد موقفه منها، وبالتالي تحتم عليه أن يواجه فينسحق، أو أن يداهن في مرحلة بنائه التربوي فينحل ويتناقض وينشق على نفسه.
3- علاقة العمل الإسلامي ببعض المتحلقين حول الحكام:
وقد جرت عادة كثيرٍ من الحكام أن ينتخبوا لبطانتهم «أدوات بشرية» من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية في القطر، وممن لهم سابقة في العمل السياسي، يتخذونهم وسائط للاتصال بالحركات المتواجدة في البلد. يعاملون أحزاب اليسار بالأدوات التي لها سابقة في النشاط الاشتراكي أو شهرة به، ويستدرجون الحركات الإسلامية بالأدوات التي لها سابق خبرة بالدعوة الإسلامية وانشغال بها.
والأخطر في القضية أن الحكام يظنون هؤلاء الوسطاء مخلصين لهم، وبعض أعضاء الحركات يعتقدون أنهم لهم ناصحون، في حين أن هؤلاء «الأدوات» ليسوا مخلصين للحكام ولا للحركات، وإنما هم مخلصون فقط لأنفسهم. فهم يوهمون الحكام أنهم أوصياء ذوو نفوذ لدى الحركات، ويوهمون الحركات أنهم مفيدون لها لدى الحكام. وإذا ما بدا لهم أن أن إحدى الحركات أو بعض أعضائها استعصوا على الانحراف والعمالة، تآمروا عليهم بالتلفيق والاختلاق، أو بمحاولة دفع بعض العناصر الضعيفة إلى التمرد، أو استدراج بعض العناصر القاصرة إلى المواقف المتطرفة التي لا تخدم قضيتها، وهم في كل الأحوال يسعون للإبقاء على مبررٍ لوجودهم تحت أمرة مخدومهم بكل الوسائل.
والمبدأ الذي لا محيد عنه في هذه الحالة أن تتجنب الحركات الإسلامية هؤلاء الوسطاء فيما بينها وبين الحكام كي تكون العلاقات والمواقف والآراء واضحة بين الطرفين.
4- علاقة العمل الإسلامي بالحركات الإسلامية الأصيلة:
وهي علاقة تحكمها شريعة الله التي جعلتنا أمةً واحدةً، وجعلت الأصل وحدة الجماعة، لكن الظروف السياسية والدولية وغيرها مزقت أمة الإسلام إلى أقطار ودويلات واقتضت أن تقوم في كل بلد جماعة.
ثم هي علاقة يجب أن تراعي ظروف كل قطر وإمكانيات كل منطقة، فلا تتحمل أي جماعة من الثقل ما يعوقها عن السير في منطقها، ولا تحمل غيرها من المسؤولية ما لا تتحمله شرعًا ولا وضعًا.
ثم هي علاقة يجب أن تراعي مبدأ عالمية الدعوة دون أن تسمح بتمييع العمل الإسلامي المحلي المركز، ومبدأ مركزية العمل المحلي دون أن تسمح بنمو عصبيات إقليمية أو عرقية أو مذهبية أو حزبية.
5 - علاقة العمل الإسلامي بمختلف القوى والجيوب السياسية في الأمة الإسلامية:
ومن المعلوم أن هذه القوى منها ما يعلن إسلاميته، ويتمسك بأخلاقه وتصوراته الضالة، منتحلًا مختلف المبررات، للواقع الذي يعيشه والسلوك الذي ينتهجه. ومنها ما يعلن عدم اهتمامه بالدین أصلًا، بدعوى أنه علاقة خاصة بين الفرد وربه، لا ينبغي أن تؤثر في الحياة العامة للأمة، ومنها ما يعلن صراحة علمانيته وعداءه للدين، ومنها ما اقتضت مصلحة القوى الداخلية أو الخارجية الاستعمارية تكوينه والمشاغبة به على التنظيمات الإسلامية الجادة، ومنها ما ليس له علاقة إلا ببعض التشوفات والطموحات الفردية للزعامة باسم الإسلام.
هذه التركيبات تطلب من أي حركة إسلامية جادة أن تتخذ لها أسلوبًا مرحليًا للتعامل، أسلوبًا يلائم ظروف النشأة والتربية. وأسلوبًا يناسب مرحلة التنظيم والتقوية، وأسلوبًا يلائم مرحلة النضج والاقتدار.
هذا الأسلوب ينبغي أن يكون مضبوطًا ومستقى من طبيعة العقيدة الإسلامية ومقوماتها وتطبيقاتها النبوية في الحركة والتعامل والتخطيط.
6- ندرة الإمكانيات وقلة الدعاة:
إن هذه الصعوبات التي ذكرت، كان من الممكن قهرها والتغلب عليها، لو توافرت الإمكانيات، ووجد الدعاة الأكفياء من الشباب والمثقفين. ولكن الملاحظ أن هذا النوع من الرجال ذوي المستوى العلمي والتربوي، والمقدرة على العمل المنظم، سقط في هوّة اللا مبالاة السياسية، فلم يتجه للعمل الإسلامي - في كثيرٍ من الأقطار - إلا مجموعة من غير ذوي المقدرة العلمية والتربوية والتنظيمية. وبذلك أصبحت النشاطات الإسلامية خاضعةً للمبادرات الشخصية، والاجتهادات الفردية، واقتصر العمل الإسلامي على التجمعات الدراسية أو الصوفية، بقيادة عناصر مخلصة، ولكنها لا تعرف غير هذا الأسلوب الذي يكون عند صاحبه عقلية متعصبة لجماعتها أو طريقتها، منغلقة على مفاهيمها وتصوراتها.
ونستطيع التأكيد أن هذا الأسلوب والعقلية المرتبطة به من أكبر عوائق اندماج العناصر الحيّة في التنظيم واستقطاب الشباب، وتزويد الدعوة بدماءٍ جديدةٍ من الدعاة الأكفياء القادرين على العمل المجدي.
إن هذه الصعوبات التي أشرنا إليها تحول دائمًا دون قيام أي محاولة تنظيمية جادة، وتجعل جُل الأشكال التنظيمية القائمة اليوم فعلًا، غير قادرةٍ على خوض المعارك العقائدية التي تواجهها. وتؤكد لنا ـ بما لا يقبل الشك - أن كثيرًا من الهياكل الحالية المبنية على التجمعات العامة غير كافية لمباشرة عملية إعادة رفع كلمة الإسلام وراية المسلمين.