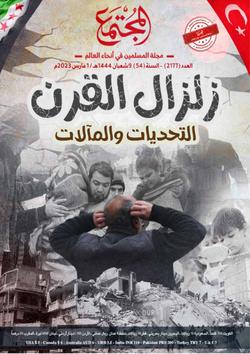العنوان هوس المجتمع المدني بين الموضة الفكرية وموت الدولة القومية
الكاتب هشام جعفر
تاريخ النشر الثلاثاء 05-مايو-1998
مشاهدات 16
نشر في العدد 1298
نشر في الصفحة 40
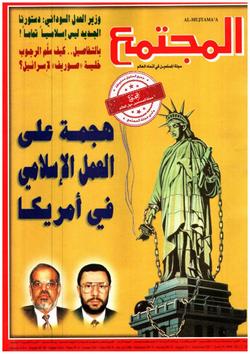
الثلاثاء 05-مايو-1998
أدرك الشيوعيون والماركسيون أن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني هي أيديولوجية النظام الدولي الجديد فتجاوبوا معها سريعًا.
بعد مؤتمرات الأمم المتحدة المتتالية بدأ الحديث عن «المجتمع المدني العالمي» وبعد التبشير بالفكرة بدأ إنشاء المؤسسات والمشاريع بحثية وتوفير التمويل الضخم لها.
اكتسب مفهوم «المجتمع المدني» ذيوعًا وانتشارًا في السياق الثقافي والسياسي العربي، حيث انتقل المفهوم إلى مصطلح، وتحول المصطلح إلى شعار، ثم تحول الشعار إلى «قيمة مرجعية» كـ «الديمقراطية» و «حقوق الإنسان» على أساسه، ووفقًا للتعريف الذي يقدم له يتم تحديد الموقف من القوى السياسية والاجتماعية الموجودة وعلى الساحة العامة قبولًا ورفضًا، وأصبح هناك «حراس» على «بوابة» «المجتمع المدني» يدخلون فيه من شاءوا ويحرمون منه من شاءوا.
في هذا السياق نحاول عبر هذا الملف الذي نفتحه هذا الأسبوع تفكيك خطاب المجتمع المدني عبر المحاور التالية:
١- بواعث بروز قضية المجتمع المدني في أوساط الأمة.
٢- رؤى متباينة حول المجتمع المدني.
٣ - التطور التاريخي لمفهوم «المجتمع المدني»، وتقويم دلالاته.
٤- المنظمات غير الحكومية باعتبارها من ضمن شجرة المفاهيم المرتبطة بالمجتمع المدني، ونعرض في هذا المحور لرؤية البنك الدولي لدور ومهام هذه المنظمات.
٥- المقابل الإسلامي المفهوم المجتمع لمدني
أ- مفهوم الأمة والرعية الفاعلة.
ب -مفهوم العمل الأهلي.
يبدو مفهوم المجتمع المدني اليوم أشبه بالموضة، فما من بحث فلسفي أو تاريخي أو سياسي، وما من مقال أو تعليق أو تصريح إلا ويعرض لمفهوم المجتمع المدني برؤى وتصورات متعددة وتوظيفات مختلفة، ومن المؤكد أن المفهوم قد اكتسب ذيوعًا وانتشارًا في السياق الثقافي والسياسي العربي، حيث انتقل مفهوم المجتمع المدني إلى مصطلح، وتحول المصطلح إلى شعار، ثم تحول الشعار إلى «قيمة مرجعية»، في حد ذاته، مثل مفاهيم «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان» التي ارتبطت أساسًا بتطور التشكيل الحضاري الغربي، فهذه المفاهيم جميعًا وغيرها من المفاهيم تحولت في واقعنا العربي إلى منظومة متكاملة يستخدمها البعض بدلالات ومعان ومضامين معينة تمثل في أحيان كثيرة رؤيته هو لهذه الدلالات وتلك المعاني والمضامين، يستخدمها البعض كمعيار لتحديد الموقف من القوى السياسية والاجتماعية الموجودة على الساحة قبولًا ورفضًا، وتحول هؤلاء من مجرد مفكرين وباحثين أو حتى سياسيين إلى «حراس» على «بوابة المجتمع المدني»، يدخلون فيه من شاءوا ويحرمون منه من شاءوا.
هذا الذيوع والانتشار الذي تحول إلى هوس، عبر عنه بعض المتفيهقين قائلًا: إن المرء يخشى أن يطالعه مفهوم المجتمع المدني اليوم لا حين يفتح كتابًا أو مجلة، بل حين يفتح الباب أو يطالع من النافذة، ويرى البعض الآخر أن المجتمع المدني هو الآن بؤرة النقاش والحوار في الشرق الأوسط، ويمكن رصد عوامل متعددة وبواعث شتى وراء الاهتمام المتزايد بالموضوع أهمها:
١ – المثقف العربي والموضة الفكرية: يلاحظ بصفة عامة أن كثيرًا من المثقفين العرب – على خلاف طائفة العلماء والفقهاء في تاريخنا القديم وإلى حد ما في تاريخنا الحديث – قد عانوا – بشكل كبير – من مشكلة انصراف الأمة بطوائفها وفئاتها عنهم نتيجة أسباب متعددة ليس مجال سردها الآن، ولكن ما يعنينا في الأمر أن الطائفة المتغربة من المثقفين ارتبطت أجندة تفكيرها وأولويات اهتمامها بما هو قائم في الغرب من موضوعات وقضايا، والغرب هذا المقصود به التشكيل الحضاري الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، وبقواه المهيمنة في النظام الدولي المنعوت بالجديد جزء من مثقفينا العرب ولى وجهه شطر الغرب فاتخذه «قبلة» يردد في رجع للصدى ما يتردد في الغرب من قضايا ومفاهيم وإشكاليات فإذا قال الغرب «ديمقراطية»، قال هؤلاء «ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية»، وإذا قال الغرب: «مجتمع مدني»، قالوا: «مجتمع مدني مجتمع مدني، مجتمع مدني»، وإذا قال الغرب: «عولمة» قالوا: «عولمة عولمة عولمة»، وإذا قالوا، قالت طائفة أو جمع معهم مثل ما قالوا، وقلنا نحن ما قالوا.
لقد انتقل اهتمام المثقفين العرب من قضية لأخرى على مدار العقود الثلاثة الماضية، ففي سبعينيات القرن العشرين شهد العالم العربي اهتمامًا متصاعدًا بين طائفة من المثقفين بفكرة الديمقراطية، وبات هؤلاء المثقفون ينظرون إلى الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي على أنها الوصفة السحرية التي ستزول بها كل أسقام وأمراض المجتمع العربي، واستثار الجدل حول الموضوع خيال الكتاب العربي للمساهمة في مناقشات مترامية الأطراف على صفحات الجرائد والدوريات والمجلات المتخصصة التي في أماكن شتى، كما عقدت في الثمانينيات مؤتمرات وندوات وصدرت كتب ومجلدات تناقش مكانة الديمقراطية في المجتمعات العربية المعاصرة، وتحول النقاش والجدل إلى حركة في الواقع السياسي العربي، فشهدنا تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام ۱۹۸۳م، والتي أعقبها تأسيس منظمات ومؤسسات قطرية تعنى بحقوق الإنسان في بلداتها، ثم تلا ذلك في التسعينيات زيادة كبيرة في إنشاء هذه المنظمات، وتوسيع في نطاق ومجال عملها بحيث أصبح عندنا عدد من المنظمات المتخصصة في موضوع وقضايا بعينها من قضايا حقوق الإنسان (منظمات للمرأة، وأخرى للسجناء، وثالثة فكرية).
ويلاحظ بحق د. وليد قزيها – أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة – أن كثيرًا من المثقفين الذين اهتموا بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت خلفيتهم علمانية، أو ذات صلة بالحركات الوطنية العربية والشيوعية، ويعزو ذلك إلى أن انهيار الناصرية وفشل حزب البعث في التصدي لمهام الصحوة الوطنية والاجتماعية وتحرير فلسطين كل ذلك نزع المصداقية عن حقبة كاملة من الصراع العربي السياسي، لذا أضحى كثير من المثقفين العرب – بعد إصابتهم بخيبة الأمل والإحباط إزاء تجربتهم السياسية وامتلائهم بالغضب تجاه أداء بعض الأنظمة العربية – ينظرون إلى الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي على أنها الحل لمشاكل ومعضلات الواقع العربي، ومع اتساع المناقشة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الثمانينيات ازداد تداول مصطلح المجتمع المدني أكثر فأكثر في الخطاب العربي بالنسبة للشيوعيين والماركسيين والتحرريين من المثقفين العرب، وكان الشيوعيون والماركسيون هم أكثر المثقفين اهتمامًا به وبخاصة في التسعينيات، وهذه المرة لا نتيجة فشل مشروع دول ما بعد الاستقلال، ولكن نتيجة سقوط «المشروع الشيوعي»، بسقوط الاتحاد السوفييتي، وأراد هؤلاء أن يجددوا مشروعهم السياسي ويضخوا فيه دماء جديدة، فكانت قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني هي المرشحة لضخ هذه الدماء وبخاصة أن جزءًا كبيرًا منهم قد أدركوا التحولات العالمية بعمق، ورأوا أن هذه القضايا هي أيديولوجية النظام الدولي الجديد فتجاوبوا معها سريعًا.
٢ – موت الدولة الديمقراطية: يلاحظ أن الدور التوسعي للدول العربية – باعتبارها أداة تحقيق وإنجاز التنمية – قد بلغ منتهاه في السبعينيات من هذا القرن، بعد أن كان قد بلغ ذروته في الخمسينيات والستينيات، فمنذ السبعينيات أدت مسيرة الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخليًا وخارجيًا، إلى إجبار الدولة العربية على التراجع عن العديد من وظائفها الاجتماعية والاقتصادية، بل حتى السياسية والثقافية التي ادعتها في الخمسينيات والستينيات، ويبدو أن هذا التراجع قد عبد الطريق لطرح فكرة المجتمع المدني في العالم العربي، حيث نشطت بعض الفاعليات من نقابات وأحزاب لمحاولة ملء الهامش السياسي الذي أتاحته الدولة ذاتها، إلا أن الأهم أن تخلي الدولة من دورها الاجتماعي والاقتصادي الذي تحملت عينه في الخمسينيات والستينيات حين تحولت إلى «مطعم وكأس وموظف» لجميع رعاياها، هذا التخلي أو التراجع عن أداء هذا الدور حفز قوى المجتمع لمحاولة تغطية احتياجاته الأساسية التي لم تعد الدولة توفرها له، وهنا برزت فعاليات الجمعيات الخيرية إسلاميًا وغير إسلامي، وبخاصة في الدول غير النفطية.
٣– البواعث الدولية: لاشك في أن التطورات الدولية التي أحاطت بالمنطقة دفعت لانتشار مفهوم المجتمع المدني في واقعنا العربي، في هذا السياق يمكن رصد عدد من التطورات كانت بمثابة قوة دفع للمفهوم أولها سقوط الاتحاد السوفييتي الذي تم على يد قوى المجتمع المدني، وقتها، وقد أدى هذا السقوط إلى توهم كثير من المثقفين العرب على اختلاف اتجاهاتهم بقرب تكرار التجربة في واقعنا العربي، وتواكب مع سقوط الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج الثانية تدشين مفهوم «النظام الدولي الجديد»، وهذا النظام تطلب أيديولوجية يروج بها لممارساته فكانت منظومة حقوق الإنسان، والديمقراطية، والمجتمع المدني، باعتبار الأخير أداة إنجاز التحول الديمقراطي.
أما ثاني التطورات الدولية المهمة فكانت مؤتمرات الأمم المتحدة الكبرى التي عقدت حول القضايا المصيرية في العالم، كان أول هذه المؤتمرات مؤتمر ريو المدعو بقمة الأرض سنة ١٩٩٠، ثم مؤتمر فيينا المدعو قمة حقوق الإنسان سنة ١٩٩٣م، ومؤتمر السكان بالقاهرة عام ١٩٩٤م، ومؤتمر التنمية الاجتماعية بكوينهاجن عام ١٩٩٥م، ومؤتمر المرأة في بكين عام ١٩٩٥م. وآخرها مؤتمر المستوطنات في أسطنبول بتركيا عام ١٩٩٦م، هذه المؤتمرات جميعًا تأتي نتيجة الإحساس بالحاجة إلى رؤية جديدة للعالم يشارك فيها الجميع، وكان من ضمن الجميع الذي دعي للمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، حيث كان في كل قمة من القمم الست مؤتمران في وقت واحد، الأول للوفود الرسمية، والثاني للوفود غير الرسمية، وكان الثاني يعقد قبل الأول بأيام قليلة حتى يخلص المؤتمرون إلى رؤيتهم بشأن الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر الرسمي، وكانوا يسعون إلى لعب دور في صياغة الوثيقة الرسمية، وهكذا، فإن مؤتمرات الأمم المتحدة قد دشنت بحق منظمات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا في صياغة مستقبل البشرية.
وتواكب مع ذلك أيضًا، وهذا هو التطور الدولي الثالث، أن العالم بات يشهد عددًا من الفواعل الدولية التي تصيغ العلاقات الدولية بخلاف الدول في هذا الصدد يمكن أن نشير إلى الشركات متعدية الجنسية، ومنظمات الإغاثة العالمية، وأجهزة الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، وقد ترتب على ذلك زيادة الحديث عن «المجتمع المدني العالمي» و «التحالف العالمي لمشاركة المواطنين» و«دعم المجتمع المدني في العالم»، هذا التطور انتقل من التبشير بالفكرة والدعوة إليها إلى إنشاء مؤسسات، وتدشين مشاريع بحثية، وتوفير تمويل ضخم أخذت به الفكرة قوة دفع جديدة.
٤– بواعث أكاديمية: جزء من البواعث الأكاديمية يرتبط بتطور دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية أساسًا، والجزء الآخر يرتبط برؤية الأكاديميين العرب وأولوياتهم البحثية.
يلاحظ أن دراسات المجتمع المدني التي اهتم بها الأكاديميون الغربيون في امتداد لتقاليد جديدة في دراسات الشرق الأوسط التي ظهرت في فترة سابقة كمعارضة للدراسات الاستشرافية التي انصب اهتمامها أساسًا على الأبعاد الثقافية للمجتمع العربي، وأصبح الاتجاه ينحو أكثر في دراسات الشرق الأوسط نحو العناية بخصوصية الواقع العربي، فكان التأكيد على الدور الممكن للمبادرات الأهلية في العملية السياسية، أما الأكاديميون العرب فرؤوا في قضية المجتمع المدني فرصة لدراسة قضايا وموضوعات جديدة بعد أن انصب جل تركيزهم في حقل العلوم السياسية سابقًا على دراسة النظام السياسي أساسًا، ودعم من هذا التوجه على حجم التمويل الكبير نسبيًا والمتاح في هذه الدراسات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل