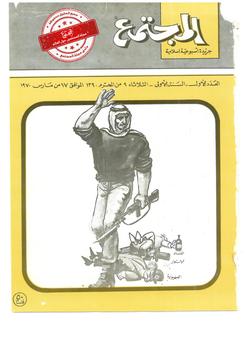العنوان وعرضوا على ربك صفا
الكاتب أحمد محمد عبد الله
تاريخ النشر الثلاثاء 05-فبراير-1974
مشاهدات 15
نشر في العدد 186
نشر في الصفحة 21

الثلاثاء 05-فبراير-1974
﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ (الكهف: 47-48).
قد تستخف إنسانا ما قصيدة شعرية لاقت هوى في نفسه لصدق التجربة الشعورية عند الشاعر ومدى مطابقتها لإحساس القارئ وشعوره ولكنها لا تلبث أن تذوى شيئا فشيئا لأنها عاطفة مشتركة أحس فيها القارئ أنها تجربة عاشها هو أيضا فترجمها الشاعر، وما أكثر ما يمر الإنسان بمثل هذه التجارب، فتستثيره قصيدة شعرية جميلة صادقة، أو عبارة متقنة دبجها يراع كاتب ماهر عن حالة شعورية خاصة فتعدت حدودها الذاتية إلى المشاركة الوجدانية للآخرين.
● أما الآية القرآنية، أما القرآن الكريم فشيء آخر غير هذا وذاك، فليس هو مما تعارف عليه الناس من اهتياج العواطف، وإثارة الأحاسيس المتوفرة، ثم همودها وخمودها بعد حين إذا كثر التردد والتكرار، وطال عمر الحديث عن القصيدة أو العبارة، فكثيرا ما تفقد رونقها وتصبح عادية لا تأثير لها كما كان في السابق، لدى المرة الاولى أو الثانية.
● والآية القرآنية عكس هذا تماما، فهي انبعاث شعور حقيقي، ثم إضرام هذا الشعور فليس هو بمنطفئ إن أعاد القراءة والتملي بل إنها دفقة جديدة، وفيض مشاعر وأحاسيس جديدة تنمو وتكبر مع كل قراءة معادة، وفي كل مرة تتفتح آفاق جديدة بعيدة تحمل المسلم إلى التطلع والإكثار من المداومة على التردد فإذا هو في عالم شعوري عميق، وليس هذا الشعور عاطفيا متوقفا، يقف بصاحبه عند طلاوة اللفظ وحلاوة العبارة وحسن الأداء والصور البلاغية، ولكنه شيء جديد، إنه روح عاملة، لأنها تعي ما تقرأ وتفهم ما تتلو، وتعرف أن القراءة دفعة نحو العمل، لتحقيق هذا المسطور، فليس هذا المسطور للتملي والالتذاذ والتذوق، ولكنه روح عمل لتحقيق هدف نبيل.
● إن القرآن حياة، حياة لا يفهمها ولا يقدرها ولا يدركها إلا من تتحرك فيه هذه المشاعر وهذه الأحاسيس النابضة، ويحس دبيبها في قلبه وفي كل جارحة من جوارحه، وهل الحياة إلا إعطاء كل جارحة وحاسة حقها من العيش لأداء مهمتها ووظيفتها التي خلقت من أجلها، ومن حرمها وصبر فله عوضا عنها خيرا الجنة، إن كان مؤمنا!
● والقرآن حياة، حياة ممتدة فسيحة لا يبلغ المرء آخرها، ودنيا جديدة لا يهنأ بها إلا من ذاق حلاوة الإيمان واستشعره بجناته وتمثل ذلك في حياته خير تمثيل، إنه عالم حسبه أنه للإنسان مأوى فيه كل ما تطمح إليه النفس البشرية من حياة هانئة مستقيمة لا تعكير فيها ولا انحراف، وهذا العالم الكبير صد عنه كثير من الناس صدتهم عن ذلك المغفلة وجمح بهم الغرور وساقتهم المعاندة والمكابرة وأمراض النفس أمامها، كما ساقت كثيرين من قبلهم، قص علينا القرآن قصصهم؛ فهل ولجت -أخي المسلم- إلى هذا العالم الشاسع، وهل تحركت نفسك المؤمنة مع كل حرف من حروفه وهل أحسست وأنت تقرأ آية من آياته في خشوع أن هناك شيئا ما، يحرك قلبك ويداعب مشاعرك ولا يدعك على حالك التي كنت فيها من قبل، إنه الإيمان يحركك ويدفعك إلى الارتباط العميق مع ما تقرأ، إنه ذلك السر العظيم الذي يستكن في قلب المؤمن، إنها الفطرة الصادقة تتجاوب مع ما جعل للإنسان من عوامل الارتباط بحياته منذ أن قرر له أن يكون من إحياء هذه الدنيا، حتى اللحظة التي يموت فيها ويودع الدنيا إلى دنيا آخرة، قدمها بهذه المشاعر الصادقة والمدركات التي قادته إلى هذا الارتباط العميق فهدته فسلكت به الطريق القويم.
وويل للخاسرين الذين أخضعهم الكبر لسطوته وفتنت معادنهم علائم المعاندة فانساقوا معها، ورفت عليهم خيالات الزهو فإذا هم في غيهم يعمهون.
أخي المسلم، إنها عظمة الآية القرآنية، وروعة الحياة في ظلال القرآن، فهل قرأت هذه الآيات جيدا وتصورتها ذلك التصور الدقيق الذي عنته الآية الكريمة، وهل داخل قلبك شيء من الخوف والوجل، وداخلتك رهبة الموقف وخشية الورود في يوم يحشر فيه الناس، لا متخلف منهم أبدا.
أدق قلبك دقات الروع عندما ارتسمت بمشاعرك صورة، الجبال وهي سائرة، هذه الجبال العظيمة المنتصبة يقف أمامها الإنسان فذا هو ذرة من ذراتها، فإذا هي تمر كمر السحاب، أرأيت إلى هذه الصخور الصم. وهذه الكتل المتراصة التي تقصر أمامها قوة الإنسان فيبدو ضعيفا عندها، وإن جال بها بحديده وناره ومفرقعاته فإنه كالطفل يهدم بنية ضخمة، بكل براءة الأطفال وتصورهم، هذه الجبال تمر كالعهن المنفوش، كالقطن الطائر، في خفته وسرعة دفع الريح له.
وهذه الأرض بكل ما فيها، وما تهالك عليه البشر، فسالت دماؤهم وانتهبت حقوقهم، وضاعت آمالهم في غمرة آلامهم، وسرقت لقمة العيش من أفواه كثيرين منهم، ثم هذه الأرض بجبالها وبحارها وزروعها وحيوانها وكل ما دب فوقها وما انتصب عليها أو نبت فيها، هذه الأرض تبدو للعيان بارزة فلا ارتفاع فيها ولا انخفاض، سطح أجرد لاشية فوقه، هل تتصور هذا المشهد، وهل طبع في قلبك حيا يتحرك ينبض بالحياة، ثم قبل كل هذا، كيف موقفك وأنت ترى هذه المناظر والأرض لا استقرار لها، فالارتجاع والاهتزاز، وتسأل الناس عما يجري وما يحدث وهم بين مفجوء وخائف ومولول، أي هلع يصيب الإنسان وأي جزع، أليست صورة معبرة ناطقة، هذه فحوى عبارة صغيرة وتجد هذا المشهد مفصلا أكثر في آيات أخر.
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهنا نقلة من المشهد الأول، فمنظر الأرض انتهى، وجاء مشهد آخر أشد رهبة وكربا، إنه يوم اللقاء، يوم مارى فيه قوم وصدق به قوم، يوم شغل الناس به فمن اتبع فطرته فقد هدى ومن تمرد عليها فوروده اليوم ورد مشئوم عليه، جزاء ما قدم وارتكب من مخالفات وشرور ومعاص.
إنه موقف الحشر، ذلك المكان الغريب، الذي تنفطر فيه القلوب وتتعلق إليه الأعين وتشرئب الأعناق، والتفت كل حوله، وما يجدي الالتفات؟! فهذا هو التاريخ البشري كله يحاكم اليوم.
عجبا، أكل هؤلاء في أرض واحدة، وفي صعيد واحد، أمام الديان جل وعلا، وشخصت الأبصار وطال انتظارها، فليس عن هذا الجمع أحد قد تخلف، إن الذرية كلها قد حضرت لا يفتقد منها شخص واحد أبدا، إن الله لا يخلف الميعاد!!
● وجيء بهم زمرا تتبعها زمر، وصفوا في أرض المحشر حيث كان الموعد
من يوم أن كانت الدعوة تنزل من السماء تبلغهم ذلك، وكان الجاحد في عمايته وجهله ترتع، ويتعالى ويتبرم بالدعوة والنبي ويرميها بصفات القسوة ويتهم حاملها بالتطاول عليه وعلى ما ورث من مجد آبائه وأجداده!
وفي هذا الموقف الكبير، تنخلع القلوب من فزع وتعتري الأجساد رجفة الهلع، فالمؤمن مع خشيته وخوفه فله حبل رجاء يصله، فهو قد أحس إخلاصه وطاعته وعمله وتفانيه وصبره، فلعل ما صدق به في الدنيا يكون سبيل أمل في هذا اليوم المشهور، والكافر لا يدري بأي تعلة يتعلل، فهذه صحائفه مكشوفة وسجله يشهد كفره وعتوه وفجوره، فلم يجد المعاطس إن اشمخرت وتكبرت يوم كان التهديد والوعيد ينزل، فيزاد الظالم في العتو والهزء والسخرية، ولم يجد النفوس الكبيرة - التي أثقلت الأجسام - ذلك التمادي والغرور والأبهة والتفاخر، فكلها كانت أعراضا زالت بزوال الإنسان عن دنياه الفانية وظل مسطورا كل هذا، وعلى رأس الخلائق يتلى ويفضح صاحبه، أي خزي هذا وأي عار ليته يصبح رفاتا فينتهي ولا يقف هذا الموقف، ولكن هيهات!
﴿وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ (الكهف: 48).
نعم، كما خلقوا أول مرة، فهذه أجسادهم لم تنقص وهذه جوارحهم التي ارتكبت كل الجهالات وهذا القلب المحير الذي لا يدري كيف يكون الاستقرار وهذه النفس الوجلة القلقة التي لا يجد الاطمئنان إليها سبيلا، وإنما الخوف والبلوى والجزع عوامل مختلفة تتدافع فيها، فتزيد من حرقتها وتسعر نار لومها وتقريعها.
وارتدوا، يصاولون النفس، الأمارة بالسوء، ألم تمل عليهم بكل ما فيها من صلف وهوى وغواية شيطان مندس في الدم يجري معه، ألم تمل عليهم ذلك التعالي والترفع، في غير مجال التعالي والترفع، فعلى من يكون هذا التعالي وهذا الترفع، أعلى الله -عز وجل - وهو الخالق الباري؟!
ولمن يكون تحديها، لمن بيده القوة والملك والجبروت؟! سبحانه وتعالى. وكانوا ينتفخون زهوا ويملئون أفواههم صراخا، أن لا عودة ولا بعث ولا نشور، ولا وقوف في هذا الموقف، ولكنهم الآن يشهدون باطل قولهم وكذبهم وترفعهم وتعاليهم، ويجنون ثمرة استعلائهم على الله ومحاربة رسله، وينالون حظهم من وعيد ربهم الذي لا يخلف الميعاد، إن وعد، وقد لجوا في طغيانهم وتمادوا في إسفافهم وخلودهم إلى الدنايا، فانهارت كل أفكارهم وسفهت أحلامهم، وها هم الآن يقفون الموقف الذي كذبوا لقاءه، ويشهدون بأم أعينهم ما زعموه أنه لله يكون!
هل عشت هذا المشهد في هذه الصورة، وهل أدركت حواسك جميعا أن لكل منها وظيفة وعملا، فإذا ما تعدت حدود هذا المشروع لها وغوت، وتطاولت وظلمت، وامتدت ببطش ونالت من الناس بغير حق كيف تكون، وما المآل؟!
إن مجرد المرور بهذه الآيات يبعث بالنفس الرجفة والخوف فما بال المتأمل والمستطلع لما تحويه من تجسيد ليوم، تتخلى فيه الأعضاء والحواس والجوارح، تتخلى عن نصرة صاحبها لتشهد ضده، وتعلن بصراحة ما كان يسخرها به صاحبها، ويفغر هو فاه دهشا وعجبا، من أنطق هذه الجوارح، وما عدها هو إلا أشياء ميتة يحركها هو وينفخ فيها الروح التي يستغل بها مآربه ويحقق أطماعه.
إن هذه المحاكمة العادلة للبشرية جمعاء ورؤية الناس وهم يتدافعون نحو مصيرهم، لا يمكن أن يحيط به تصور العقل الإنساني، وحسبه أن يستشعر بعضا مما فيه، يحتمله عقله وما يمر به في حياته مع الناس في حالات الازدحام والضيق، وهنا، ترى الناس على وجوه.
المؤمنون، عليهم من الله سلام ورحمة، وهم بما عانوا من الشدائد وتحملوا من صنوف العذاب وصبروا واحتسبوا ذلك في الله قليل، هم الوارثون في هذا اليوم الذي تشيب لهوله الولدان، والكافرون المعاندون المستكبرون، زمر تجري إثر زمر، تبحث عن صاحب الشفاعة سيد الخلق أن سلام عليك أغثنا، واشفع لنا عند ربك.
هؤلاء الذين يمرون الآن سراعا يبحثون عن سيد البشر في ذلك الموج الطامي من الخلائق، هم الذين أنفقوا ما استطاعوا من جهد ومال، ونشروا كل رذيلة وحاربوا كل فضيلة، وسعوا في الأرض خرابا ودمارا وفي الناس تقتيلا وتشريدا وللأنبياء ورسالات السماء، تكذيبا وطعنا وسبا وشتما ومحاربة، هؤلاء هم الذين يصرخون، إنهم مذنبون، وفي هذه الساعة التي حدق بهم ما لم يكونوا له بمنتهين فحق عليهم القول، فصدقوا عندما أحسوا الهزيمة وسقطوا وأن ميدانهم الذي يجرون فيه ضيقا كسم الخياط، فلم يعودوا يعرفون طريقا، هؤلاء هم الذين يغمرهم التساؤل المخيف، والبكاء وبحر الدموع!
وما الجدوى وما الفائدة، بعد أن صدق الله وعده، وآتى عباده ما وعدهم فليس الذنب إلا ذنبهم وليست الجناية إلا أنفسهم الواهية وشهواتهم واستكبارهم، ألا فلينتظروا ما يفرج عنه الموقف ويوم تكشف الصحائف ويرون أفعالهم مدونة لا يغادر السجل صغيرة منها ولا كبيرة، هناك فقط، يرون أن زعمهم بأن لا بعث ولا عودة، قد خاب وانطوى، أما المؤمن فيتذكر حصول هذا، فهو في عمل دائب وتفكير متوال وتوحيد لله مستمر وإقرار له وخضوع ودعاء وخشوع، لعل المورد يكون هينا والحساب أقل وطأة.
ولا يتحقق هذا إلا لمن أسلم القياد وآمن فاستقام إیمانه، ولم يعدل به شيئا وعمل فأخلص العمل وأتقنه، وتنافس في الخير، وبكت عيناه من خشية الله، وضمه الليل في جوفه بكاء يحذر الآخرة وفي نهاره عاملا لا يترك لحظة إلا وله فيها مغنم من دعوة حق وصدق، يبتغي الثواب ويحذر غضب ربه وسخطه وعقابه.
أحمد محمد عبد الله
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل