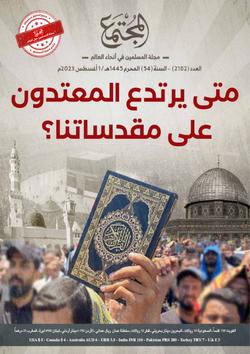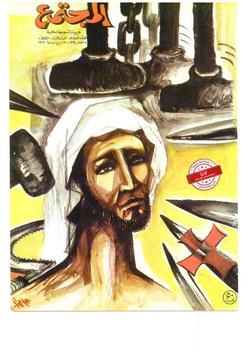العنوان المجتمع التربوي- العدد 1034
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 19-يناير-1993
مشاهدات 17
نشر في العدد 1034
نشر في الصفحة 52
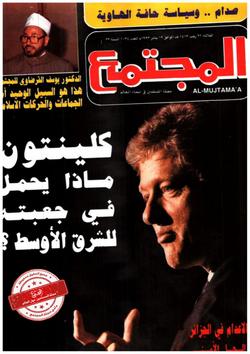
الثلاثاء 19-يناير-1993
وقفة تربوية
كيف تكسر النفور والغضب؟
في يوم من أيام يناير وأمام الكعبة المشرفة، وفي صلاة الفجر، كان يصلي إلى جانبي رجل ما كنت أعرف جنسيته، ولكنه لفت نظري عندما صلى سجدتين سهو بعد الصلاة، فقلت له: أخي العزيز، إذا كنت قد أخطأت في الصلاة فالإمام ضامن، ولا داعي لسجود السهو، فنظر إلي نظر المغضب وقد تجهم وجهه، وقال بلهجة حادة: أنا شافعي وعندنا إذا ترك دعاء القنوت لا بد من سجود السهو. وتنحى عني جانبًا على صورة من لم يعجبه ما قيل له. ثم نودي لصلاة الميت. وكانت فرصة بأنه عاد إلى مكانه بجانبي، وبعد انتهاء الصلاة، وضعت يدي اليمنى على كتفه وربت عليه وقلت له: يا أخي، إنما أنا ناصح، ولا داعي للغضب، فإن كنت مخطأ فبين لي خطئي، وليس هناك داع للغضب. بعد هذه الكلمات انكسر شيء من غضبه وفورته، وبدأ يشرح لي ما فهم من مذهبه في هذه القضية. ورددت عليه بيسر وهدوء وبينت له حبي للإمام الشافعي، وشرحت له باختصار شديد «الإمام» ضامن أو کلام الإمام الشافعي رضي الله عنه: «إن صح الحديث فهو مذهبي»، وشكرني على ذلك، ثم جلست بعيدًا عنه، فما لبث بعد أن انتهى من التسبيح أن جاءني يعتذر، ويصافحني مصافحة المتأسف على موقفه السابق، وقال لي: يا أخي، نحن أتراك قريبون من العراق، وفهمنا للعربية ركيك، وليس عندنا قدرة الاستنباط وفهم الأحاديث ومراميها، لذلك لا بد لنا من تقليد إمام ثبت، فأيدته على ذلك وبينت له محبتنا للأتراك، وأنه لا فرق بين مسلم وآخر، وكلنا إخوة في الله، ثم تحدثت معه عن تركيا وزيارتي لها، وبعض القصص التي حدثت لي هناك؛ فسر كثيرًا لذلك، ثم ختمت له حديثي بالفرق بين المقلدين، وأن هناك تقليدًا أعمى وتقليدًا مبصرًا، والتقليد الأعمى هو الذي لا يلتفت إلى الدليل حتى وإن وضح أمامه وضوح الشمس، فوافقني على ذلك، ثم بينت له ما يعني حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله، وأن منهم «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»، وقلت له: أرجو أن نكون منهما، ففرح كثيرًا بذلك، ودعا بذلك، ثم ودعني بحرارة وسرور.
أبو بلال
«أنزلوا الناس منازلهم»
بقلم: محمد الشيخ حسين- الأحساء- الهفوف
نرى بحمد الله كثيرًا من الدعاة العاملين للإسلام من زاده الله بسطة في العلم والجسم وحباه من صفات الطيبة والسماحة والحلم وآداب جمة يصعب حصرها وفتح عليه من كنوز العلم والحفظ لكثير من المتون في شتى الفنون ووفقه للدعوة إلى الله سنوات متواصلة؛ إلا أنه مع ذلك كله لا يتقن فن التعامل مع الآخرين وحسن مخالطتهم، فأمر العلاقات الاجتماعية أو العامة لديه مهمل، فهو يعامل الجميع بأسلوب واحد ويتكلم معهم بطريقة متماثلة ويعاملهم بنفسية متشابهة، فلا اعتبار لمقام أحد منهم أو سنه أو وجاهته أو هيبته، وهذا ما يثير حفيظة البعض بالسخرية والتهكم منهم على هذا الداعية، بل تبلغ الجرأة ببعضهم أن يصفه بالسذاجة والتي نسميها في المصطلح الدعوي: غفلة الصالحين؛ لنخفف من شأنها.
إن ما يحز في النفس أن هذا الداعية مهما تدرج في سلك الدعوة إلى الله سيظل قاصر النظر وغير مؤهل لقيادة العمل الإسلامي والارتقاء به ما دامت هذه الصفة تلازمه؛ وسبب ذلك فقدان الوعي التام بالقاعدة التربوية النبوية: «أنزلوا الناس منازلهم»، ونحن لا نشك أن الداعية قد علم بها وقرأ عنها، وإنما نشك أنه طبقها وعمل بها بصورة سليمة.. ولو ذهبنا نتأمل تاريخيًّا في هذه القاعدة لوجدنا شواهدها كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسبب ورود هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها آخر عليه ثياب وله هيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنزلوا الناس منازلهم»«۱» (أخرجه أبو داود). وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»«2» (أخرجه الترمذي).
وتأمل في قول الباري عز وجل لموسى وأخيه: ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (44)﴾ (طه: 43، 44) فندرك أن الله سبحانه وتعالى أعطى أمر المقام والسلطان قولًا يناسبه كي تتم الاستجابة المطلوبة، وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار في قضية تحكيمه سعد بن معاذ في بني قريظة لما قدم سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا لسيدكم»«3» ألا يدل ذلك على تعليمه صلى الله عليه وسلم لصحابته أن يقدر صغيرهم كبيرهم وشبابهم شيوخهم فيحفظ لصاحب الفضل فضله، ولصاحب الجهاد جهاده وبلاء، بل أنعم النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم مع خصومه فستجده أنه يستمع إليهم بإنصات وهم كفرة فجرة جاءوا بالباطل؛ ومع ذلك يستمع إليهم ويرد عليهم بالرد الحاسم الحازم؛ فعندما جاء عتبة بن ربيعة وأراد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه، قال له صلى الله عليه وسلم: «قل يا أبا الوليد أسمع...» ثم تركه يتكلم حتى إذا فرغ عتبة قال: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟»، قال: نعم، قال: «فاسمع مني...»«4». فكل ما سبق شواهد تدل على أهمية حسن معاملة النفوس ومخاطبتها بقدرها.
أخي -حفظك الله- إن الناس يتفاوتون في خلقهم وخلقهم ويتدرجون في وظائفهم ومناصبهم، ويتمايزون في علمهم وفهمهم ويختلفون في كثير من أمورهم، وهذا من دلائل قدرة الله وعظيم صنعه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ (22)﴾ (الروم: 22) فإن كانوا يختلفون في الألوان والألسنة فهم يختلفون تبعًا لذلك في العلم والفهم والتصورات، فلا بد إذًا أن تواجه هذه الفروق الفردية بأساليب متنوعة وتخاطب هذه الأصناف على قدر عقولها وإدراكها فيتعامل مع بعضها بحذر ومع الآخر بحزم ومع الثالث برفق.. وهكذا، وكل ذلك منطلقه الحرص على تبليغ الدعوة بأحسن طريقة، وأن لا ترد بسببنا وسوء طريقتنا فنسيء من حيث أردنا أن نحسن، ونصد عن سبيل الله من حيث أردنا أن نرغب فيه، ورضي الله عن ابن مسعود حينما قال: «ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» (أخرجه مسلم في مقدمة كتابه).
إن من أسباب بروز هذه الظاهرة في واقع الدعوة اليوم: القصور في التربية وقصرها على النواحي النظرية فقط، فالداعية لم يتلق المنهج السليم للتعامل مع الآخرين من أفواه العارفين وخبرة المجربين من الدعاة الأولين والعلماء العاملين، واكتفى عن ذلك بقراءة الكتب، وكما قيل: من كان شيخه كتابه كثر خطؤه وقل صوابه. ومن أسبابها أيضًا: انشغال الداعية التام بالدعوة في صفوف التلاميذ والمبتدئين في الالتزام لمدة طويلة يكبر معها عمره وتظل عقليته محدودة، فلا يحسن أن يتعامل مع من فوقه أبدًا، وأسلوبه لا يصلح إلا لمن دونه غالبًا، فلذا تجده يتحاشى التعامل مع كبار القوم ووجهائهم ويرفض الاحتكاك بالمسئولين وكبار السن ورجال الأعمال وغيرهم، أضف إلى ذلك كله الغياب شبه التام للداعية عن المحافل العامة والمناسبات الكبيرة وعدم حضور الديوانيات وغيرها؛ مما جعل عقدة الخجل من الآخرين تكبر معه وتظل هذه النقيصة ترافقه.
إن على الدعوة الإسلامية اليوم ممثلة في الأفراد والحركات أن تسعى جادة في القضاء على هذه الظاهرة وتجعل التخلص منها في سلم أولوياتها، وألا تطلب التوسع والانتشار على حساب الأفراد وتربيتهم، وبالتالي تخرج للأمة أجيالًا هزالى في الفهم والقصور، خاطئين في العمل والتصرف، ومن ثم قاصرين في الإدارة والقيادة. كما أن على الأفراد المسئولية الأولى في إعداد النفس واستكمال فضائلها ومعرفة كيفية مخالطة الآخرين، وفن التعامل معهم كأن يتخذ الأخ صديقًا مخلصًا يدله على عيوبه ويرشده إلى الصواب عند الحاجة. كما على الداعية أن يتميز بالصبر والاتزان دائمًا، يعرف من يتعامل معه قبل أن يتلفظ بكلمة أو يبدأ بحركة أو يتخذ موقفًا، وقد يسعف الداعية في هذا الجانب بعض الكتب التربوية لمسلمين أو غيرهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها وأهلها.
الهوامش:
«1» جامع الأصول 6/ 574.
«2» جامع الأصول 6/ 573.
«3» تهذيب سيرة ابن هشام: ۲۲۷.
«4» الرحيق المختوم: 125، 126.
__________________________
رسالة مستعجلة
الرسائل كثيرة ومتنوعة، وكل رسالة لها قدرها ووزنها، أما عن رسالتي هذه فأرسلها إلى كل قلب تناسى أن له موعدًا مع الله سوف يحاسبه على ما قدم وما أخر.
أشعر بأني قلق كئيب محزون ليس على أحد، ولا عزاء على ميت، إنما هو عزاء على تلك القلوب الميتة القاسية التي بنت جدرانها بهوی تتبعه ودنيا تغويها، ولم تبن سور الخوف والرجاء الذي به تستطيع أن تجابه هذه الأهواء التي تريد أن تفتك وتفجر قلبها وتجعله شظايا متناثرة في أيدي الشياطين تتلاعب بها كيفما شاءت.
فكرت كثيرًا في وضع القلوب النائمة في أحضان الدنيا وبين أذرع الأيام، وتذكرت قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: «إن لكل أم أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا». نعم يا صاحب رسول الله، إن الإنسان يجب أن يكون من أبناء الآخرة حتى يعمل لها ويستعد للحساب.
ماهر التمار
الأحساء- الهفوف
وقفات في سورة الكهف
«الصبر على التربية»
﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا﴾ (الكهف: 69). يقول الكيلاني رحمه الله: «لا تهربوا من خشونة كلامي، فوالله ما رباني في دين الله إلا الخشن». نعم أيها الأحبة، الصبر ضياء ينير دربك إلى الله تعالى، فالنفوس جبلت على الراحة والدعة، فعندما تريد إيقاظها من سباتها ورغدتها، تمانع وتراوغ فلا بد من الصبر، وهذه حقيقة أوضحها الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام عندما قرر له هذه الحقيقة، فالتعليم والتربية قوامها الصبر ولا علم بلا صبر، بل الإيمان نصفه صبر: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67)﴾ (الكهف: 67)ولكن نفسية المتعلم وروح المريد لا تتحمل الصعاب وتصبر على الحرمات حتى تذوق طعم الإيمان، والصبر من مظاهر الرجولة والبطولة، فإن أثقال التربية وتزكية النفوس لا يطيق رفعها الضعاف والمرضى، وأنت أخي الحبيب لا بد لك من الصبر على المربي، فأنت من الرجال كما عهدناك، تقبل التوجيه وترضى به وتصبر على مشقته وصعوبته على النفس؛ إذ بدون النصيحة والمتابعة والمحاسبة لا يستطيع الإنسان بلوغ ما يريد؛ لأن المراد لا ينال غالبًا إلا بتحمل المكاره وحبس النفس عليها.
تريدين نيل المعالي رخيصة فما انقادت الآمال إلا لصابر
نعم لا تسمو النفوس إلا بالصبر، ولا تزهو القلوب إلا بالصبر، ولا يتربى الفرد إلا بالصبر ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِين﴾ (البقرة: 45)، ومن متطلبات التربية ننطلق عبر أثير الصبر.
عبد العزيز القصار
النقد الذاتي: الحلقة «3»
ليس على الإنسان أن يقول ما يريد.. بل على الإنسان أن يقول ما ينفع
في حلقتين سابقتين تناول المشاركون في النقاش الإجابة على أسئلة طرحت عليهم حول: الحركة الإسلامية ونقدها، والفرق بين النقد والنصيحة إسرارًا وإعلانًا.
وفي هذه الحلقة يتناول الأستاذ محمد سالم الراشد إجابة السؤال الثالث
المجتمع: يوجد داخل الحركة الإسلامية تيارات في «النقد الذاتي» أحدهما يرى «النقد العلني»، والآخر يرى «النقد الداخلي»، فما هي ميزات ومساوئ كل من التيارين؟
الأستاذ: محمد الراشد: من خلال اطلاعي على ما طرح في الساحة الإسلامية من نقد ذاتي لا أستطيع أن أصف ما طرح بأنه نقد ذاتي، وإنما هو طرح لآراء الجماعات والشخصيات والعاملين في الميدان الإسلامي في بعض المواقف والقضايا؛ أي لم يمارس منهجية محددة في النقد الذاتي بصورة صحيحة، فمثلًا في قضية احتلال العراق للكويت اختلفت الجماعات الإسلامية، فكان لكل جماعة موقف، وانتقد كل طرف الطرف الآخر، وكذلك الموقف من الحرب العراقية- الإيرانية، ولم أر سوى طرح مجموعة من الآراء في قضايا الخلاف، ولا تستطيع أن تستخلص رؤية واضحة أو نصيحة محددة توجه الحدث أو الموقف أو تأخذ بيد المخطئ، والنقد الذاتي في الواقع بهذه المنهجية قليل من يمارسه، وعادة ما ينتج عن ذلك النقد أو الخلاف حاجز نفسي جديد أو شرخ في العلاقات، أو أزمة ثقة بين العاملين في الحقل الإسلامي والنقد الذاتي المفترض هو أن تتحدد القضايا بدقة.
ثم يحدث الحوار، ومن خلال الحوار تتبين الحقائق وتتثبت المواقف وتحدد الأخطاء والإيجابيات، وتستخلص النتائج وتسدد مسار الجماعات وأن يحيط كل ناقد نفسه بالتقوى والحرص على الوصول إلى الحق.
وقد حدث خلاف فيما بين العاملين في الحقل الإسلامي حول مدى فائدة النقد الذاتي العلني، وقال آخرون بأن النقد الذاتي الداخلي لا ينتج عنه تصحيح للأخطاء، وقد تتباين الآراء في هذه القضية ولكن كلًّا من النقدين جائز وله دليل في الشرع، ولكن من الملاحظ أن النقد الذاتي الداخلي أقل ضررًا على الجماعة على المدى القريب، ولكنه إذا استمر بصورة غير محددة بقواعد شرعية فإنه يضر على المدى الطويل في صحة مناخ العمل الإسلامي، وقد ينتج عن ذلك بمرور الزمن قواعد عرفية تعطيها الحق للتجاوز عن أخطاء القادة في المواقف والأحداث مما يضعف ثقة القاعدة الإسلامية بالقيادة ويؤصل الخطأ بشكل منهجي.
وفي الجانب الآخر أن النقد الذاتي العلني إذا لم يكن منهجيًّا ومتحريًا الدقة والتثبت ومحاطًا بالتقوى، فإنه قد يسبب فتنة إسلامية عادة تضعف مسار الحركة الإسلامية في إصلاح المجتمع بدلًا من تطوير أدائها ودفع دورها الإصلاحي.
كما أنه على الصعيد الداخلي تصبح عمليات النقد الذاتي عملية استثنائية، وليست أساسية حيث تعطي الحركة الإسلامية في عمومها الانشغال بالواقع الخارجي على أن تحيط بأخطائها وتصحح مساراتها بصورة منهجية.
وعلى الصعيد الخارجي فإن النقد الذاتي العلني إلى الآن لم تتضح نتائجه الإيجابية بصورة مثمرة، وعادة ما يحقق الأسلوب الذي يتبع في النقد العلمي حاجزًا نفسيًّا حتى عند القاعدة الإسلامية مما يجعل صرخة الناقدين في واد يذهب أثرها وتبقى ملامتها مما يضعف على مرور الزمن السيرة العملية للنقد العلني، كما أن استفادة الخصوم من هذا النقد العلني قد ركز في العقل الباطن للقاعدة والقيادة الإسلامية أن النقد الذاتي العلني ما هو إلا أداة تنفع خصوم الحركة الإسلامية وتضر بمصلحتها.
وأود أن أعقب على سؤالكم حول أسباب توجه البعض للنقد العلني؛ وذلك فيما يلي:
أولًا: عدم وجود هيئات داخلية في الجماعات الإسلامية مهمتها النقد وتصحيح الأخطاء، وقد ترى شريحة من العاملين في الحقل الإسلامي أن القيادة تتكاثر أخطاؤها في مجالات ومواقف وأحداث تضر بمسار المجتمع أو مسار الحركة الإسلامية ذاتها، وفي نفس الوقت لا تستطيع هذه الشريحة أن تعبر عن رأيها تعبيرًا كاملًا مما يضفي على الخطأ صفة الاستمرارية دون رقابة داخلية على الخطأ.
ثانيًا: اقتصاد بعض المؤسسات والهيئات والجماعات الإسلامية لنظام مؤسسي قادر على استيعاب النقد الذاتي الداخلي مما يجعل هذه العملية خاضعة للإمكانات الذاتية للعاملين في الحقل الإسلامي؛ حيث يبرز من يملك إمكانات الحجة والبلاغة واللحن في القول على العاملين بجدية وإخلاص مما لا يعطي للعملية الفاعلية الصادقة في تعديل مسار الأخطاء والاستفادة من الإيجابيات البارزة من تفاعل حركة الإصلاح في المجتمع.
كما أن ذلك يشجع على تكدس الأخطاء دون تصحيح، مما ينذر بتفجير الأوضاع على شكل تكون تيارات وتكتلات قد تجنح نحو الحزبية أو الانفصال عن الجماعة بحجة إصلاح الأخطاء.
ثالثا: نقص الوعي والفهم في قضايا الخلاف ونظر الشريعة في هذه القضايا، فهناك الاجتهاد الحركي الذي يعتبر في المرتبة الثالثة من حيث دائرة الخلاف؛ حيث يكثر الخلاف في إطار الاجتهاد الحركي، ومنه ما يدخل في الخلاف الممدوح، ومنه ما يدخل في إطار الخلاف المذموم.
وعلى العاملين في الحركة الإسلامية أن يتعرفوا جيدًا على أصول الخلاف؛ فهناك خلاف متعلق بصلب الدين وأصله، وهناك ما هو داخل في إطار الاجتهاد الفقهي المذهبي، ويمكن إعذار القيادة في الثاني بعد مناقشة خطئها إلا أنه التالي يتوجب التفسير الأصولي عند الخطأ ومن ثم تصحيح الخطأ بصورة أصولية ومنهجية علمية.
وفي حالة الخطأ في قضايا الخلاف يتوجب على القيادة أن تعذر قاعدتها وناقديها، كما يجب على أفرادها وناقديها أن يعذروا القيادة في هذا الخطأ، إلا أنه يتوجب تصحيح الأخطاء، وعند الخلاف يرجع إلى قيم العمل الإسلامي وقواعده وأصوله التي بنى عليها قيام هذا العمل، وعلى سبيل المثال فإنه في عام ١٩٤٠ تأسست جماعة شباب سيدنا محمد بعد أن اختلفت مع حركة الإخوان بسبب الخلاف حول قضية الحكومة الإسلامية في مصر.
رابعًا: في اعتقادي أيضًا أن من أحد الأسباب هو قدرة وسائل إعلام الخصوم على إحداث اختراق من الوعي الباطن لبعض قيادات أو قواعد الحركة الإسلامية؛ مما يعيد ترتيب أفكار هؤلاء في أولويات النقد الذاتي، مما يدفع إلى تبني منهج النقد العلني دون اعتبارات للمصلحة العامة للحركة الإسلامية، وفي المقابل يقابل ذلك بالمبالاة أو عدم اهتمام من الطرف الآخر مما يعزز عملية النقد الذاتي العلني.
خامسًا: قلة فرص التدريب على الحوار والنقد الذاتي وفق منهج أصولي داخل الحركة الإسلامية، سواء بالكتابة أو الحوار المباشر؛ حيث إن التدريب على النقد الذاتي في أطر الحركة الإسلامية يساعد كثيرًا في استيعاب الأفكار وتعديل أساليب النقد الذاتي، ويحدد نتائج قيمة لتطوير العمل وأساليب وسبل إصلاح حركة العمل الإسلامي في المجتمع.
سادسًا: ندرة الكتابات التي تؤصل منهجية النقد الذاتي والحوار والخلاف بين فصائل الحركة الإسلامية مما يعطي شعورًا عامًّا عند قواعد الحركة الإسلامية بعدم أهمية هذا النهج في إصلاح الحركة الإسلامية، كما أنه يساعد ذلك في تجهيل قواعد الحركة الإسلامية في أسلوب النقد، فإما أن يكون النقد غوغائيًّا وغير هادف ويصب في مصلحة أعداء الإسلام، أو التغيب الكامل عن إحداث إصلاح عن طريق النقد الذاتي وإعطاء منهجية الحركة الإسلامية قدسية غير شرعية.
المجتمع: هل النقد العلني أولى أم لا؟
الراشد: أعتقد أن ذلك محكوم بعدة قواعد منها:
أولًا: مقدار المصلحة والمفسدة.
أعتقد أن النقد العلني له فوائد وأيضًا يجني أضرارًا على الحركة الإسلامية، وهذا محكوم بمقدار المصلحة والضرر الناتج عنه. فإذا كان هناك خطأ عام وواضح ويمس قطاعًا من المسلمين ويسبب مضارًّا واضحة لمسار الحركة الإسلامية ولم تقم أساسًا الحركة الإسلامية بإصلاح هذا الخطأ، فإنه يتوجب على الإنسان أن يقدم النصيحة وفق قواعدها الشرعية؛ حيث إن نصيحة أمراء العدل تختلف عن نصيحة أمراء الجور.. أما إذا كان الخطأ داخل الحركة في نظمها وأساليبها وغير ذلك مما يمس كينونة الحركة الإسلامية، فمن المصلحة أن يكون النقد الذاتي من الداخل، والله أعلم بالصواب.
ثانيًا: التثبت ووضوح الأدلة؛ حيث إن النقد الذاتي هو ملخص لحكم في قضية معينة، ولهذا يتوجب إسناد الأدلة من الرواة الثقات مع التفحص الطبيعة الدليل وترابط الأدلة بعضها ببعض، فكم عانت الحركة الإسلامية من الروايات الخاطئة والنقول غير الموثقة «وآفة الأخبار رواتها» والتسرع في إصدار الأحكام أصبحت سمة بارزة في قيادات الحركة الإسلامية عدا أفرادها وأحداثها، ولو رجعنا إلى التاريخ الإسلامي لرأينا العجب العجاب مما يبين أن ليس كل مستور من العقول أو الفعل صحيح.
كما أن تصحيح الخطأ قد يكون بعد مدة ويظل الناقدون ينقدون هذا الخطأ كما حدث في تصحيح سيد قطب رحمه الله لقضية المنهج في الصفات في سورة الأعراف.
أو يؤخذ رأي الثقة أنه رأي لا جدال فيه علمًا قد يكون العلم الذي وصل إليه غير مكتمل، فيحكم هذا الثقة بما لديه من أدلة، وقد يكون غاب عنه أدلة أخرى، وقد أفرد الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابًا في هذه القضية لعلاج الجدل الثائر حول خلاف الأئمة رضوان الله عليهم.
ثالثًا: الأهلية: وأقصد بالأهلية هو أن يملك الناقد الذي ينقد ذاته وجماعته وإخوانه في الميدان رصيدًا من العلم الشرعي ورصيدًا من الحجة والمنطق، وقدرًا كافيًا من المعلومات والأدلة الموثقة، كما أنه يملك رصيدًا هامًّا من الخلق الإسلامي عند ثورة الغضب الهاجم عند الخلاف، فقد يضر بقلمه ولهجته أو قد ينتاب قلمه أو لسان نصحه الأدب الشرعي في النصح، مما يفضي لخصومة لا يقصدها، وأن يملك الناقد أيضًا إلمامًا ووعيًا بواقعه والمتغيرات التي تحيط بالعمل الإسلامي، فالتجربة والممارسة تصقلان رأي الناقد وترشد نصحه ونقده.
القاعدة الرابعة: من يقدر المصلحة: في اعتقادي أن من يقدر المصلحة هو الشخص نفسه الذي يقوم بعملية النقد الذاتي، وللآخرين نقده إن شاءوا في ذلك، فالعامل في ميدان الحركة الإسلامية والذي تفحص فيها وعمل بها وأخلص العمل لله وجاهد فيها فله جهاد آخر في إصلاح دعوته وترشيد مسارها، وليس لأحد أن يمنعه من أن يسدد مسار العمل الإسلامي، وكما أنه سيجني أجر النقد الحسن فإنه أيضًا سيكون مسئولًا عما سيصيب الحركة الإسلامية من ضرر عدا أنه اجتهاد في النصح.
وليس على الإنسان أن يقول ما يريد؛ بل على الإنسان أن يقول ما ينفع، وكذلك على الحركة الإسلامية أن ترضى بالعاملين في وسطها نصحاء ومرشدين لها، فإن لم يكونوا هم فمن يكون إذن؟! وعلى الجماعات الإسلامية أن تفاعل هذا النوع من النشاط الحركي في أوساطها حتى لا يصبح العاملون فيها مجرد منفذين دون وعي.
القاعدة الخامسة: تفهم وضعية وقانونية الجماعات الإسلامية في المجتمعات المدنية الحديثة، وبالخصوص التي لا تتيح للحركات الإسلامية حرية الرأي والقول، فقد يكون ذلك عاملًا مباشرًا في صيانة النشاط الداخلي لتلك الجماعات مما يقلل فرص النقد الذاتي داخلها.
القاعدة السادسة: حصول النتيجة «فاعلية النقد» فإنه من المأمول أن يحدث النقد الذاتي نتيجة وهو الهدف المقصود من النقد الذاتي؛ حيث يحدث حوارًا صحيًّا داخل أطر الحركة الإسلامية يتولد عنها رغبات صادقة في الإصلاح، وحين يتحول النقد الذاتي إلى صراع لإثبات الخطأ وتحقيق الذات لكلا الطرفين، فإن العملية تتحول إلى مراء وجدال، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدال والمراء ولو كان محقًّا، فنحن من خلال النقد الذاتي علينا أن نضع الحركة الإسلامية في إطار صحيح من العمل.
في المقابل من يقوم بالنقد الذاتي عليه أن يكون فعالًا في مناشط العمل الإسلامي ويتحمل تكاليفه ويتصبر على الجهاد فيه، ویکسر هوى نفسه لإصلاح مجتمعه الحركي والخارجي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل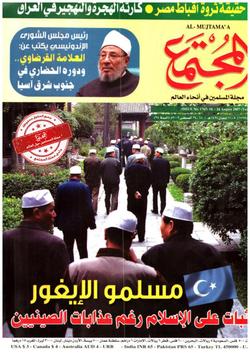
عبدالعالـي حسانـي: «مجتمع السلم» تتبنى مشروع الوحدة بين أبناء الحركة الإسلامية كافة بالجزائر
نشر في العدد 2182
32
الثلاثاء 01-أغسطس-2023