التشريك بين الإعراب والحكم.. «واو العطف» والقول بعدم وجوب الزكاة على الصبي
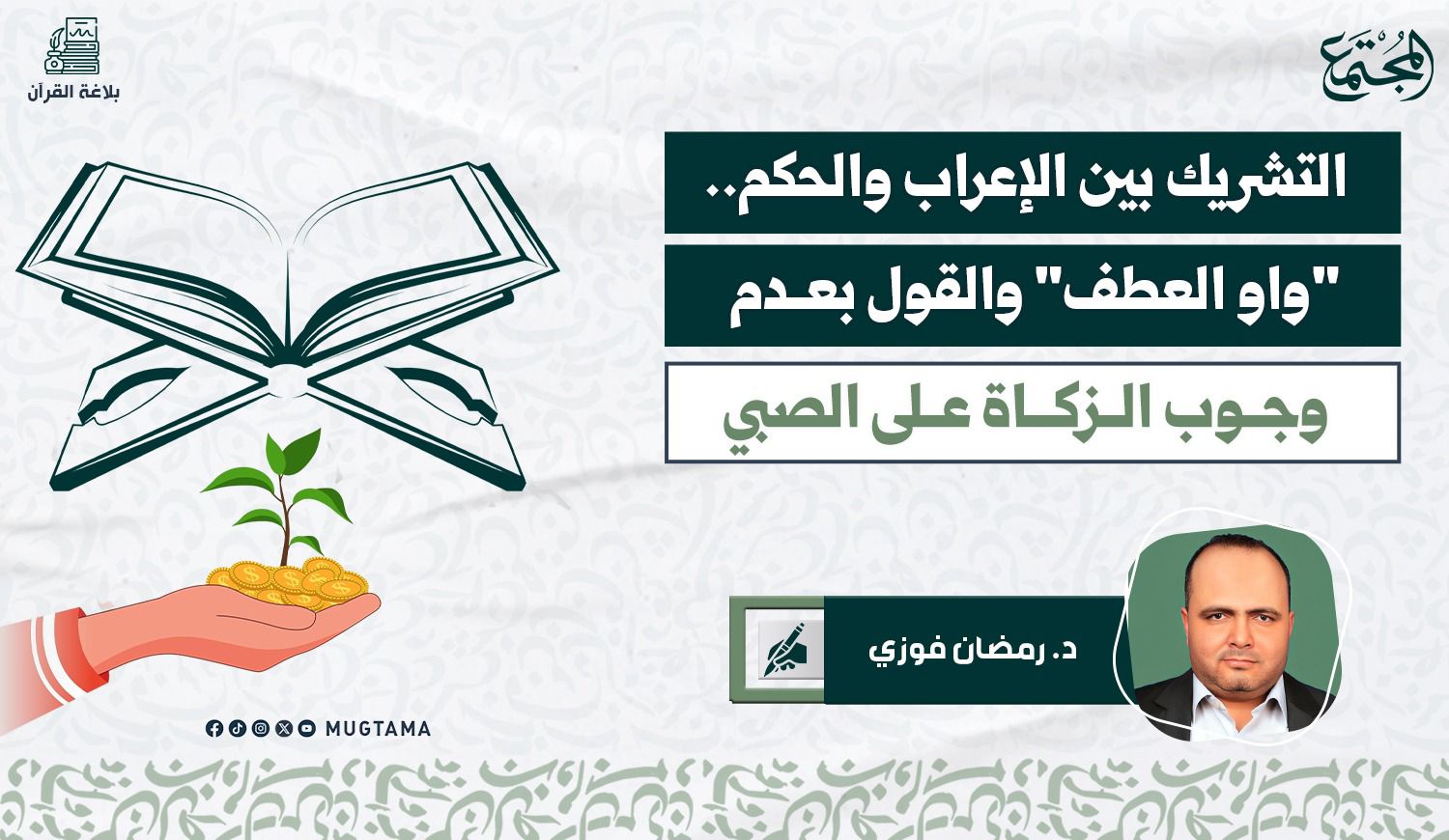
يُعدُّ «التشريك»
أو «الإشراك» من المعاني التي ذكرها النحاة لبعض حروف العطف، ومنها حرف «الواو»، ويُقصد
به إشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الإعراب أولاً، ومن ثَمَّ إشراكه في المعنى
والحكم.
وقد أكد عبدالقاهر
الجرجاني هذا المفهوم بقوله: «معلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يُشْرِكَ الثاني
في إعراب الأول، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب» (دلائل
الإعجاز، ص 222).
أقسام «الواو» من حيث التشريك
التشريك في
المعنى ليس مطَّرداً في كل حالات العطف بالواو؛ فقد قسَّم النحاة الواو من حيث
التشريك إلى أربعة أقسام؛ قسمين في عطف المفرد، وقسمين في عطف الجمل، على النحو
التالي:
أولاً: في عطف المفردات:
يمكن تقسيم
الواو في عطف المفرد إلى نوعين:
1- الجامعة
المشركة: وهي الأكثر؛ حيث يصح إسناد الفعل لكل من المعطوف والمعطوف عليه بمفرده، مثال:
«قَامَ زيد وَعَمْرو»؛ لأنك لو قلت: «قَامَ زيد وَقَامَ عَمْرو» جاز، فشركت بالواو
بينهما في إسناد الفعل إليهما.
2- الجامعة غير
المشركة: وهي التي لا يصح فيها إسناد الفعل لكل من المعطوف والمعطوف عليه بمفرده؛
لأن الفعل لا يكون إلا للاثنين، مثال: «اخْتصم زيد وَعَمْرو»، إذ لو قلت: «اخْتصم
زيد واختصم عَمْرو» لم يَصح، وكذلك: «هَذَانِ زيد وَعَمْرو»؛ لأنه لا يخبر عن
الاثنين بواحد. (الفصول المفيدة في الواو المزيدة، ص 56).
ثانياً: في عطف الجمل:
وفي العطف في
الجمل جعلها الجرجاني على ضربين:
1- الجمل
العاطفة التي لها محل من الإعراب: وهذه تشرك الجملة الثانية في حكم الأولى، وتجري
مجرى عطف المفرد على المفرد.
2- الجمل
العاطفة التي لا محل لها من الإعراب: وهي التي أثارت إشكالاً عند اللغويين، كقولك:
«زيد قائم وعمرو قاعد»؛ حيث لا يمكن الادعاء بأن الواو أشركت الثانية في إعراب قد
وجب للأولى؛ إذ لا يوجد هنا أمر معقول يُؤتى بالعاطف ليُشرك بين الأولى والثانية
فيه.
والذي يُشكل
أمره هو الضرب الثاني، وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة
أخرى، كقولك: «زيد قائم وعمرو قاعد»، و«العلم حسن والجهل قبيح»، لا سبيل لنا أن
ندّعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه، وإذا كان
كذلك فينبغي أن تعلم المطلوبَ من هذا العطف والمغزى منه، ولمَ لم تستوِ الحال بين
أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: «زيد قائم، عمرو قاعد»، بعد ألا يكون هنا أمر
معقول يُؤتى بالعاطف ليُشرك بين الأولى والثانية فيه؟ (دلائل الإعجاز، ص 222،
223).
ثم يفسر سبب هذا
الإشكال قائلاً: «واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في «الواو» دون غيرها من حروف
العطف، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني.. وليس للواو معنى سوى الإشراك في
الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأول.. فإذا كان ذلك كذلك، ولم
يكن معنا في قولنا: «زيد قائم وعمرو قاعد» معنى تزعم أن «الواو» أشركت بين هاتين
الجملتين فيه، ثبت إشكال المسألة» (دلائل الإعجاز، ص 222، 223).
التطبيق الأصولي والفقهي.. القِران في اللفظ يوجب القِران في الحكم
انتقل مبدأ «التشريك»
من ساحة اللغة والنحو إلى علم أصول الفقه، ليُطرح التساؤل: هل القِران في اللفظ
يوجب القِران في الحكم؟
أجاب السمرقندي
بأن «عامة أهل الأصول قالوا: لا يوجب، وقال بعض الفقهاء: إنه يوجب» (ميزان الأصول
في نتائج العقول، ص 415).
ومثل لهذا الأمر
قائلاً: وصورة هذه المسألة أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين كل جملة
مبتدأ وخبر، فالجملة المعطوفة هل تشارك الجملة المعطوف عليها في الحكم المنوط بها؟
فأجمعوا أن المعطوف إذا كان ناقصاً بأن لم يذكر فيه الخبر، فإنه يشارك المعطوف
عليه في خبره ويشاركه في حكمه كقوله: «زينب طالق وعمرة»، فإن قوله و«عمرة» يشارك
زينب في وقوع الطلاق، وقد عللوا هذه المشاركة بكون الثاني (عمرة) ناقصاً لا يفيد
لنفسه دون المشاركة في خبر الأول، وقد نقلت هذه المشاركة بواسطة حرف المعنى «و».
(ميزان الأصول في نتائج العقول، ص 415).
القِران بين الصلاة والزكاة وإسقاط الزكاة عن الصبي
أحد أبرز
التطبيقات الفقهية المبنية على القول بأن «القِران في اللفظ يوجب القِران في الحكم»
إسقاط وجوب الزكاة عن الصبي غير البالغ.
استدل بعض
الفقهاء على ذلك بآية: (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) (البقرة: 43)، وبما أن الواو تفيد
التشريك بين الجملتين، والصبي غير مخاطب بالصلاة لعدم بلوغه، فيجب ألا يكون
مخاطبًا بالزكاة أيضًا للقران بينهما.
نقل الإمام
الشافعي هذا الرأي (وإن كان قد رجح الرأي الآخر القائل بوجوب الزكاة عليه)، حيث
يقول: «وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذَا كَانَتْ لِيَتِيمٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ؛
فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،
وَذَهَبَ إلَى أَنَّ فَرْضَ الزَّكَاةِ إنَّمَا هُوَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَقَالَ: كَيْف يَكُونُ عَلَى يَتِيمٍ صَغِيرٍ فَرْضُ الزَّكَاةِ،
وَالصَّلَاةُ عَنْهُ سَاقِطَةٌ..» (الأم: 2/ 30).
وكذلك نقله
السمرقندي مؤكداً الدليل اللغوي: «وعلى هذا الأصل –يقصد القِران في اللفظ يوجب
القِران في الحكم- تعلق بعض الفقهاء في نفي وجوب الزكاة على الصبي بقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ) لقد عطفت الزكاة على الصلاة؛ لذلك يجب أن تشاركها، فلا تجب
الصلاة عليه وكذا الزكاة، تحقيقاً للمشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه، وقد تمسك
الفقهاء في هذا التعليل بأن «الواو» للعطف لغة ولهذا تسمى واو العطف عند أهل
اللغة، ومقتضى العطف هو الشركة في الخبر» (ميزان الأصول، ص 415).
ومن الفقهاء من
نقل الرأي القائل بعدم وجوب الزكاة على الصبي دون الإشارة لهذا الدليل اللغوي،
واكتفى بنسبة الرأي لصاحبه فقط، ومن هذا ما ذكره ابن حزم في المحلى: «وأما إبراهيم
النخعي، وشريح، فقالا: لا زكاة في ماله جملة» (المحلى، 4/8)، ونقله القاسم بن سلام
عن الحسن؛ حيث قال: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، إِلَّا فِي زَرْعٍ
أَوْ ضَرْعٍ» (كتاب الأموال، ص 551).
مظاهر التيسير في القول بعدم وجوب الزكاة على الصبي
على الرغم من أن
الرأي القائل بعدم وجوب الزكاة على الصبي يُعدُّ مرجوحاً عند جمهور الفقهاء الذين
يرون وجوبها في ماله كالبالغين، فإنه يظل خلافاً معتبراً يُحقق جانباً من التيسير
في أحوال معينة؛ مثل:
- التيسير على القائم على أمر الصبي أو اليتيم بعدم تكليفه بأداء الزكاة -التي تعد عبادة ولا تخلو من بعض المشقة- عن غيره بالإضافة لأدائها عن نفسه هو.
- هذا الحكم فيه
حفظ لمال الصبي أو اليتيم؛ فقد يكون القائم عليهما غير قادر على تنمية أموالهما
واستثمارها، ومن ثم تكون عرضة للنفاد والهلاك من خلال إخراج الزكاة منها كل عام
دون تنميتها؛ ففيه تيسير عليه (القائم على أمر اليتيم) من جانب آخر وهو عدم إلزامه
واضطراره لاستثمار الأموال وتنميتها؛ وهو ما لا يخلو من المشقة.
اقرأ أيضاً:
- عطف الجمل المتباينة وحكم الأكل من متروك التسمية
- الفصل بين المتعاطفين وحكم غسل الرجلين
















