سطوة الاستشراق على العقل الأدبي العربيّ
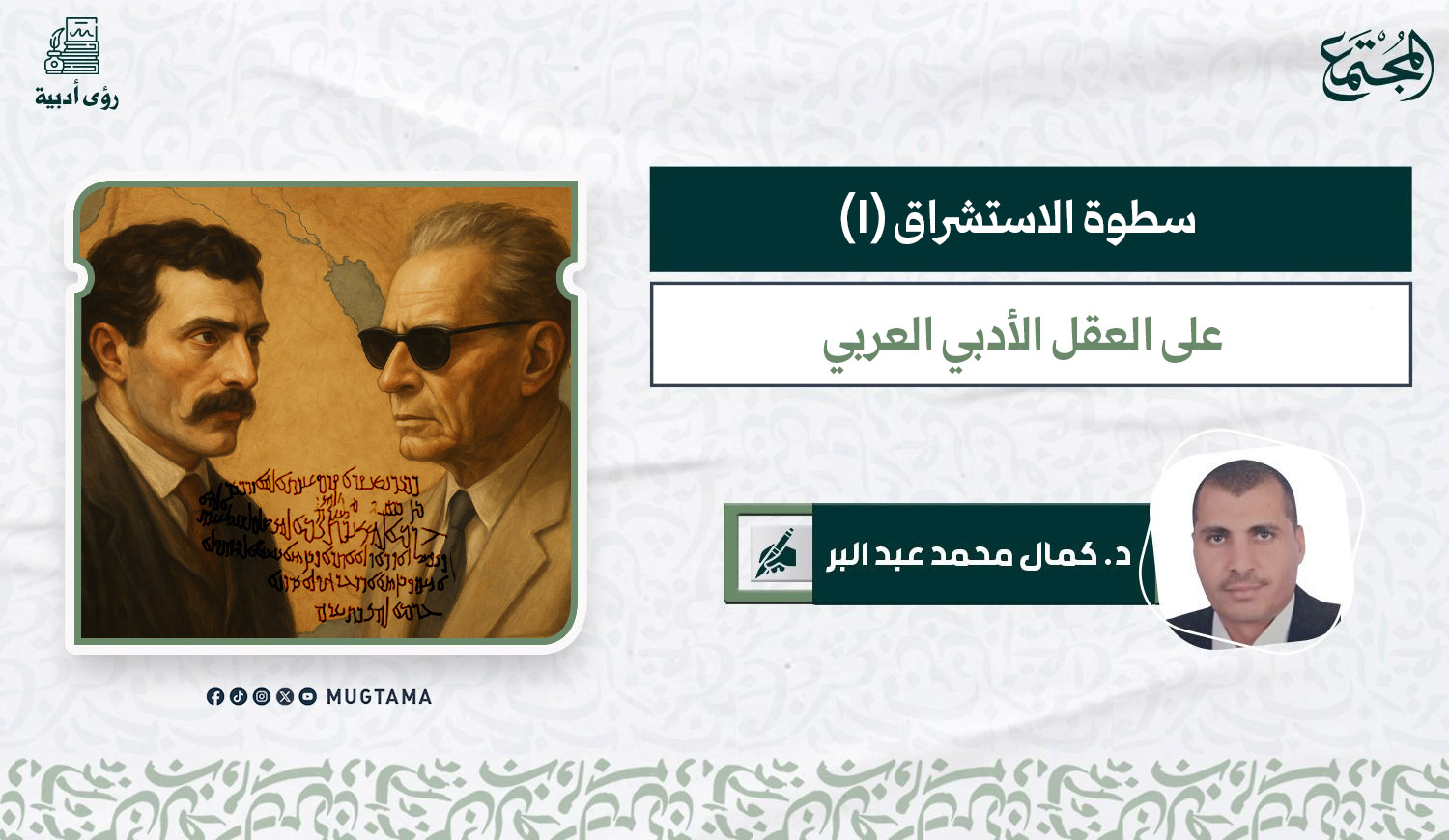
الشرق في مرآة مُضلِّلة
لسنا في سياق الحديث عن نشأة حركة الاستشراق، ومدارسه وبواعثه سواء أكانت مغرضةً أم منصفةً؛ ففي الكتب التي أرخت لحركة الاستشراق ما يغني عن هذه التفاصيل، ويكفي أن نعلم أن الاستشراق قد وضع – كما يقول إدوارد سعيد – "كلّ ما هو شرقي في قاعة الدرس، أو في المحكمة، أو في السجن أو في الدليل المصوّر، بـهدف الفحص الدقيق أو الدرس، أو إصدار الأحكام، أو التأديب" (الاستشراق: 97).
ومعنى ذلك أن حركة الاستشراق قد درست كلّ ما يتصل بالشرق: علومه ومعارفه، وآدابـه وفنونه، ولغاته وأجناسه، وعاداته وتقاليده، ونظمه ومجتمعاته، ثمّ رسمت صورةً عامةً عن الشّرق كي تقدّمها لشعوب أوروبّا وملوكها، ولـم تكن تلك الصورة حقيقيةً أو دقيقةً، وإنما كانت ضبابيةً أو زائفةً إلا قليلًا، مما كتبه بعض المستشرقين المنصفين عن الشرق؛ ذلك أن المستشرقين قد حرصوا على إظهار أوربّا في صورة القويّ المنتصر، وإظهار آسيا (ممثلة الشرق) في صورة الضّعيف المهزوم، كما حرصوا على تصوير الشرق نذير خطرٍ ومبعث خوفٍ ورعبٍ دائمين لأوروبا والغرب. (الاستشراق: 120).
شبهات الاستشراق بـين الوضوح والـخفاء
إذا أغضينا الطرف عن تلك الصّورة العامة التي رسمها الاستشراق للشرق وما شابـها من زيفٍ أو غموضٍ؛ فإن عناية المستشرقين بعلوم العرب (ترجـمةً وتحقيقًا ودراسةً) ليست موضع جدالٍ أو مراءٍ، وقد تمخضت تلك العناية عن كتاباتٍ وافرةٍ في فروع الثقافة العربية المختلفة: العقيدة، والتفسير، والحديث، والسيرة والتاريخ الإسلامي، وعلوم اللغة والأدب. ولـم تخل تلك الكتابات من أخطاءٍ وشبهاتٍ جليةٍ واضحةٍ، دعت أبناء الثقافة العربية إلى مراجعتها وتفنيدها؛ مما أنتج (ثقافةً مضادةً) تقاوم ذلك الغزو الفكريّ والمعرفيّ الزاحف على الثقافة العربيّة؛ وكتاب الشّيخ محمّد الغزالي (دفاع عن العقيدة والشريعة ضدّ مطاعن المستشرقين) من أهمّ الكتب التي أُلِّفت لـهذه الغايـة، بل إنَّ ما كتب من دراساتٍ وبحوثٍ عن شبهات المستشرقين ومَنْ تأثّـَر بـهم من بني جلدتنا في مجال الدراسات القرآنية وحدها كثيرٌ جدًّا، ويكاد يـندُّ عن الحصر، وليس يخفى أن الشبهات الجلية الواضحة ولا سيّما ما يتصل منها بالشريعة الإسلامية وعلومها كانت تستدعي استجابةً سريعةً للردِّ عليها وتـفنيدها؛ يحدوها حرصٌ على الشريعة ونقائها، واستشعارٌ لواجبٍ ديني يقتضي المبادرة والتصدّي لكلّ عدوانٍ معرفيٍّ أو غيـر معرفي.
خطورة الشّبهات الـخفيّة
وإنّما تعظم البليّة حين تخفى الشبهة أو تكون غير مباشرةٍ، بمعنى ألّا يقولـها المستشرق صراحةً؛ وإنّما يضع أساسها، ثمَّ يتلقّفها تلميذٌ عربـيٌّ من تلاميذه فيصوغها صياغةً جديدةً تـُخفي معالـمها، وقد يصوّرها دفاعًا عن ثقافتنا وحضارتنا، ومن ثَمَّ يدبُّ أثرها خفيًّا في أوصال الثقافة العربية دبيب سموم الأفاعي؛ لأن الشبهة قد قيلت بلسانٍ عربيٍّ، وطَرَحَها عربي مسلمٌ فلا يتطرَّق الشَّكُّ إلى غاياته ومقاصده؛ وبخاصَّةٍ إذا كان ذا شهرةٍ وسطوةٍ معرفيَّةٍ.
وقد تكون شبهات المستشرقين أكثر خفاءً في ميدان الأدب والنقد؛ لأن موضوعات الأدب العربي لا تتصل في الغالب بأحكام الحلال والحرام، ولا تؤخذ بالحذر أو الحيطة التي تؤخذ بـهما موضوعات الشّريعة الإسلامية وأحكامها؛ ومن ثَمَّ تجد نـقَّاد الأدب يستسهلون ولا يكترثون اكتراث علماء الدِّين، وقد تغريـهم مقولات المستشرقين، فيُرَدِّدونـها غير متحرِّجين أو متأثِّمين؛ وبخاصةٍ حين تبدو تلك المقولات جديدةً أو غير تقليديّـةٍ! ولكلّ جديدٍ رونقٌ وسحرٌ خالبٌ، وقد ينطلي بريق المقولات الاستشراقية على بعض الكتَّاب والأدباء، فتتسرَّب إلى كتاباتـهم، وينقلها كاتبٌ عن آخر دون مراجعةٍ وتـقويمٍ؛ أو دون التفاتٍ إلى خَبْئِهَا، وما قد يكون فيها من وجهٍ تخريبيٍّ، وذلك ما عنيته بسطوة تلك المقولات، وسلطانـها المعرفـيّ!
معركـة الشّعر الـجاهلـيّ نـموذجًًا
إذا أردنا أن نـقدّم نموذجًا واضحًا لتلك السّطوة المعرفيّة وسلطانـها القاهر؛ ففي (معركة الشِّعر الجاهليِّ) التي ابتعثها د. طه حسينٍ من مرقدها خير مثالٍ؛ فما كان العقل العربيُّ يكترث بقضيَّة الانتحال في الشّعر الجاهليّ أو يعطيها أكبـر من حجمها؛ لأنَّـه يعلم أنَّ الانتحال والكذب من طبائع بعض البشر في كلِّ عصرٍ ومِصْرٍ؛ وإذا كان رسول الله ﷺ، قد كُذِبَ عليه، ووُضِعَتْ على لسانه أحاديثُ لـم يقلها؛ أيستبعد العقل العربيّ أن يُوضع الشِّعر ويُنسب لشعراء الجاهليّة أو حتّى شعراء الإسلام؟! ألـم يقل ابن سلَّامٍ الجُمَحيِّ خلال حديثه عن شعراء المدينة: "أشعرهم حسَّان بن ثابتٍ، وهو كثير الشِّعر جيِّده، وقد حـمل عليه ما لـم يـحمل علىٰ أحدٍ، لـمّا تعاضهت قـريشٌ واستبّت وضعوا عليه أشعارًا كثيرةً لا تـُنـَقّىٰ". (طبقات فحول الشعراء: 1/ 126)؟!
وتلفتنا مقولة ابن سلامٍ السابقة إلى وعيٍ باكـرٍ في الثقافـة العربيّة بقضيّة (الانتحال في الشّعر الجاهليّ)، فقد قال ابن سلامٍ في موضعٍ آخر من طبقاته: "وفي الشّعر مصنوعٌ مفتعلٌ موضوعٌ كثيرٌ لا خير فيه، ولا حُجّة في عربيّةٍ، ولا أدبٌ يستفاد، ولا معنًىٰ يُستخرج، ولا مَثَلٌ يُضرب، ولا مديحٌ رائعٌ، ولا هجاءٌ مقذعٌ، ولا فخرٌ معجبٌ، ولا نسيبٌ مستطرفٌ، وقد تداوله قومٌ من كتابٍ إلىٰ كتابٍ، لـم يأخذوه عن أهل البادية، ولـم يعرضوه علىٰ العلماء، وليس لأحدٍ - إذا أجـمع أهل العلم والرواية الصّحيحة علىٰ إبطال شيءٍ منه - أن يقبل من صحيفةٍ، ولا يـروي عن صُحُفيٍّ"(طبقات فحول الشعراء: 1/ 4).
ومعنى كلامِ ابن سلامٍ أنّ فكرة الانتحال قديمةٌ معروفـةٌ؛ فما الّذي جَدَّ – إذن – حتّى تتحوّل على يـد د. طه حسين وقلمه إلى معركةٍ تشغل الرأي العامَّ، ويسيل فيها مدادٌ كثيرٌ؟!
الجديد هو (سطوة الاستشراق)؛ أو تناول قضيّة الانتحال وفـق رؤية المستشرقين ومقولاتـهم التي بالغت فوصفت الشِّعر الجاهليَّ كلَّه بأنّـَه مُنْتَحَلٌ؛ ولقد تناول الأستاذ الرافعيّ – قبل د. طه حسين - قضية الانتحال واستقصاها في كتابه "تاريخ آداب العرب" الّذي نشره في سنة 1911م؛ قبل الدّكتور طه بخمسة عشر عامًا؛ حيث نَشَرَ د. طـه كتابه (في الشّعر الجاهليّ) سنة 1927م. ولـم يثر الأستاذ الرّافعيّ الضجّة التي أثارها د. طه حسين؛ لأنّ الرافعيّ قد اختطّ لنفسه منهجًا صار عليه والتزمه في اعتدالٍ؛ فضرب - كما يقول - صفحًا عن الروايات الضّعيفة، والمبالغات السّخيفة، وبالغ في التّثبّت والتحقيق، وتجريح النقلة والرّواة مقتصدًا في الثّقة بـهم، معتدلًا في التهمة لـهم (تاريخ آداب العرب: 1/ 30).
أمّا د. طه حسين فقد حلب في آنية المستشرقين الذين سبقوه ولا سيّما مرجليوث؛ إذ يـرىٰ د. عبد الرحـمن بدويّ أنّ موضوع صحّة الشّعر الجاهليّ قد شغل الباحثين الأوربّيين منذ سنة 1861م علىٰ أقلّ تقديرٍ؛ لأنّه تصوّر أنّ المستشرق الألـمانيّ تيودور نُولْدِكَه أوّل الباحثين المحدثين الّذين أثاروا موضوع انتحال الشّعر الجاهليّ. والحقّ أنّ المستشرق الفرنسيّ سِلْفِسْتَر دِي سَاسِي (ت: 1838م) كان أوّل من اهتمّ بـهذه المشكلة؛ إذ نشر في عام 1826م كتابًا موسعًا، بعنوانٍ عربيٍّ: (كتاب الأنيس المفيد للطّالب المستفيد وجامع الشّذور من المنظوم والمنثور)، ضمن سلسلةٍ تتضمّن دراساتٍ وتحقيقاتٍ وترجـماتٍ لنصوصٍ عربيّةٍ متنوّعّةٍ، مثل: لاميّة العرب للشّنفرى، فضلًا عن قصيدتين للنّابغة والأعشىٰ ميمون بن قيسٍ، وكان ممّا لحظه علىٰ هذه القصائد: التّنبيه علىٰ الإشكالات الّتي تثيرها مصادرها الشّفاهيّة الأصليّة، مثل: الأصالة واختلاف الروايات.
وتطرّق إلىٰ الموضوع ذاته مستشرقون آخرون مثل: نُولْدِكَه وآلْڤِرْتُ، وتناولـه المستشرق الشّهير أَجنتِس جُولْدِتسِيهَر؛ لكنّه لـم يزد علىٰ ما جاء به نُولْدِكَه وآلْڤِرْتُ شيئًا يذكر.. وأخيرًا خَطَا البحث خطوةً جبّارةً بمقالٍ كتبه ديڤد صَمويل مَرجِلْيُوث في عدد يوليو سنة 1925م من مجلّة (الجمعيّة الآسيويّة الملكيّة)، استغلّ فيه نتائج النقوش الحميريّة والعربية الجنوبية، وركّز خصوصًا علىٰ الدوافع الدّينيّة في انتحال الشّعر الجاهليّ والتغيير في روايته زيادةً أو نقصًا أو تحريفًا. وقد ردّ عليه برونليش في السّنة التّالية (1926م). [دراسات المستشرقين حول صحة الشّعر الجاهليّ: 12، 13].
وليست مشكلة د.طه حسين في أنّه تناول الانتحال في الشّعر الجاهليّ؛ فقد سبقه إليها العرب والعجم قدماء ومحدثين كما ذكرنا؛ وإنّما مشكلته في المنهج أو الرؤية الّتي تناول بـها القضية؛ إذ يشتطّ د. طـه في الشّكّ في الشّعر الجاهليّ فيقول - سالكًا سبيل مرجليوث في الاستنباط -: "فأوّل شيءٍ أفجؤك به في هذا الحديث هو أنّي شككت في قيمة الشّعر الجاهليّ وألححت في الشّكّ أو قل ألحّ عليّ الشّكّ فأخذت أبحث وأفكّر وأقـرأ وأتدبّر حتّىٰ انتهىٰ بي هذا كلّه إلىٰ شيءٍ إلّا يكن يقينًا فهو قريبٌ من اليقين. ذلك أنّ الكثرة المطلقة ممّا نسمّيه أدبًا جاهليًّا ليست من الجاهليّة في شيءٍ، وإنّما هي منحولةٌ بعد ظهور الإسلام، فهي إسلاميّةٌ تمثّل حياة المسلمين وميولـهم وأهواءهم أكثر ممّا تمثّل حياة الجاهليّين ولا أكاد أشكّ في أنّ ما بـقي من الأدب الجاهليّ الصّحيح قليلٌ جدًّا لا يمثّل شيئًا ولا يدلّ علىٰ شيءٍ، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصّورة الأدبية الصّحيحة لـهذا العصر الجاهليّ. وأنا أقدّر النتائج الخطيرة لـهذه النظريّة، ولكنّي مع ذلك لا أتـردّد في إثباتـها وإذاعتها" (د. طه حسين: في الأدب الجاهليّ).
هذه مقولةٌ واحدةٌ من مقولات د. طه حسين عن الشّعر الجاهليّ، ونلحظ فيه إلىٰ أيّ مدًىٰ يشتطّ د. طه كي يسقط الشّعر الجاهليّ من حساب التّاريخ بوصفه أثـرًا صادرًا عن ذلك العصر، وقد اشتطّ كذلك في الحملة علىٰ أنصار القديم وسلقهم بلسانٍ حادٍّ فرماهم بالجمود والغفلة عن الاجتهاد، لا يستثني منهم سوىٰ الأستاذ الرّافعيّ، ويثني علىٰ تناوله أثـر القصص في نحل الشّعر.
وقـد تجلّت سطوة هذا التّناول الاستشراقيّ في موقف الدّرس الأدبيّ من قضيّة الانتحال، فبعد أن كان دارسو الأدب الجاهليّ يمرون بـها مرورًا عابرًا، ولا يعطونـها أكبـر من حجمها، فـرضت تلك القضيّة سلطانـها على كلّ كتابٍ معاصرٍ يؤرّخ للشّعر الـجاهلّـيّ؛ إذ يستشعر مؤلّفه الحرج؛ إن لـم يتوقّف أمام قضيّة الانتحال ومعركة د. طه حسين، أو يـفرد لـها مبحثًا خاصًّا من كتابه!! .. وللحديث بـقيّةٌ.
اقرأ أيضًا
رؤية المستشرقين لرحلة الإسراء والمعراج وتأثيرها في الفكر العربي
المستشرقون.. والدعوة إلى العامية
ثورة الاتصال.. هل توفر فرصة لعودة الحضارة الإسلامية؟!

















