علماء وفقهاء ومفكرون.. هؤلاء تحدوا الإعاقة
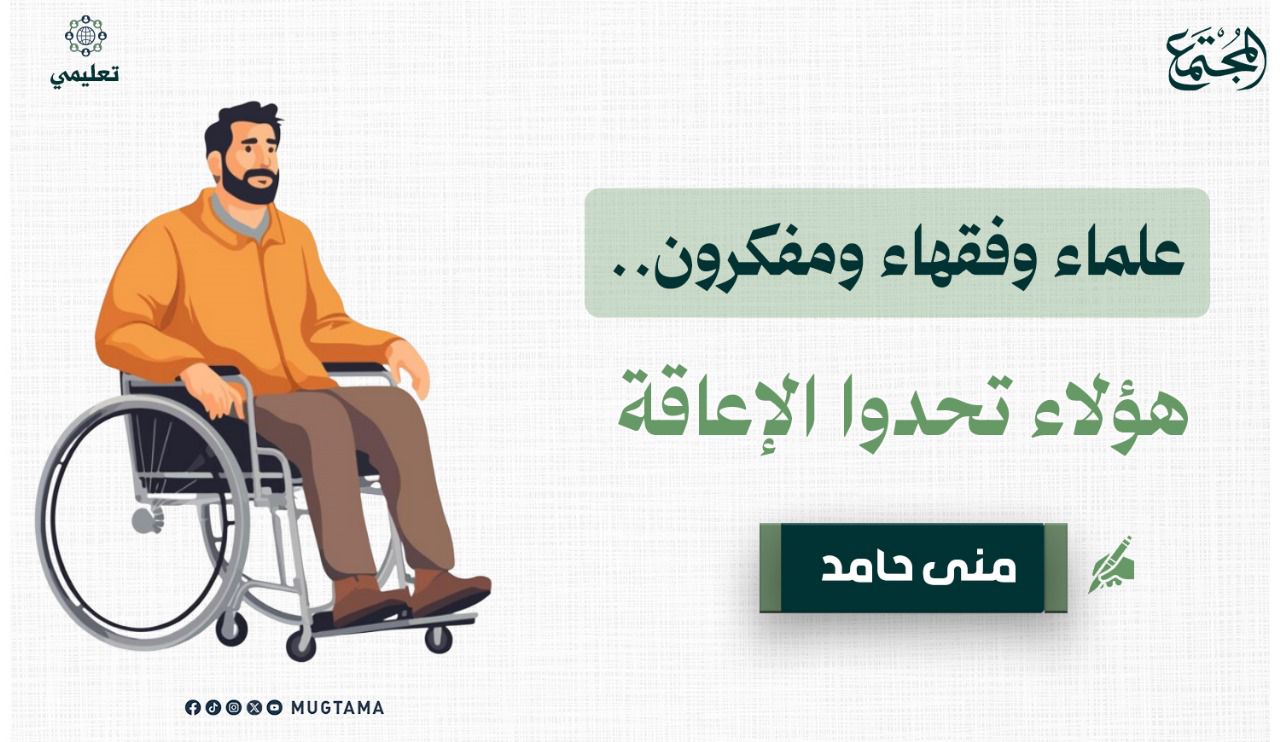
في رحاب تاريخنا الإسلامي الممتد، برزت
أسماء لامعة من علماء وفقهاء ومفكرين تحدوا إعاقاتهم الجسدية ليتركوا بصمات خالدة
في ميادين المعرفة والعلوم، ولم تكن إعاقاتهم يوماً نقصاً في قيمتهم الإنسانية، بل
كانت برهاناً عملياً على قوة الإرادة وسمو الهمة وعلامة لحكمة الله في خلقه،
وتجسيداً لقيم الإسلام التي تكرم الإنسان لروحه وعقله قبل جسده.
امتلأ تراثنا بقصص هؤلاء الذي أصَّلوا
لقاعدة القرآن في تكريم الإنسان؛ (وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (الإسراء: 70)، فلا تمييز بين سليم الجسد وغيره،
وهو تكريم يفتح باب المشاركة لا العزل، ويعضده ميزان نبوي يقطع مع ثقافة المظهر: «إن
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (صحيح مسلم،
2564).
وكان عبدالله بن أم مكتوم، الصحابي
الأعمى، أبرز من حفظ لهم التاريخ أدواراً خالدة في تاريخنا، فكان مؤذناً للنبي صلى
الله عليه وسلم، ومستخلفاً على المدينة مراراً، وحاضراً في لحظة «عبس» القرآنية
التي رفعت شأن طالب العلم ولو كان ضعيفاً في النظرة الاجتماعية التقليدية، وخلدت
اللوم الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم في آيات نتلوها إلى يوم القيامة.
لكن ابن أم مكتوم لم يكن مجرد نموذج، بل
مثل أثره مدرسة أزهرت بفروعها على مر تاريخنا الإسلامي، ليمتد خيط القدوة في
التابعين إلى مفتي مكة؛ عطاء بن أبي رباح، الذي كان أعرج، ثم أصيب بالعمى، وانتهت
إليه الفتيا بمكة، وعده معاصروه من الفقهاء أعلم الناس بمناسك الحج.
الترمذي والأعمش
وفي طبقة أئمة الحديث، يمثل أبو عيسى
الترمذي، صاحب السنن، شاهداً مهماً في السياق ذاته، فقد بكى حتى عمي، وبقي ضريراً
سنين، كما تنقل عنه ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي، ومع ذلك أخرج كتابه
الشهير، الذي صار أحد أشهر الكتب الستة في مرويات السُّنة النبوية.
قدم الترمذي نموذجاً مبكراً للتكييف
المعرفي، فتعذر البصر لم يمنع التحصيل والتصنيف والنقد، لأن البيئة العلمية وقتها
احترمت الحافظة والضبط والرحلة والإجازة كبدائل عملية للأدوات البصرية، وهو ما
يلهمنا ضرورة تصميم بيئات صديقة لذوي الهمم في مجتمعاتنا باعتبارها حقاً شرعياً،
وليس مجرد فضل أخلاقي.
وفي مدرسة الكوفة الحديثية، لُقب سليمان
بن مهران بـ«الأعمش» لضعف بصره، ومع ذلك أصبح «شيخ المحدّثين» في طبقته، ذائع
الرواية والإتقان؛ ما برهن على أن قوة المنهج (نقد الأسانيد، وملازمة الشيوخ،
وتقييم الأقران) هي الفيصل في تحقيق القيمة العلمية والمعرفية.
وفي إطار المدرسة ذاتها، يبرز أبو معاوية
محمد بن خازم، الضرير، إذ كان من حفاظ الكوفة، وأصيب بالعمى صغيراً وصار من أوثق
رواة الأعمش ولازمه لنحو عشرين سنة.
وفي علوم القراءات، قدم الشاطبي (القاسم
بن فيره الشاطبي، الضرير) نموذجاً آخر لحقيقة أن فقد البصر لا يحول دون ريادة
العلم والمعرفة؛ فقد كُف بصره صغيراً وأنتج «حرز الأماني ووجه التهاني» التي صارت
عمدة لدارسي القراءات السبع إلى اليوم.
نموذج حضاري
ولولا البيئة الحاضنة التي وجدها نجومنا
المضيئة من علماء المسلمين ذوي الهمم في المجتمع الإسلامي، لما كان عطاؤهم العلمي،
ولما كان نموذجهم الحضاري، إذ إن هذه البيئة هي التي قدمت التقدير العملي لقيمة
الإنسان بروحه وعقله قبل جسده.
فروح الرؤية الإسلامية لا تنظر إلى
الإعاقة على أنها نقص أو عجز، بل هي ابتلاء وامتحان، على نحو ما ورد في قول النبي
صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يُشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجةً،
وحط عنه بها خطيئة» (متفق عليه)، وهو الحديث الشريف الذي يصنف الإعاقة باعتبارها
سبباً محتملاً في رفع الدرجات ومغفرة الذنوب، إذا صاحبها الصبر والاحتساب.
ومع أن موضوع هذا المقال تاريخي في
جوهره، فإن المقارنة مع واقع دمج ذوي الهمم في مجتمعاتنا اليوم مفيدة لفهم شروط
النجاح المؤسسي في تحويل مدرسة ابن أم مكتوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى
بيئة مصممة على أساس صديق لذوي الهمم، خاصة أن عديد البيانات العربية المعاصرة في
التعليم الدامج تظهر فجوات كبيرة في جاهزية المدارس وتأهيل المعلمين والبنية
الداعمة لذوي الهمم، ومنها تقرير «الإسكوا» عن الإعاقة في المنطقة العربية (2018م)
الذي استخدم بيانات تعدادية ومسوحاً أثبتت استمرار فجوات التعليم والعمل للأشخاص
من ذوي الهمم.
كما تبين دراسة استقصائية أجراها د. خالد
بن فهد الغنيم حول «معوقات مشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية بالمملكة
العربية السعودية» على عينة من 278 شخصاً من ذوي الإعاقة (بصري، سمعي، حركي)، أن
المعوقات الصحية هي العائق الرئيس أمام مشاركتهم في الأنشطة، وليست الإمكانات
المادية أو التجهيزات، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين
لصالح الذكور؛ ما يشير إلى الحاجة لبرامج تستهدف الإناث من ذوي الإعاقة بشكل خاص.
بيئة تعليمية
إن تصميم بيئة تعليمية صديقة لذوي الهمم
يفرض علينا الانتقال من خطاب القدوة إلى تحديد معايير عملية لمنهجية التربية
والتعليم داخل مدارسنا وجامعاتنا، وهي المعايير التي تبدأ بثلاث طبقات مترابطة؛
حوكمة واضحة تحدد مسؤوليات الدمج ومواردها، وخطة تربوية ذات تقويمات بديلة، وبنية
وصول مادية ورقمية ترفع الحواجز أمام دمج ذوي الهمم في تحصيل العلم والمعرفة.
وفي هذا الإطار، يعد رفع الحرج عن ذوي
الأعذار مع إبقاء حقهم في المشاركة مقصداً قرآنياً، كما ورد في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) (النور: 61)؛
ما يعني أن تصميم بيئة صديقة لذوي الهمم ينبغي أن يلتزم بهذا المقصد بوصفه معياراً
رئيساً.
وبهذه العدسة يصبح: كيف نسهل عملية
الدمج؟ السؤال المحوري في مؤسساتنا بدلاً من سؤال: هل يستطيع ذوي الهمم الاندماج؟
ومن إجابته يمكن ترجمة سير ابن أم مكتوم، والترمذي، والشاطبي، إلى معايير قبول
وترق تقوم على الجدارة العلمية وفق فرص متساوية لجميع بني آدم.
اقرأ أيضاً:
















