فقه الوسطية اللغوية الدعوية (1 - 2)
لغة الدعاة بين التكلف والابتذال
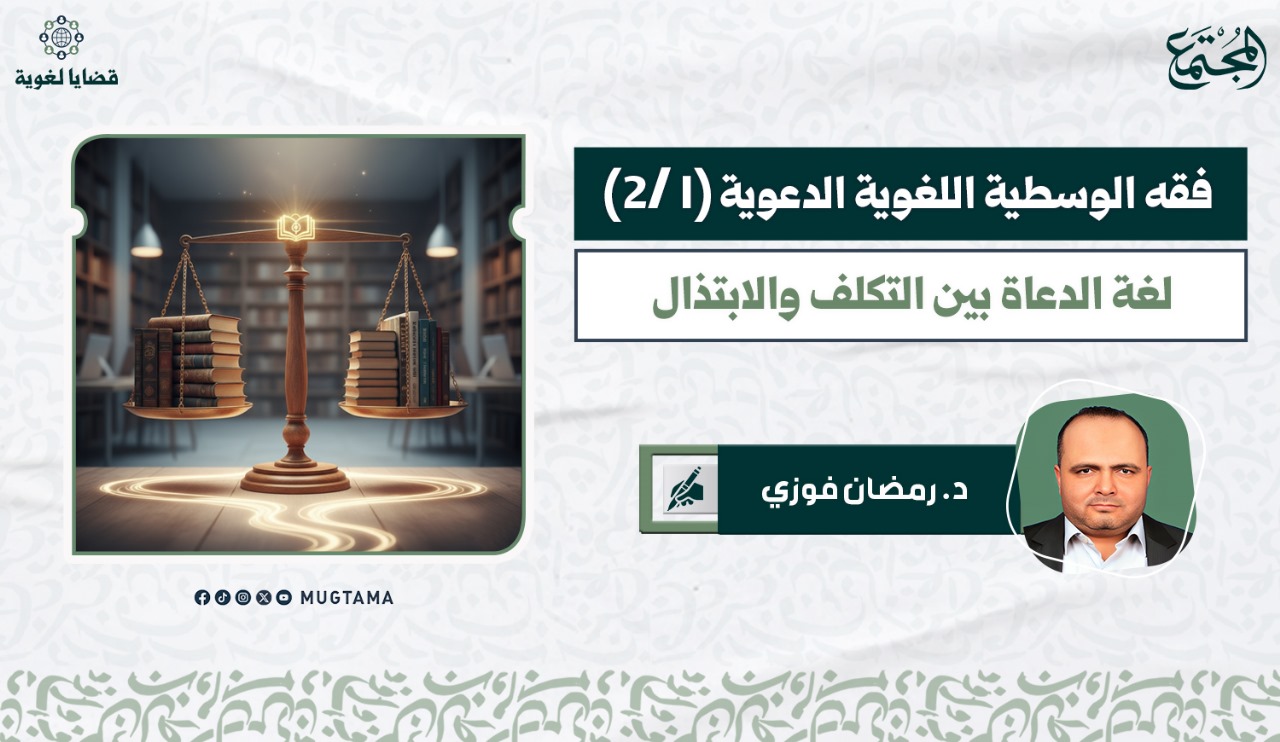
تؤكد النصوص
الشرعية أن اللغة ليست مجرد أداة اتصال، بل ركيزة لإقامة الحجة وأساس التبليغ، قال
الله تعالى: (وَمَا
أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)
(إبراهيم: 4)؛ حيث تدل هذه الآية دلالة واضحة على أن اتفاق اللسان شرط
ضروري للإبانة والتبليغ، اللذين يعدان المقصد الأسمى لإرسال الرسل، وقد شاء الله
عز وجل أن يشرف اللغة العربية ويجعلها لغة الإسلام الخالدة، فأنزل بها القرآن
الكريم: (إِنَّا
أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (يوسف: 2)،
وقال عز وجل: (وَكَذَلِكَ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ
حَوْلَهَا) (الشورى: 7).
إن الاعتناء
باللغة العربية يتجاوز كونه فضيلة إلى مرتبة الشعيرة الدينية والحضارية، وفي هذا
المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات
من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميّزون»، بل إن تعلمها أصبح واجباً شرعياً مرتبطاً
بفهم المصدرين الأساسيين للدين، كما قال الإمام الشاطبي: «من أراد تفهم القرآن فمن
جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة».
وإذا كان الدعاة
هم ورثة الأنبياء في تبليغ رسالة الإسلام، فالواجب يحتم عليهم تعظيم هذا الشعار
وإتقان هذه الأداة؛ فمن هنا ينطلق الفهم السليم للنصوص، ومن هنا يتجنب الداعية
الوقوع في الخطأ الذي حذر منه الإمام الشافعي بقوله: «ما جهل الناس، ولا اختلفوا
إلا لتركهم لسان العرب».
واقع الأداء اللغوي للدعاة
لا يخفى على
مراقب للواقع الحالي ما تمر به الأمة العربية والإسلامية من اغتراب ثقافي وتشظٍّ
فكري، ربما يكون انعكاساً لواقع سياسي مأزوم، له أثره المباشر والواضح على اللغة
العربية التي تعاني من هجران اجتماعي وتنحية لها من معظم مظاهر الحياة العامة، حتى
انزوت في بطون الكتب والمراجع التراثية المقصورة على الباحثين والأكاديميين.
وحال الدعاة في
التعامل مع الواقع المأزوم للغة العربية لا يختلف كثيراً عن باقي شرائح المجتمع،
فالمتتبع له يجده على النحو التالي:
أولاً: التشدد والتقعر:
يتبنى هذا
الفريق منهجاً متشدداً في الأداء اللغوي، فهو يستخدم من الألفاظ أصعبها ومن
العبارات أعقدها ومن المعاني أبعدها عن الفهم، وكأنه في سوق عكاظ أو ذي المجاز أو
المربد، أو كأنه يتحدث أمام حكام العرب في اللغة والأدب كالنابغة الذبياني، أو
الأقرع بن حابس، فكأنهم في منافسة لغوية تاريخية وليس مهمة تبليغ ودعوة.
أما النتائج
السلبية لهذا المنهج فتتمثل في:
- حجب الدعوة: حيث يصبح خطابهم محجوباً عن شريحة عريضة من عامة الناس الذين تتوقف معارفهم عند أساسيات القراءة والكتابة؛ فـالإبانة لا تتحقق إلا بالوضوح.
- التنفير من الدين: حيث يظن بعض الناس أن هذه اللغة المتقعرة طقس من طقوس التدين لا يمكن الاستغناء عنه، فيؤدي ذلك إلى نفورهم من الدعوة واللغة معاً.
- استغلال المتربصين: حيث يجد المتربصون بالدين ذريعة للاستهزاء من كل داعية أو متدين، من خلال تقليد هذا التقعر اللفظي أو المبالغة فيه، وهو ما يشوه صورة الدعاة في الإعلام.
- مخالفة منهج
التيسير: حيث يبتعد هذا الأسلوب عن روح الإسلام السمحة التي تتجلى في لغة القرآن
والسُّنة؛ فالإسلام جاء للتيسير، والتقعر اللغوي يوقع المستمع في عسر.
ثانياً: الإفراط في العامية والتفريط في الفصحى:
وهناك فريق أراد
التيسير في الدين لتحبيب الناس فيه وسرعة وصوله إلى قلوبهم وعقولهم؛ فحسنت نيتهم
وساءت وسيلتهم؛ حيث تساهلوا في اللغة أيما تساهل، وأغرقوا في العامية ولهجاتها؛
فنزلوا إلى حضيض المجتمع، وبدل أن يرتقوا به وبلغته تأثروا به وأقروه على ما هو
عليه؛ فتجد لغة أحدهم أمشاجاً مختلطة من اللغة العامية وبعض الألفاظ والمصطلحات
الأجنبية وبعض العبارات باللغة الفصحى وما يحفظه بالكاد من شواهد قرآنية أو أحاديث
نبوية، أو إن تحسنت حاله قليلاً حفظ بيتاً أو بيتين من الشعر، متناسين أن كثيراً
من مدعويهم الذين نزلوا إليهم يتقنون أكثر من لغة أجنبية، وأنهم قادرون على إتقان
العربية إن وجدوا منهم تشجيعاً على ذلك، وقد ساعد على انتشار هذا الأمر تنامي ما
سمي بظاهرة «الدعاة الجدد».
إننا لا ندعو
هؤلاء إلى أن يكونوا جهابذة في اللغة، ولا نقول لمن لا يتقن اللغة: «توقف عن
الدعوة»؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «بلغوا عني ولو آية..»، ولكن على من
يتصدى للدعوة العامة في الناس أن يتعلم من اللغة ما يفهم به الدين، وما يحسن به
تبليغه للناس، دون لبس أو إلباس.
أما النتائج
السلبية لهذا الفريق فتتمثل في:
- لغة مشوّهة: يصبح خطاب الداعية أشبه بـأمشاج مختلطة، يفقد فيها الاستشهاد بالآية القرآنية أو الحديث النبوي تأثيره وجلاله، ويشعر المستمع بـالتنافر اللفظي الحاد عند الانتقال المفاجئ من العامية المبتذلة إلى الفصحى الراقية.
- تقزيم رسالة الدعوة: يؤدي الاقتصار على العامية إلى حصر الدعوة في حدود جغرافية ضيقة (لهجة أهل الخليج، لهجة المغاربة، لهجة أهل الشام..)، وهو ما يحجبها عن الأمة الأوسع ويقلل من شموليتها.
- تهمة تمييع الدين: قد يُتهم هؤلاء بـتمييع الدين والتفريط في اللغة التي هي وعاء الوحي، وهو ما يشجع الشباب على هجر اللغة الفصحى والاكتفاء بما يسمعونه من عاميات ركيكة من قُدواتهم.
- خطر تحريف
الفهم: يبقى السؤال الجوهري هنا: كيف يمكنهم فهم معالم الدين ومقاصده دون إتقان
لغة الوحي؟ إن التساهل اللغوي يهدد أصالة الفهم ويخشى معه التحريف أو التبديل غير
المقصود في مقاصد الدين الأساسية.
ثالثاً: وسطية اللغة والدعوة:
وهذا الفريق
لغته سهلة عذبة رقراقة، تصل إلى الأذن فتطربها وإلى العقل فتحركه وإلى القلب
فترققه، يفهمها المثقف والأمي، كما يفهما المفكر والنخبوي، يفهما أبناء عامة الناس
كما يفهما أبناء الطبقة المخملية.
تجد أحدهم يتكلم
الساعات الطوال فلا تكل ولا تمل؛ فعبارته مفهومة ولغته واضحة ومعانيه سهلة، تجد
اتساقاً في كلامه بين ما ينطق به وما يستشهد به من آثار؛ فإذا استمعت له أنصتَّ
وإذا قرأت له تدبرت؛ فالإنسان أسير الإحسان وهو قد أحسن إليك إذ لم يشق عليك
بعبارته ولم يرهقك بألفاظه، وأيضاً لم تجد أذنك منه نشازاً ولم يُسمعك من القول
عواراً.
ونتائج هؤلاء
أكثر من أن تذكر وأكبر من أن يحاط بها؛ فليس أكبر ولا أعظم ممن تألفت حوله القلوب
وتشنفت له الآذان وفتحت له العقول؛ فحبب الناس في دين الله فأحبوه؛ فهو يجمع ولا
يفرق ويبني ولا يهدم ويبشر ولا ينفر، استوعب قول الله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ
لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)
(آل عمران: 159)؛ فهو قد لان قلبه فلانت عبارته دون ميوعة، ورَقَّ طبعه فلم
يغلظ قوله.
إن أزمة الدعوة
في تعاملها مع اللغة هي في حقيقتها أزمة في فقه التبليغ والإبانة، الدعوة الناجحة
هي التي لا تفرّط في أصالة لغتها (الوسطية ضد العامية) ولا تبالغ في تعقيدها
(الوسطية ضد التقعر).
إننا ندعو
الدعاة إلى الارتقاء بالناس إلى مستوى فصيح سهل ممتنع، لا إلى النزول بهم إلى
مستويات لغوية لا تحترم قدسية اللغة العربية كـ«شعار للإسلام»، فاللغة ليست قيمة
حضارية فحسب، بل هي قيمة دينية لا تقل أهمية عن كثير من قيم الدين التي يدعو إليها
الواعظ، الإتقان اللغوي هو جسر لا بد منه لضمان سلامة الفهم ونجاح التبليغ.
ولا شك أنه حتى
يتحقق هذا الأمر فإنه يحتاج إلى بعض المقومات والنصائح والواجبات التي نرجئ الحديث
عنها إلى المقال القادم بمشيئة الله تعالى.
اقرأ
أيضاً:
- سؤال الإعجاز: أين يقف كلام الله بين فنون القول العربي؟
- عروبة القرآن.. دلالة البيِّنة ومرامي التعقُّل والإنذار
- الحكمة من اختيار الله تعالى اللغة العربية لتكون لغة القرآن
الكريم
















